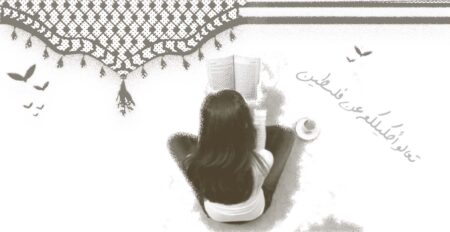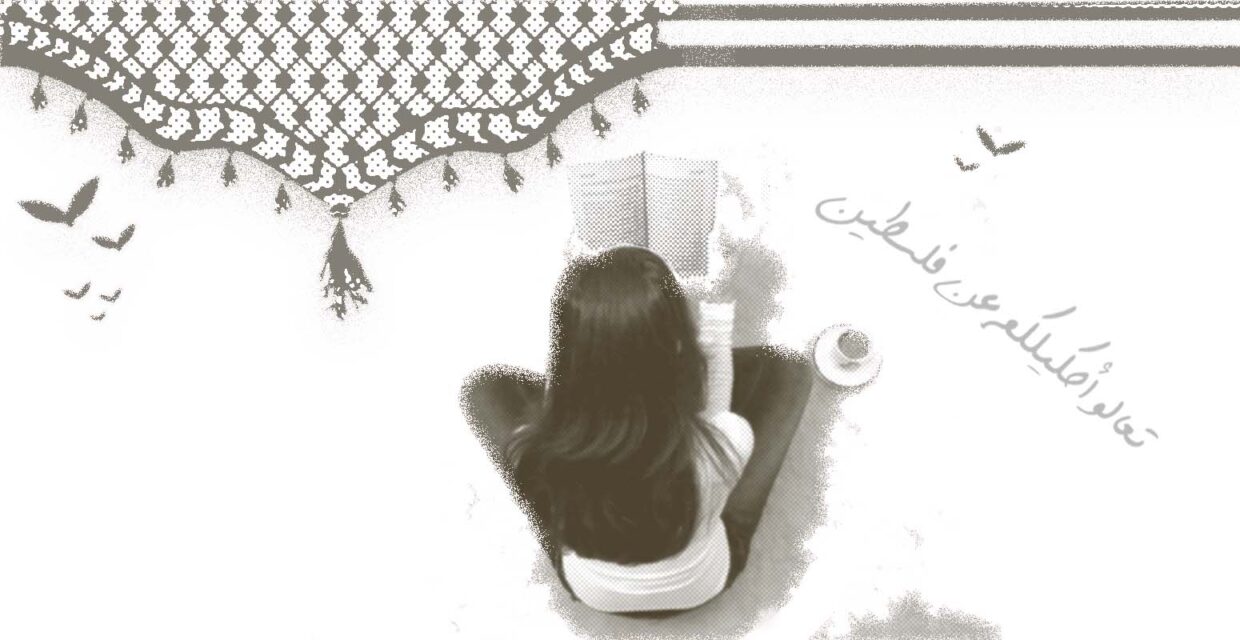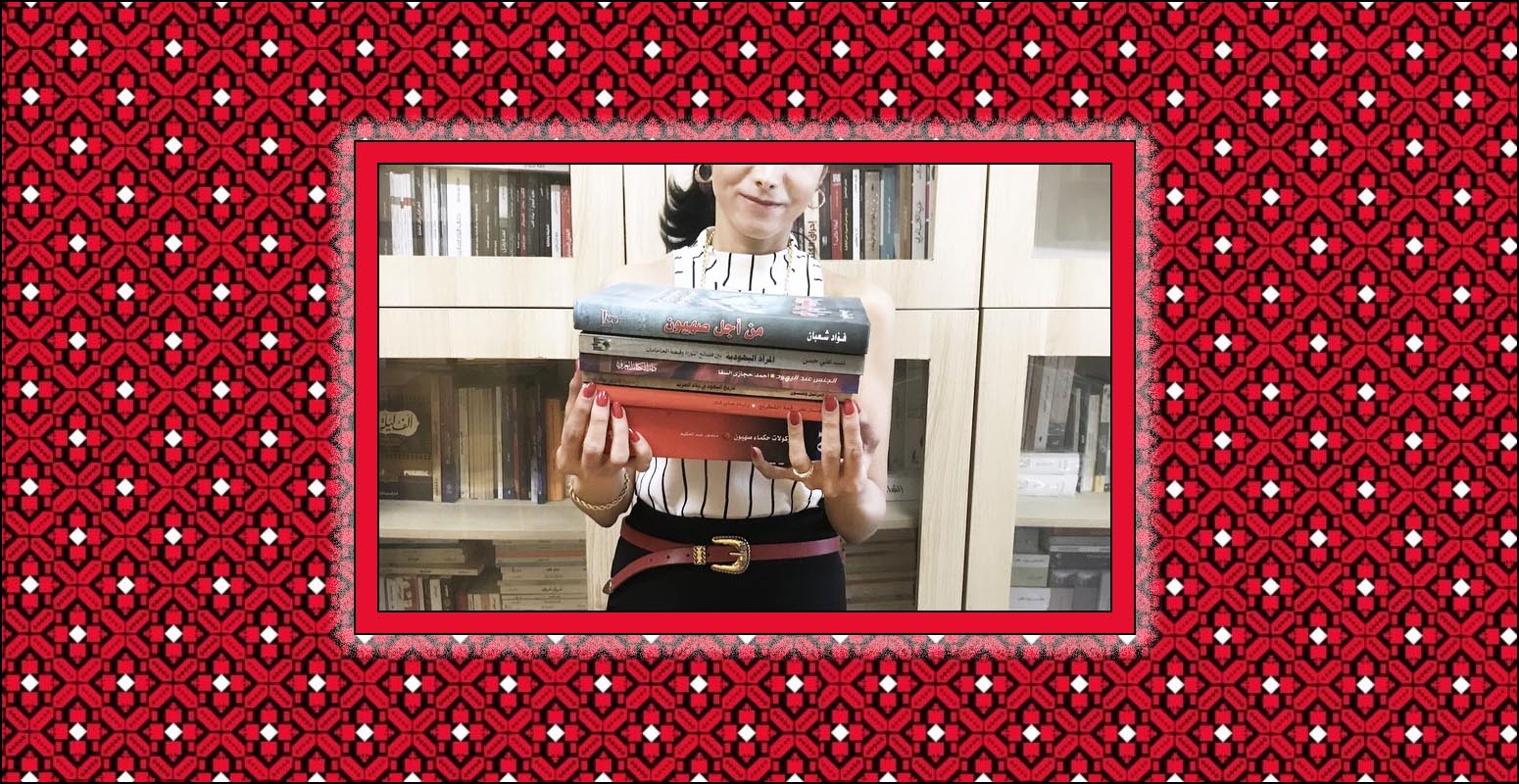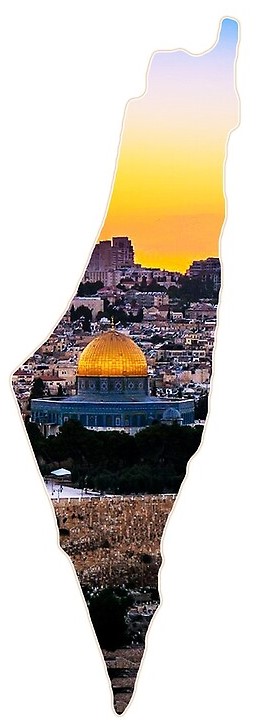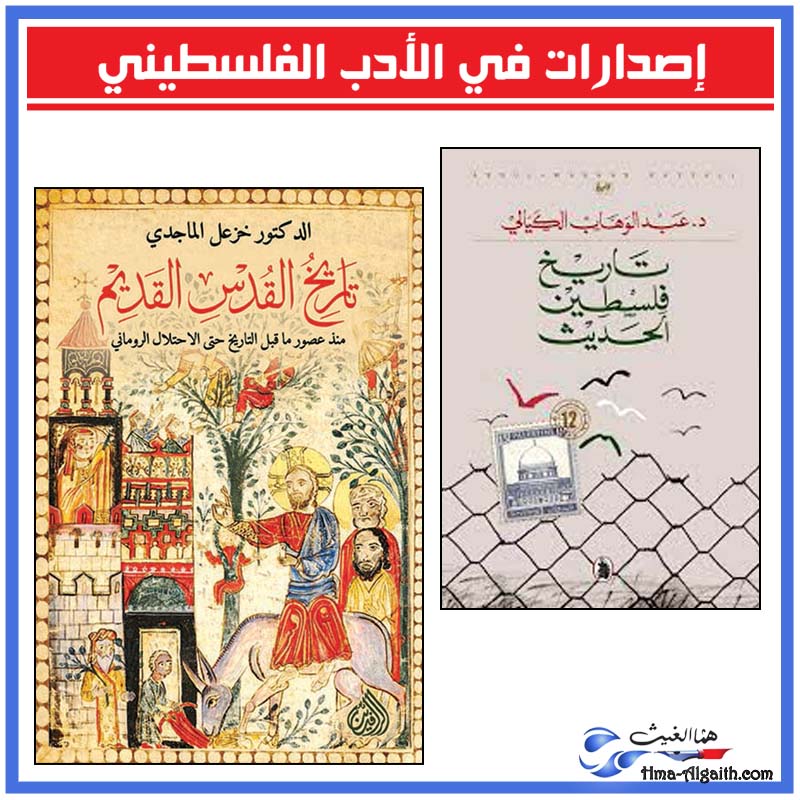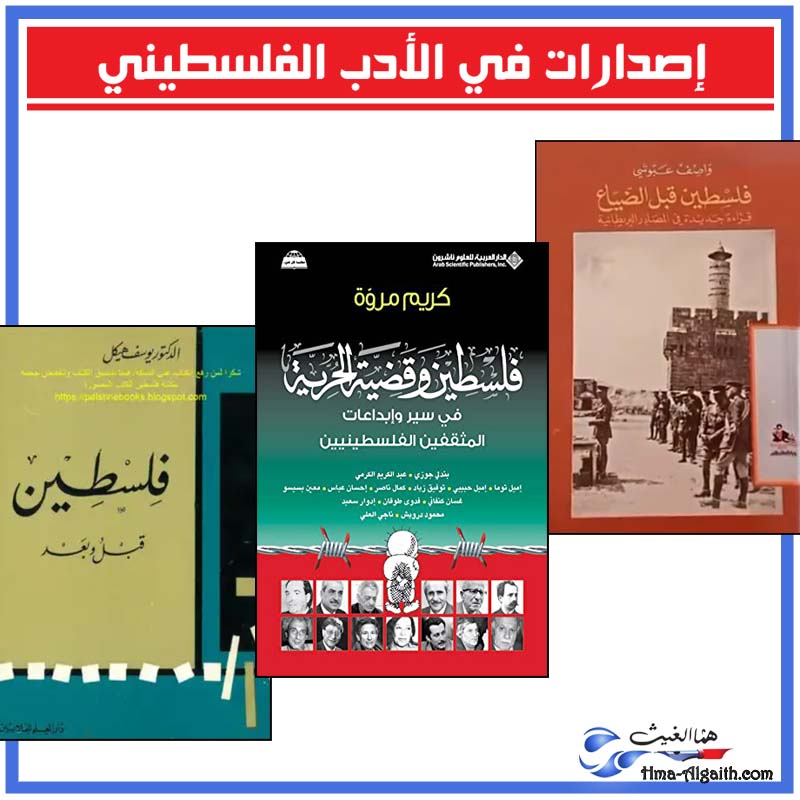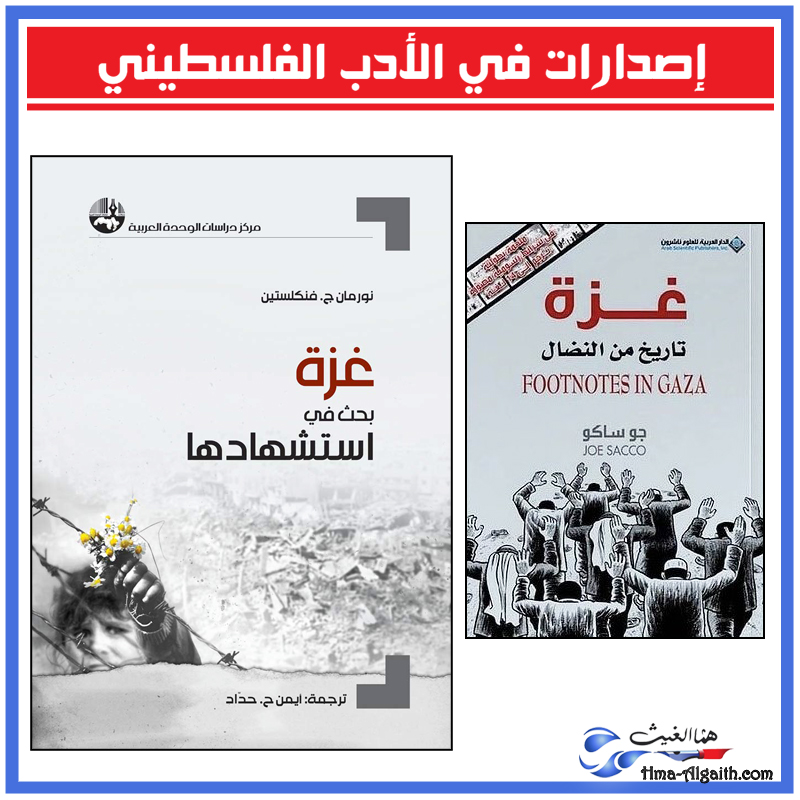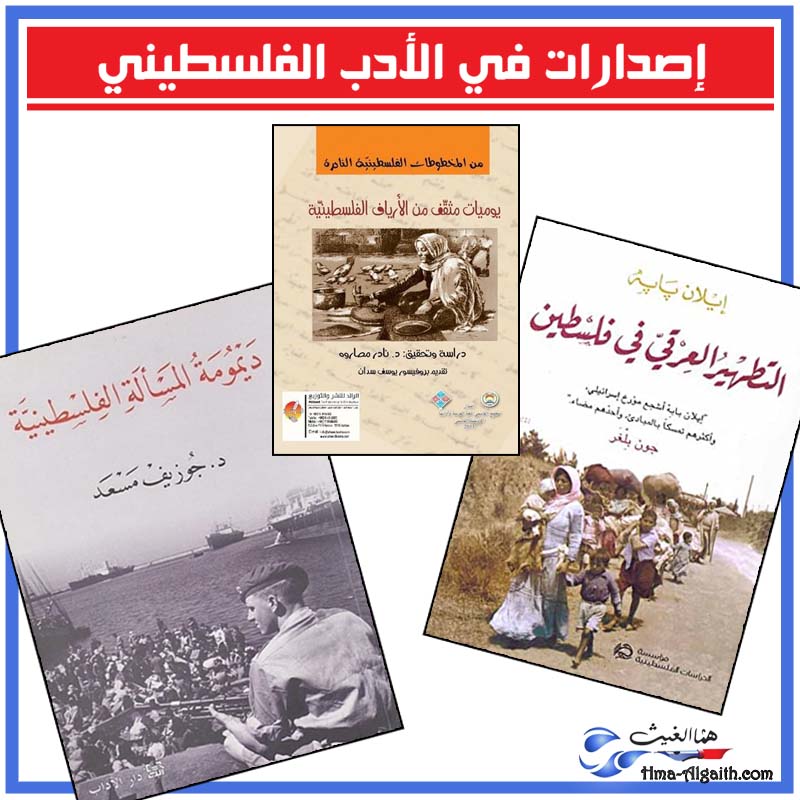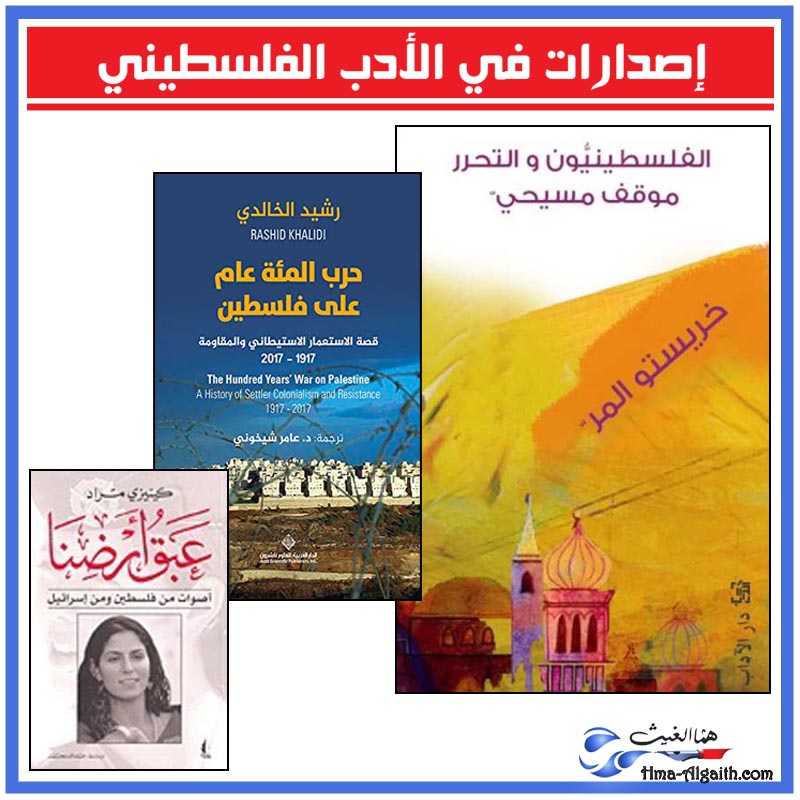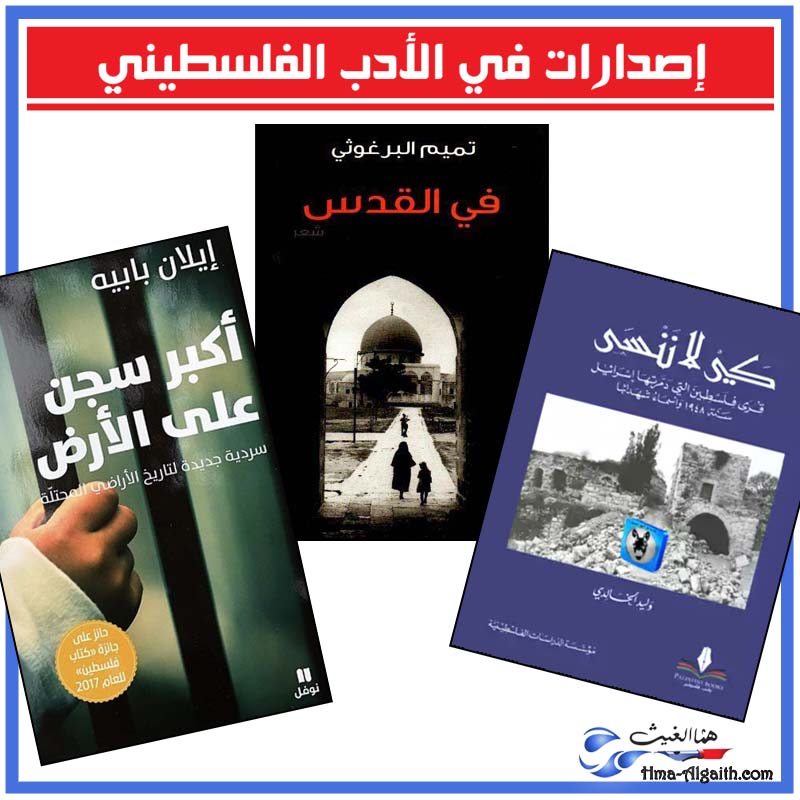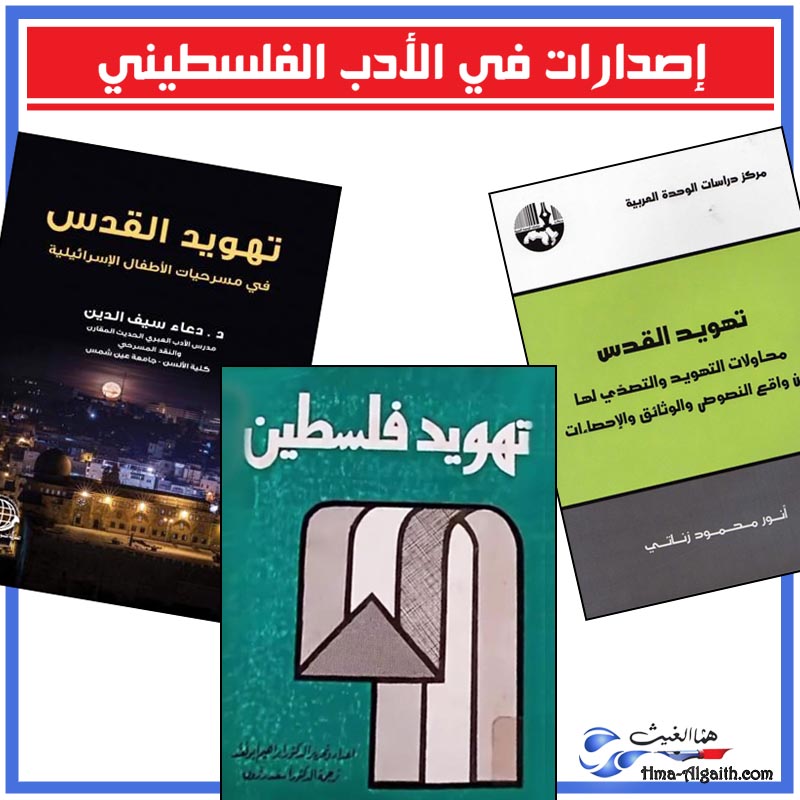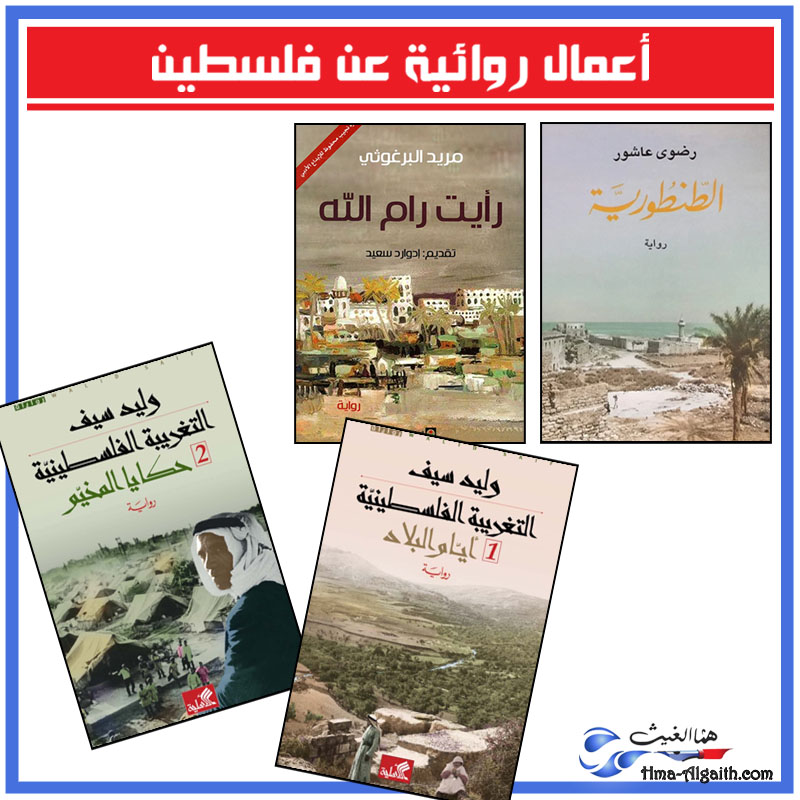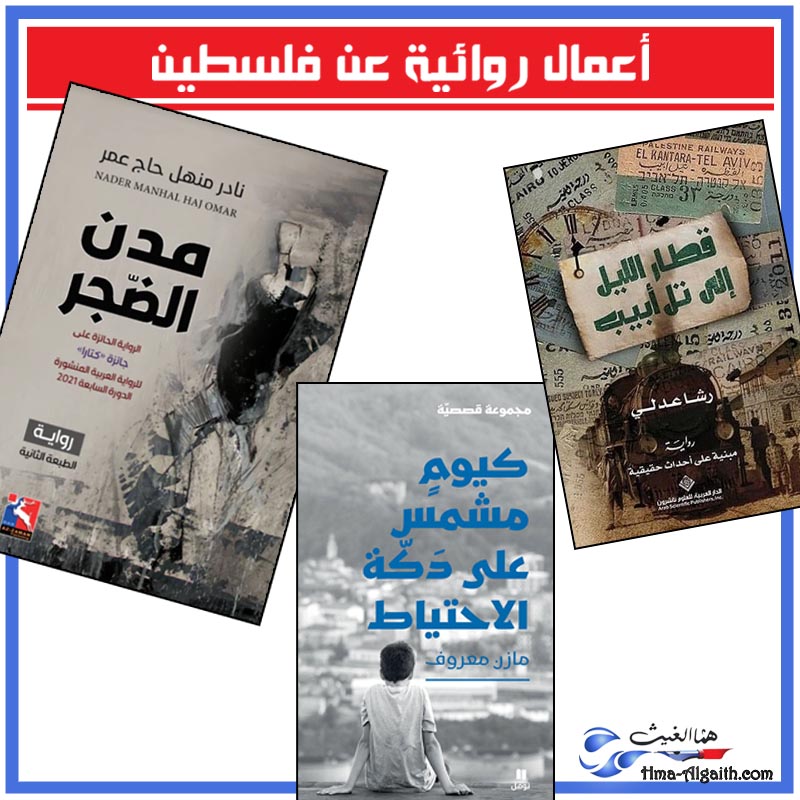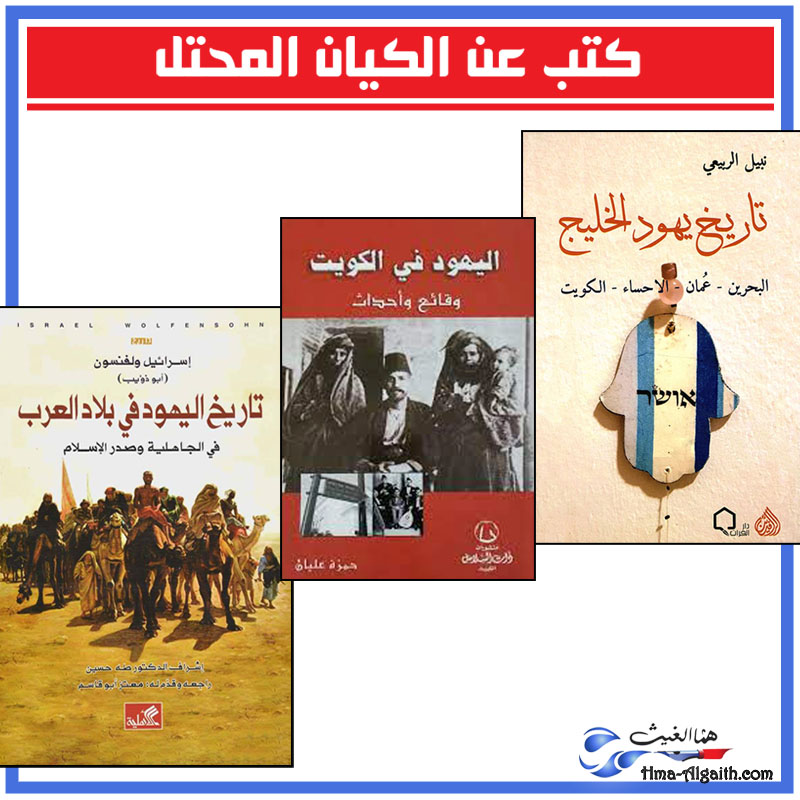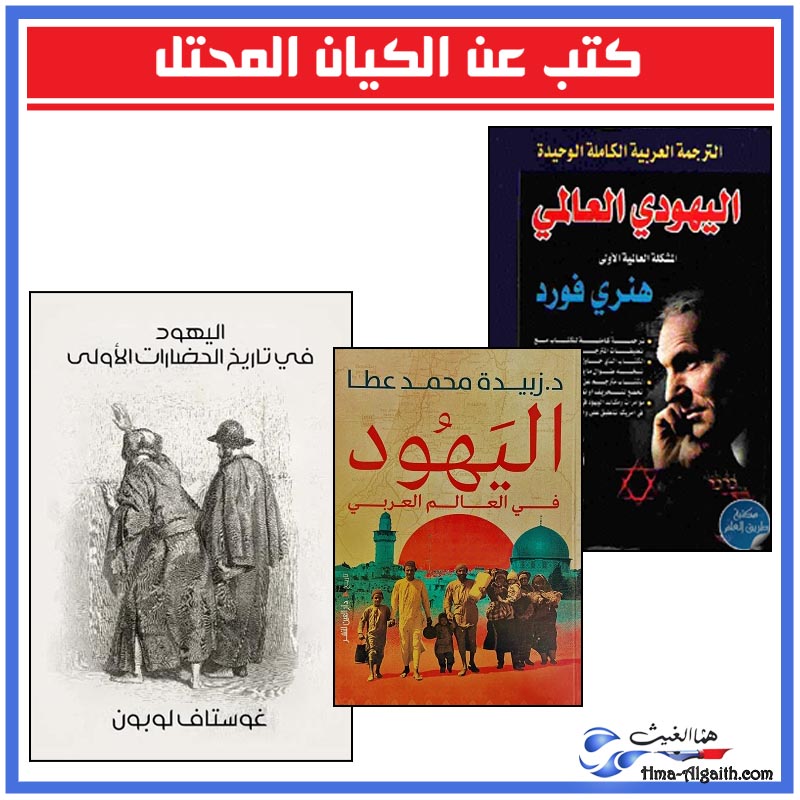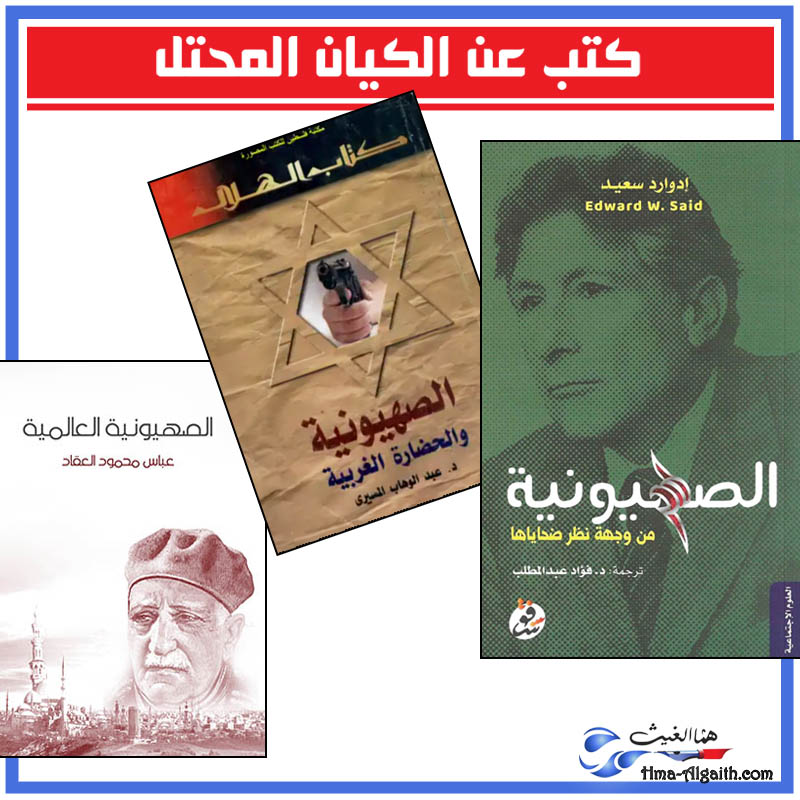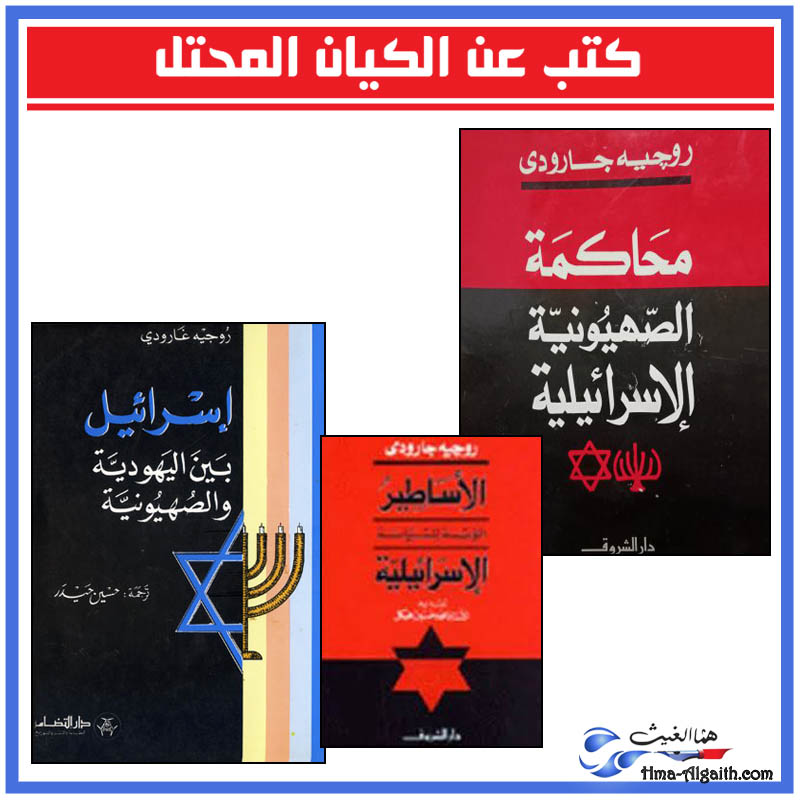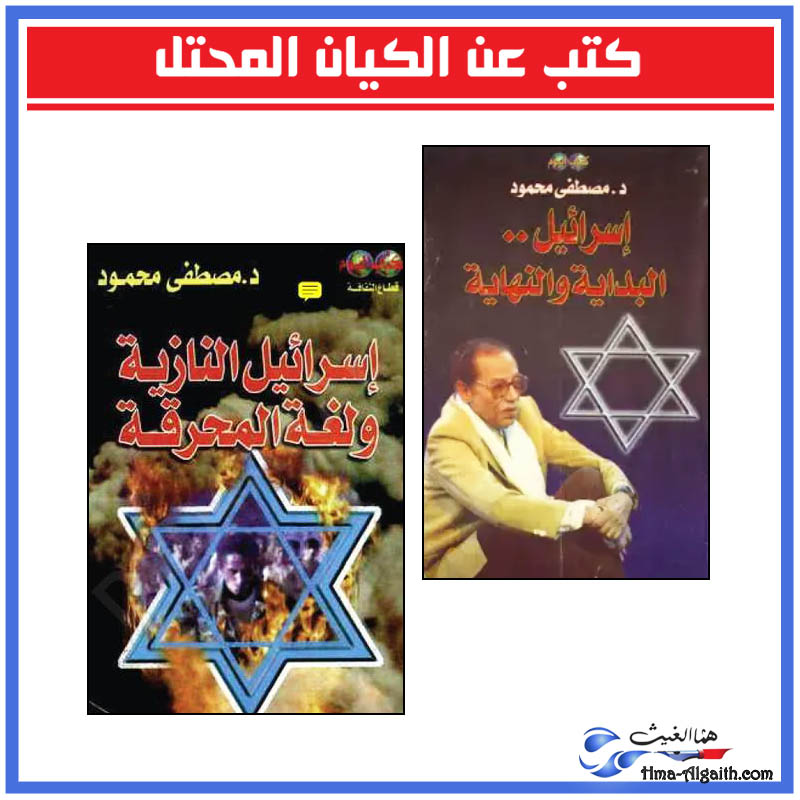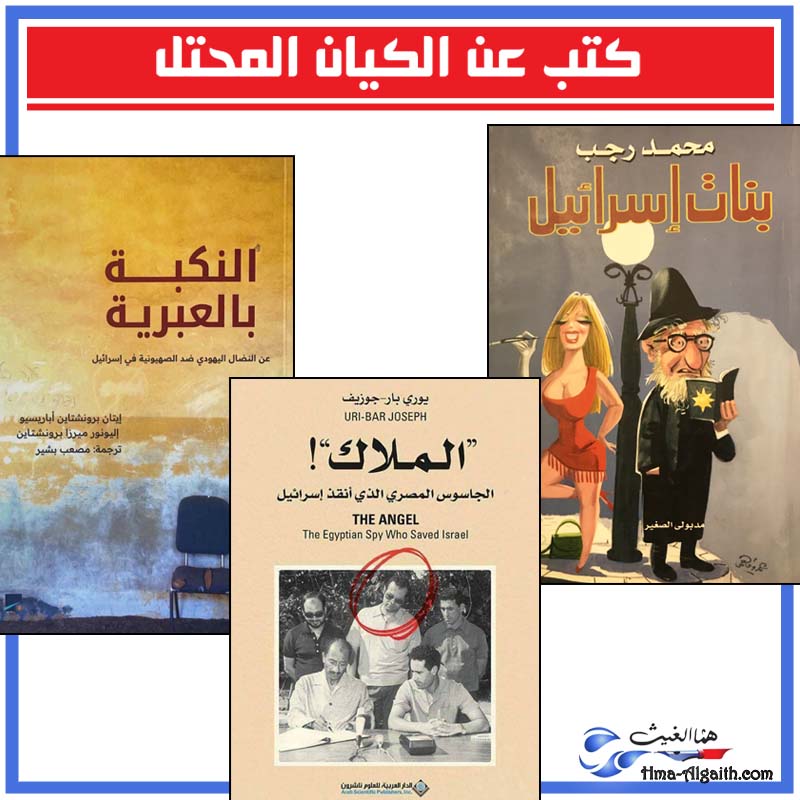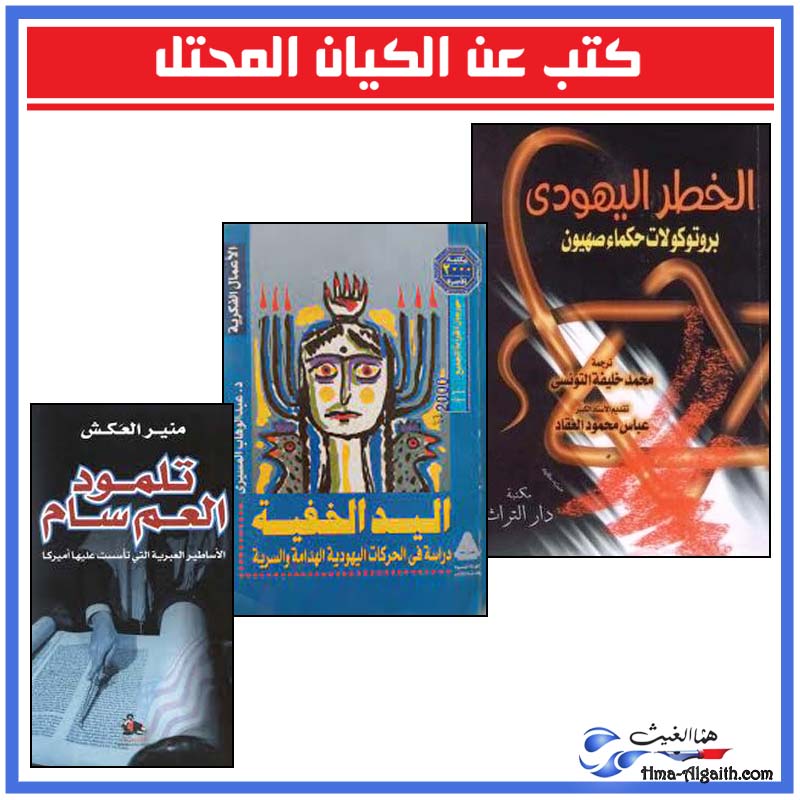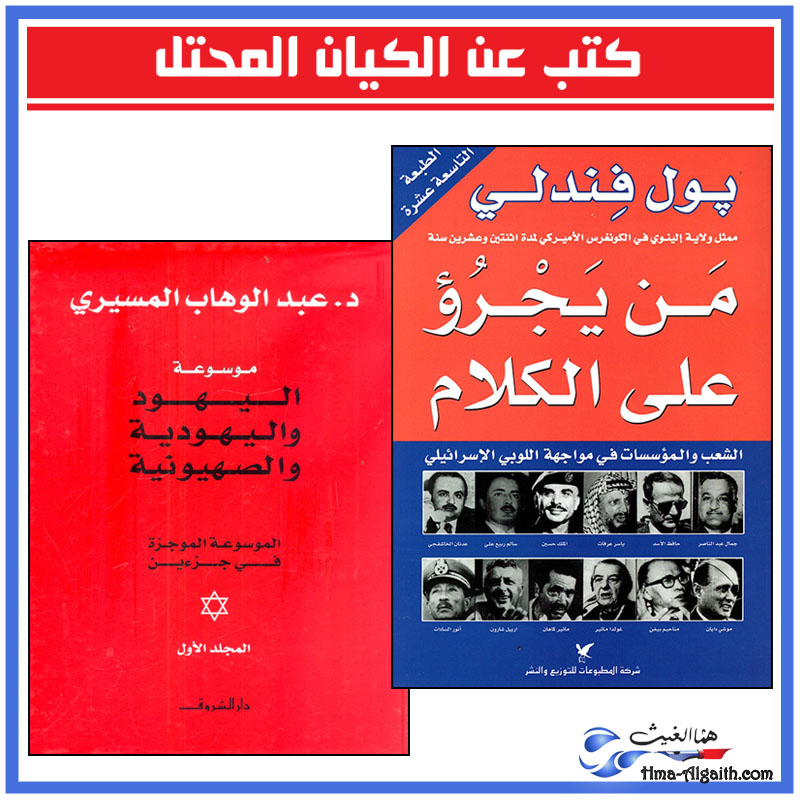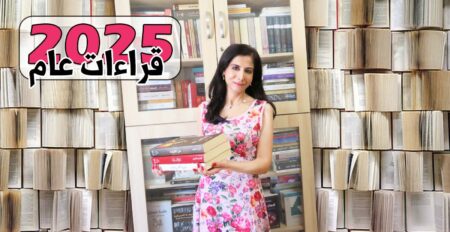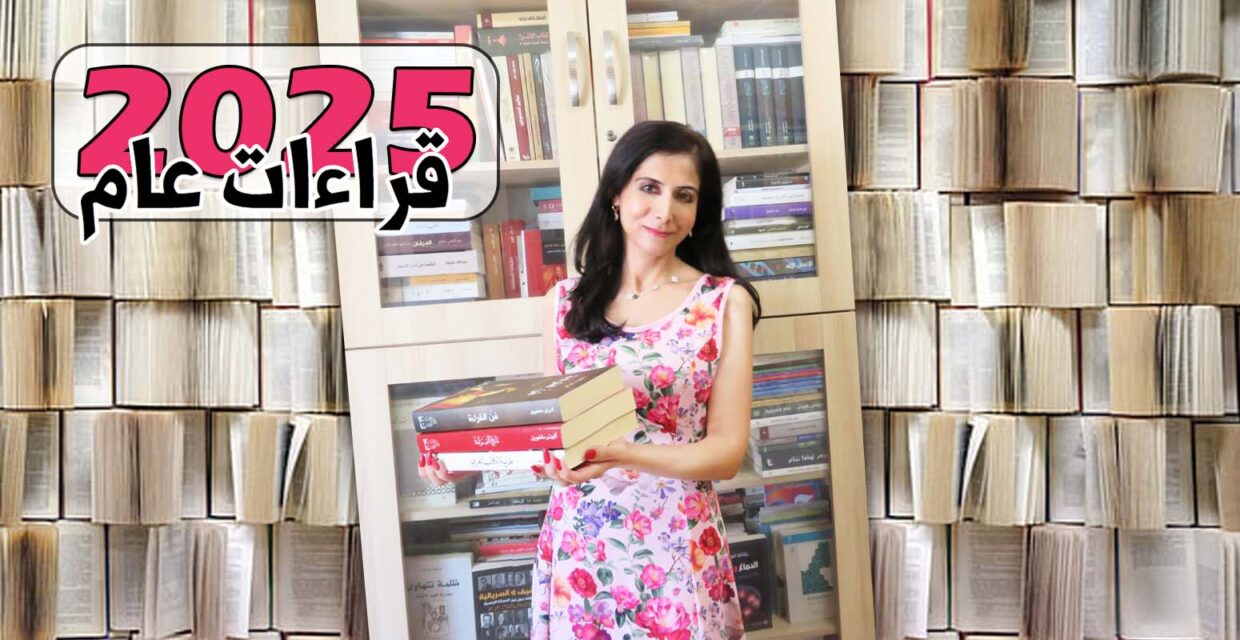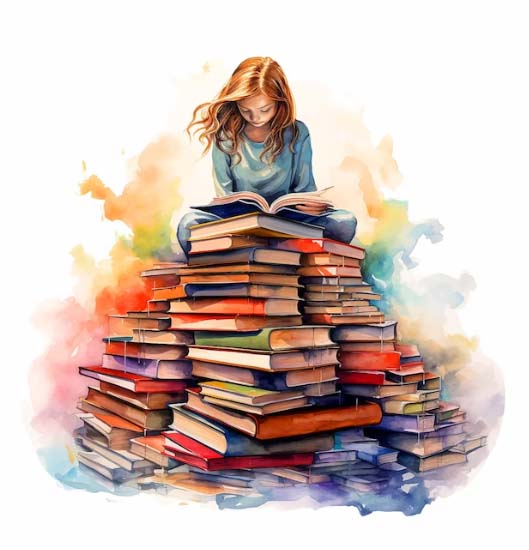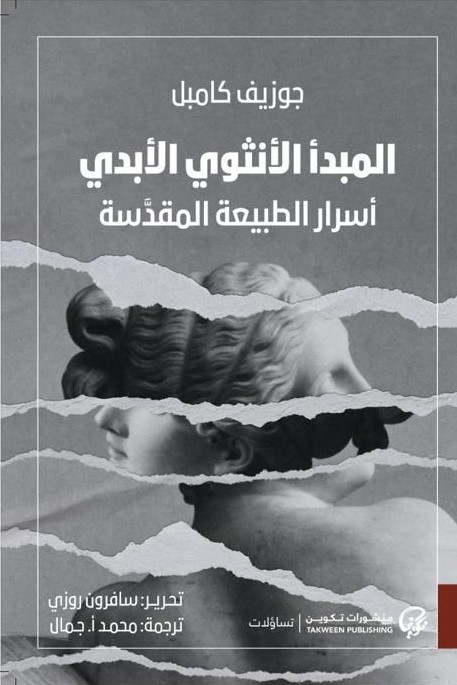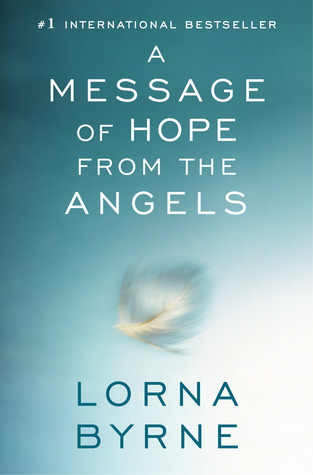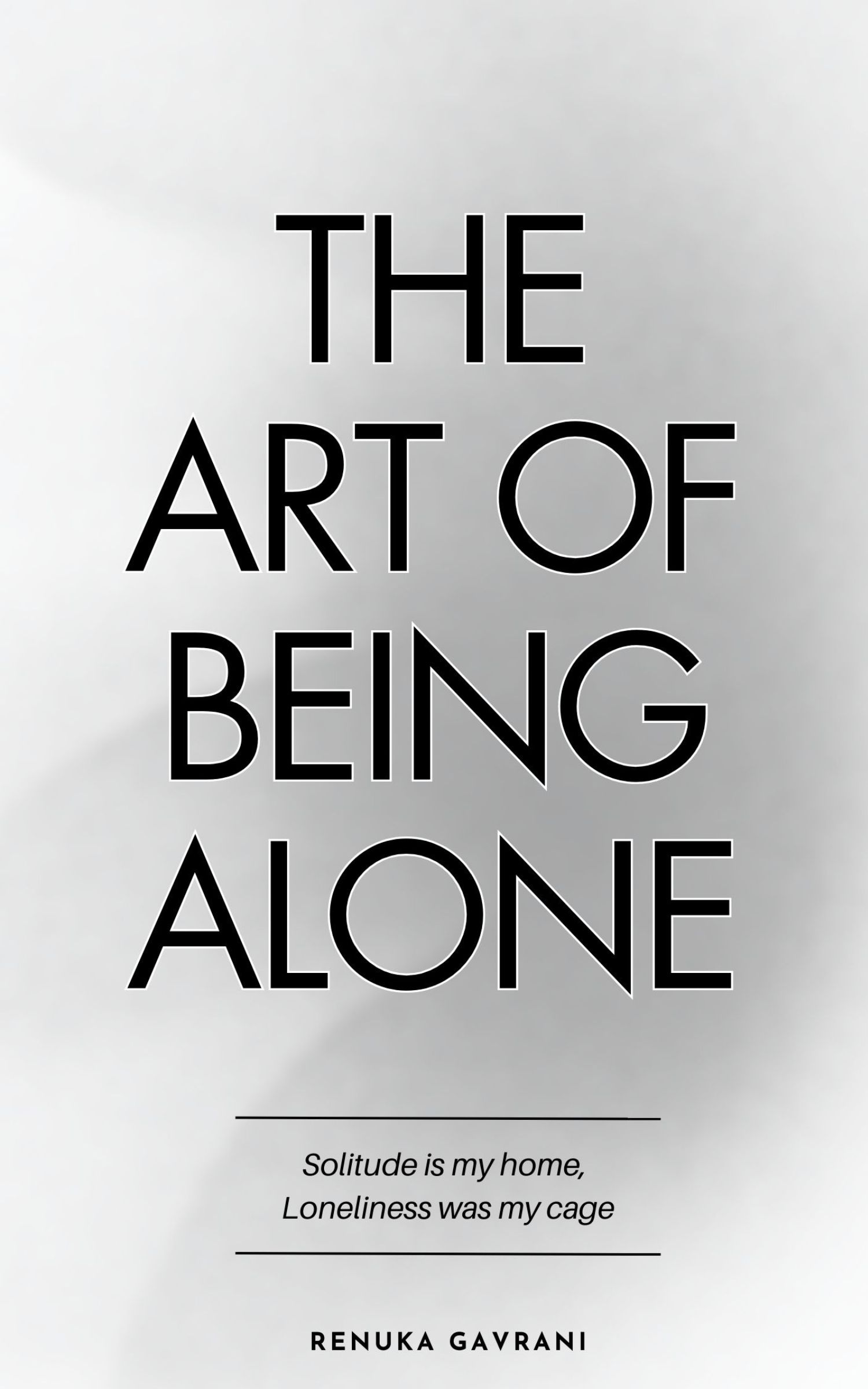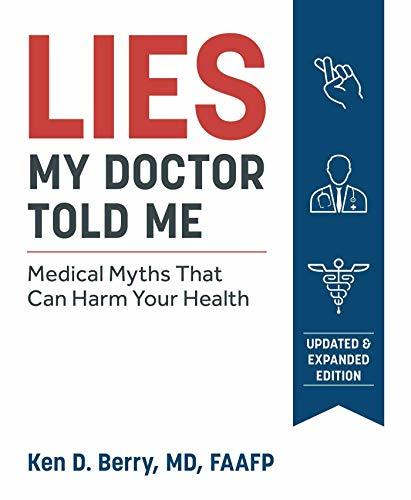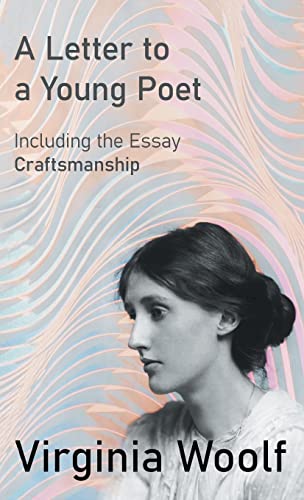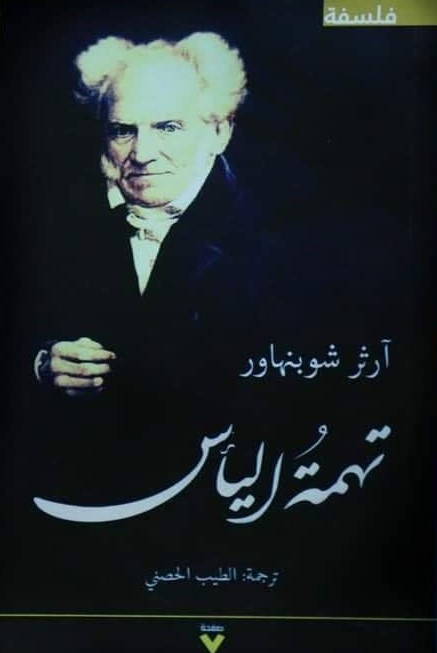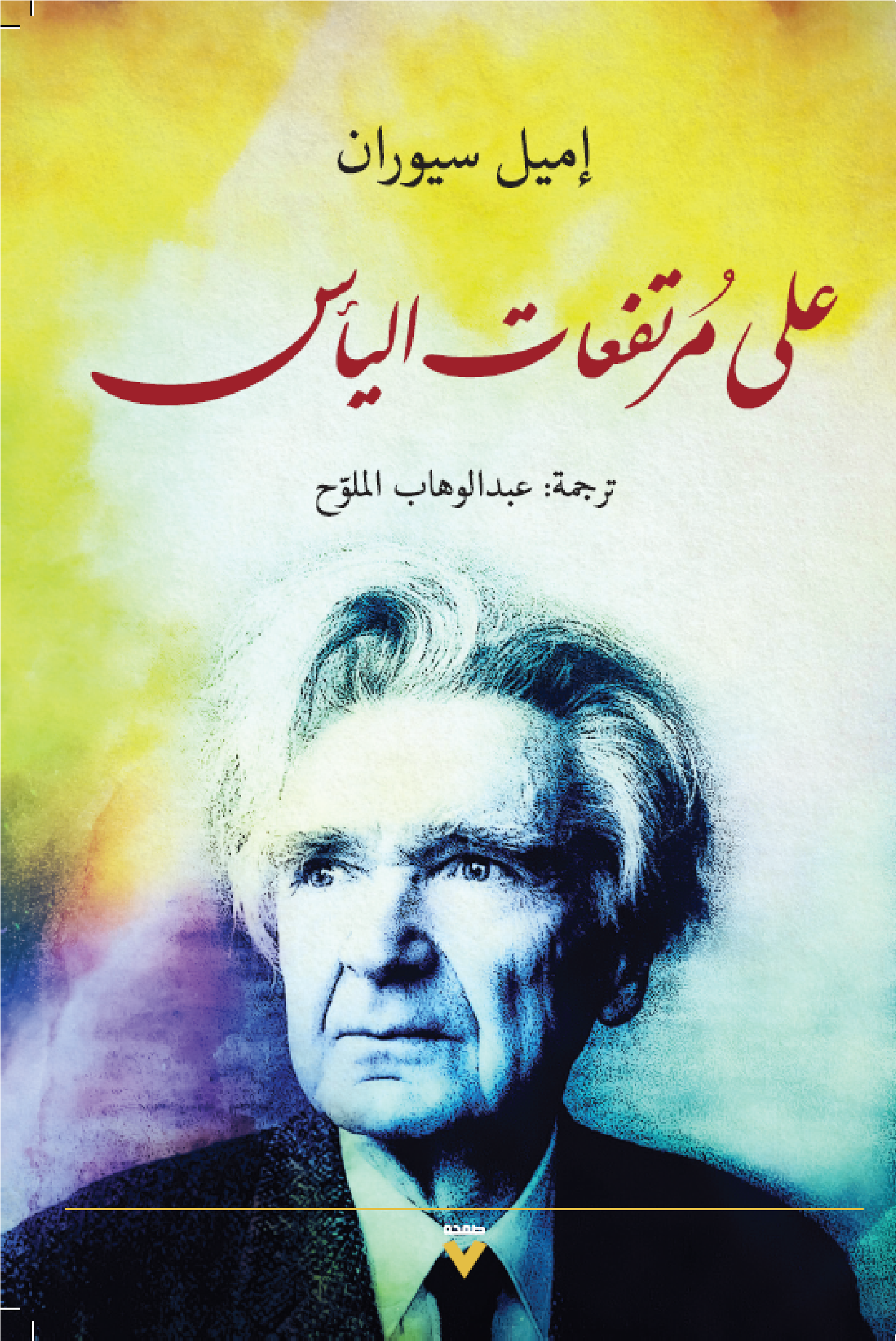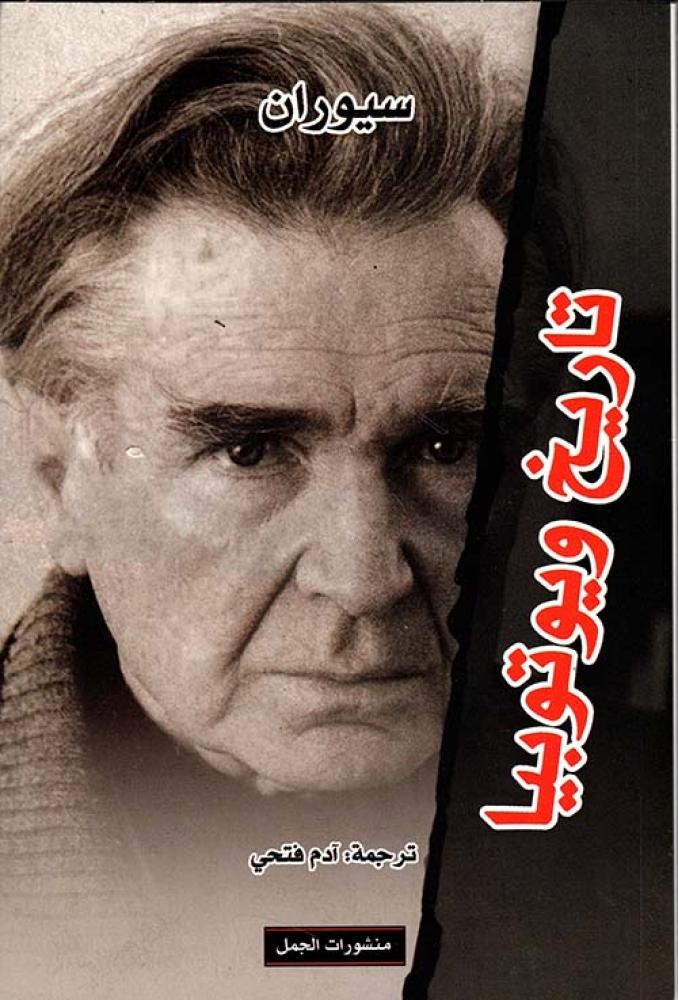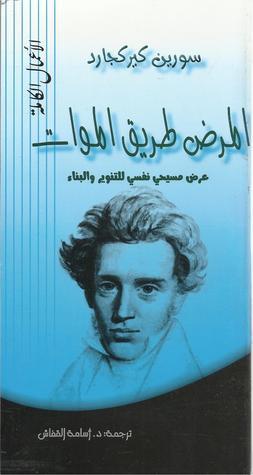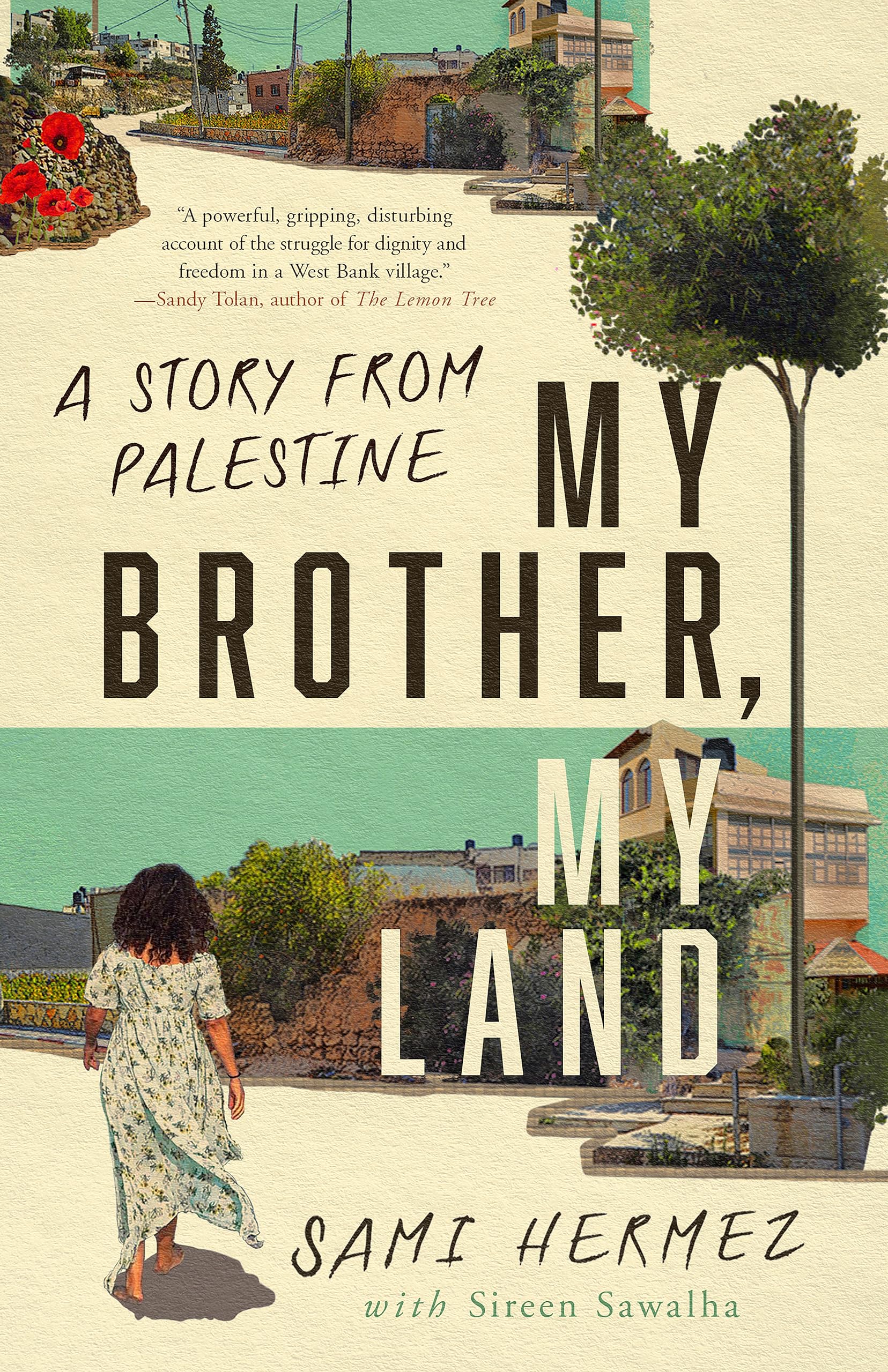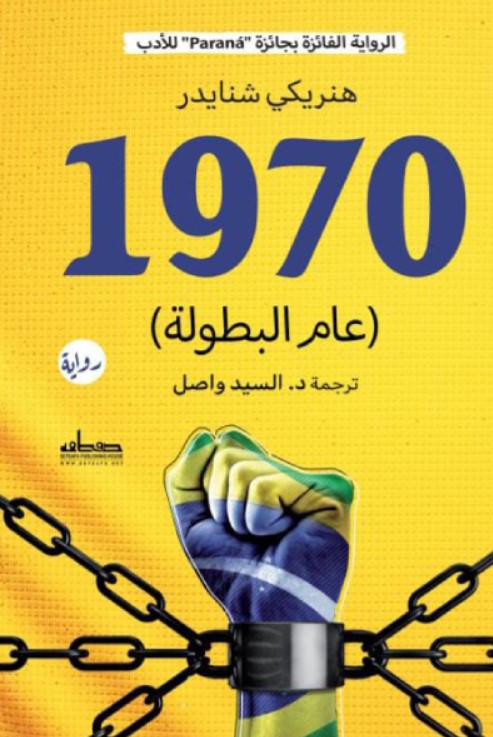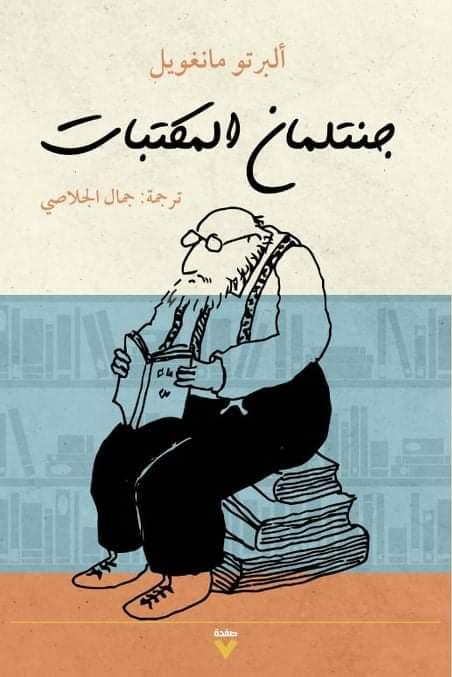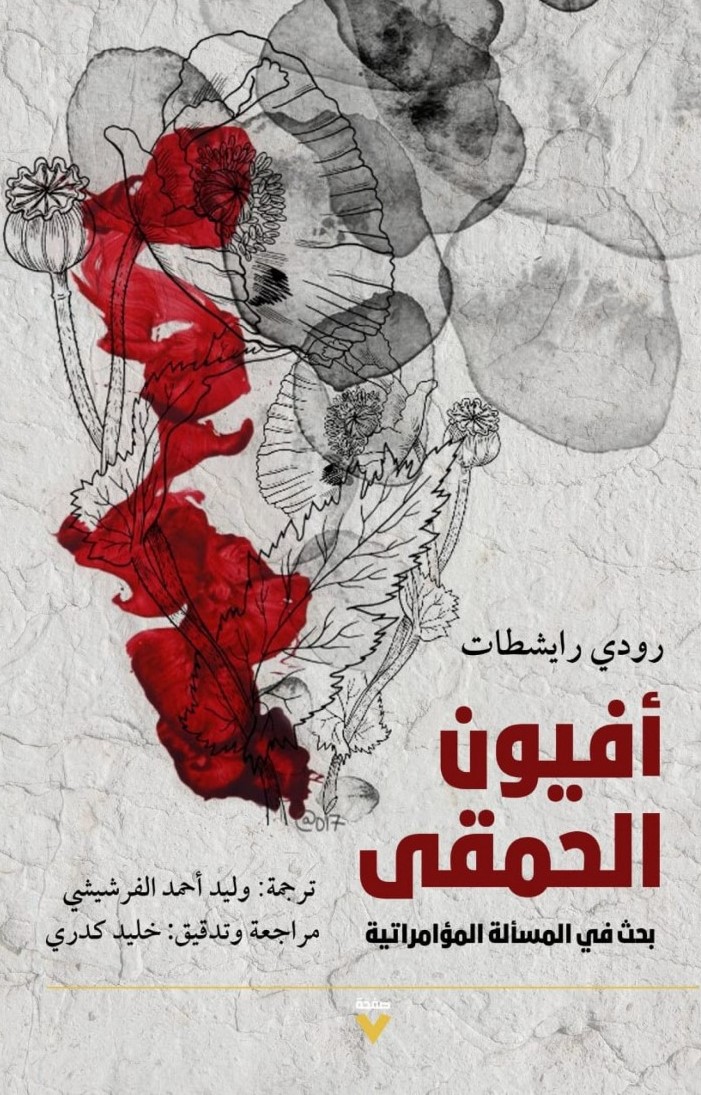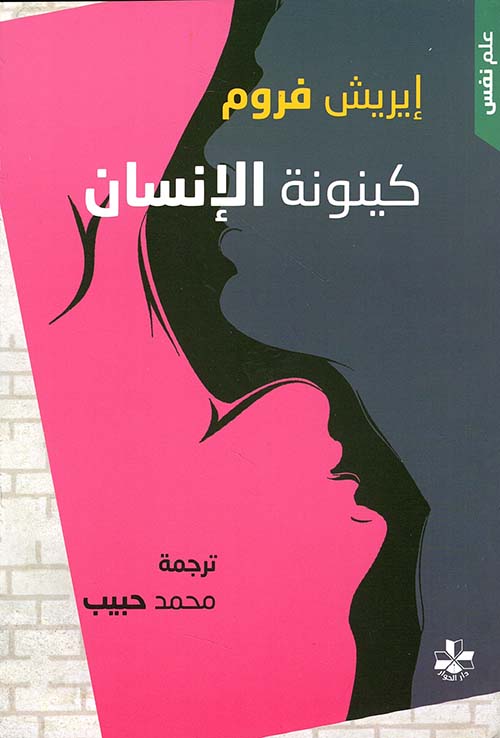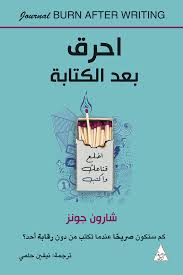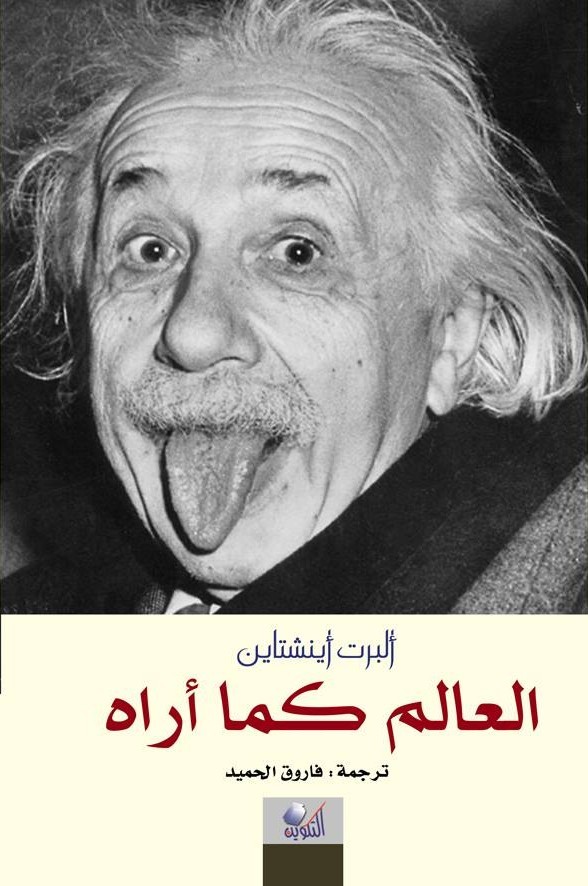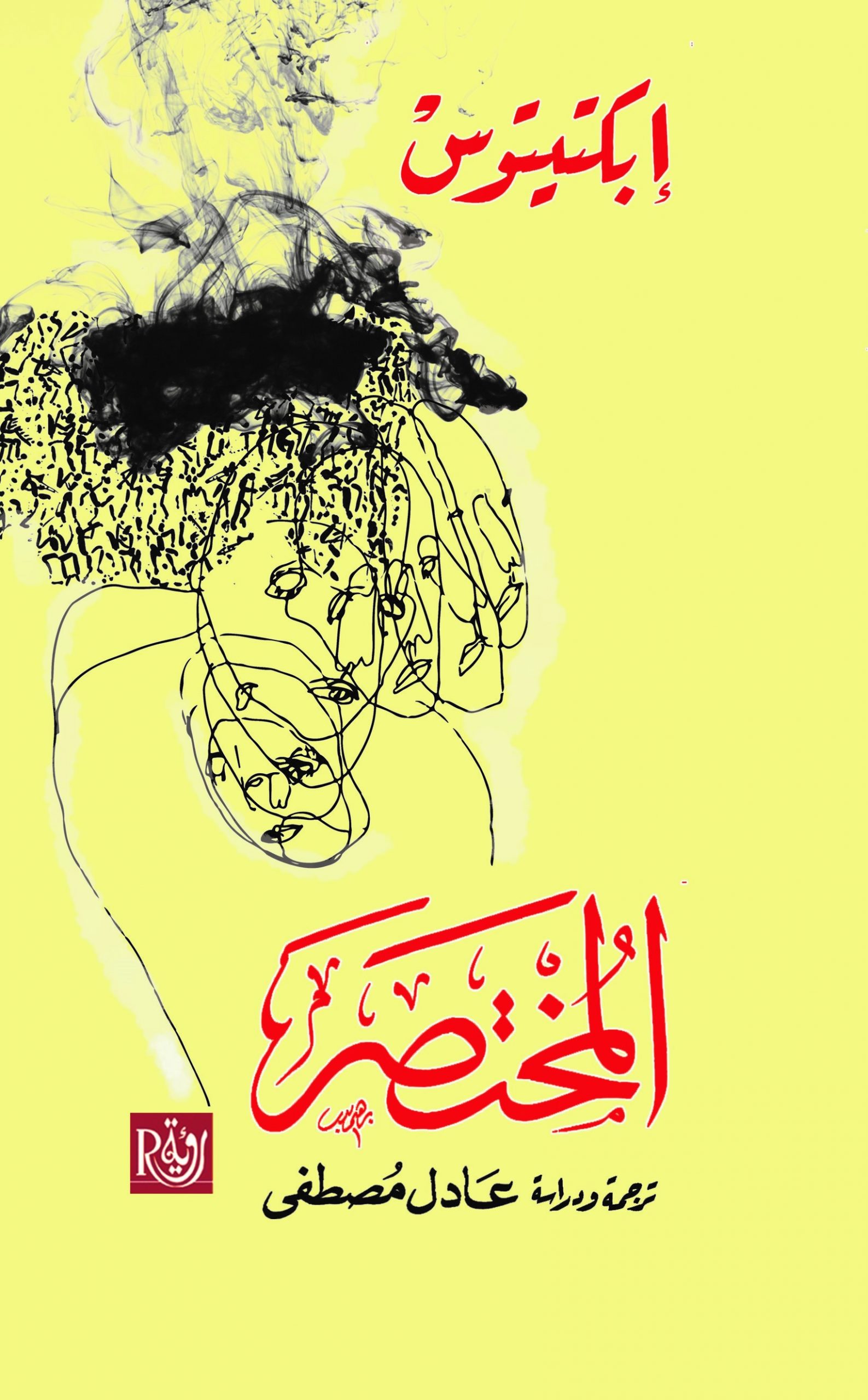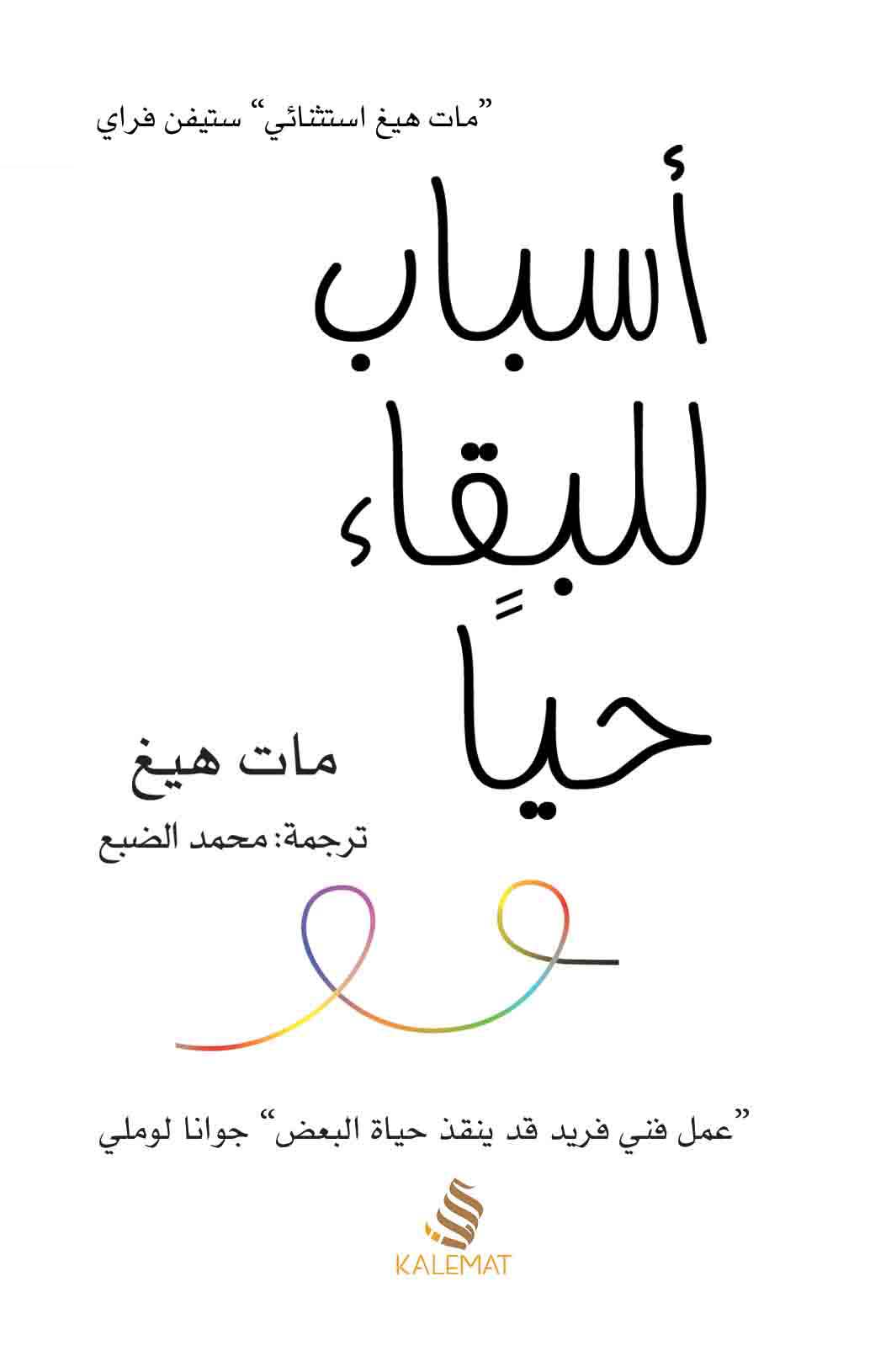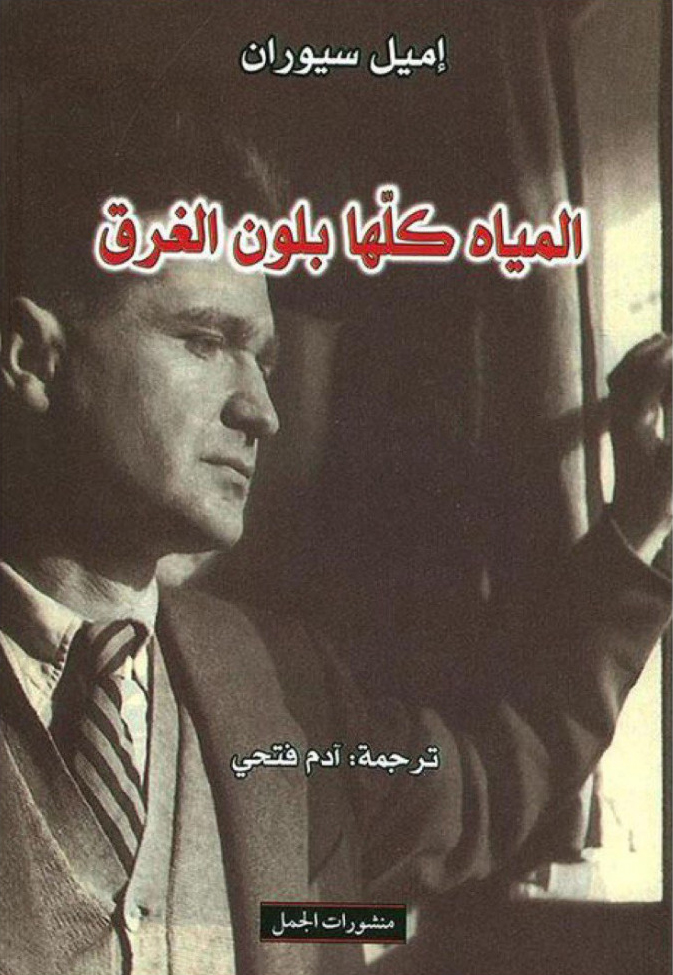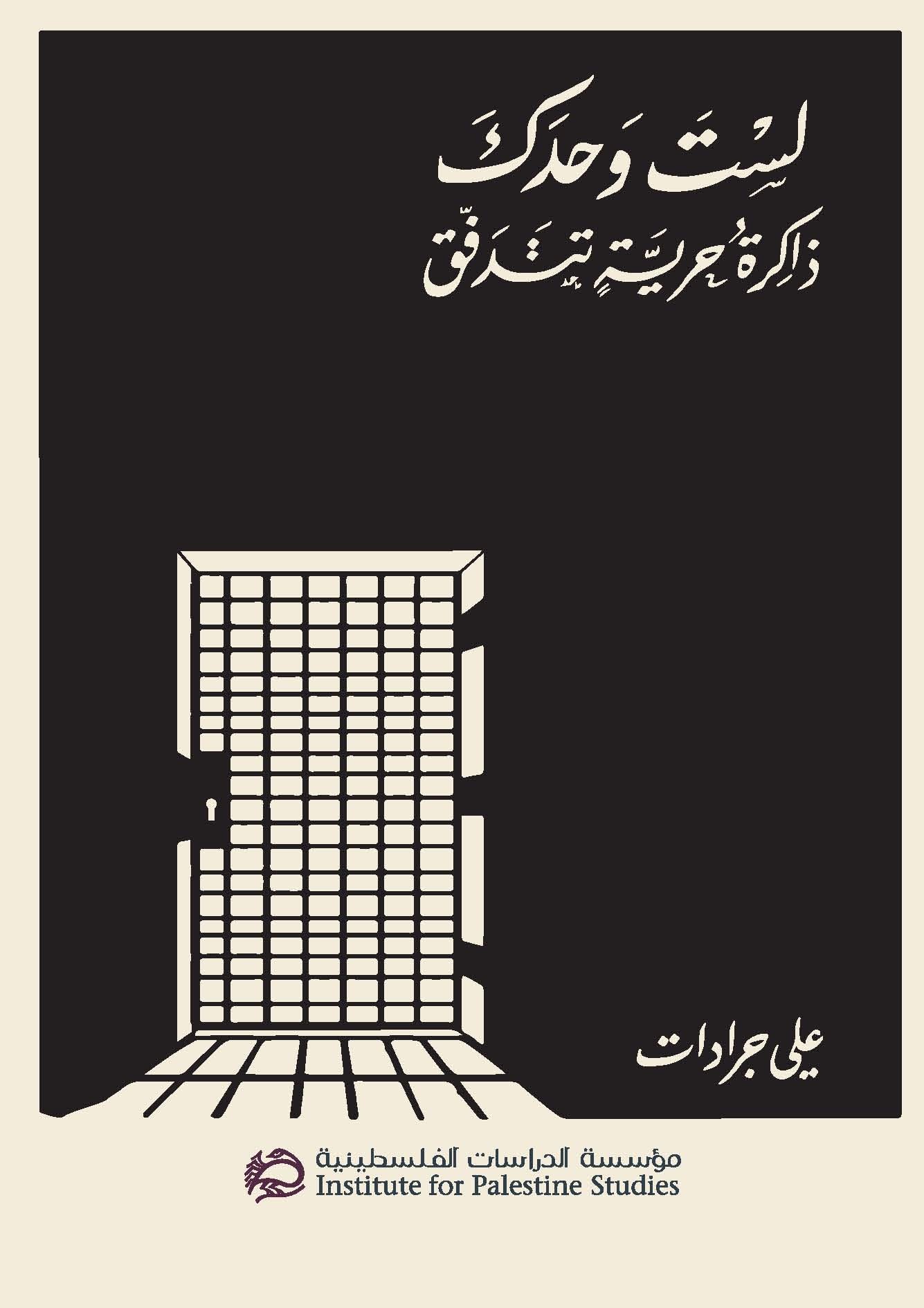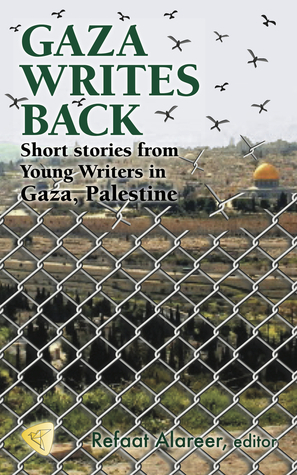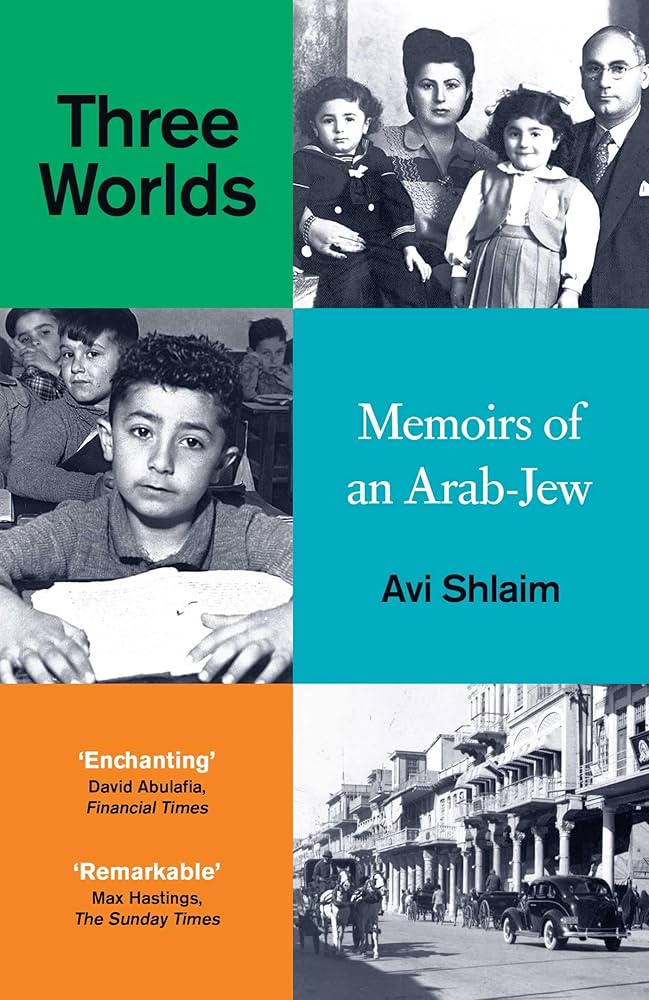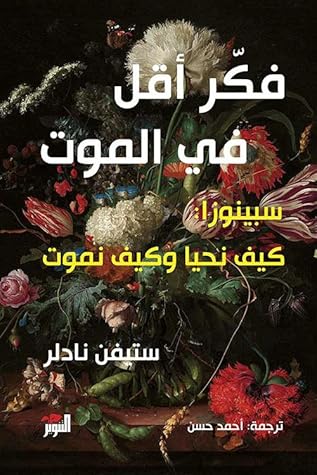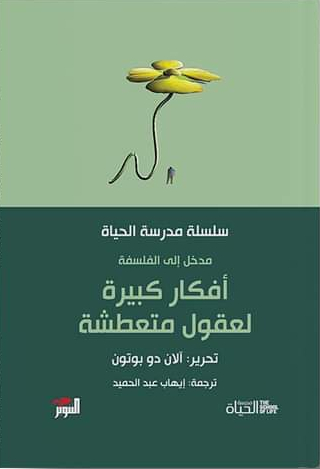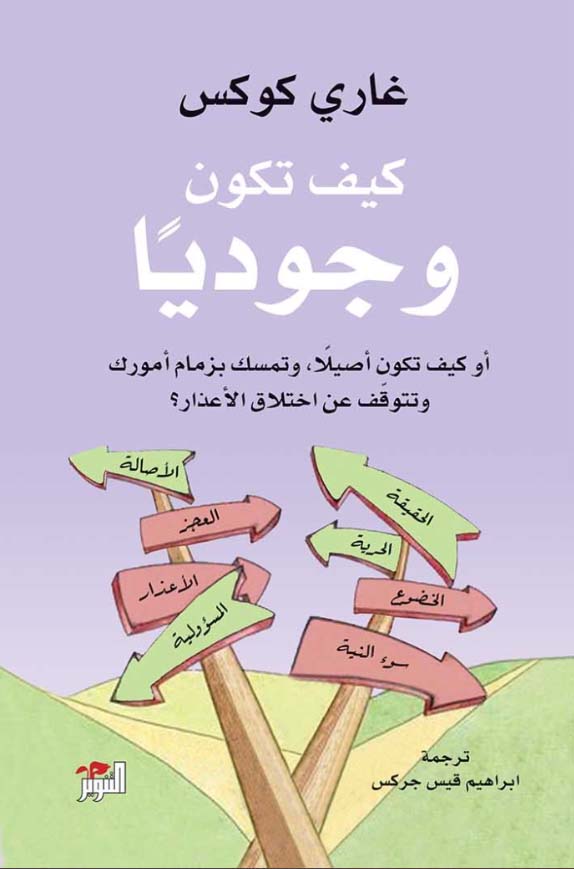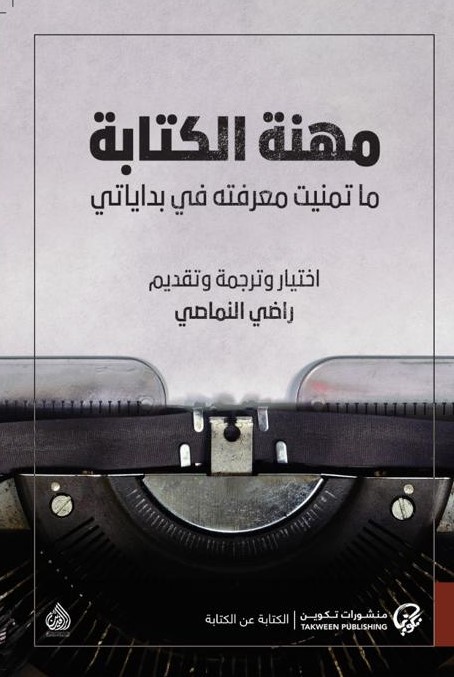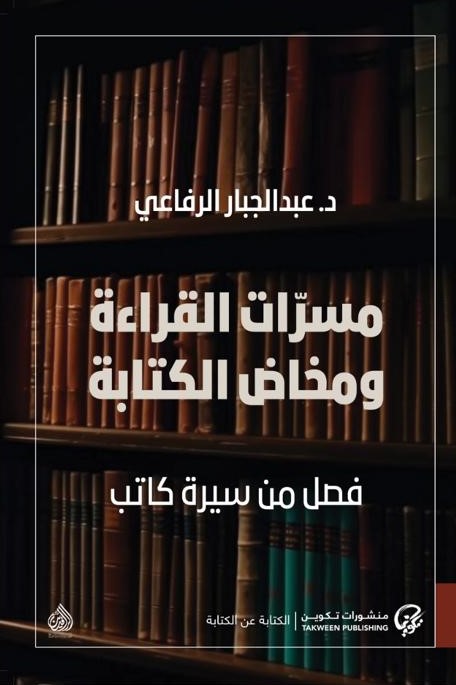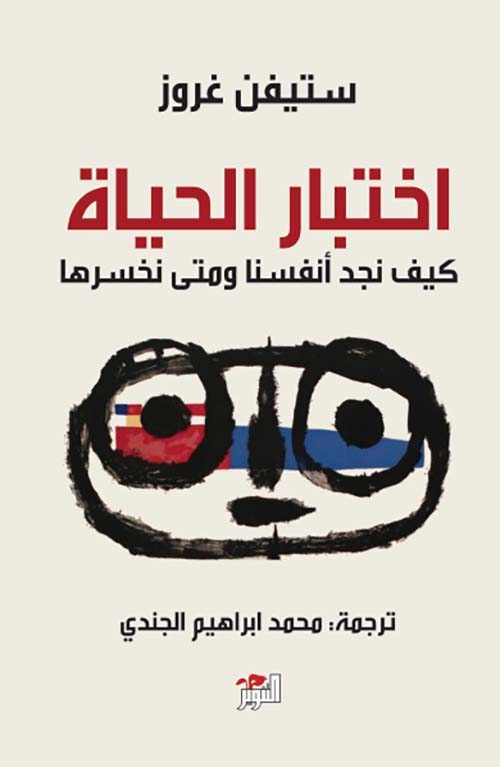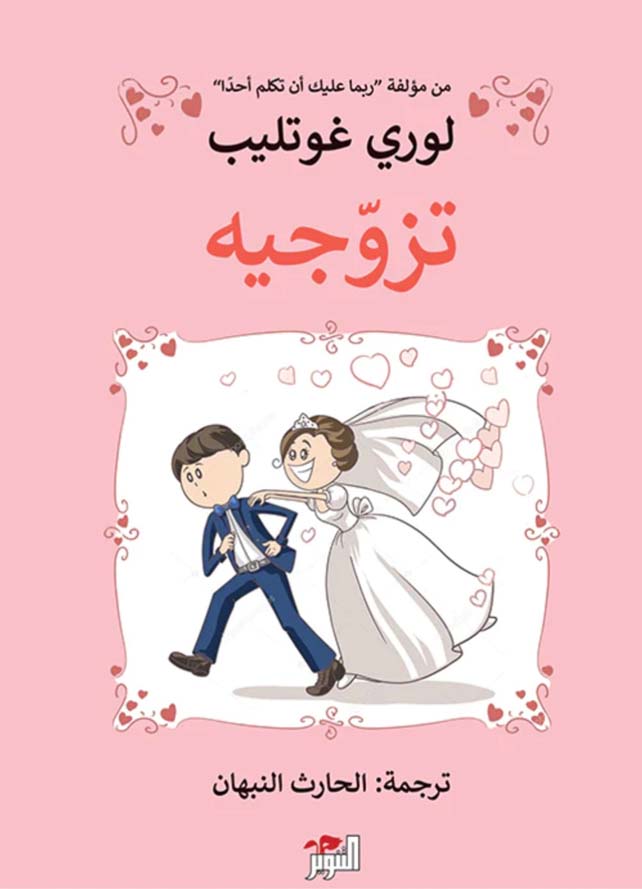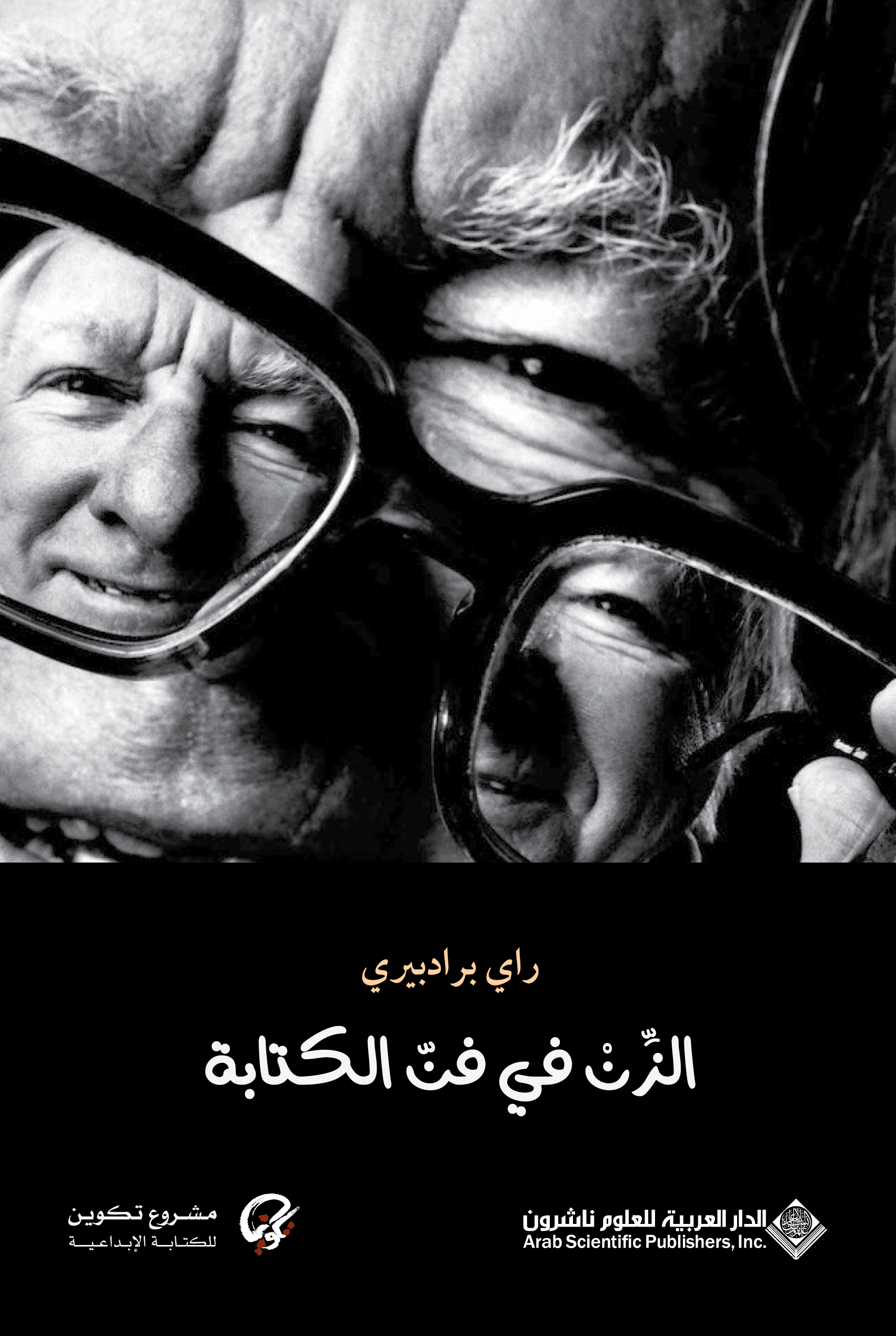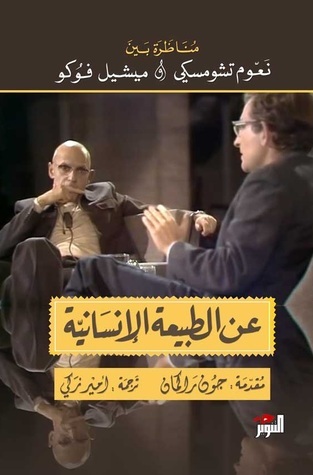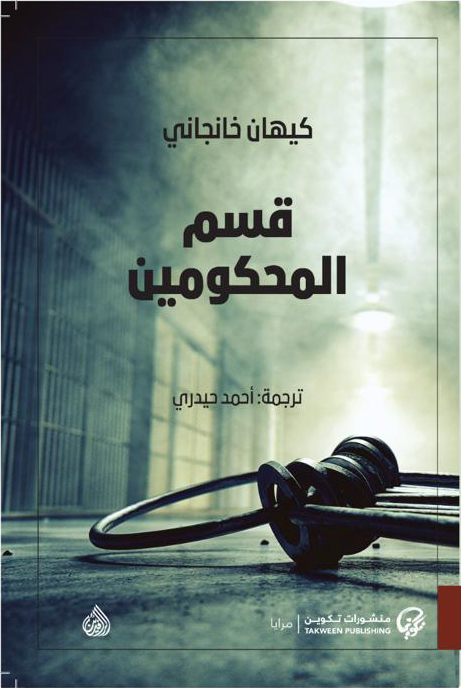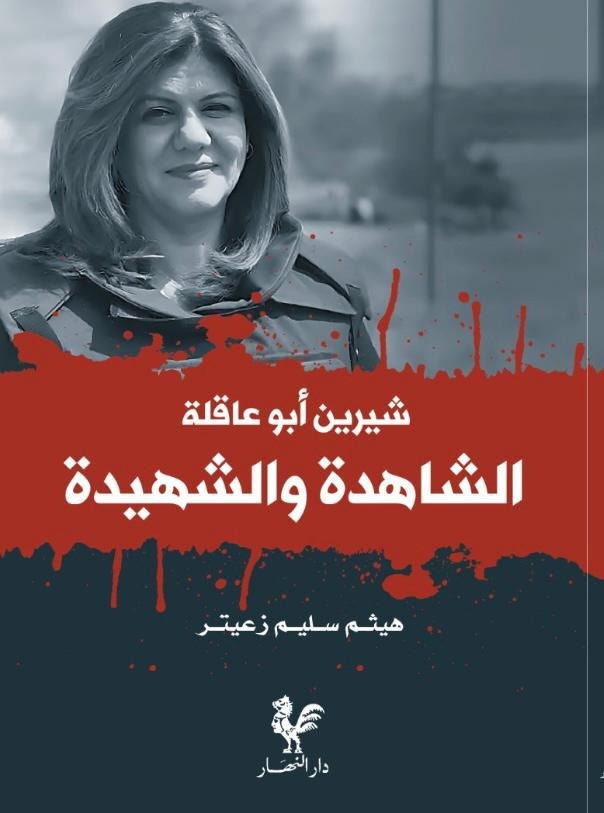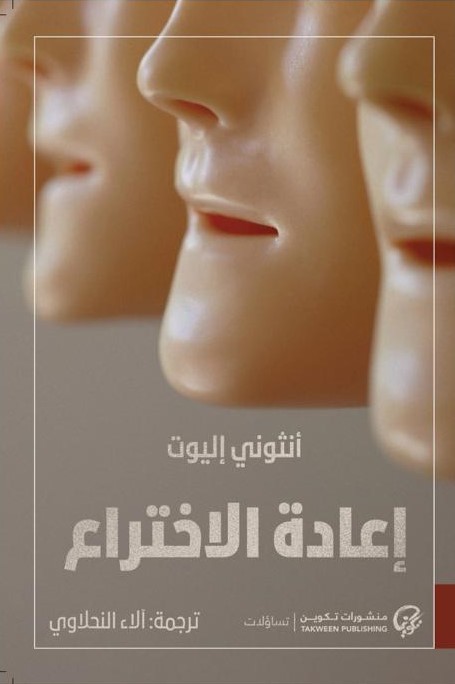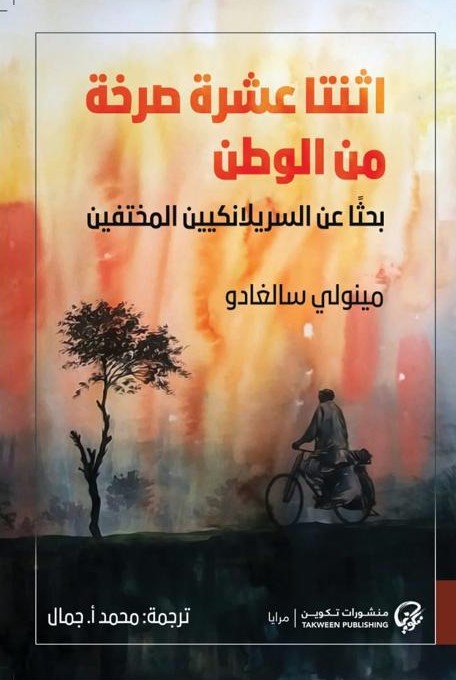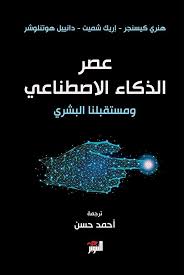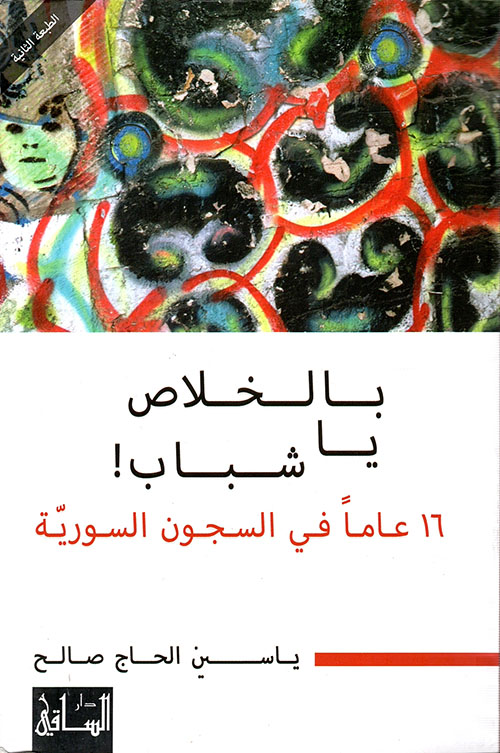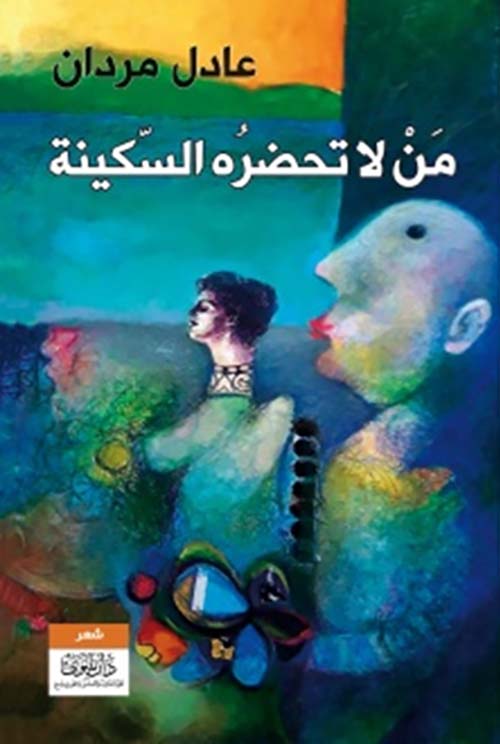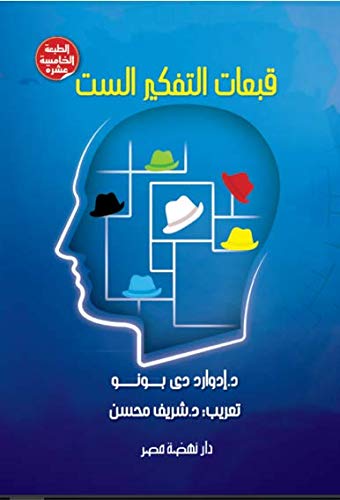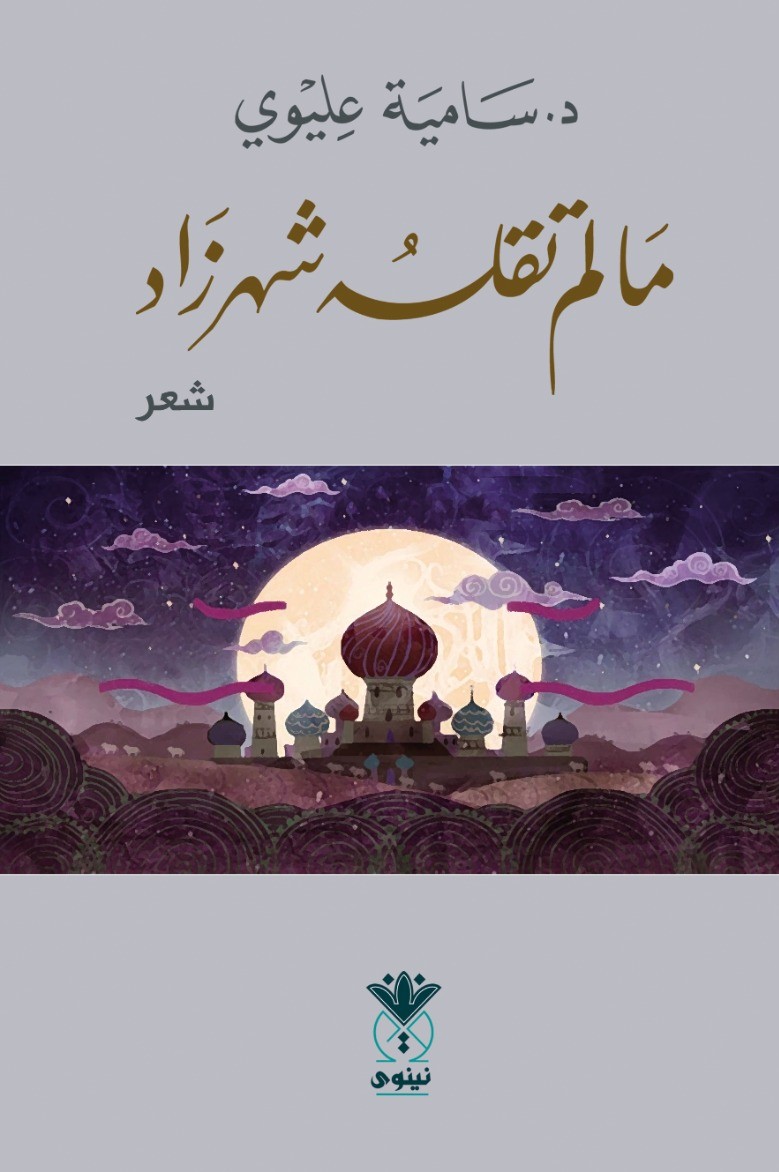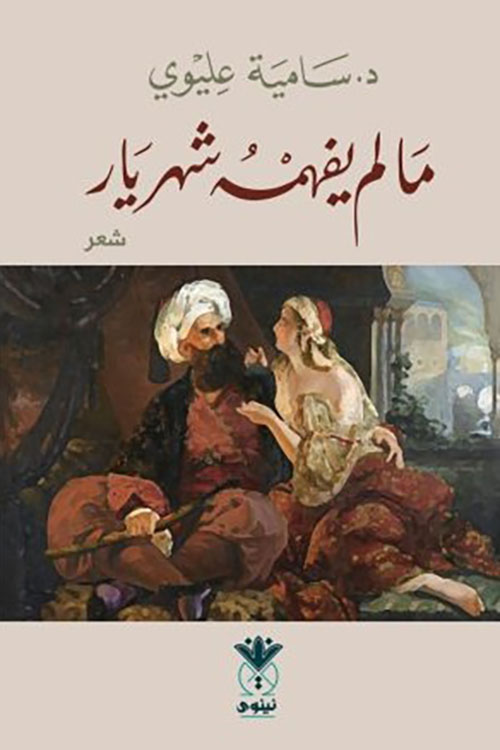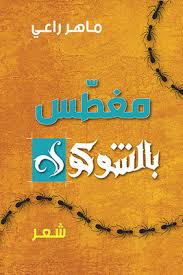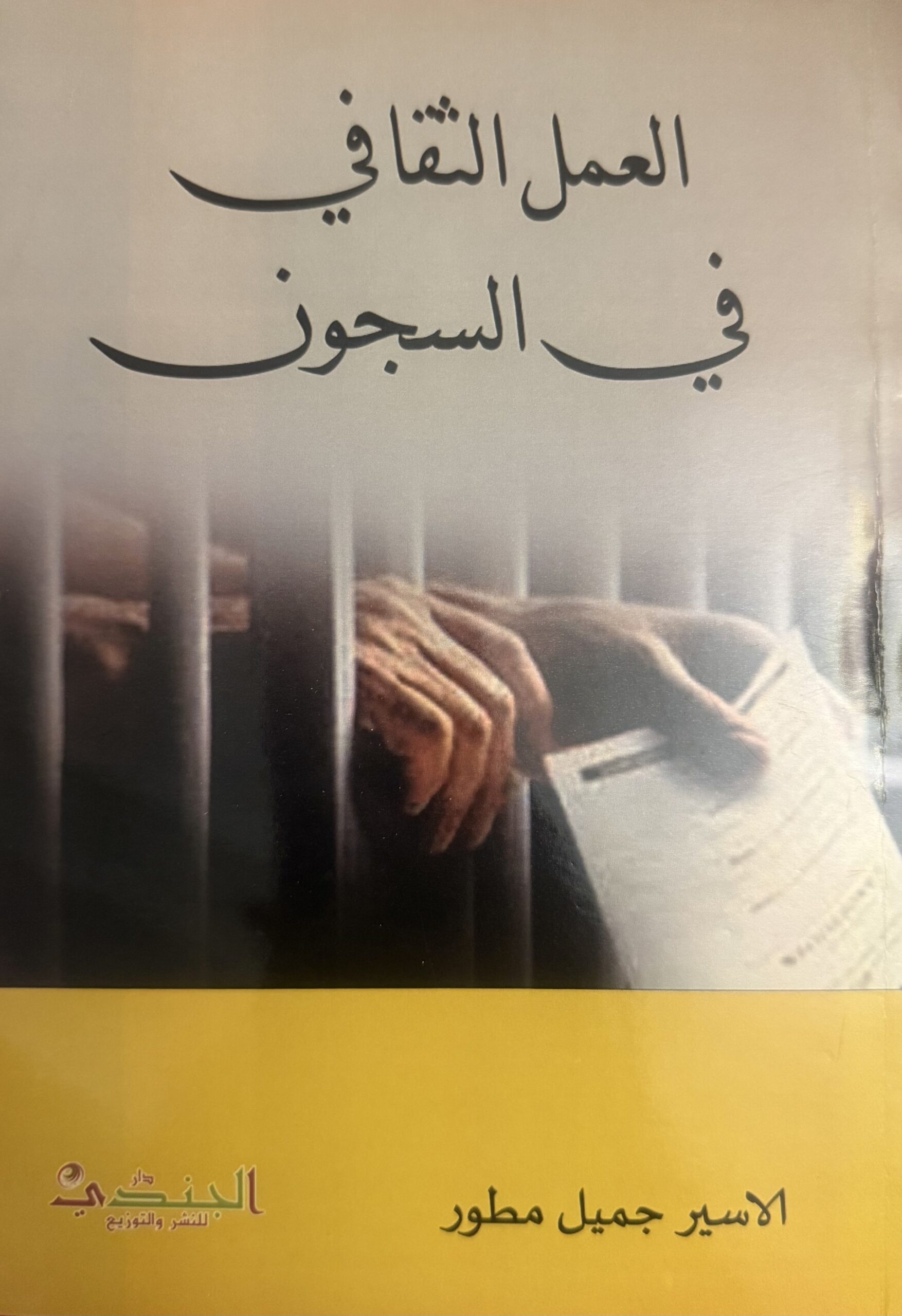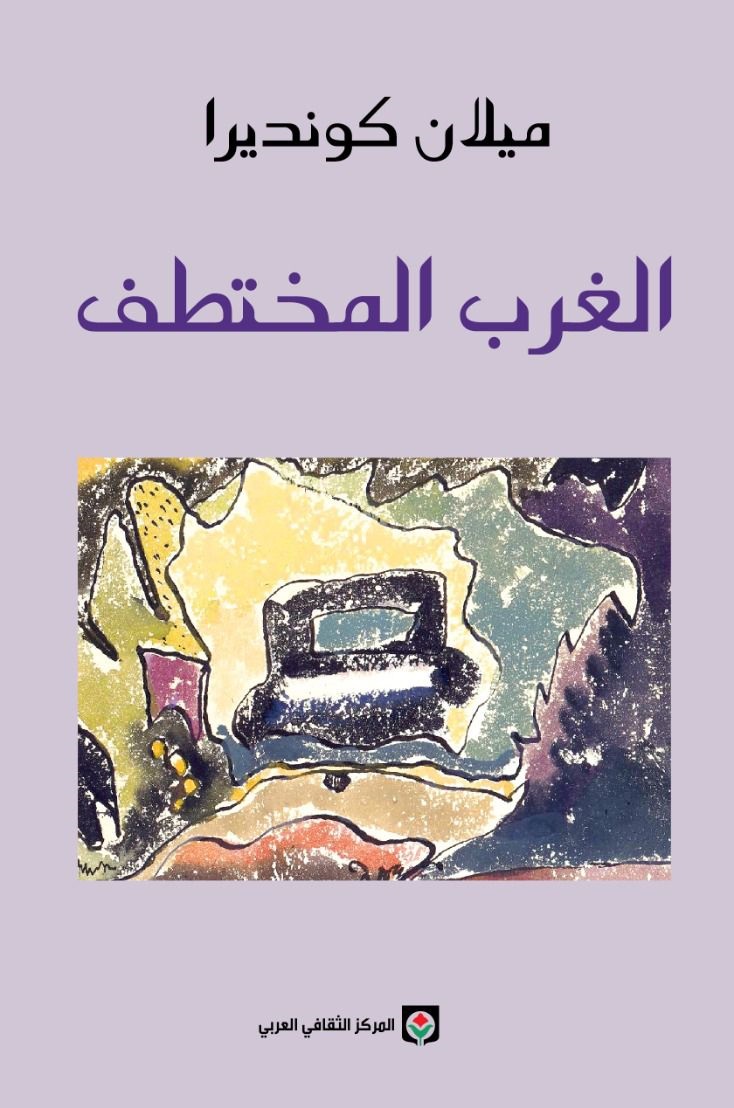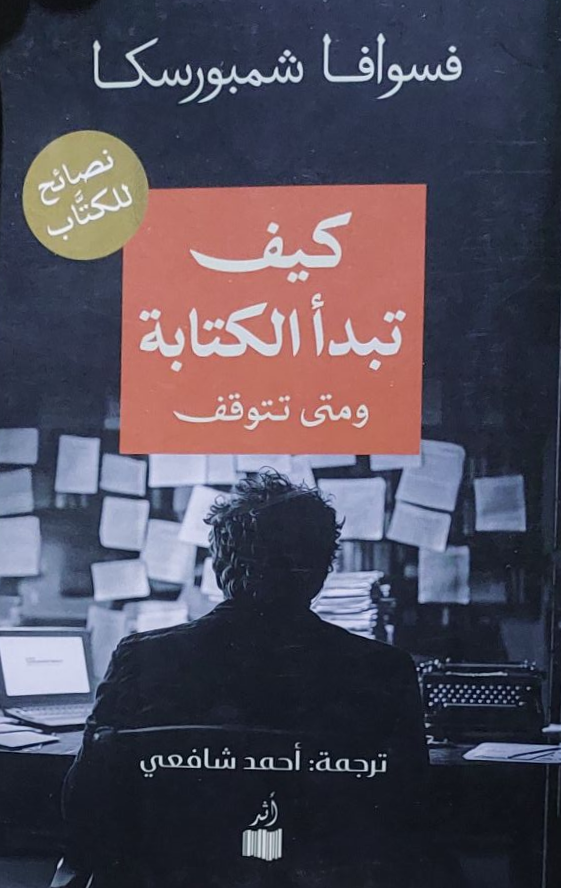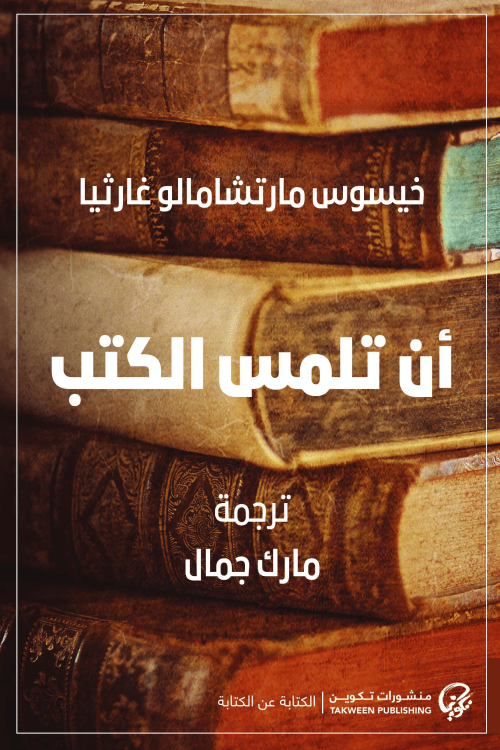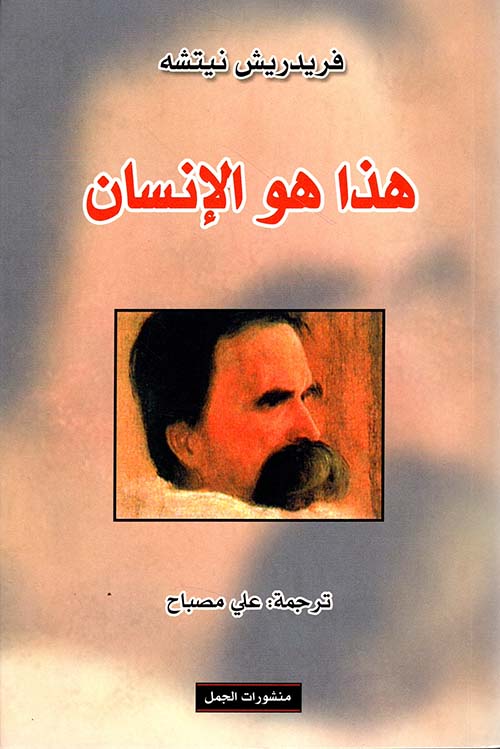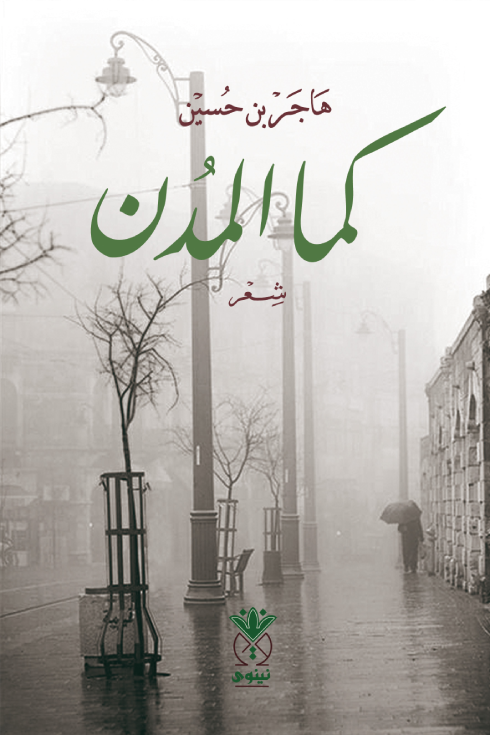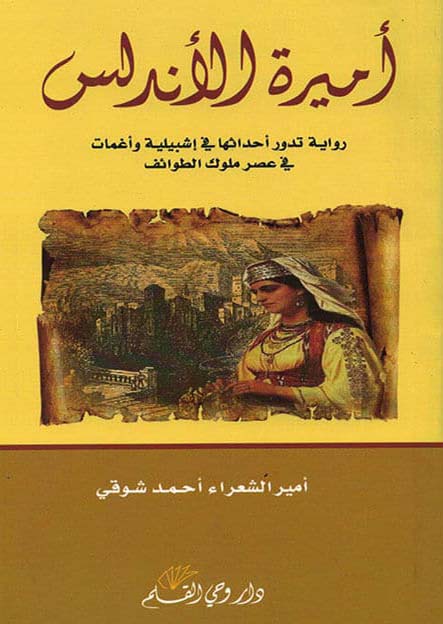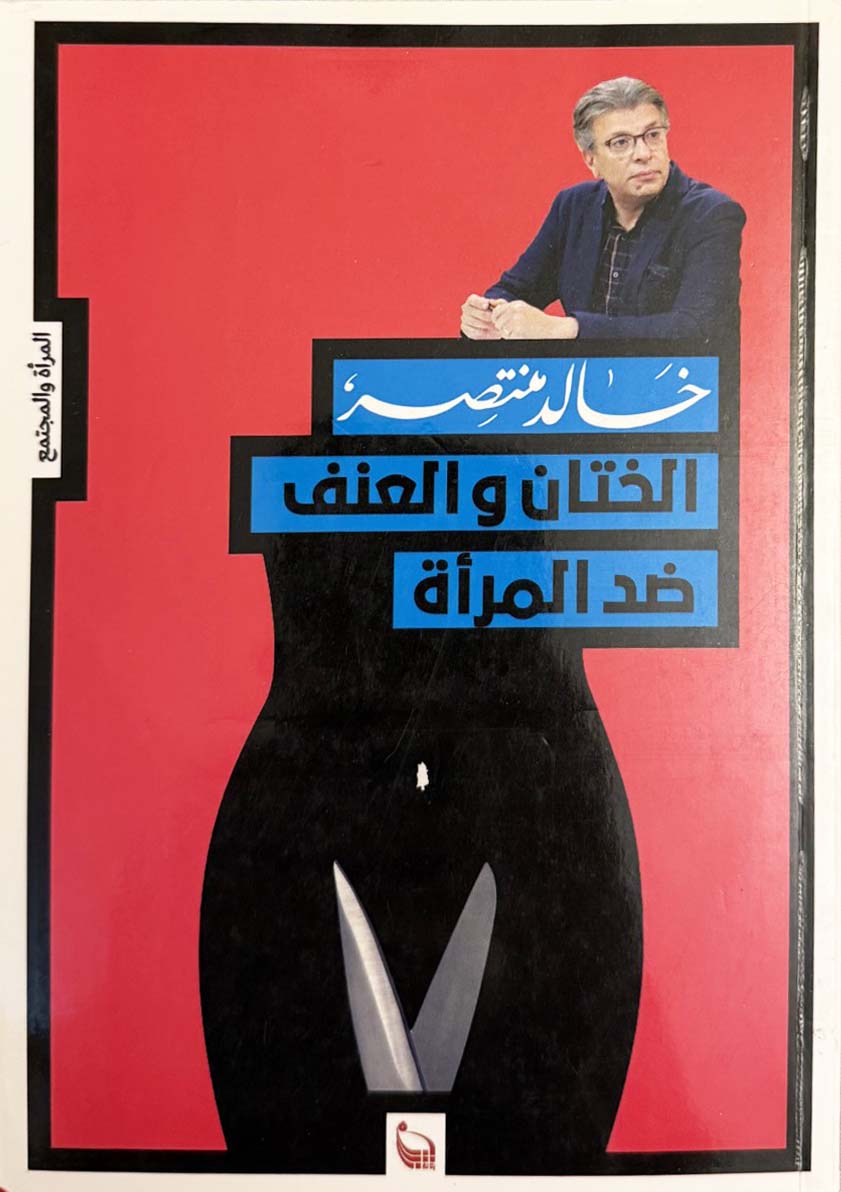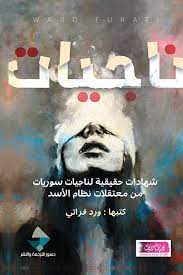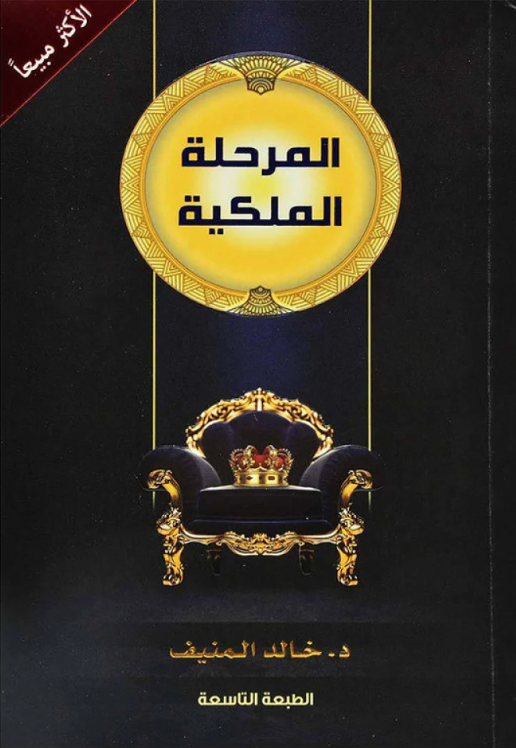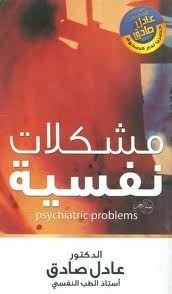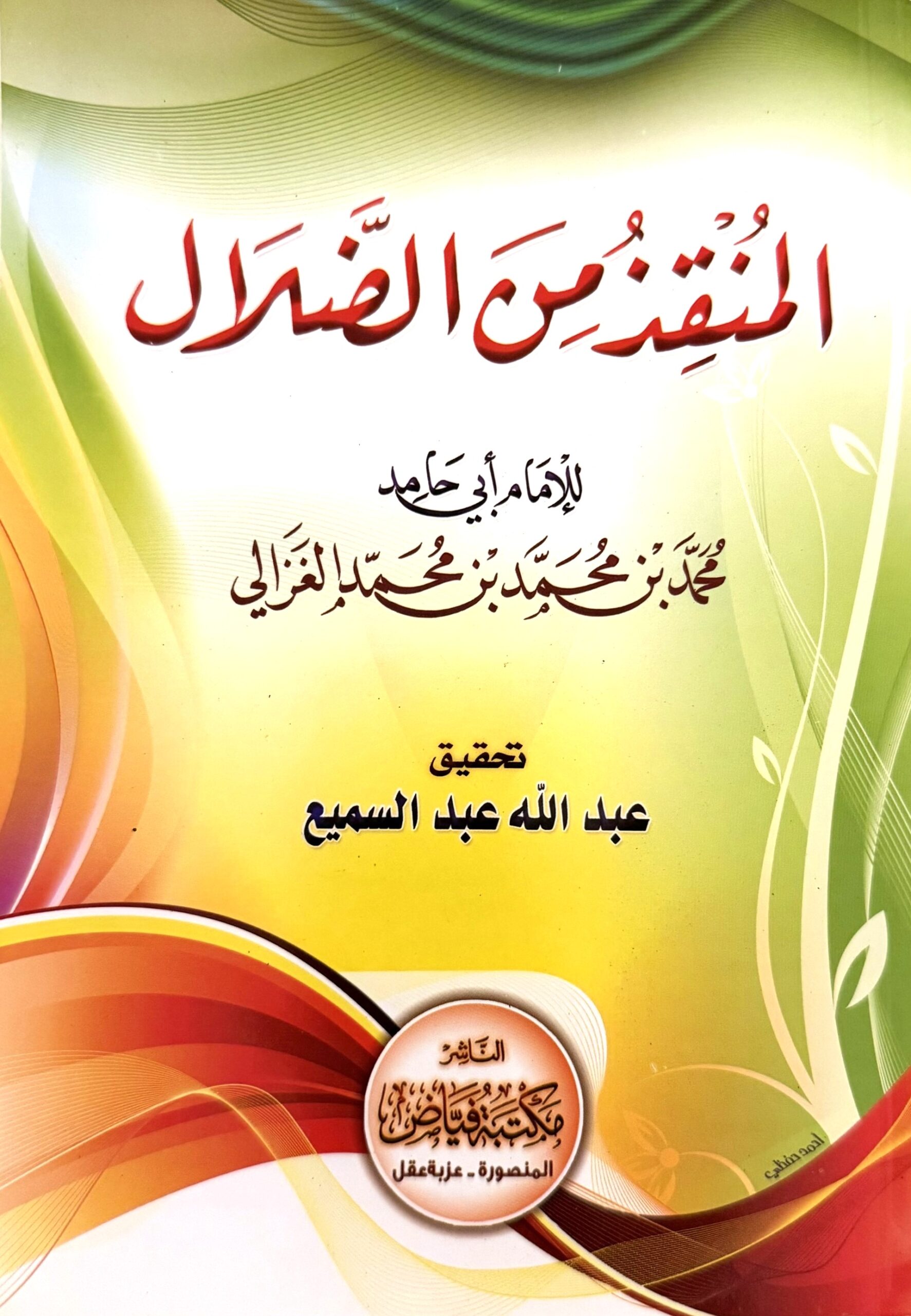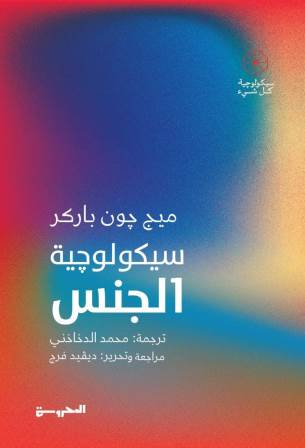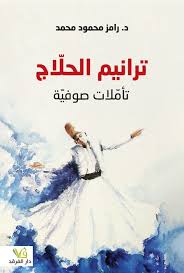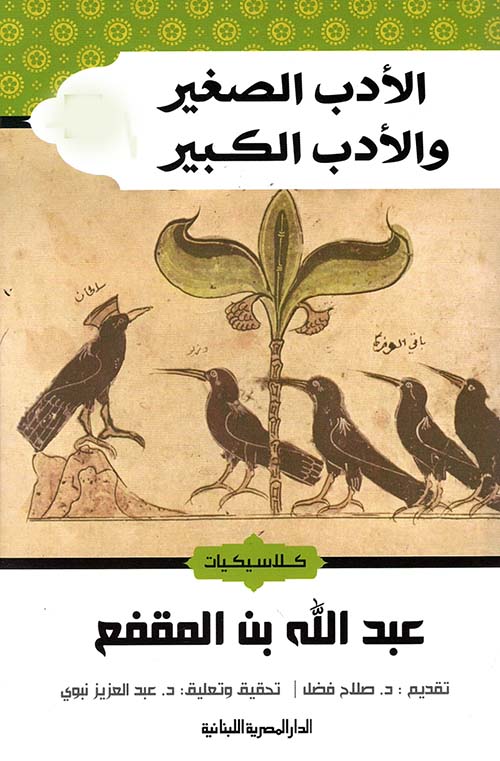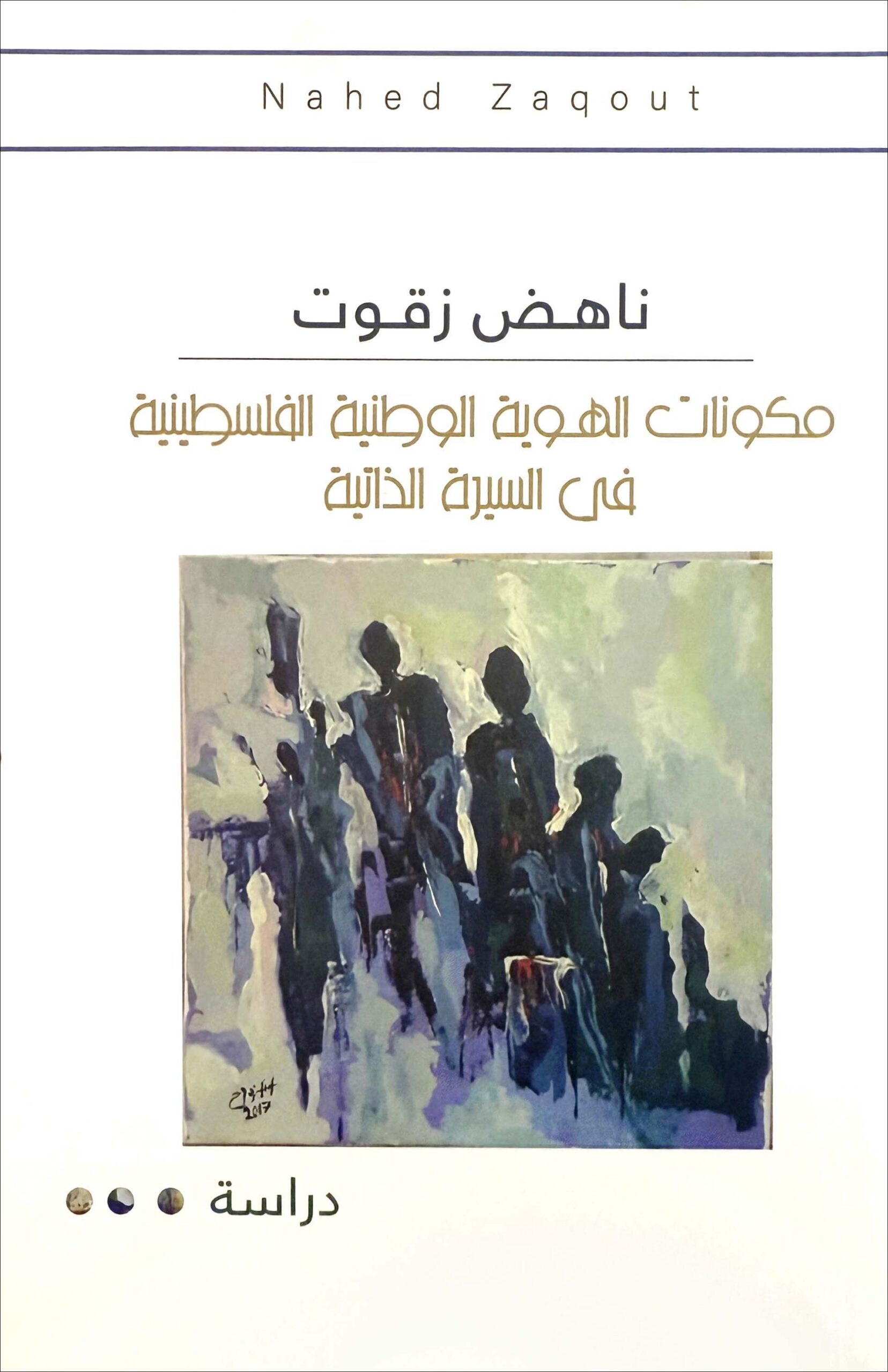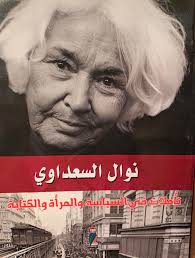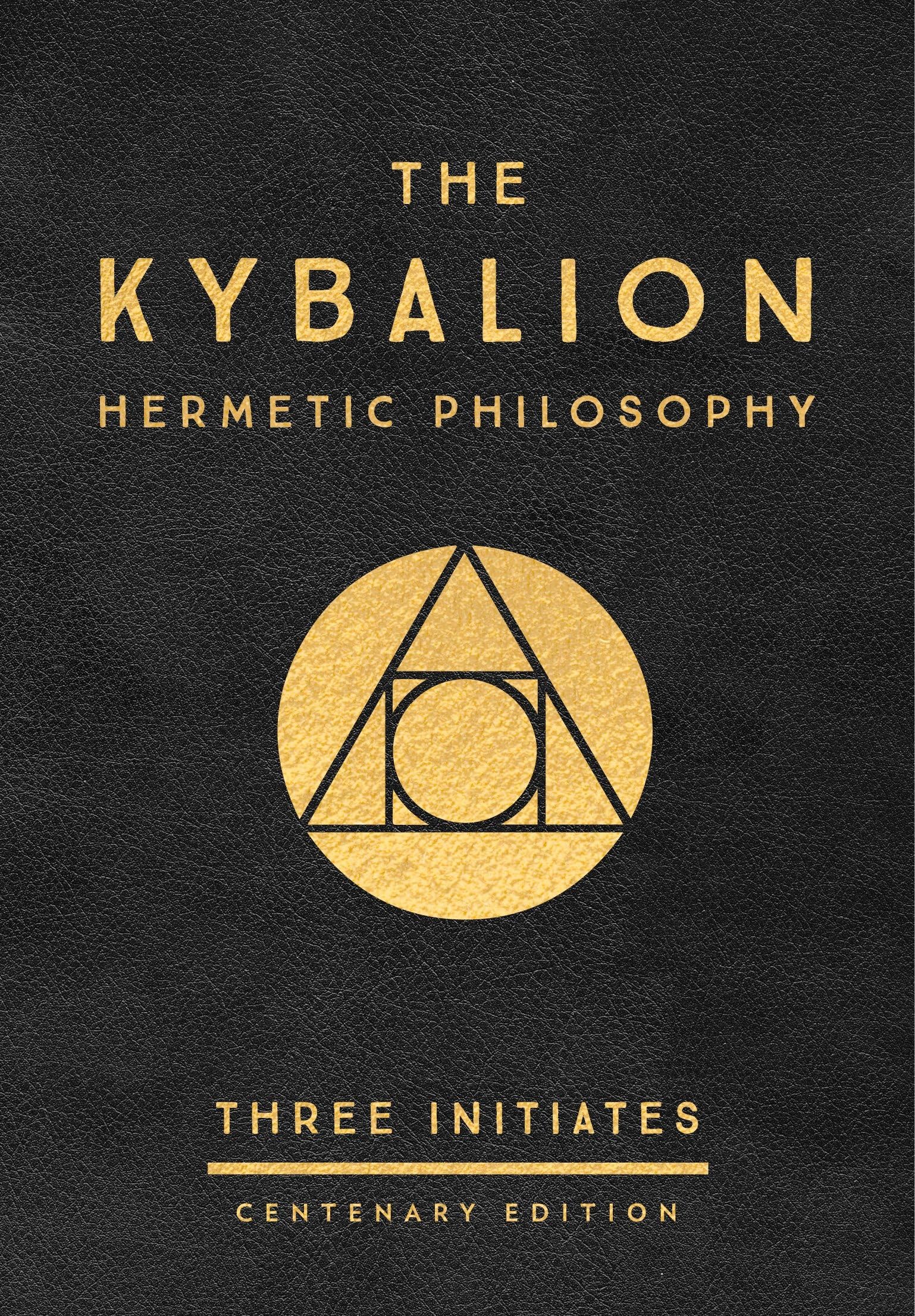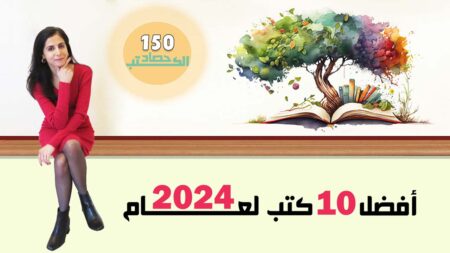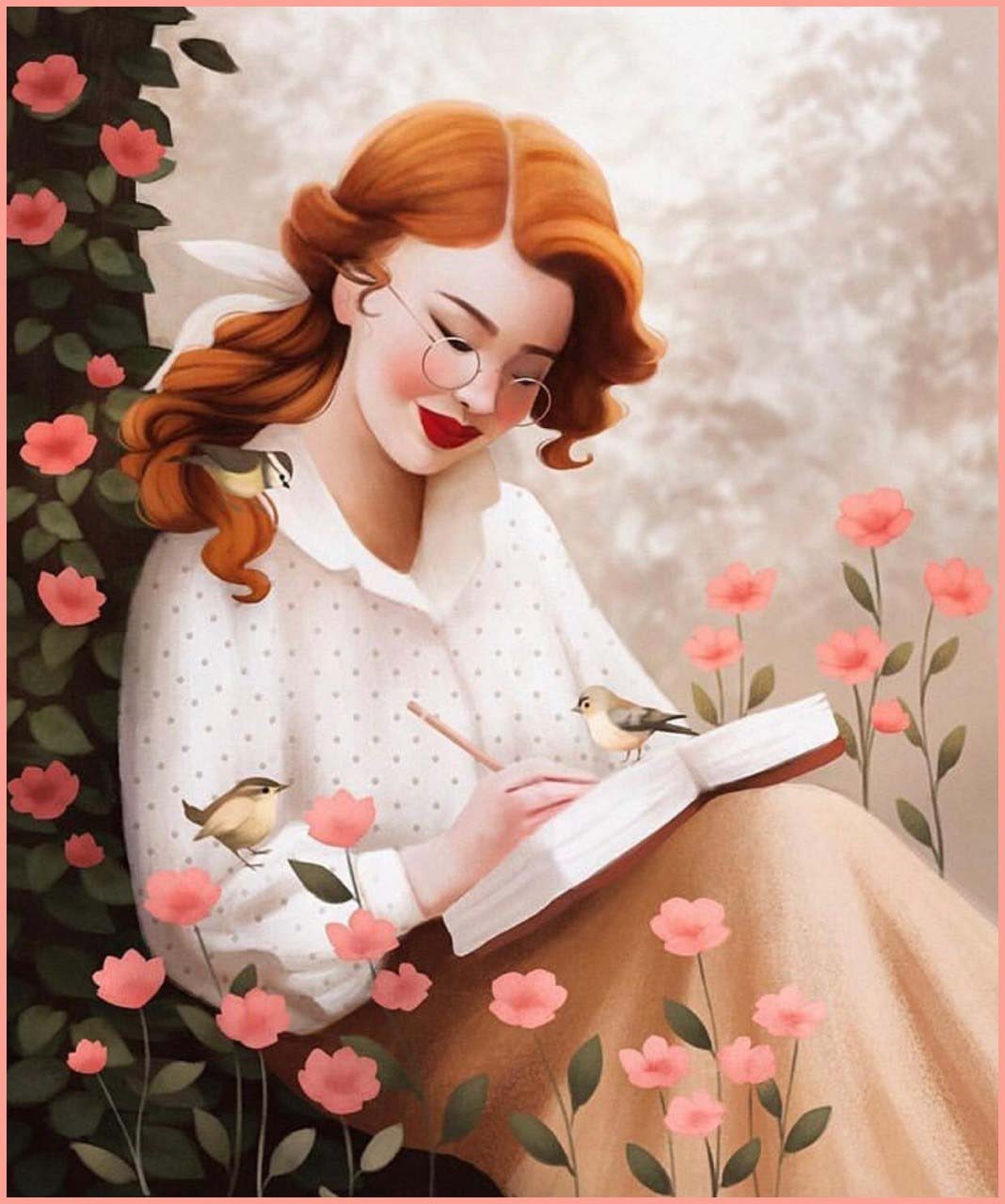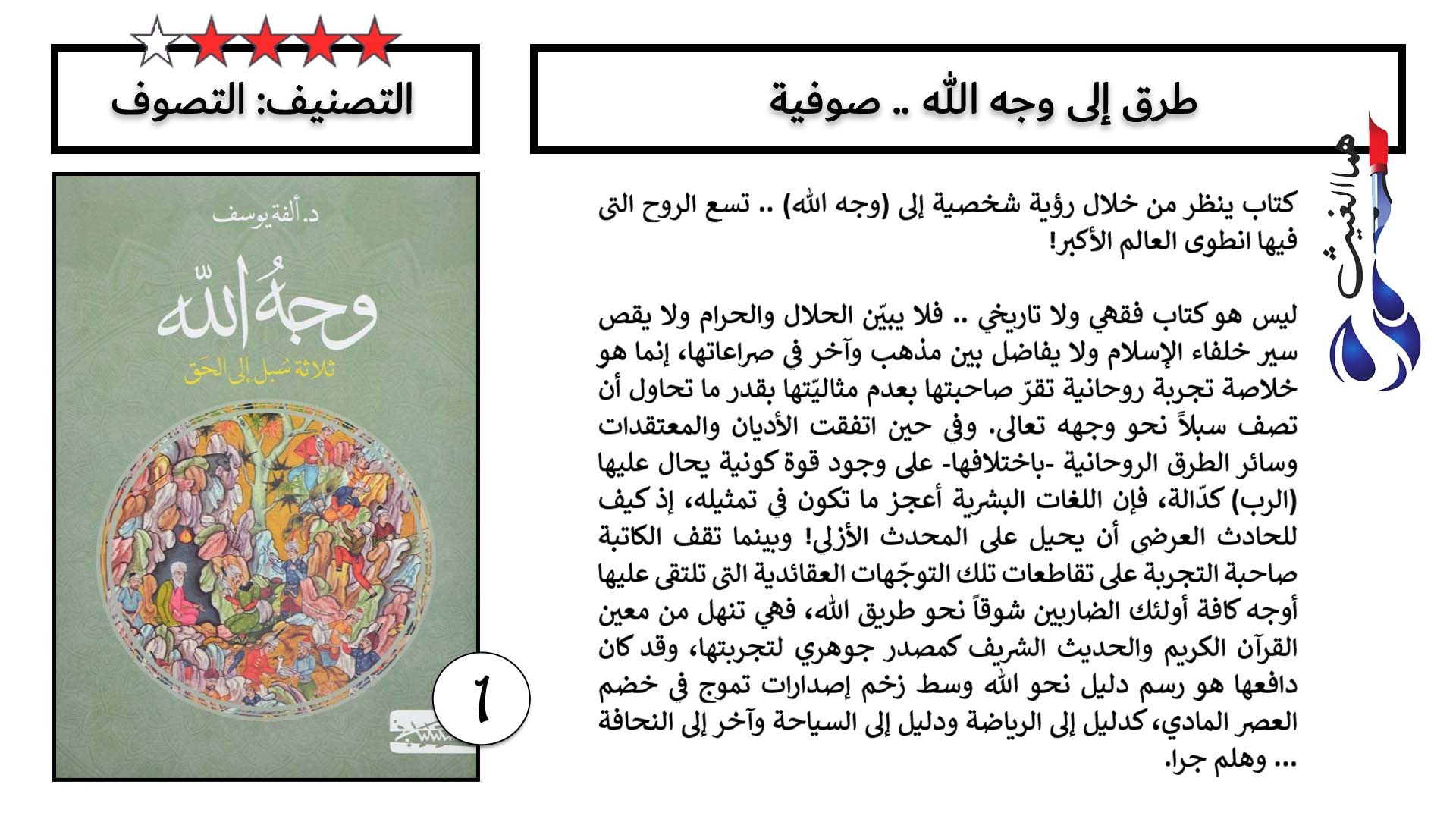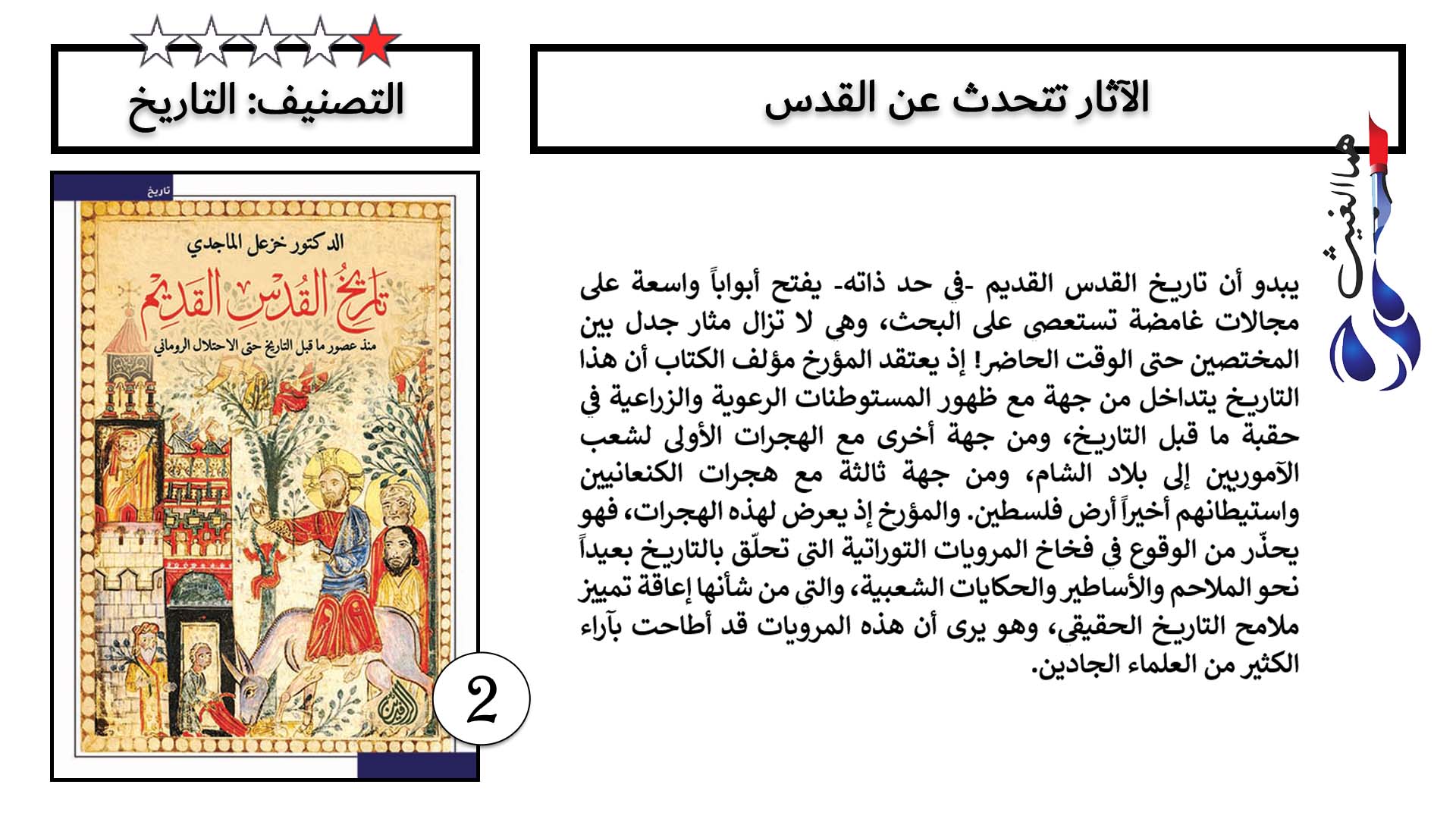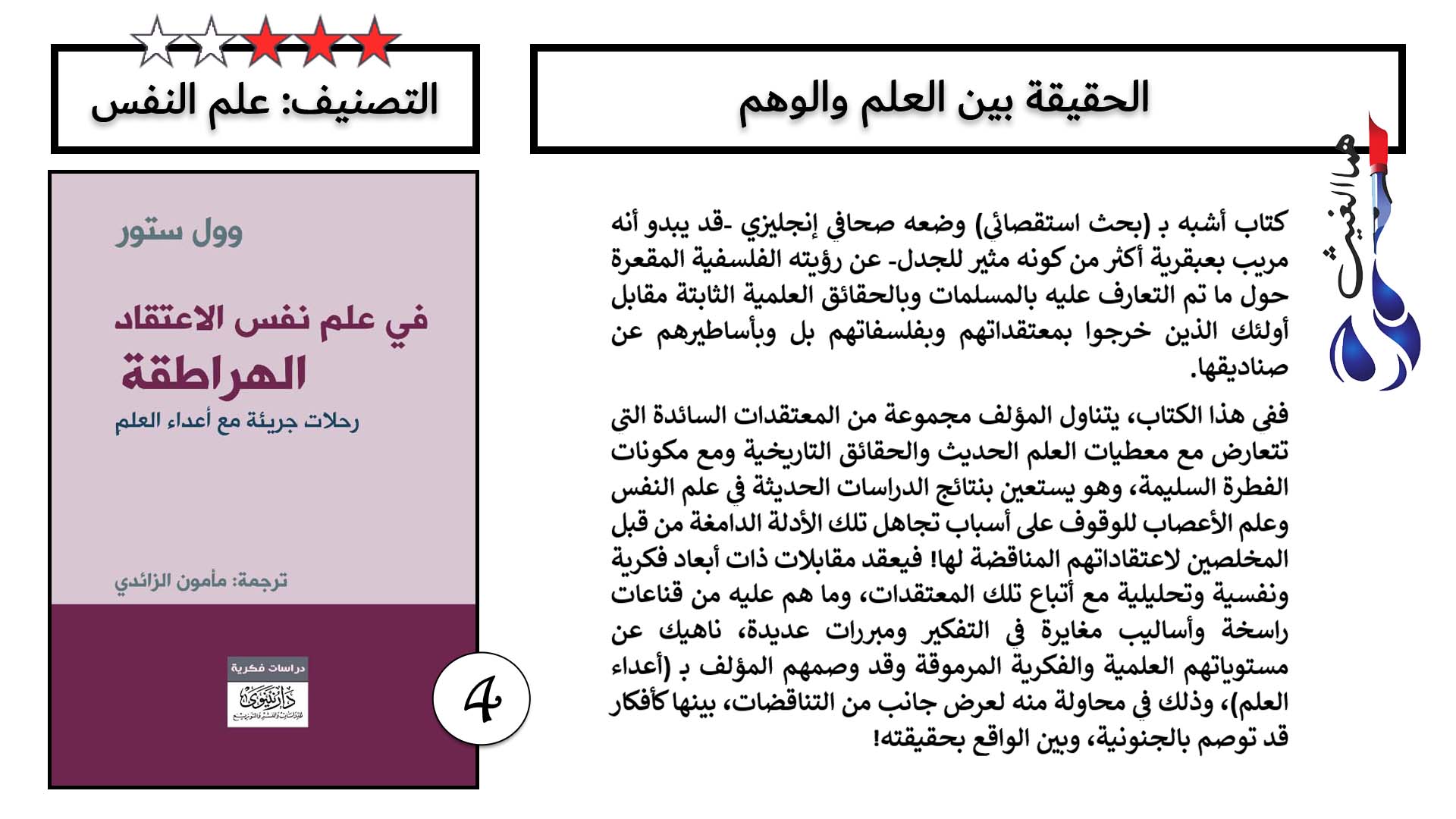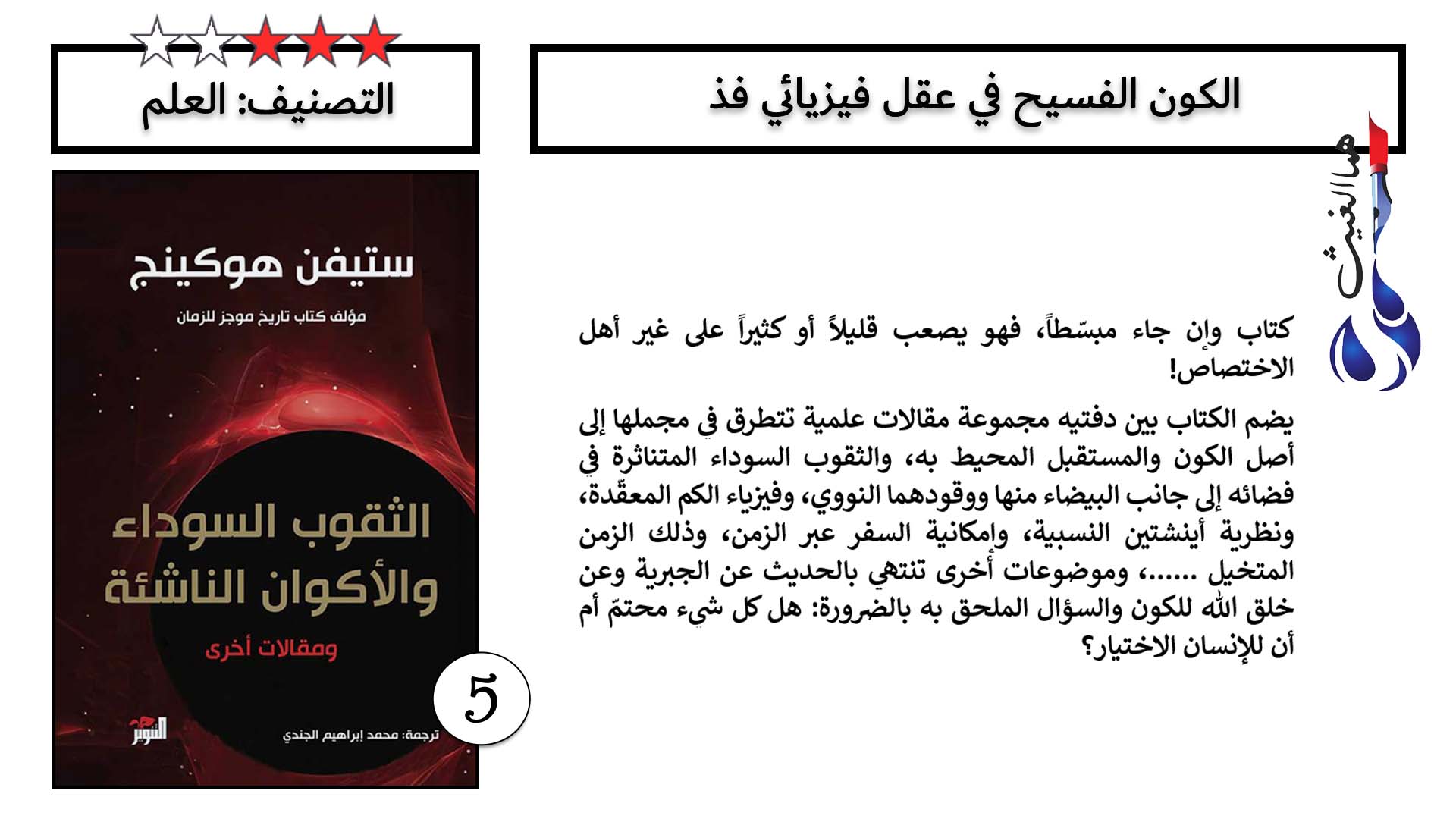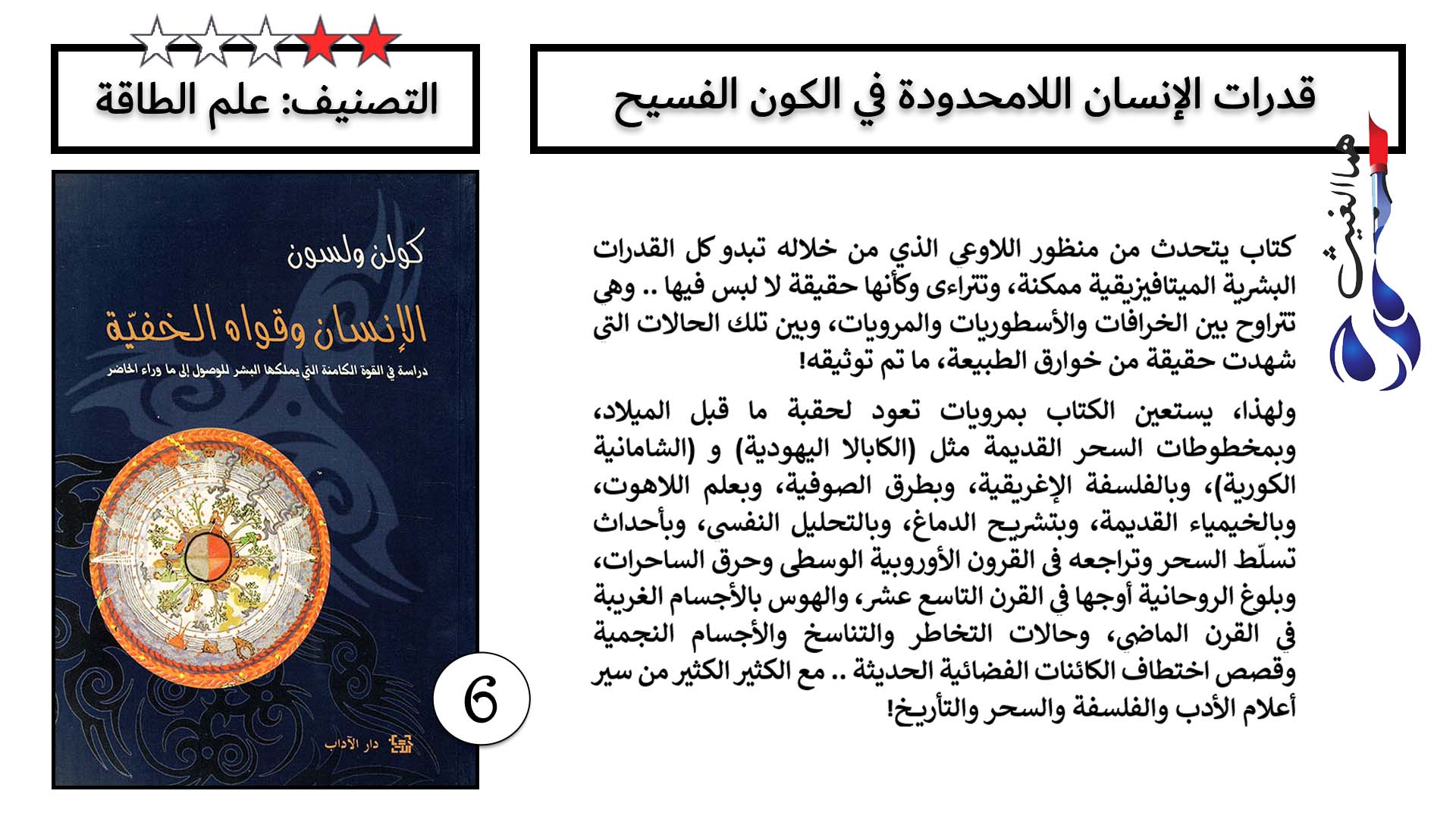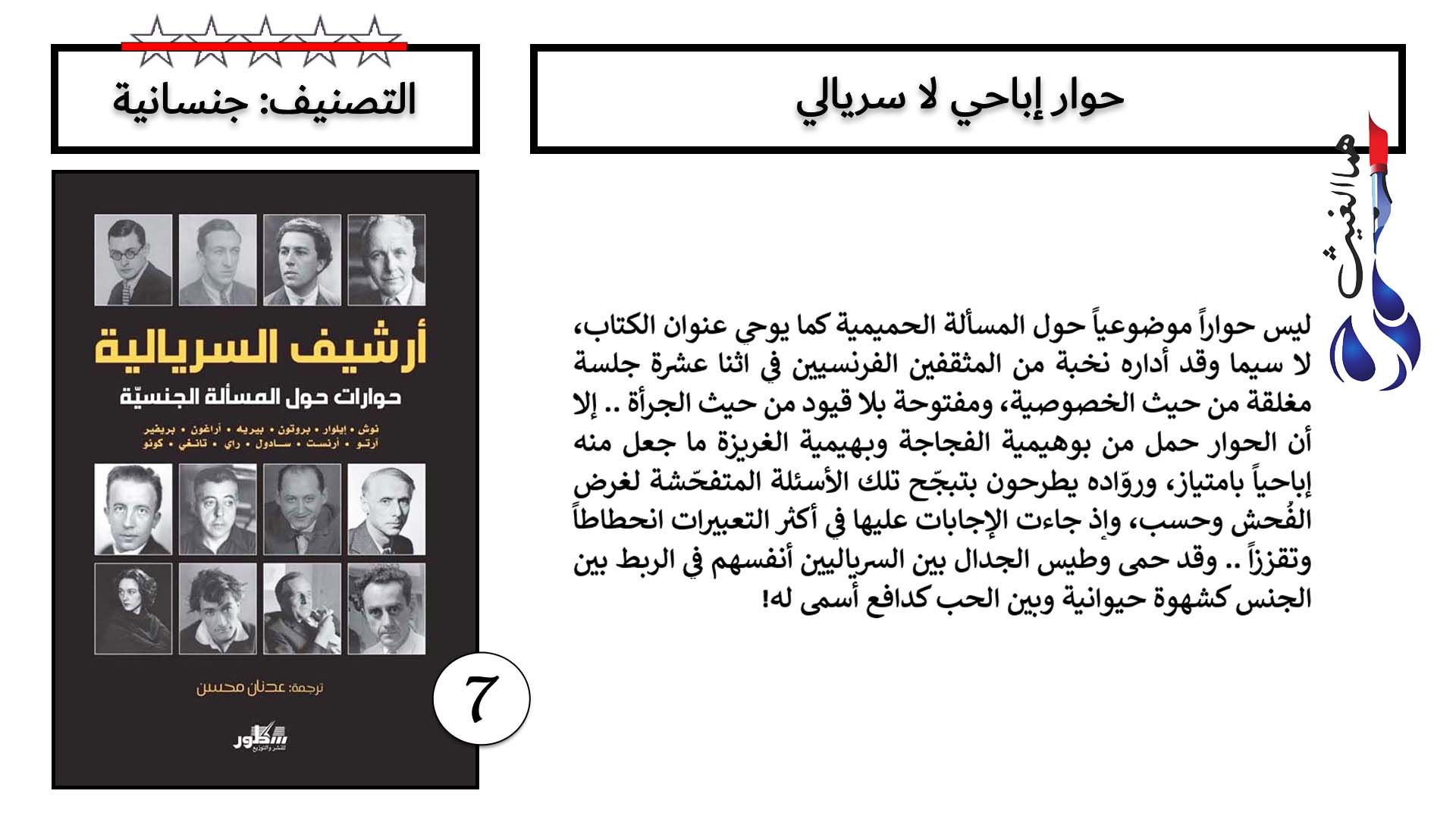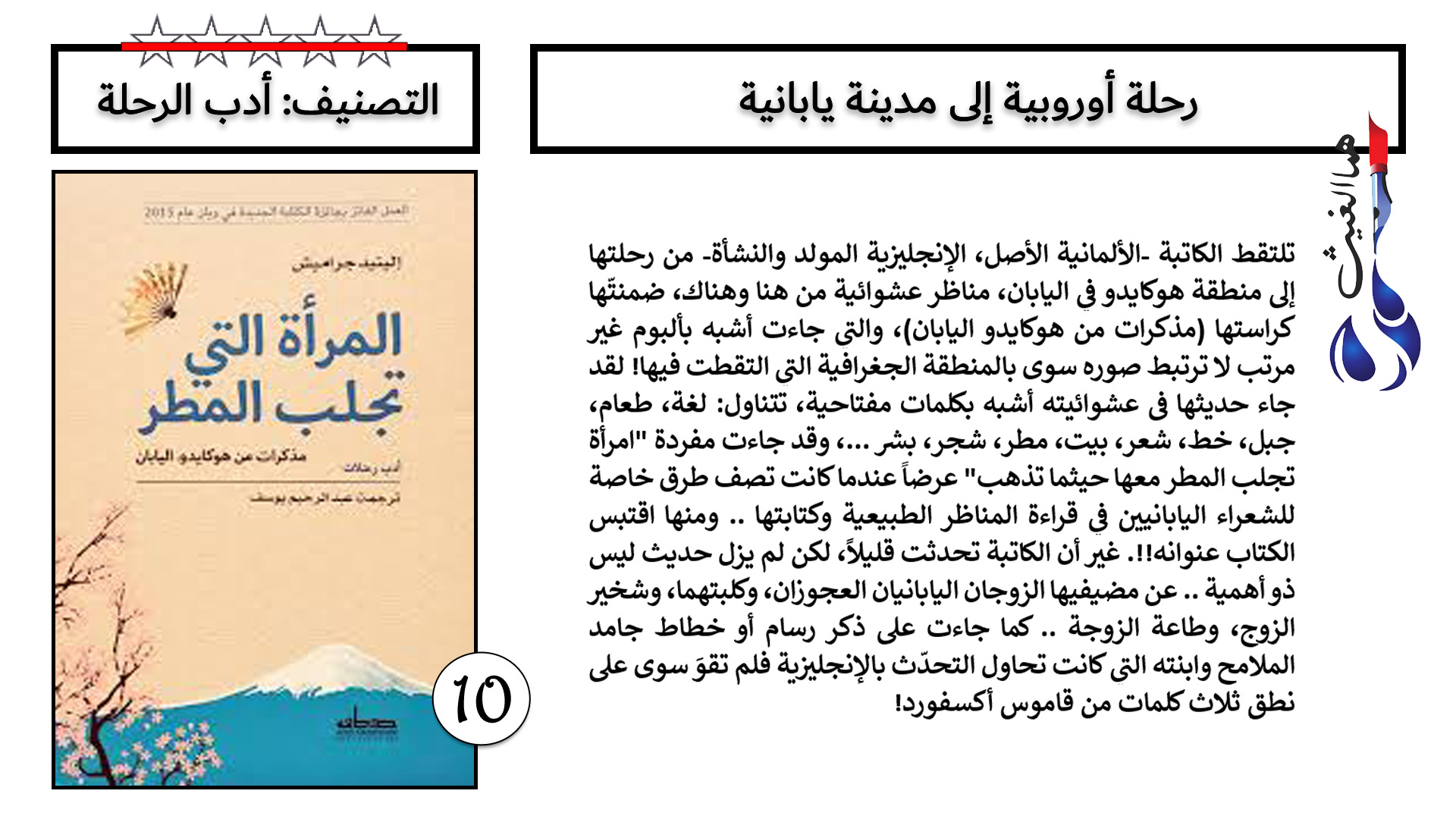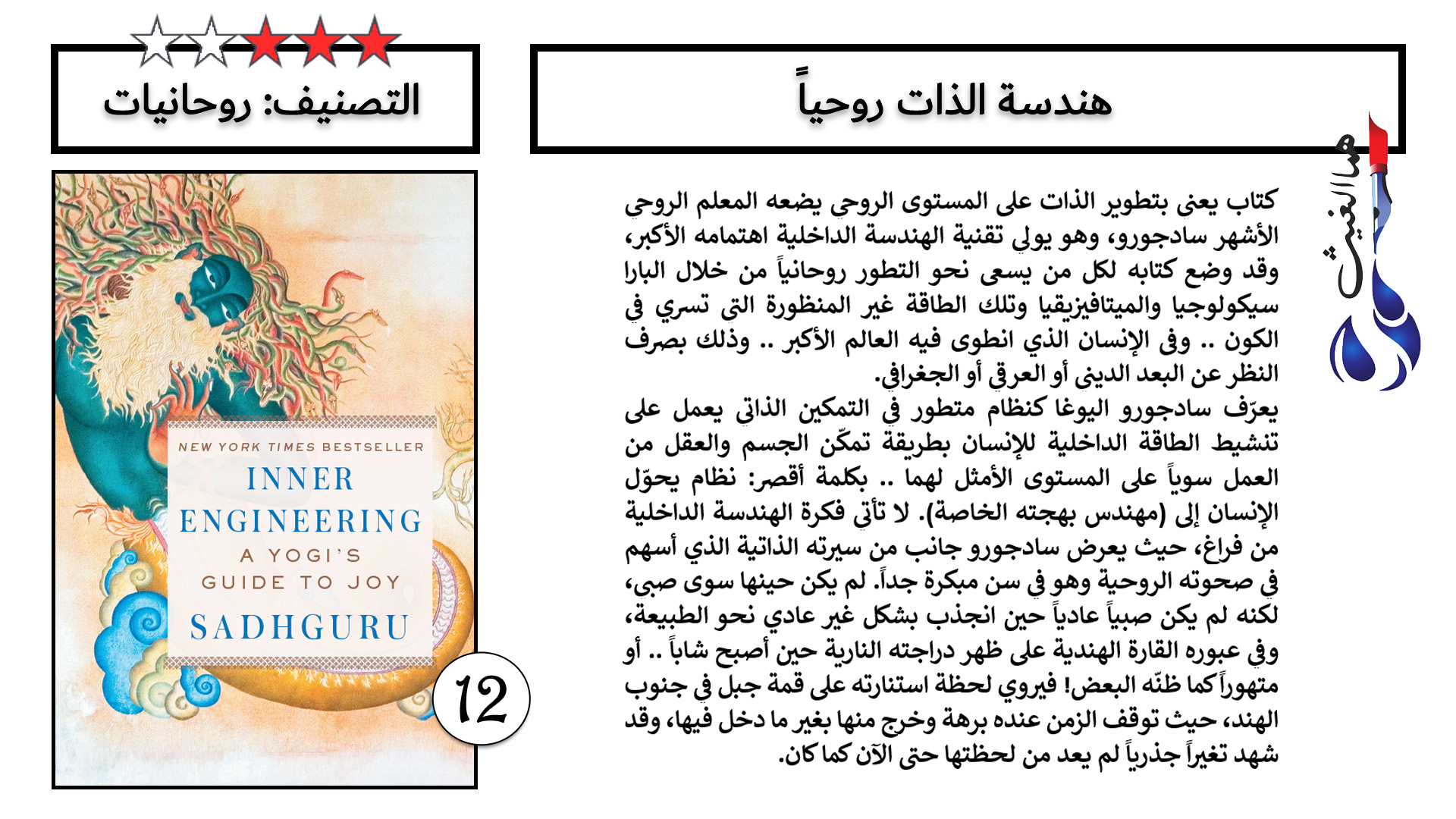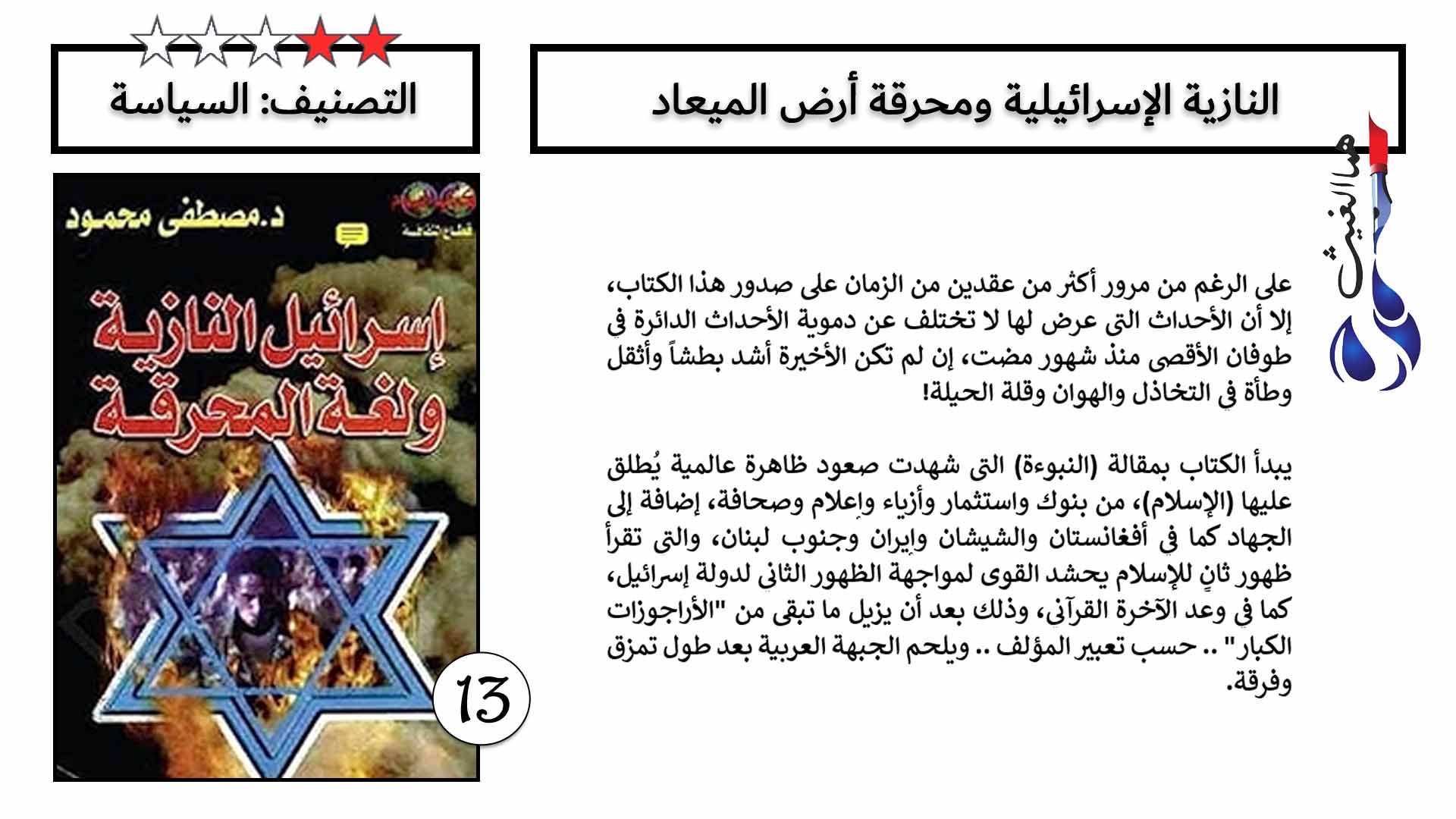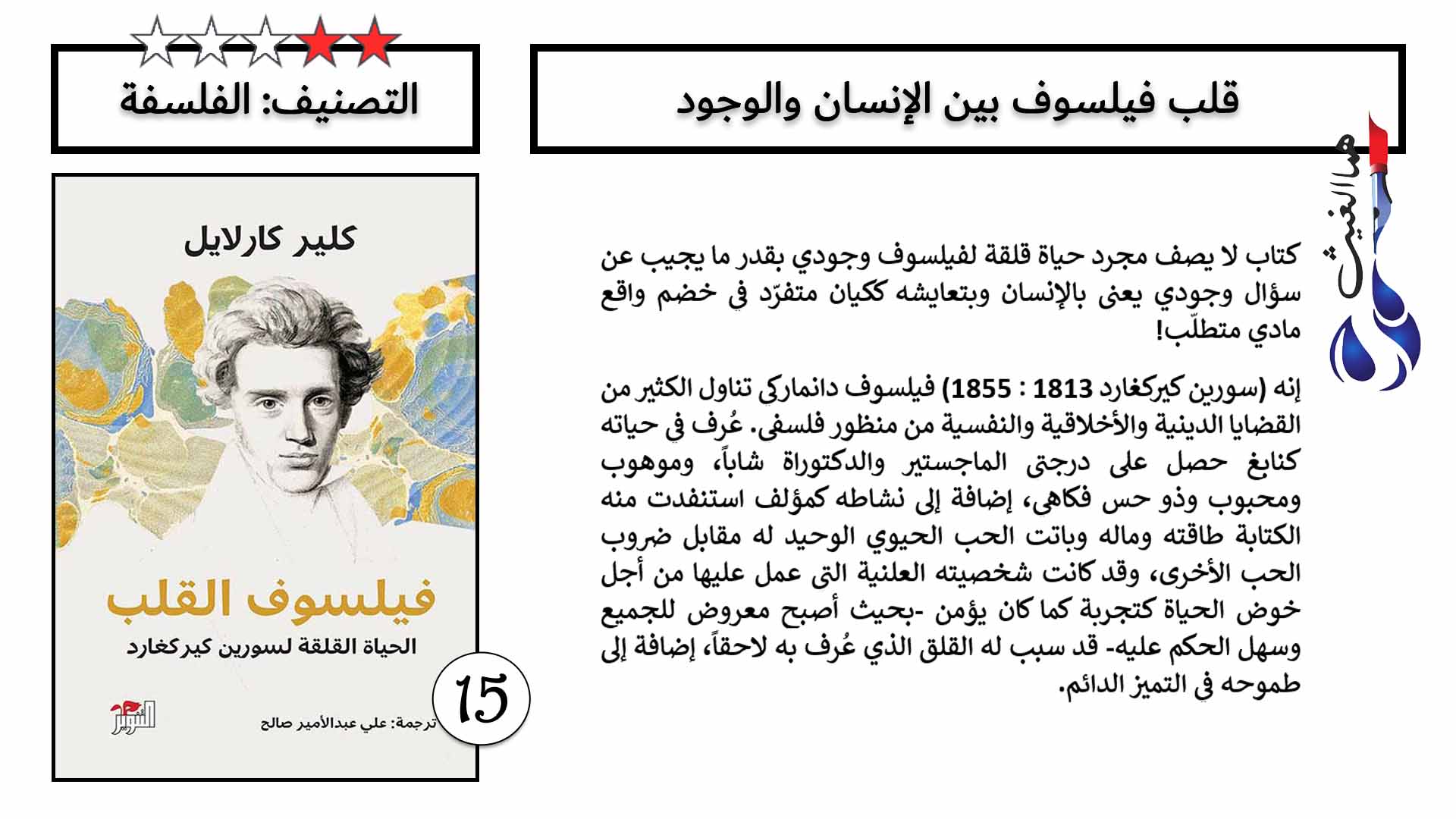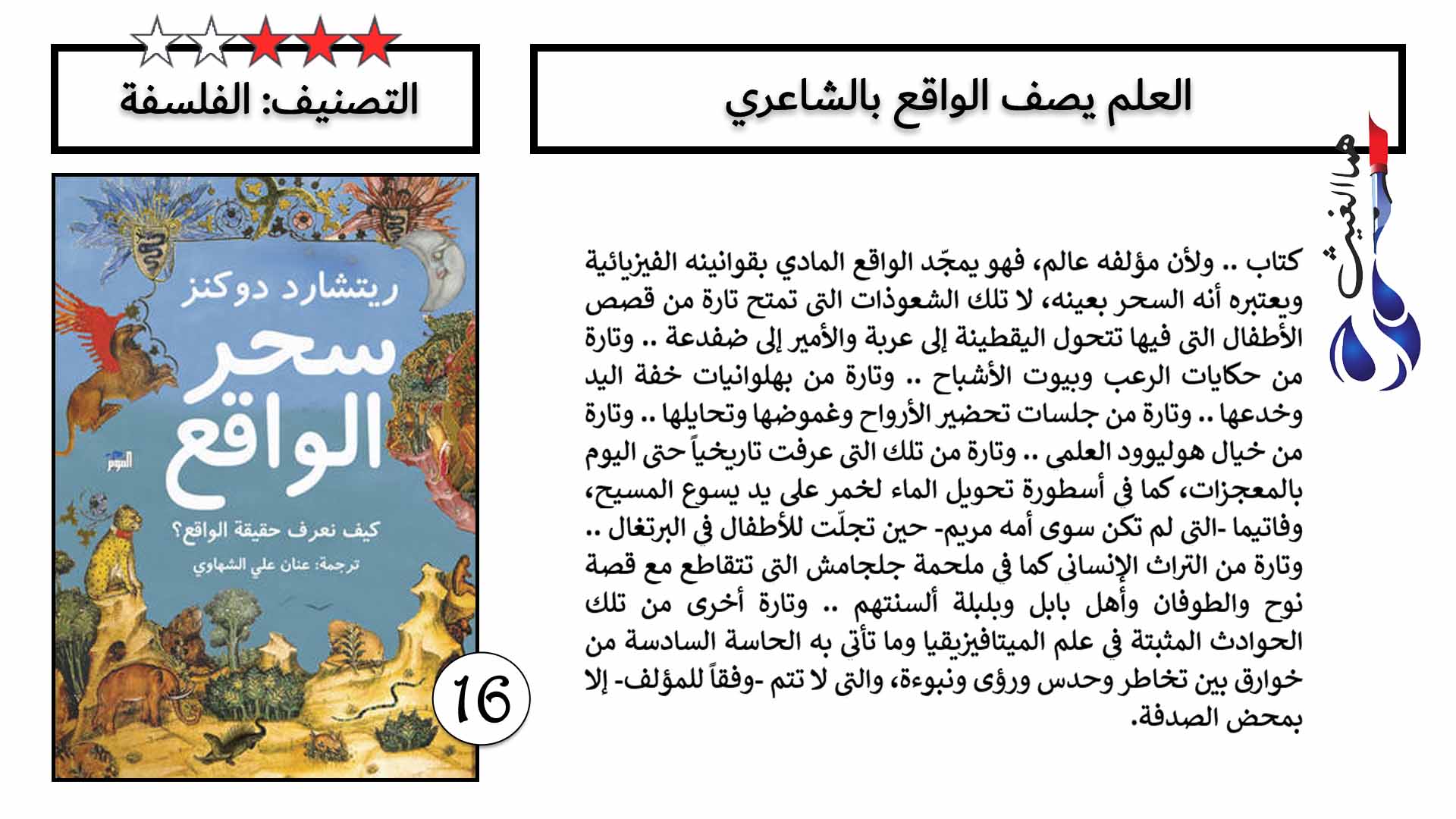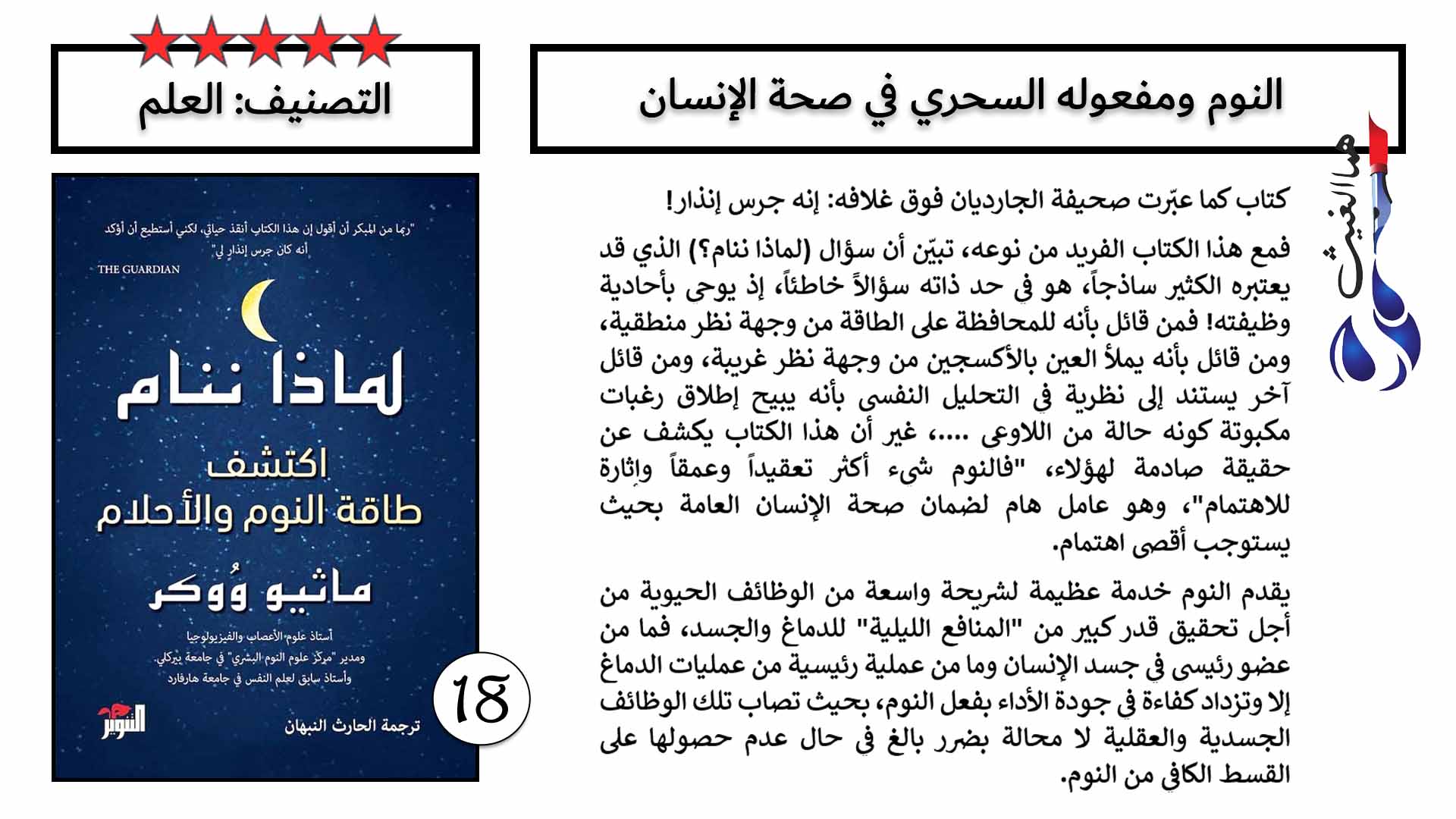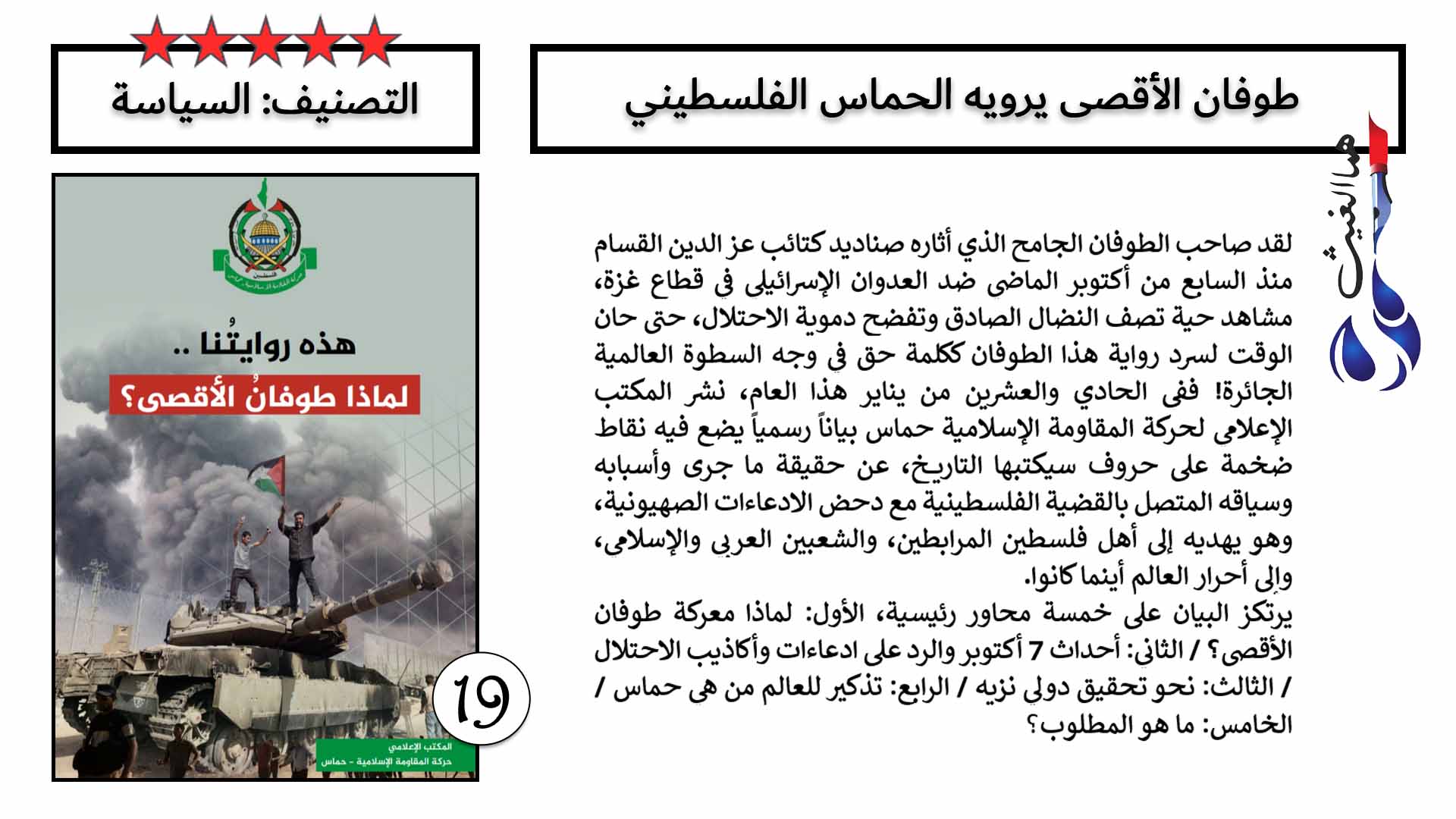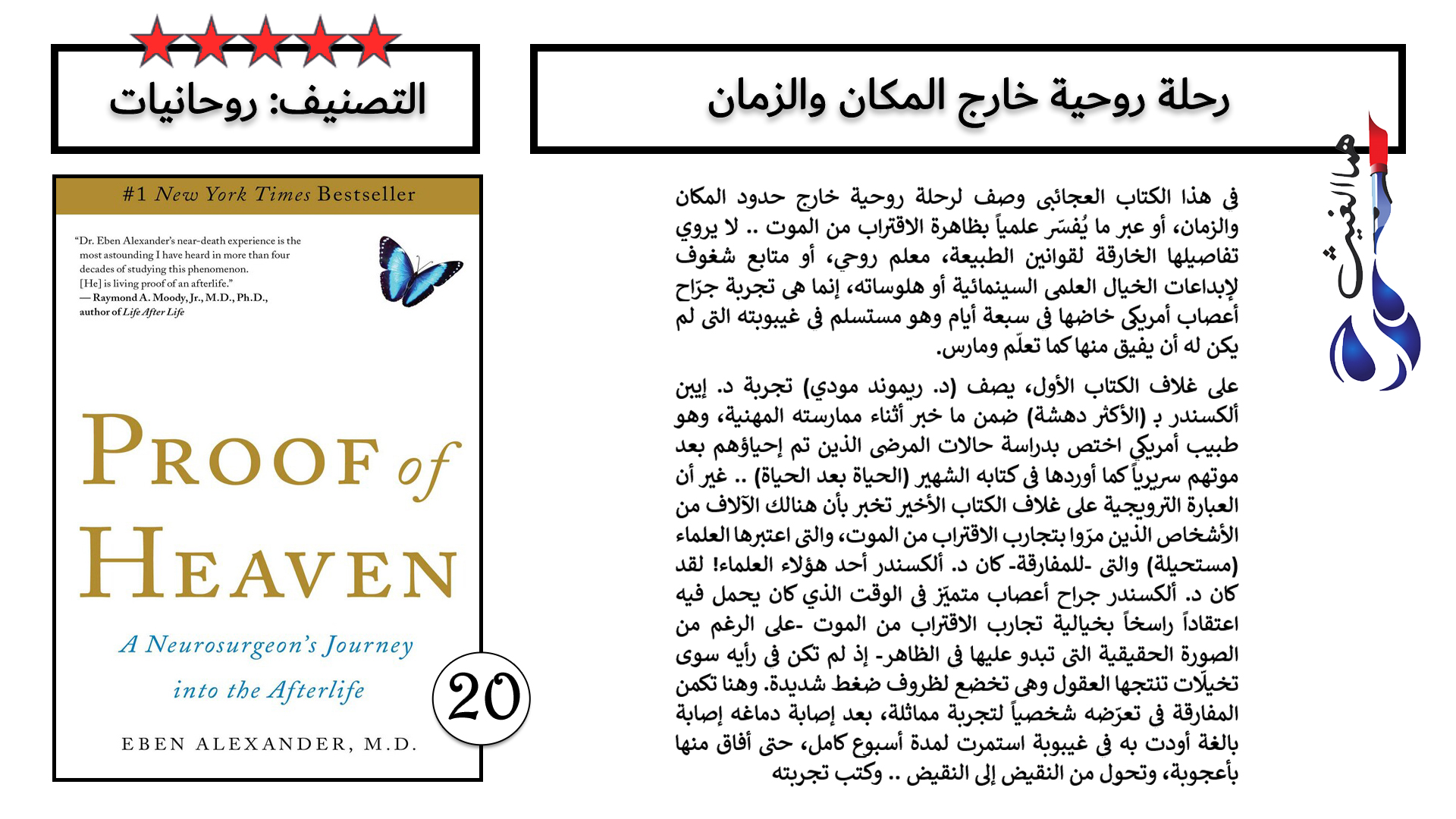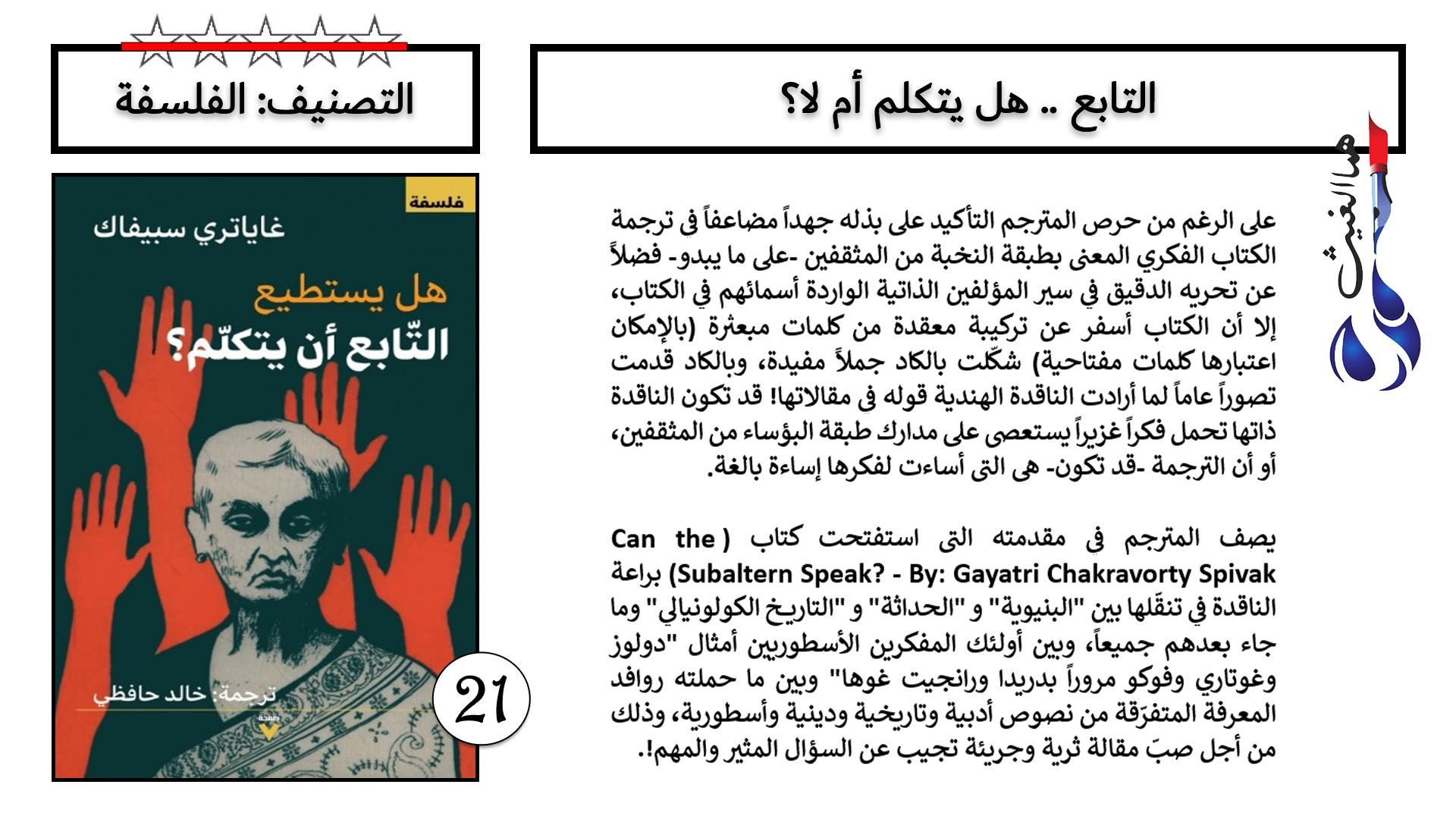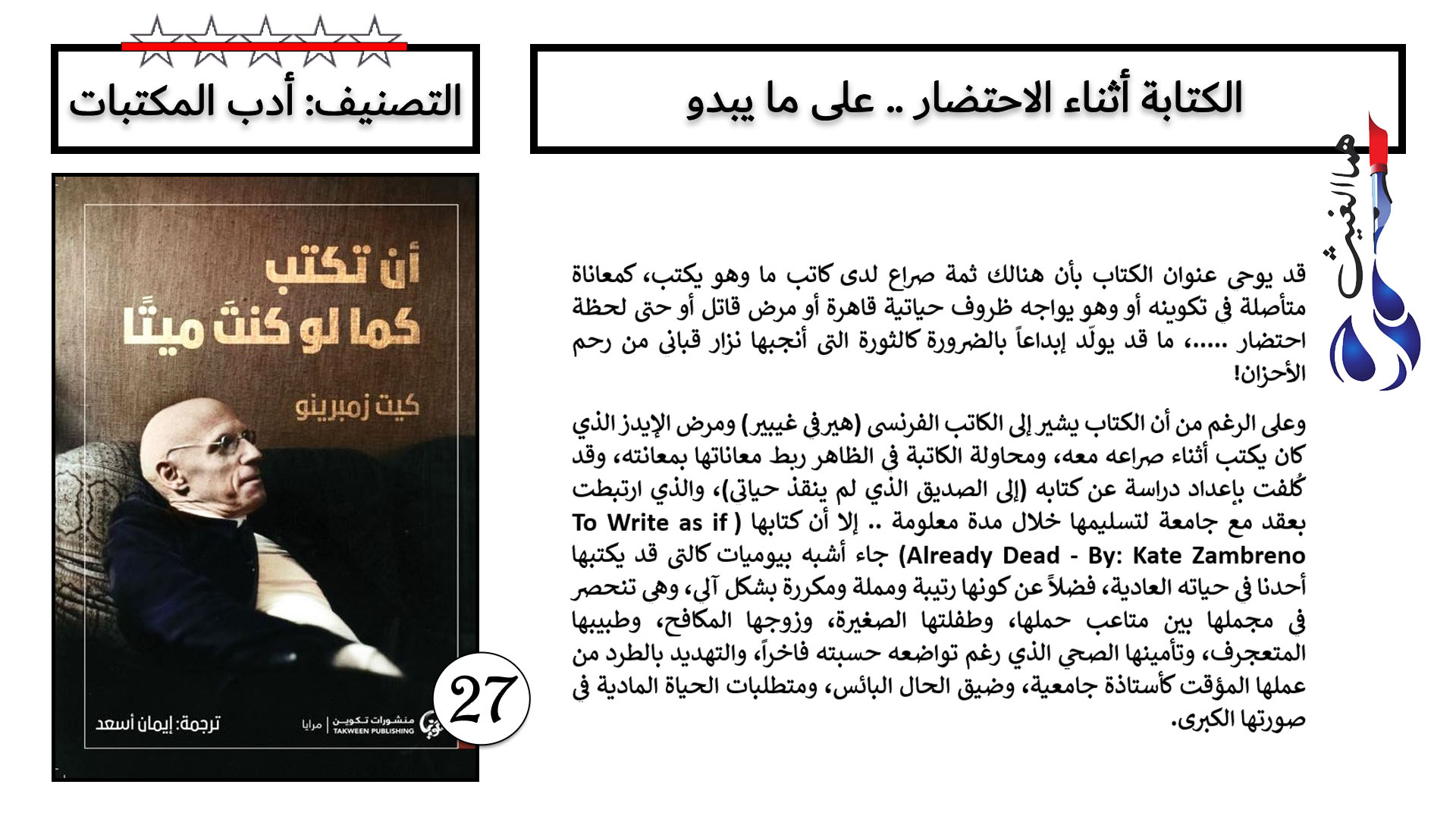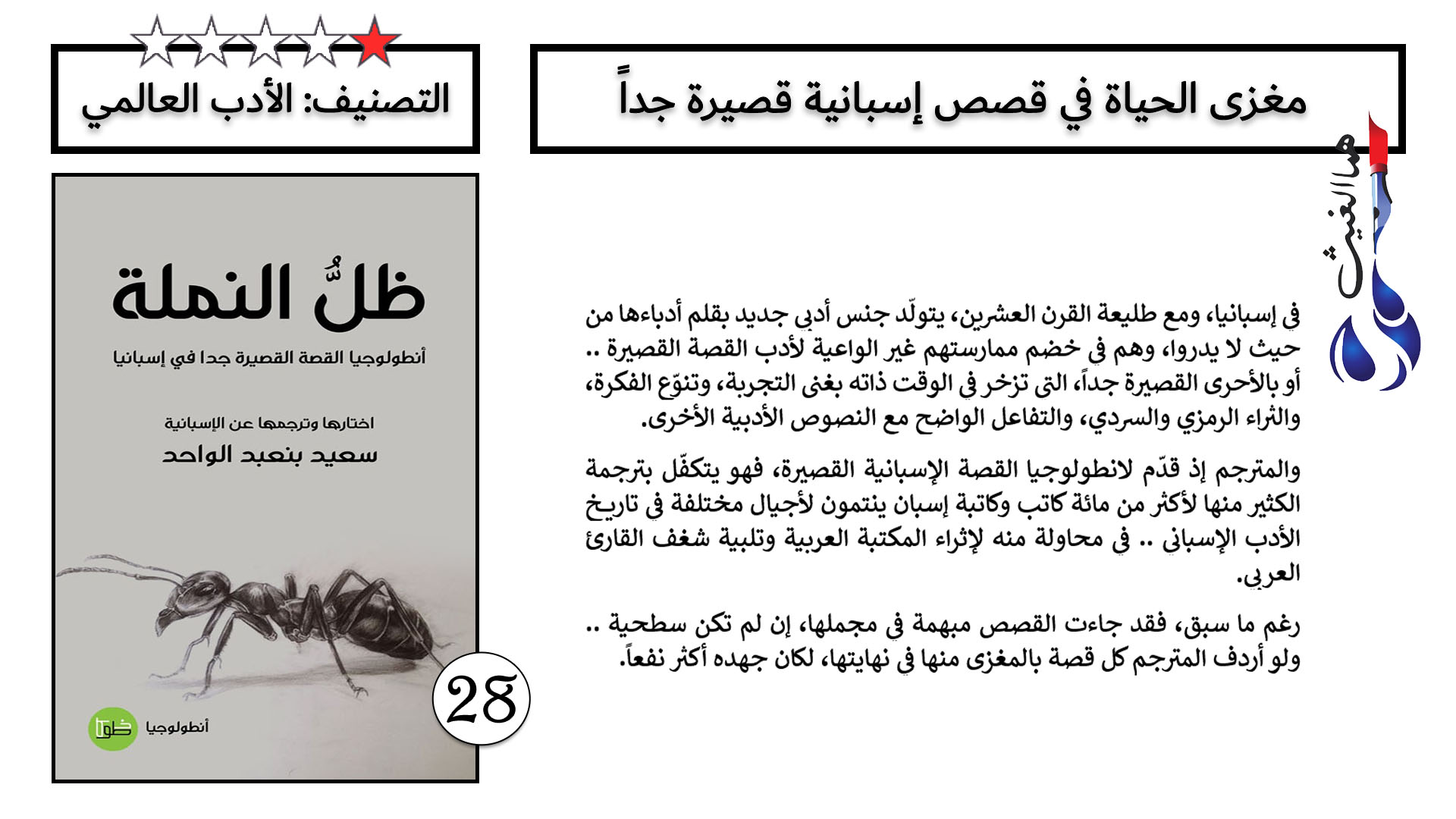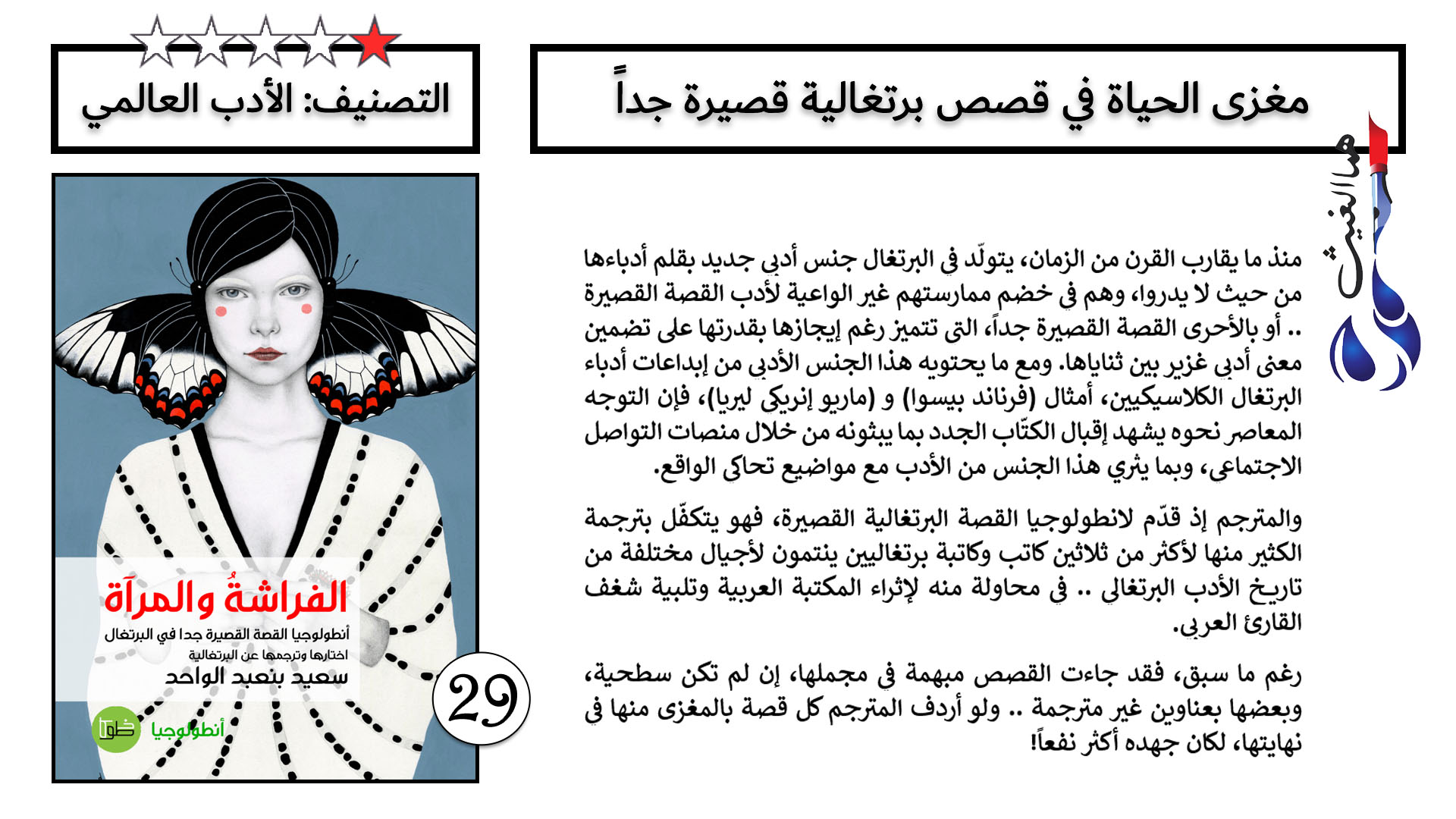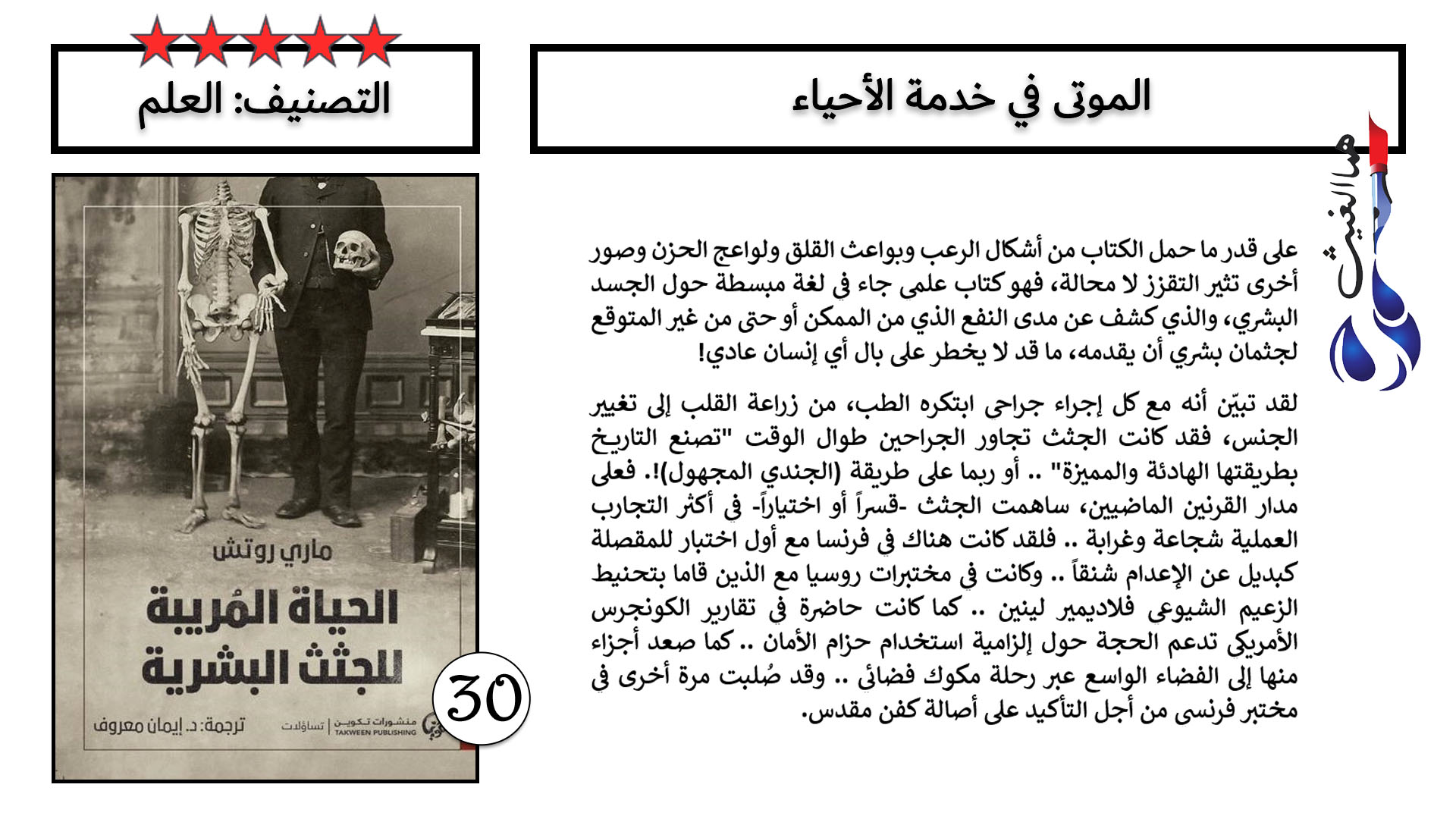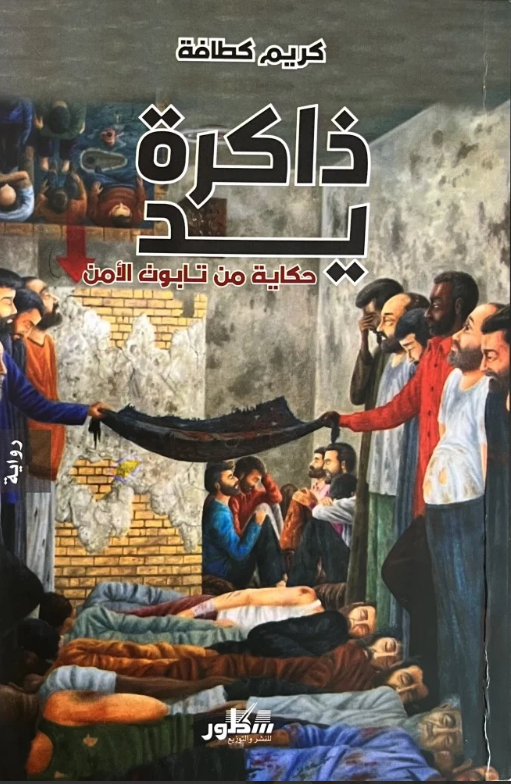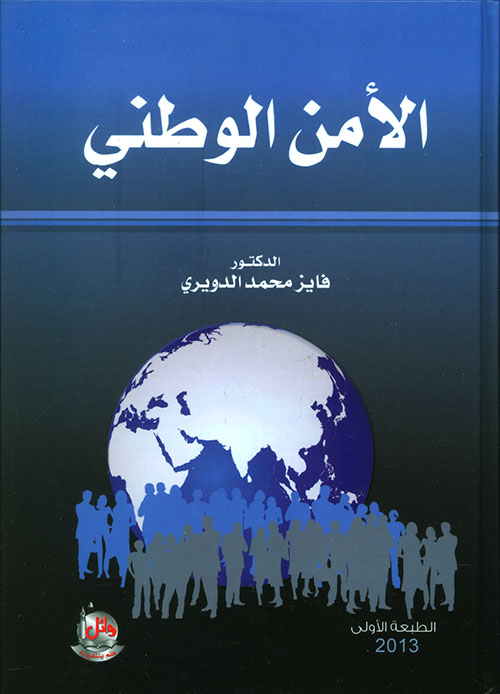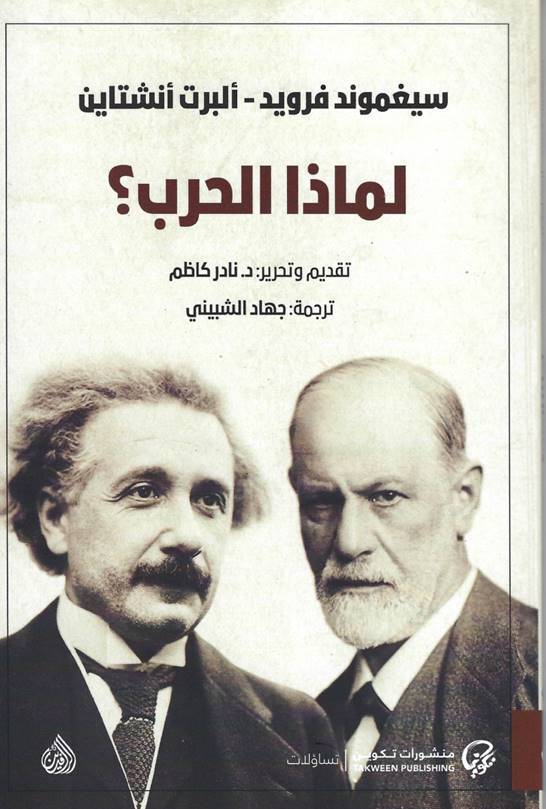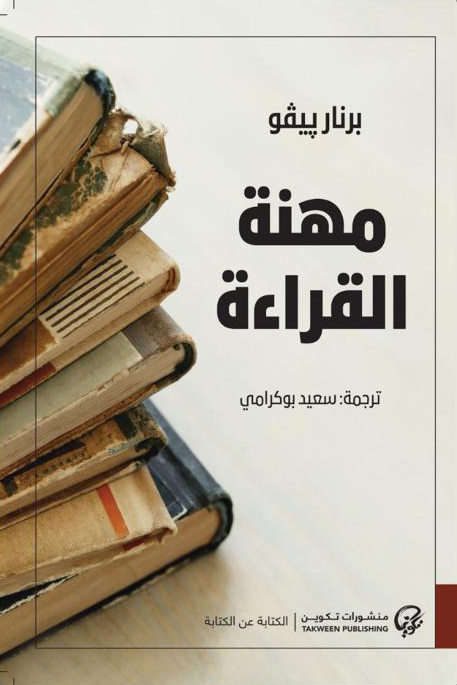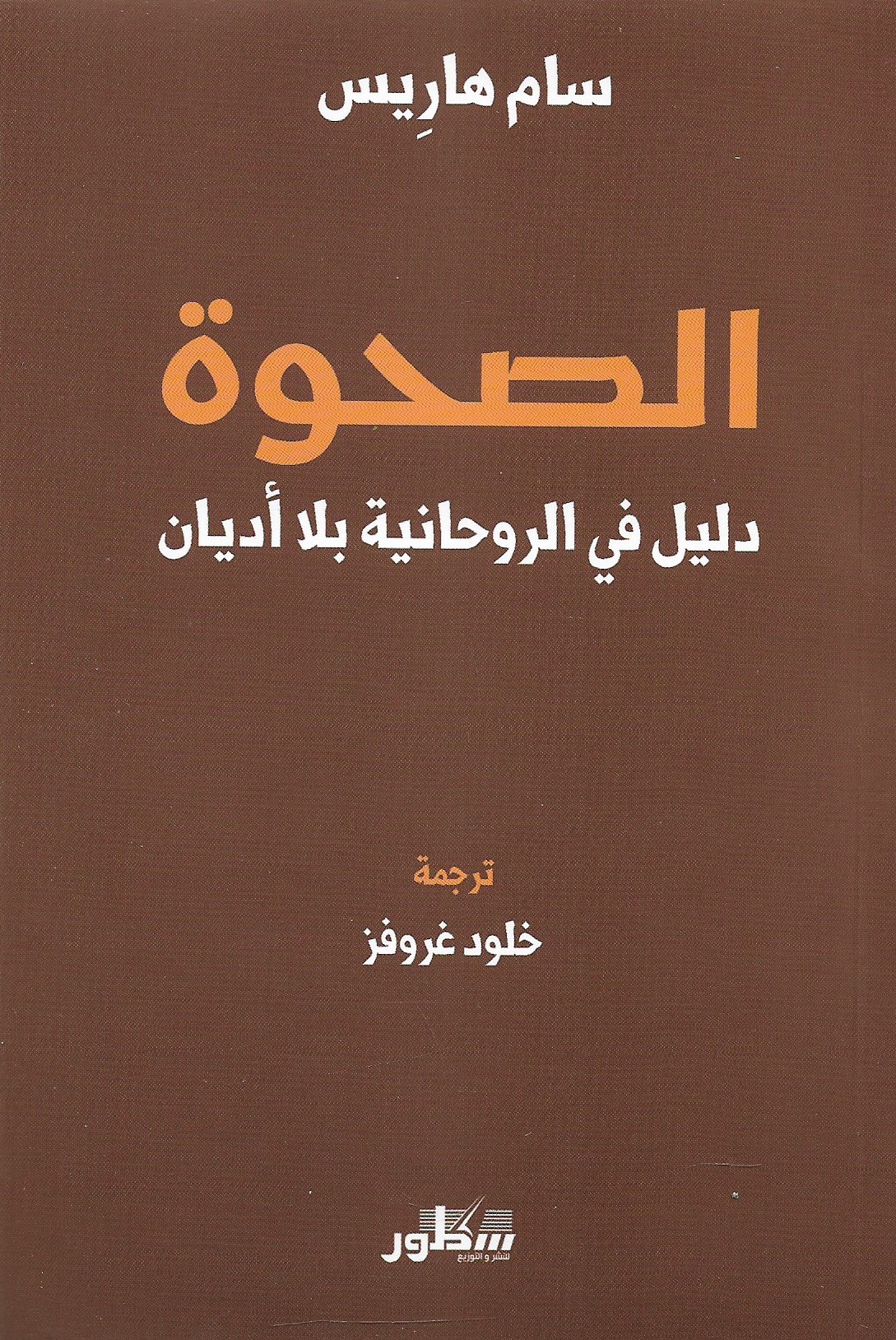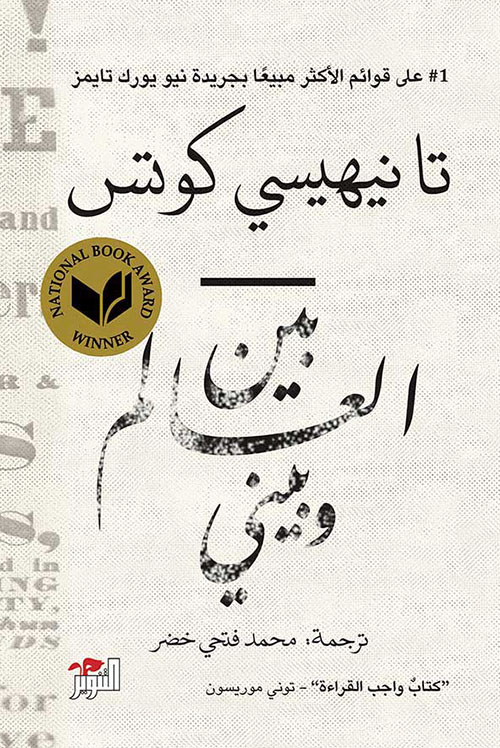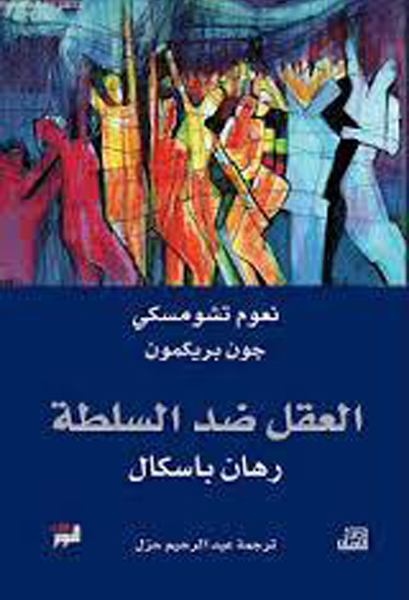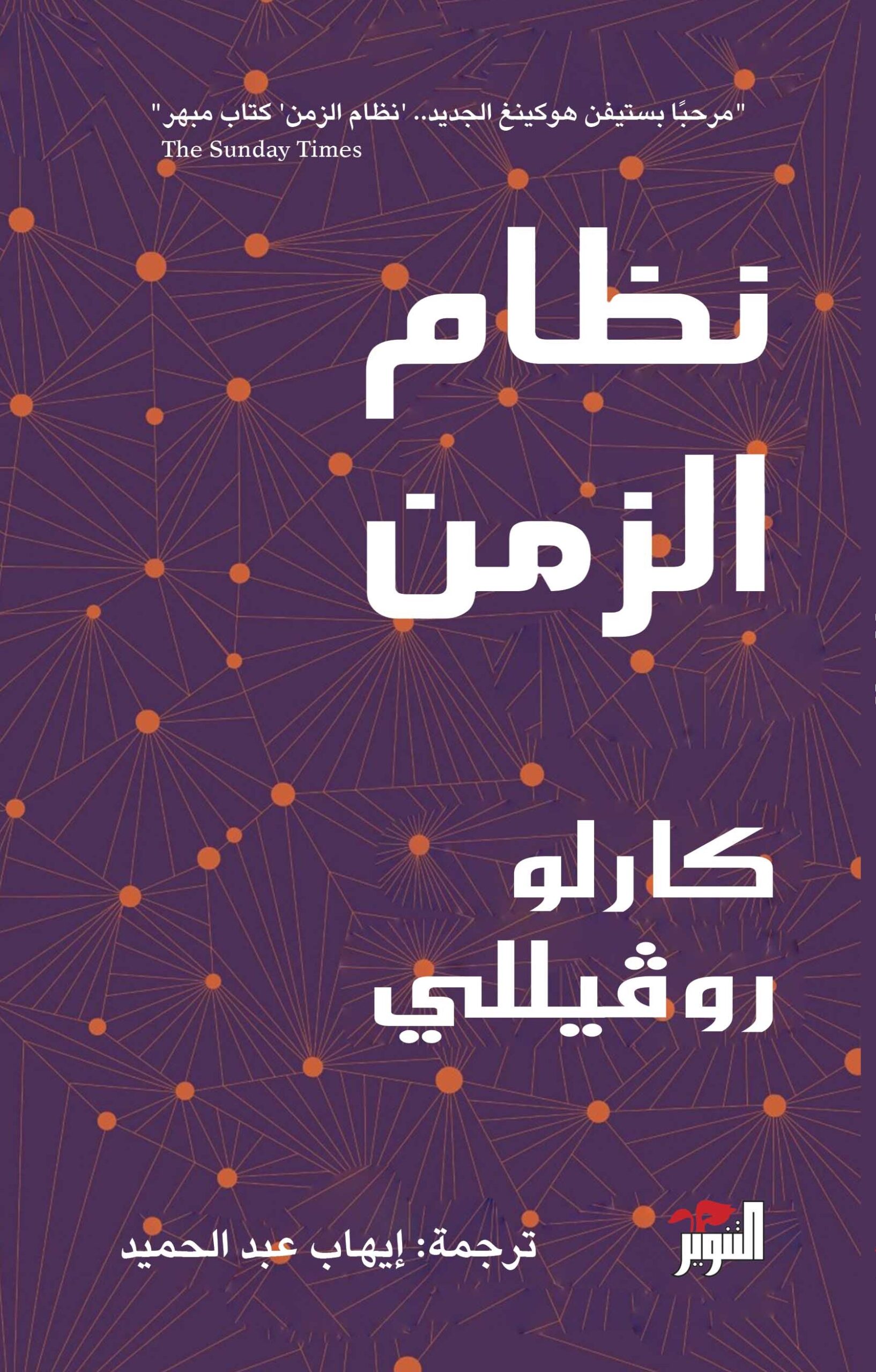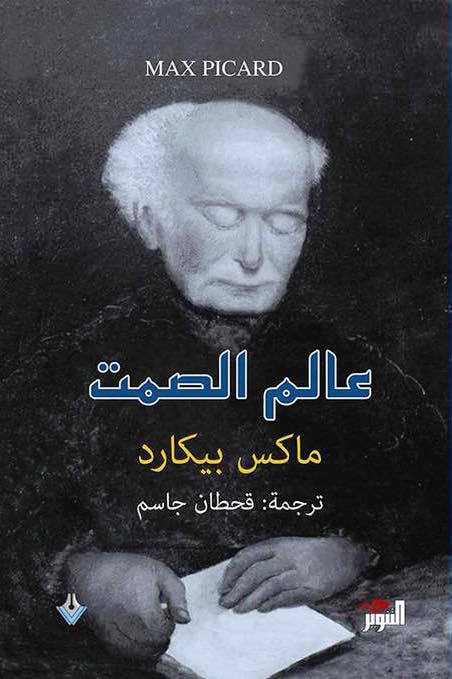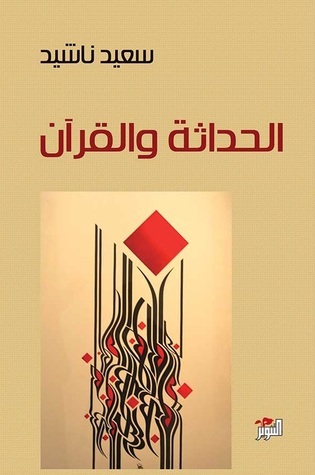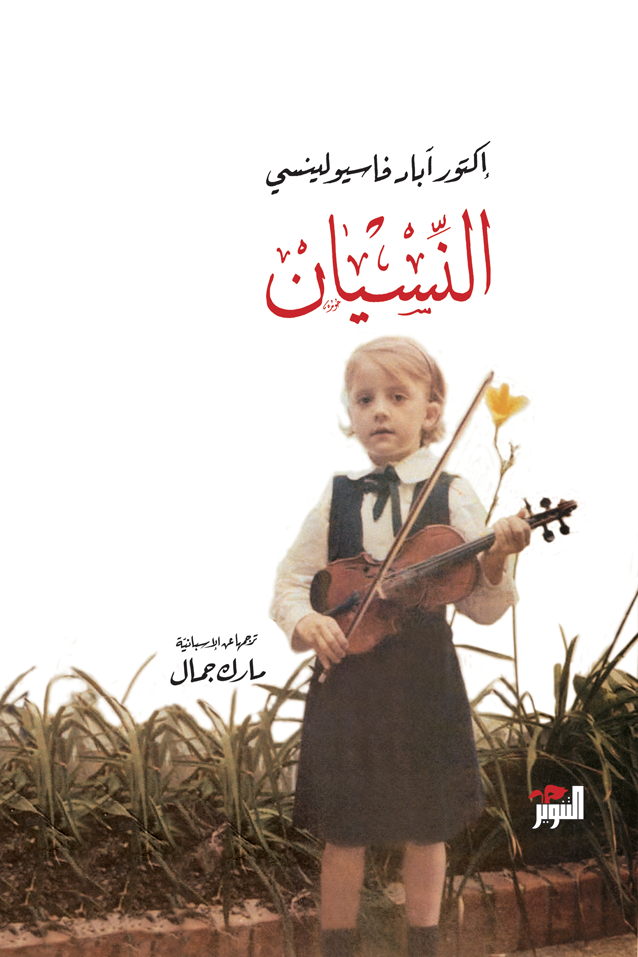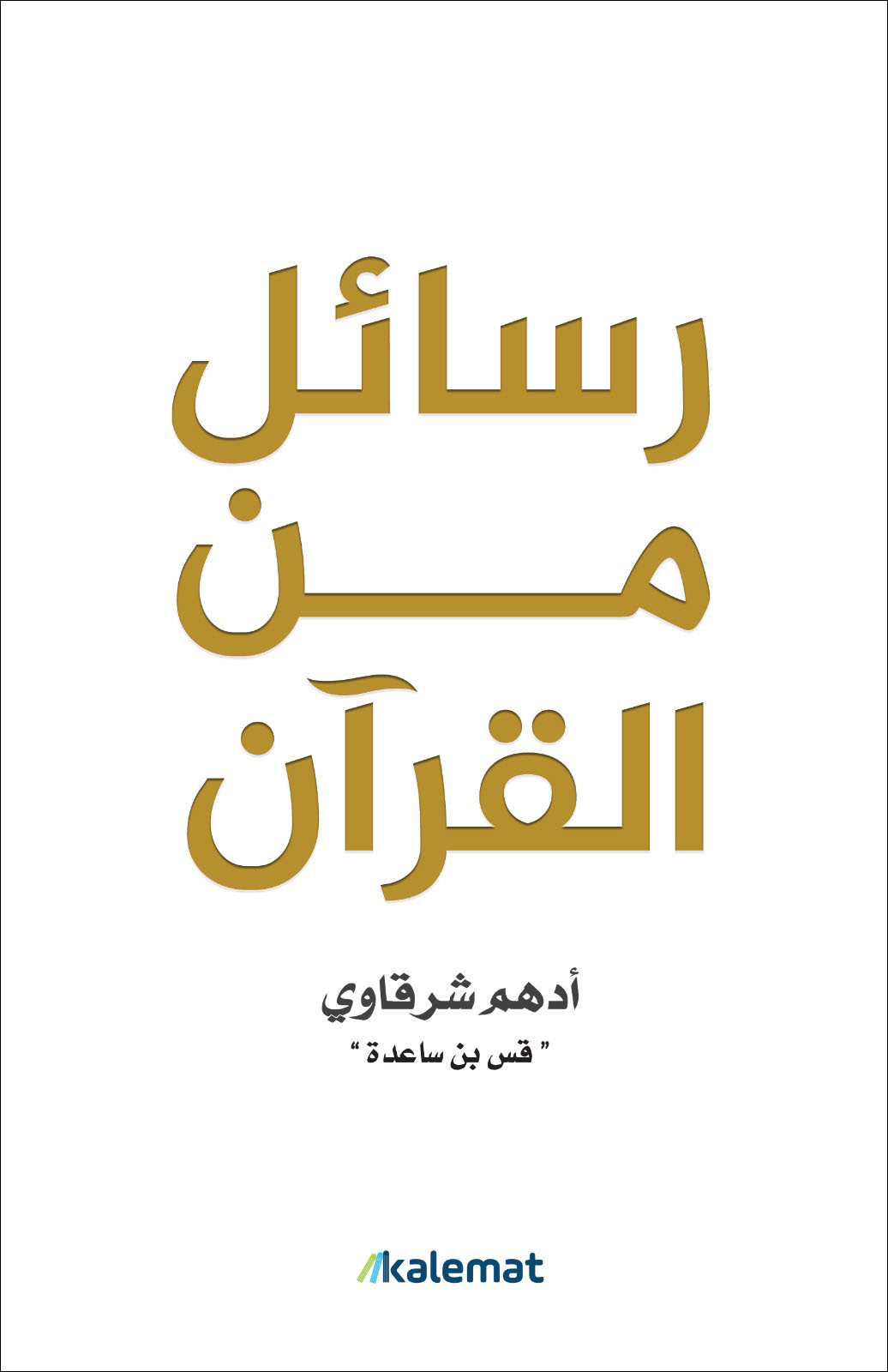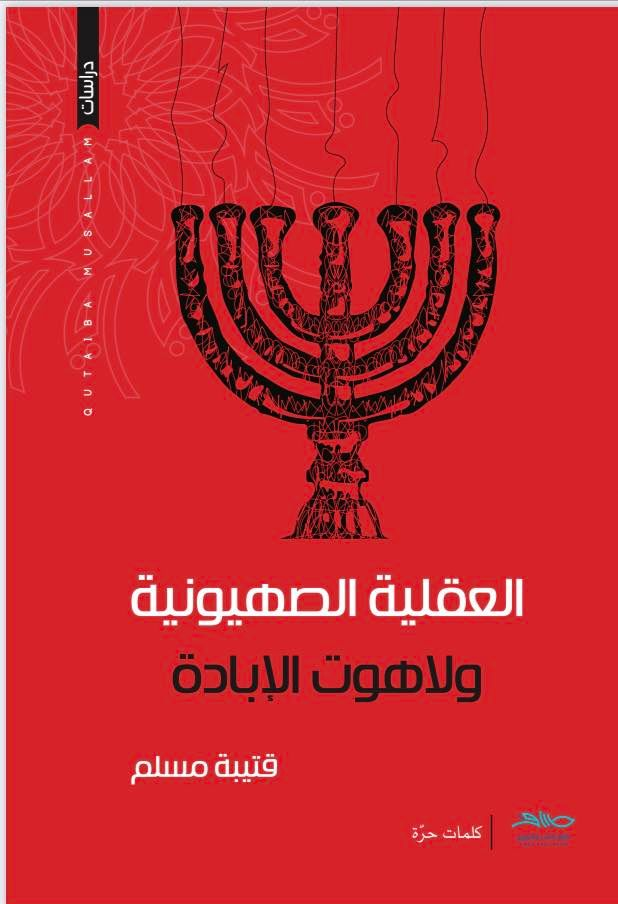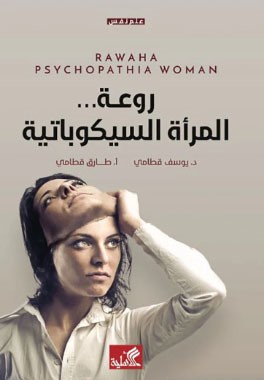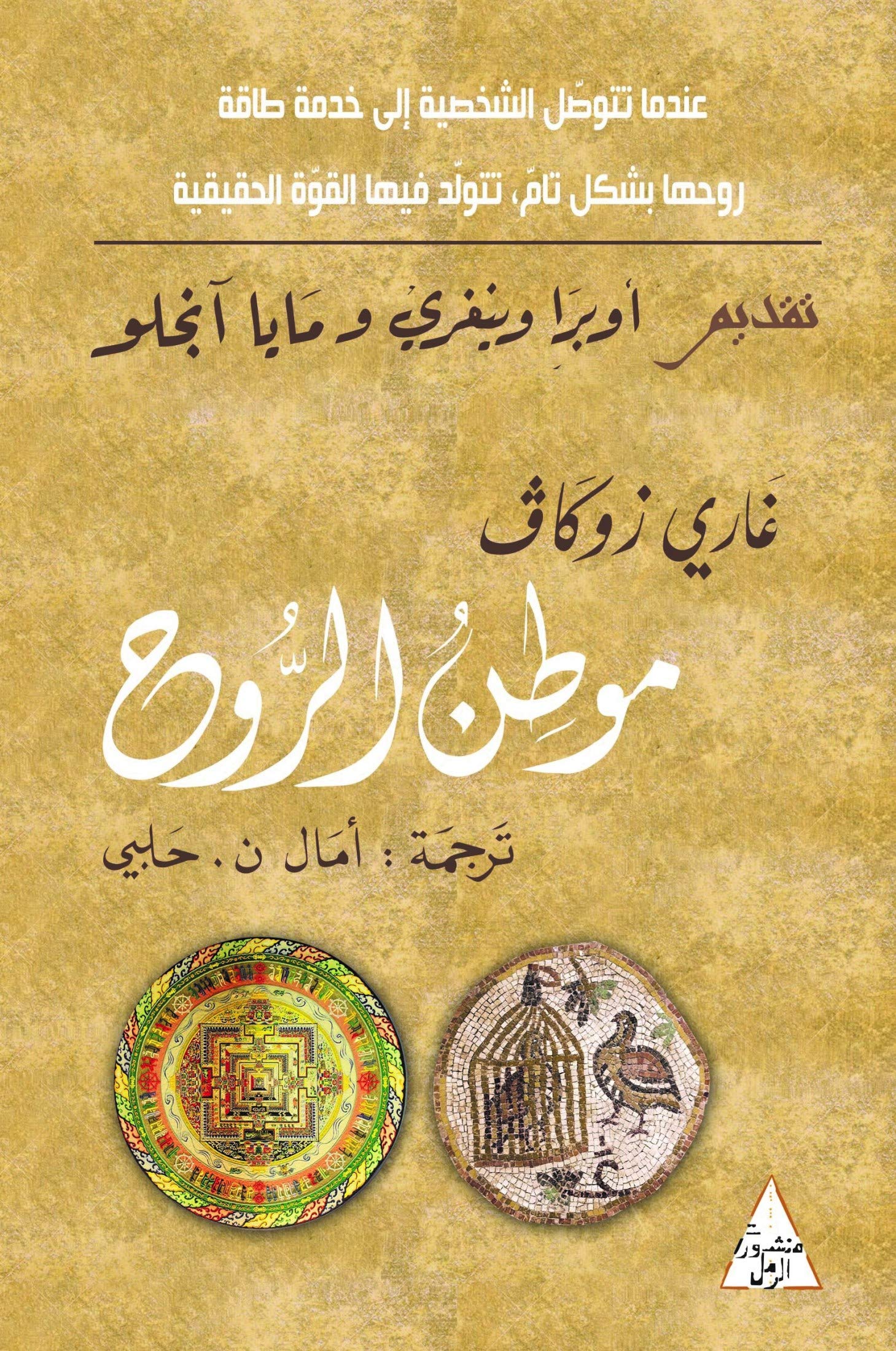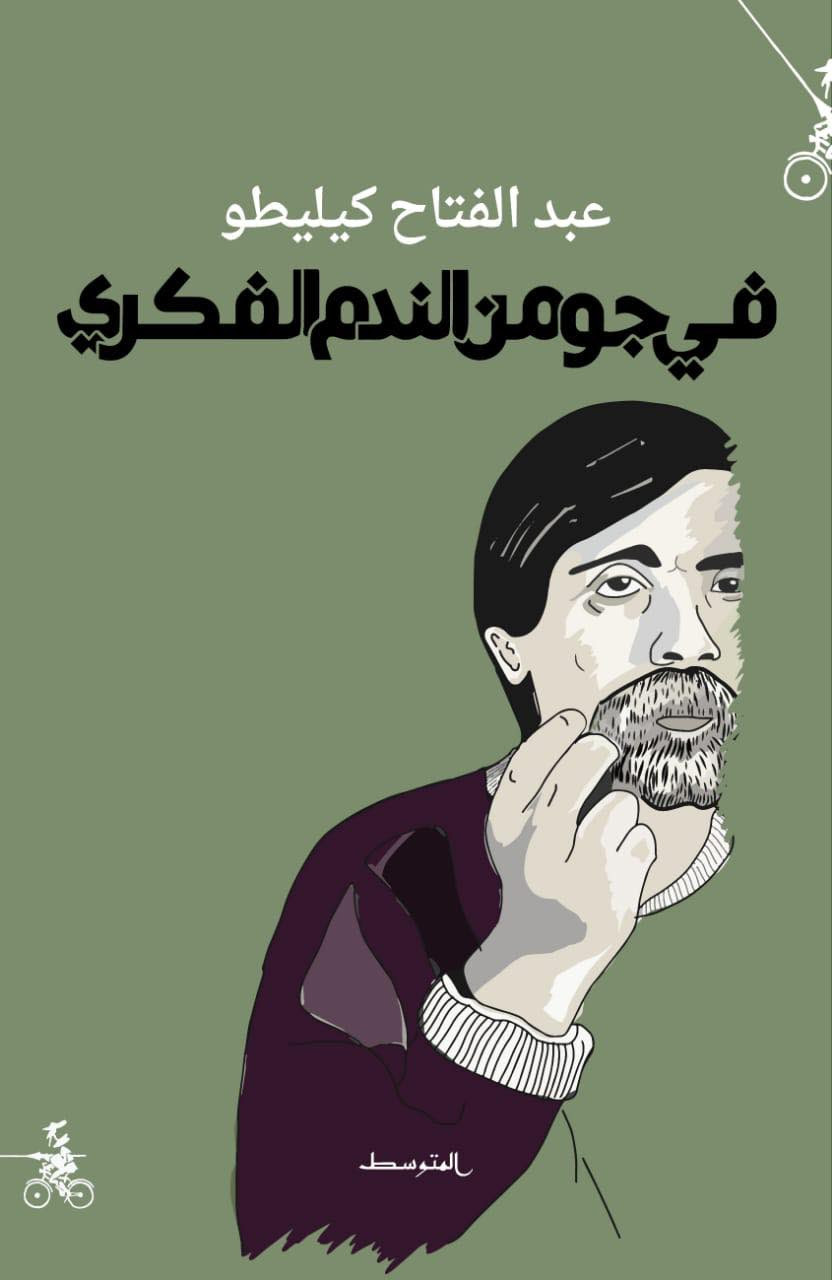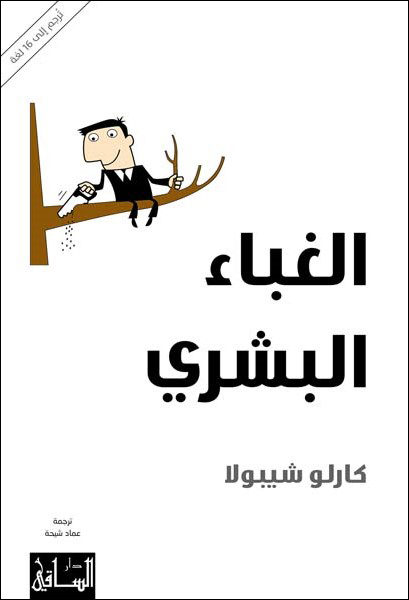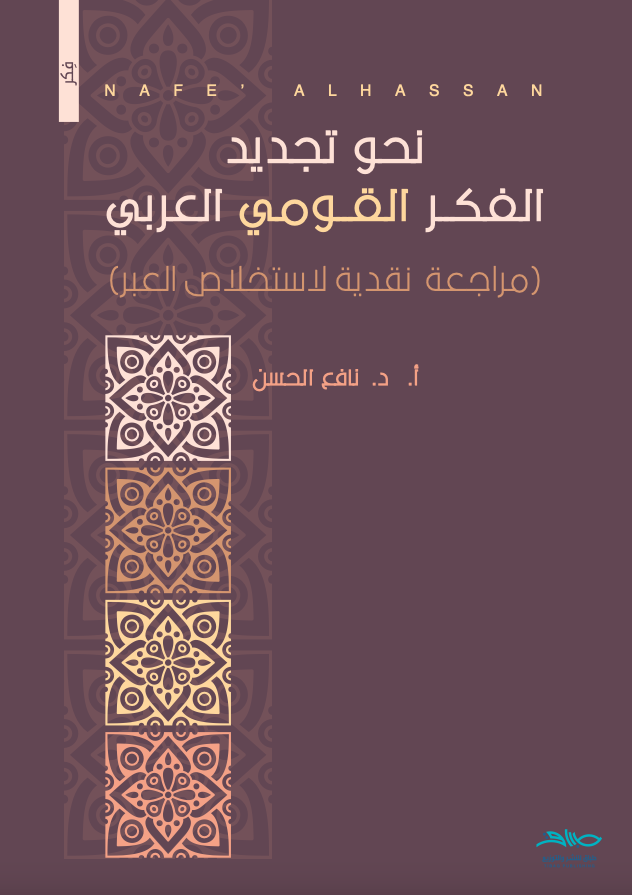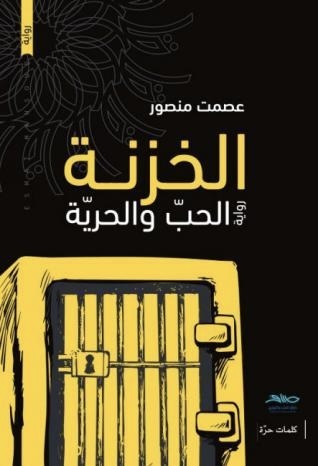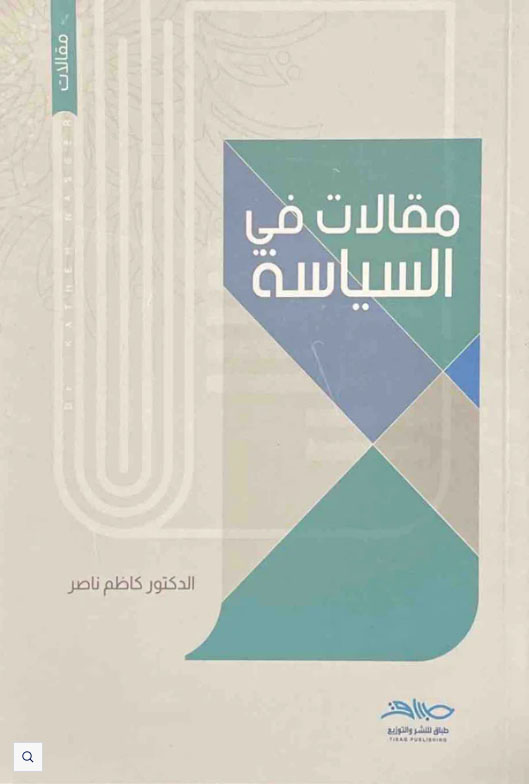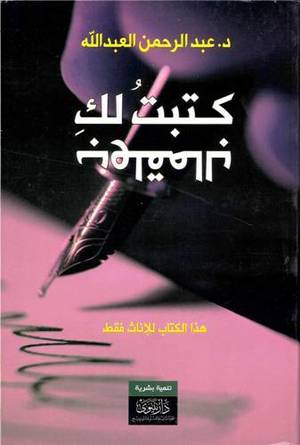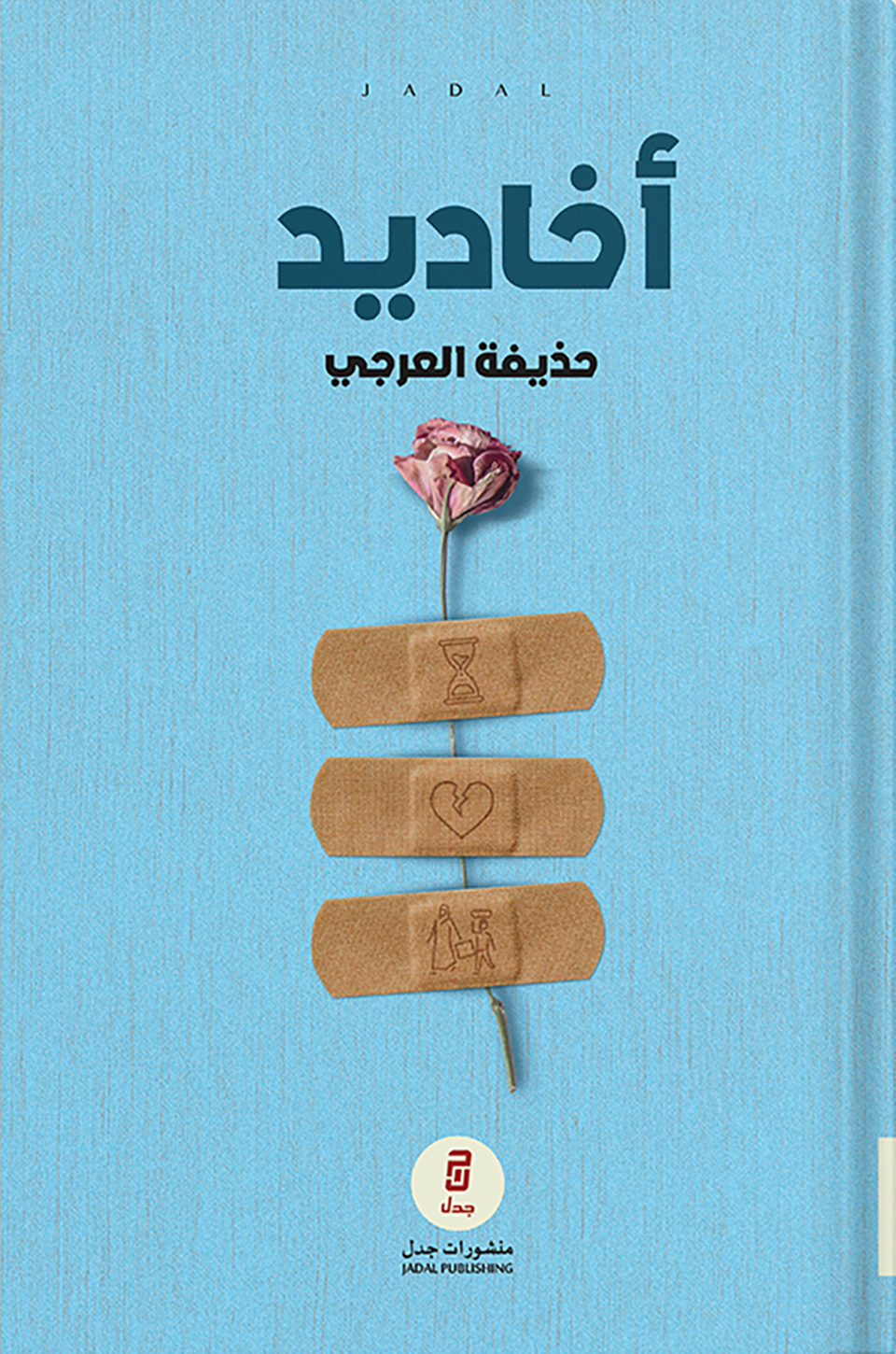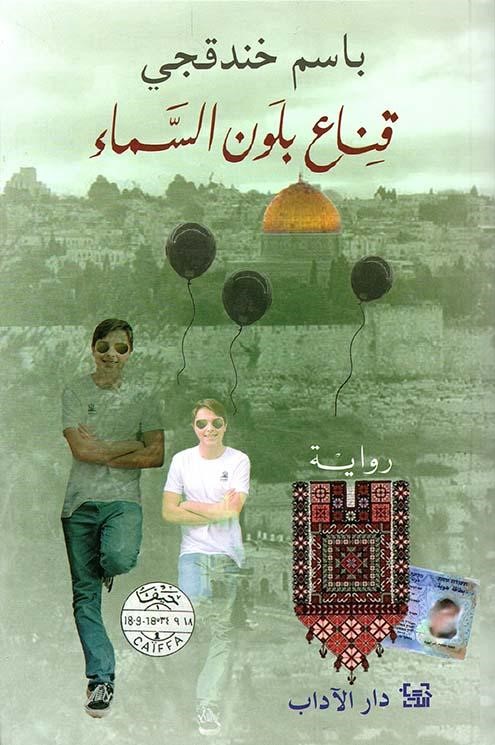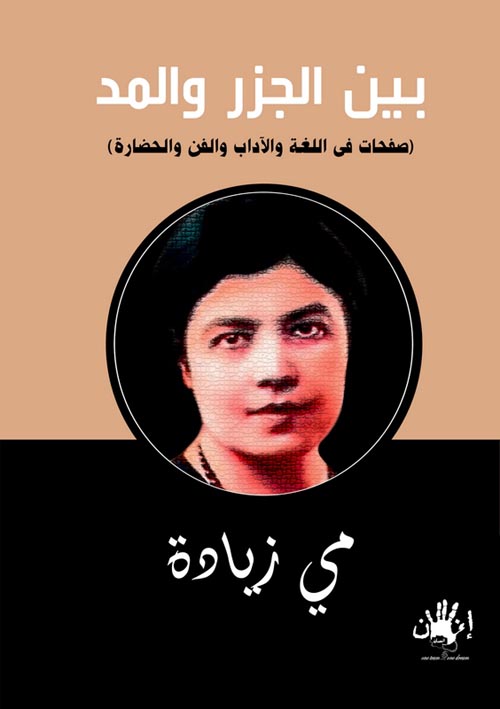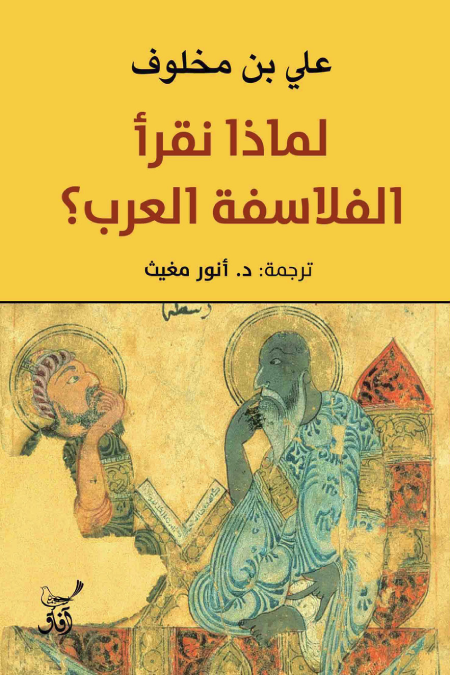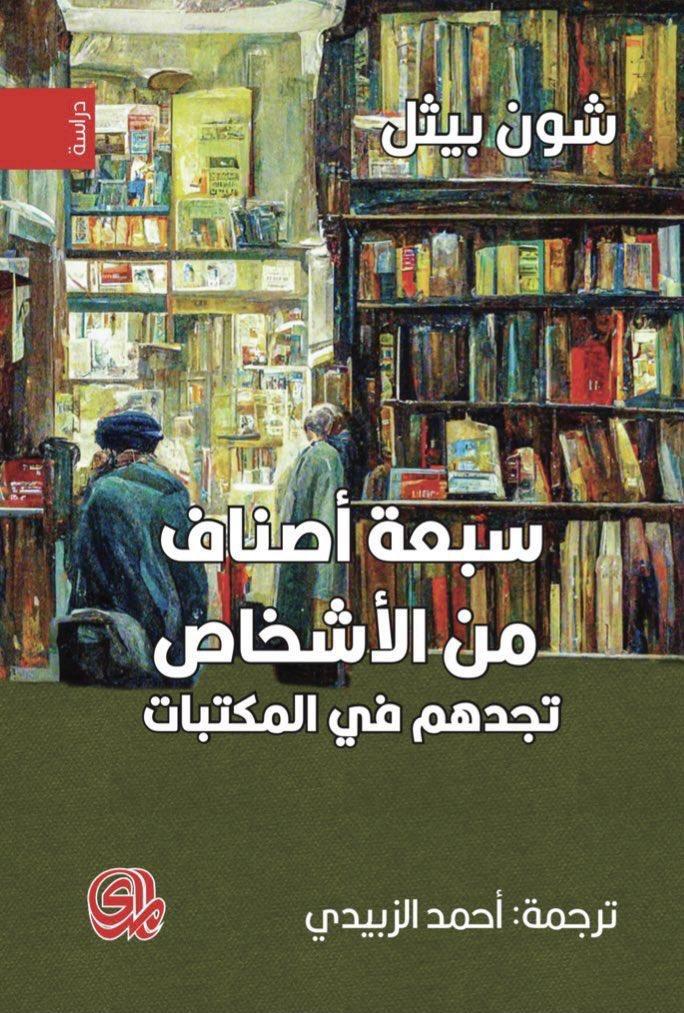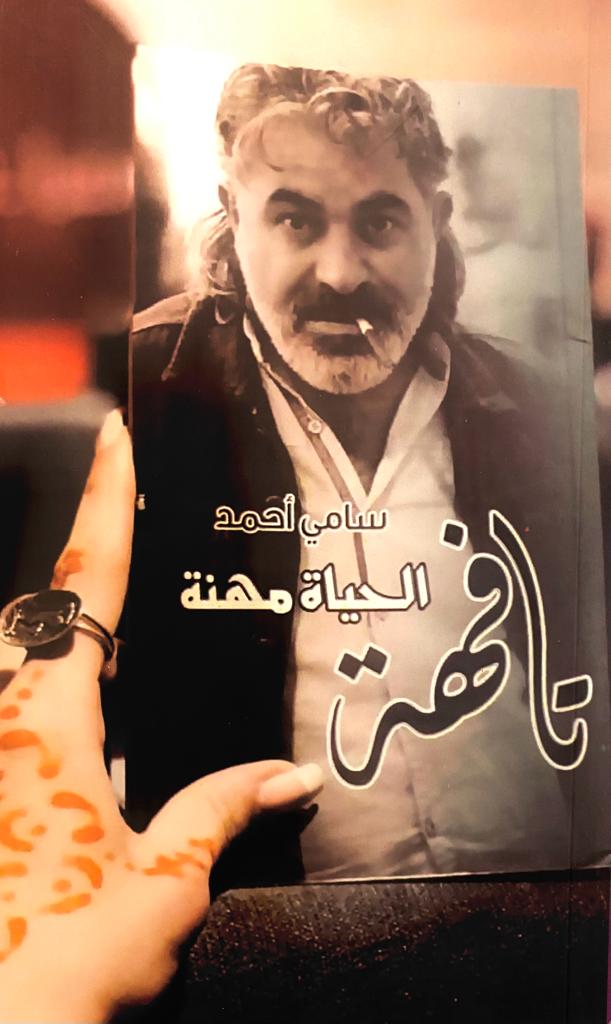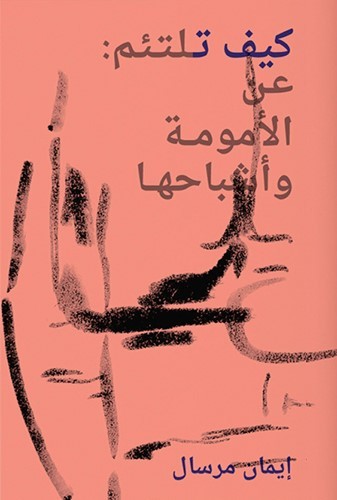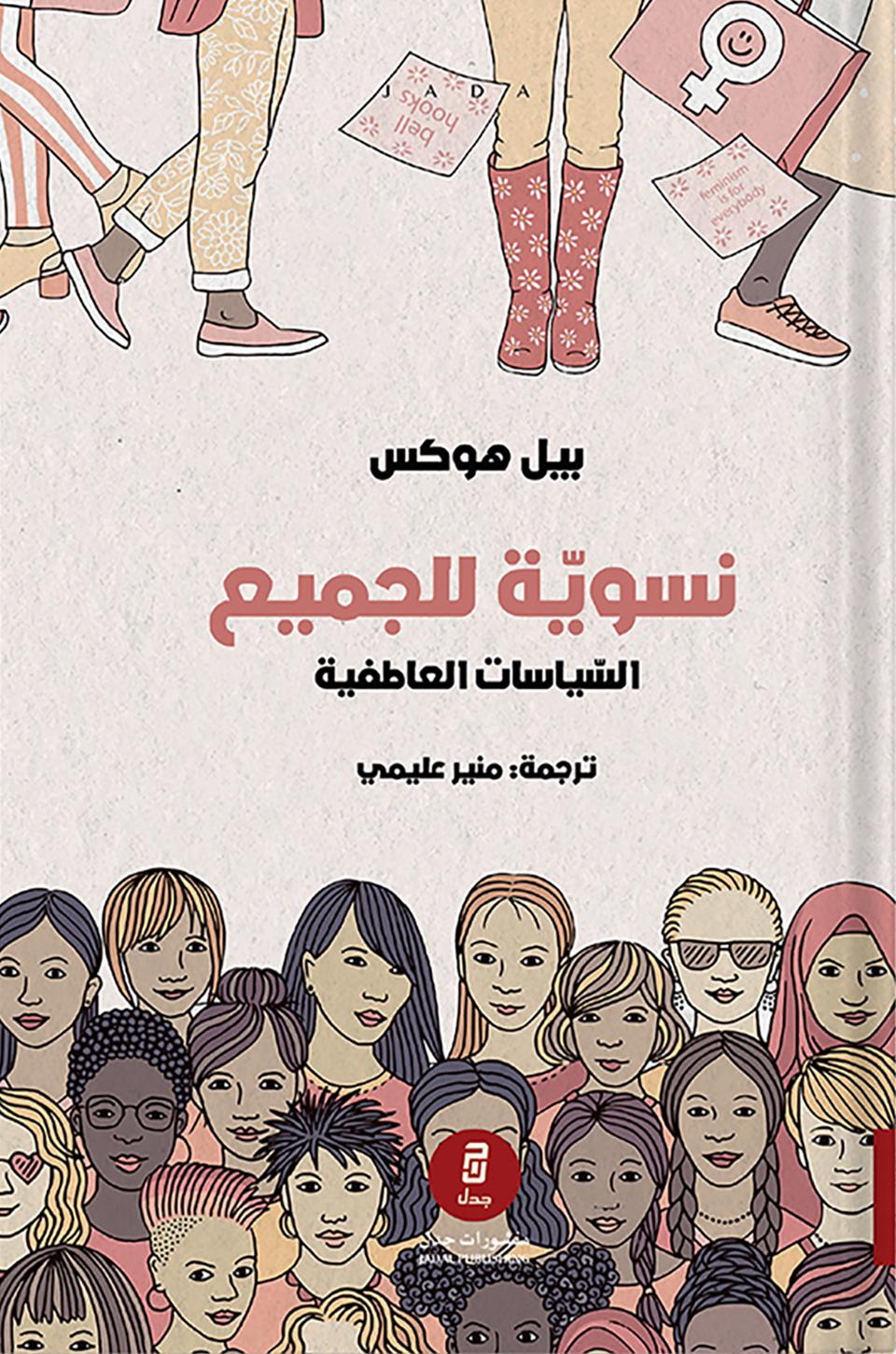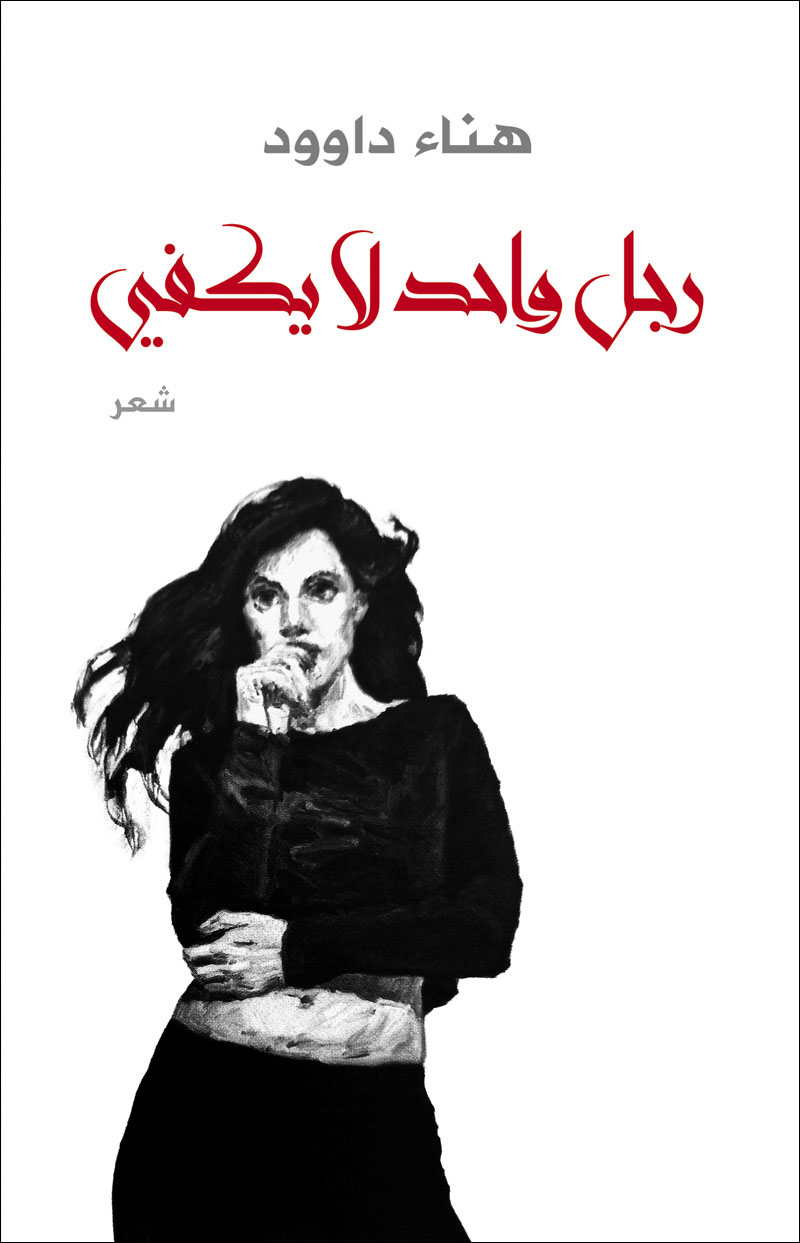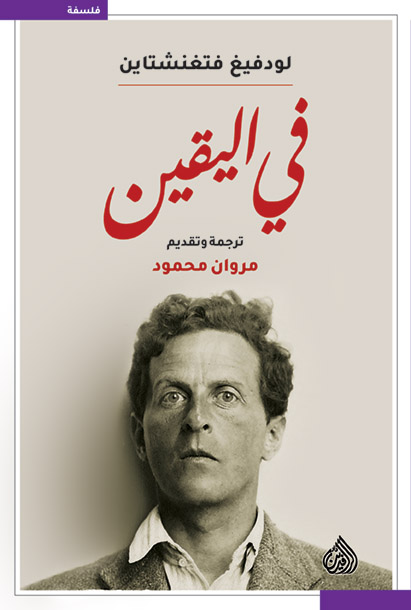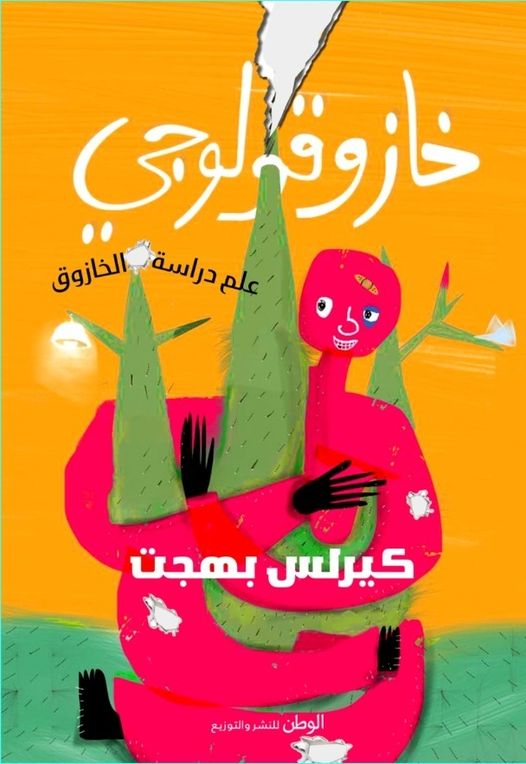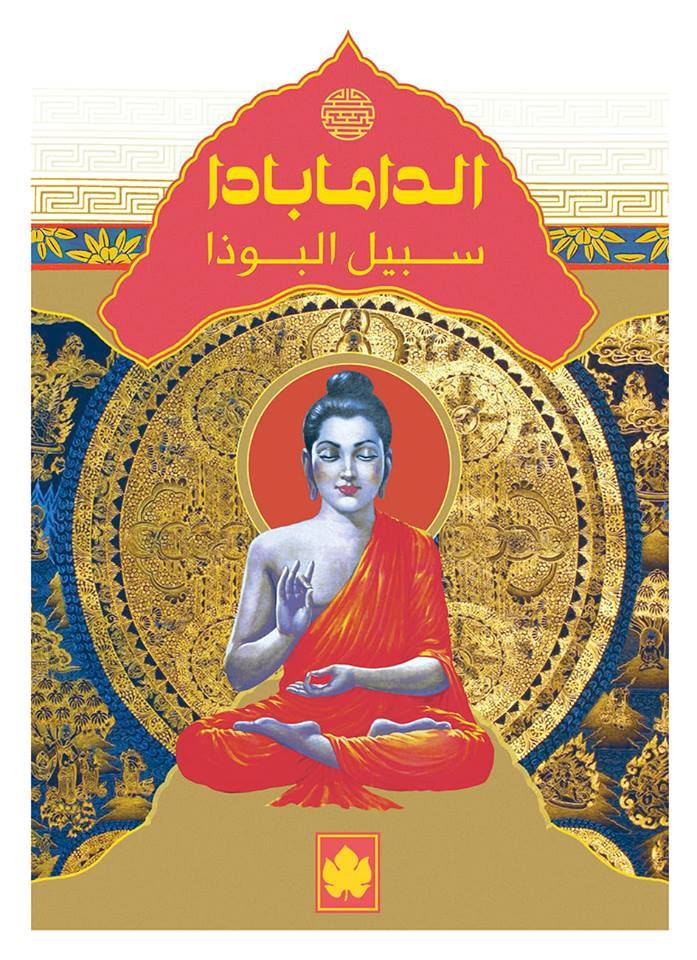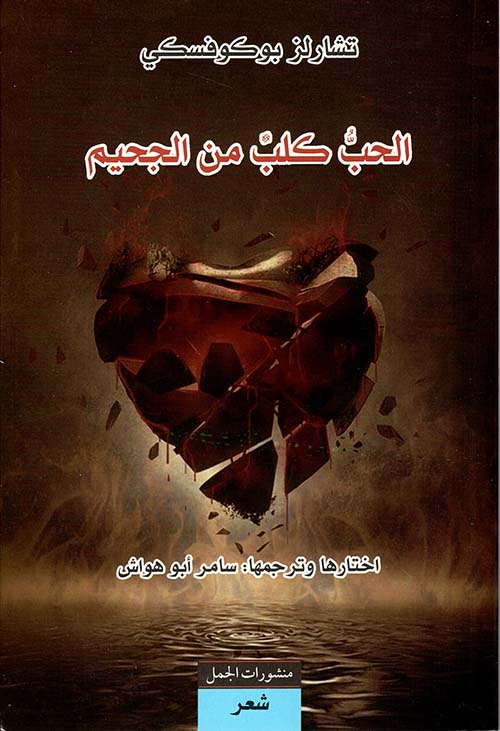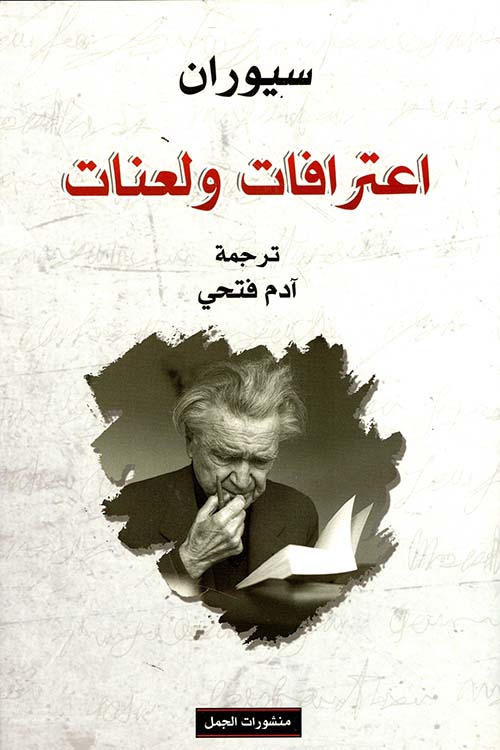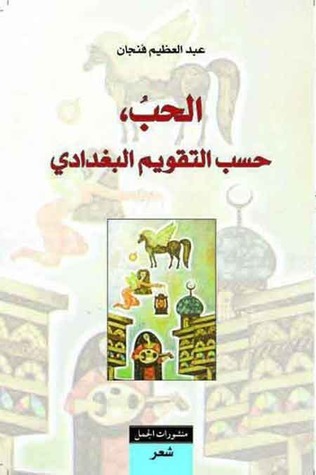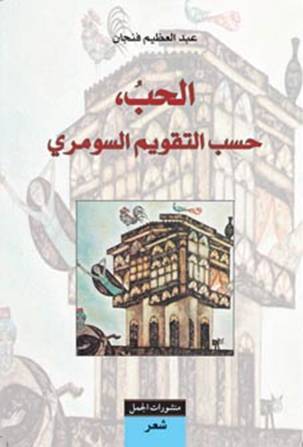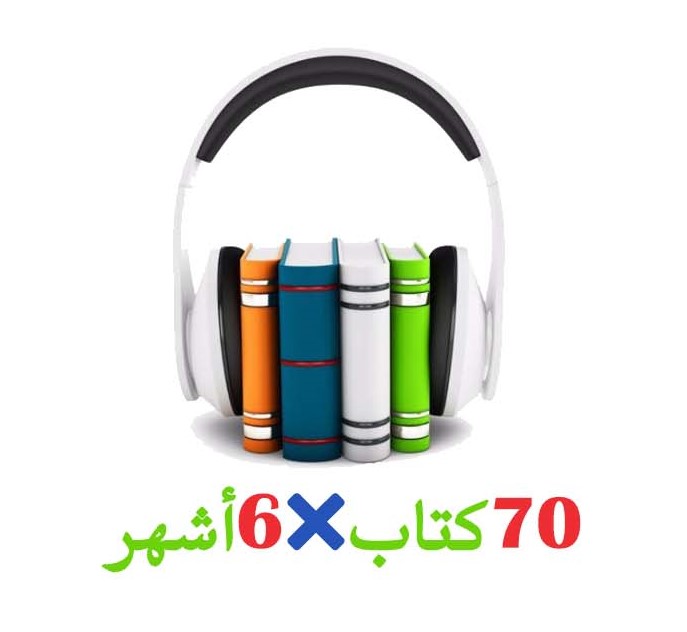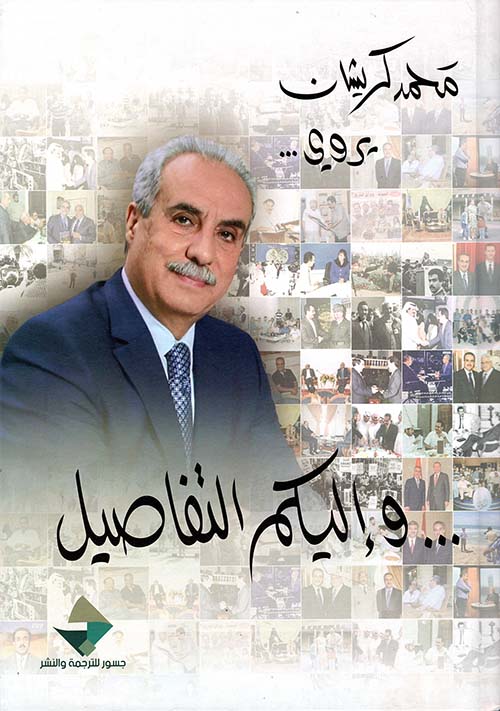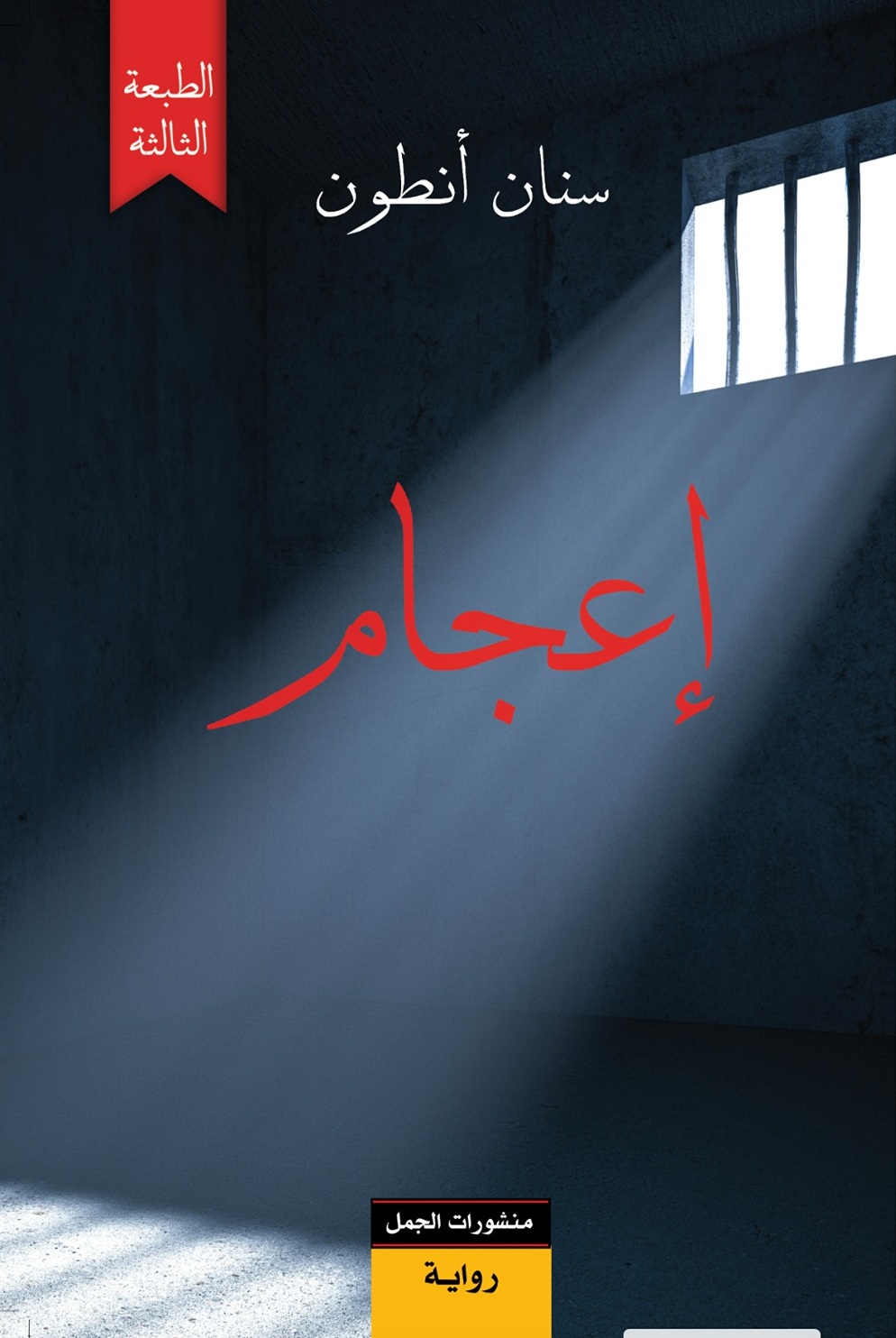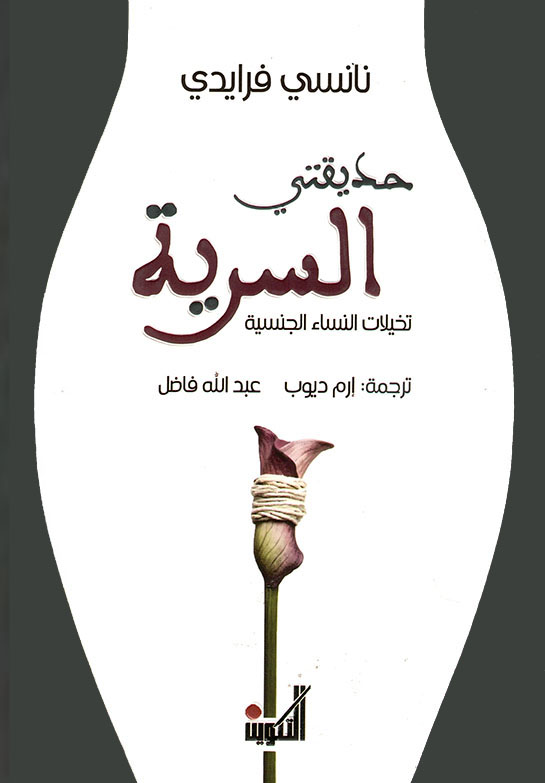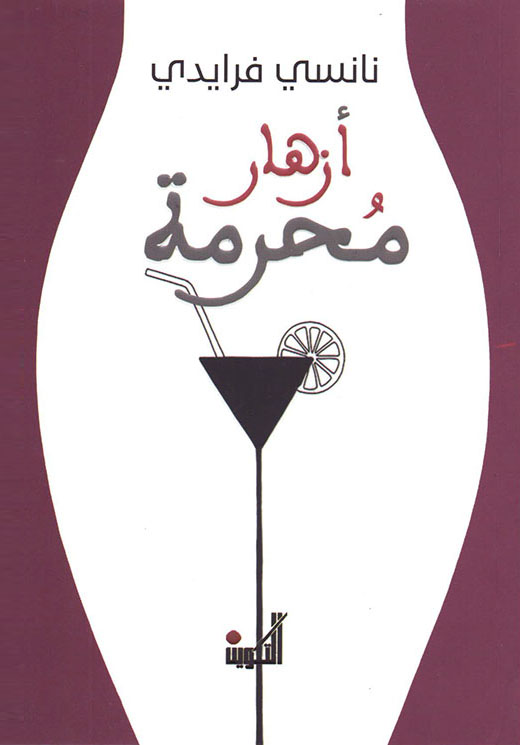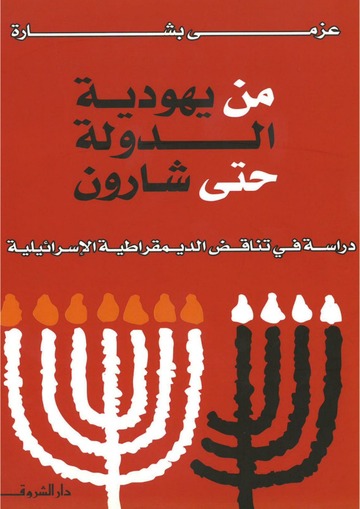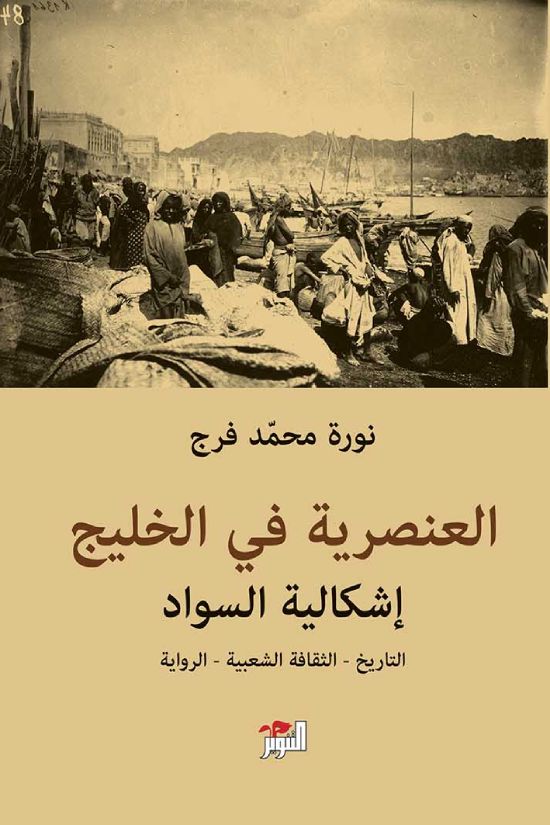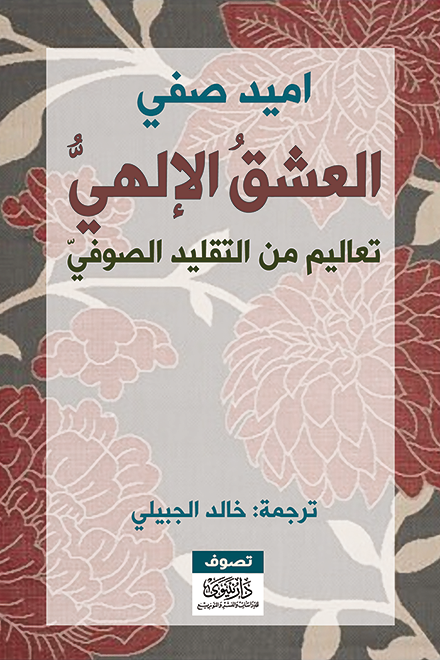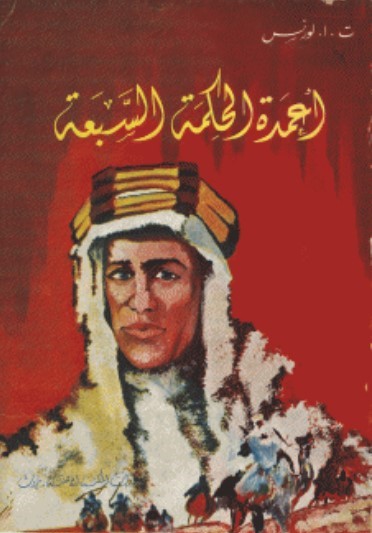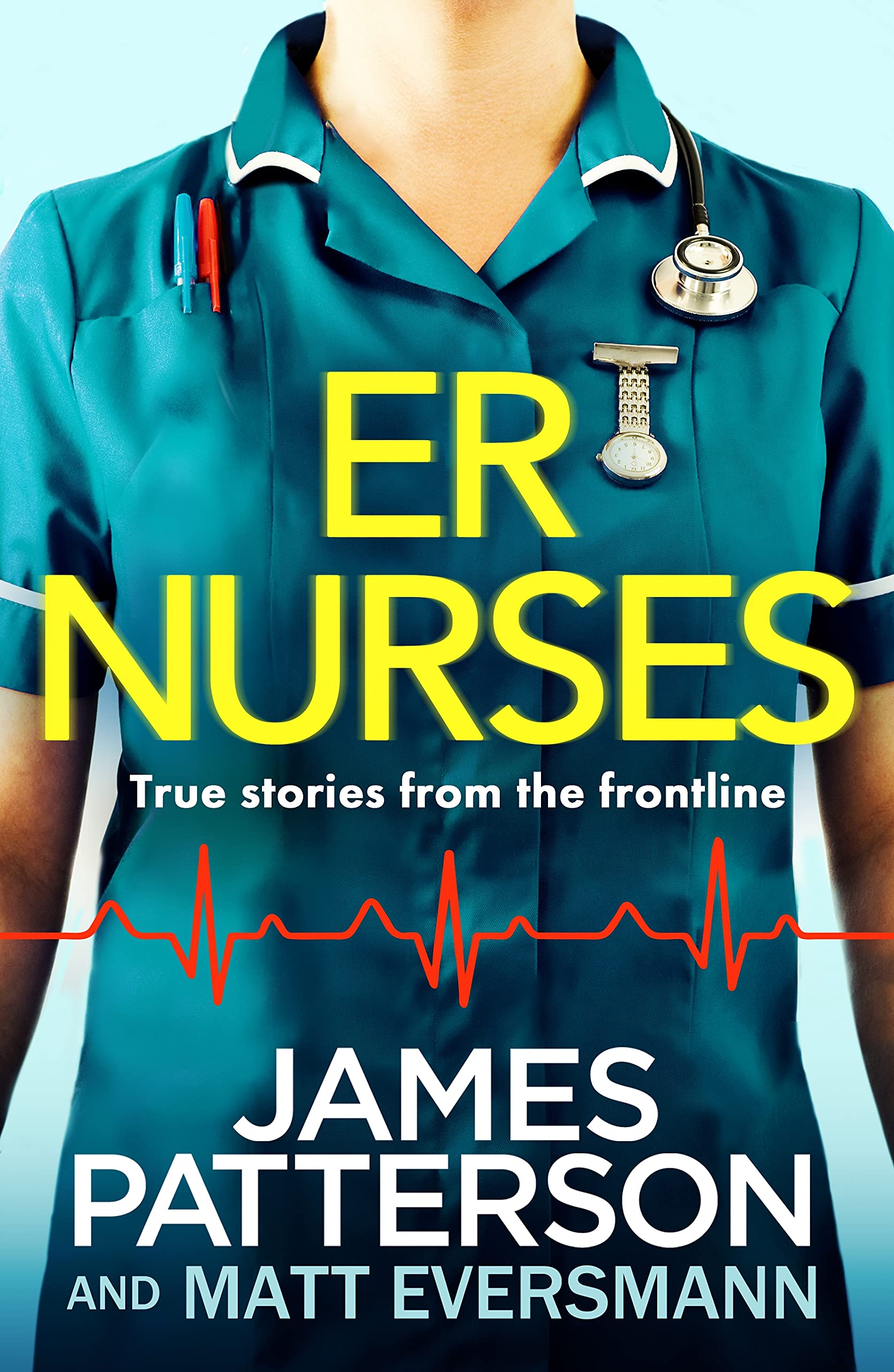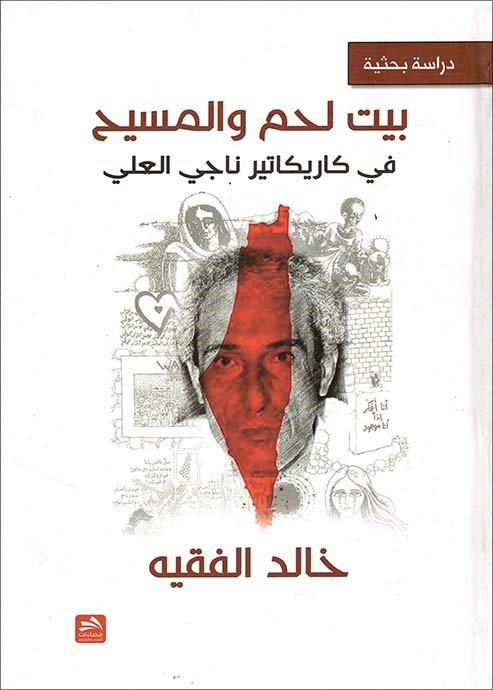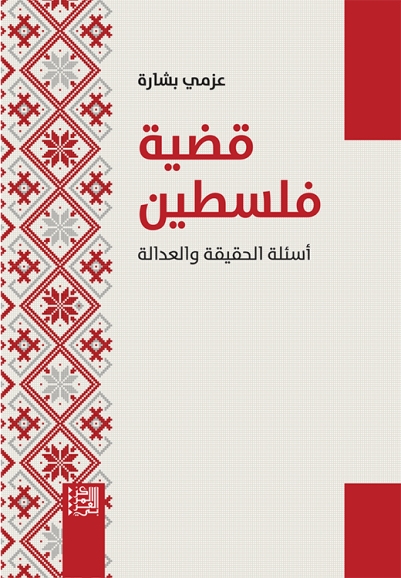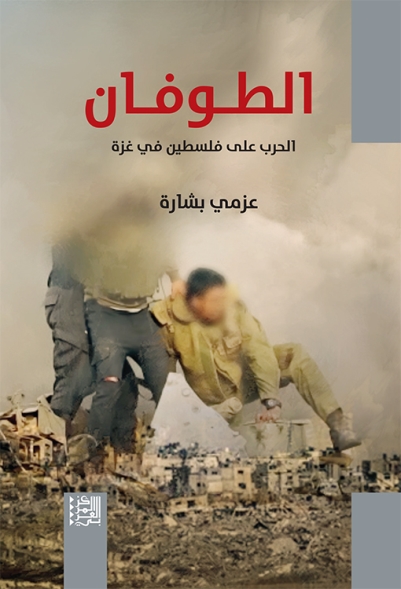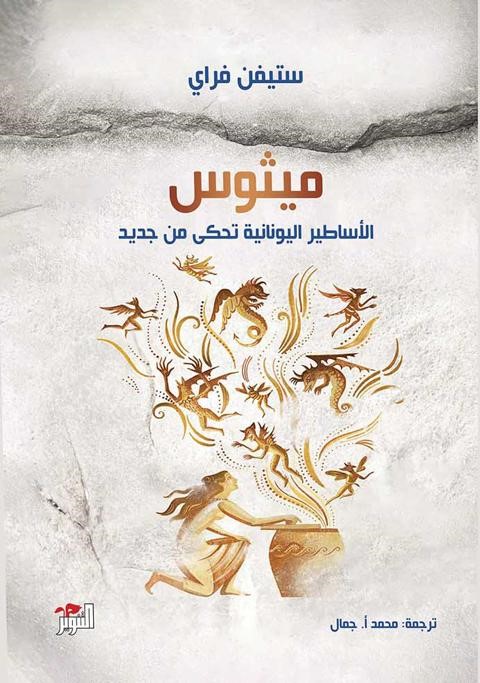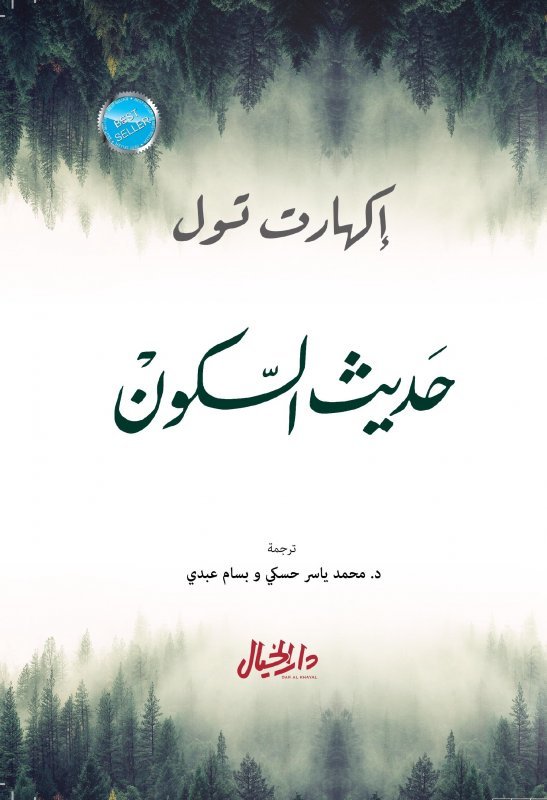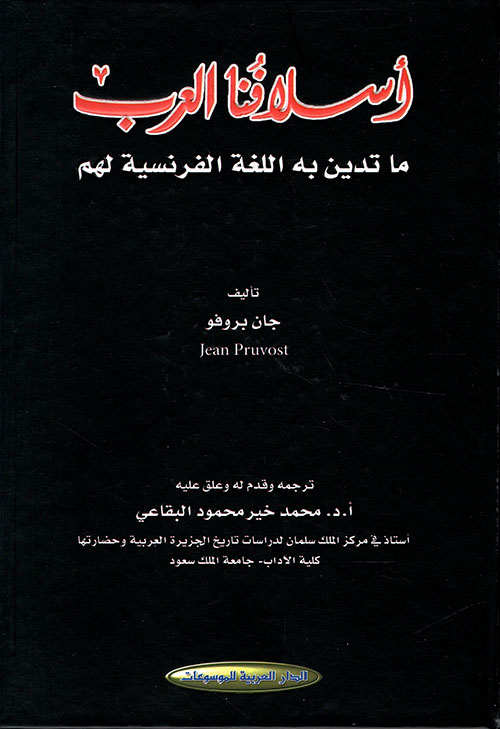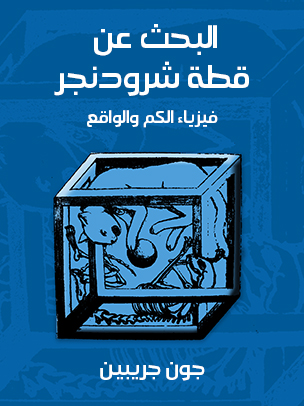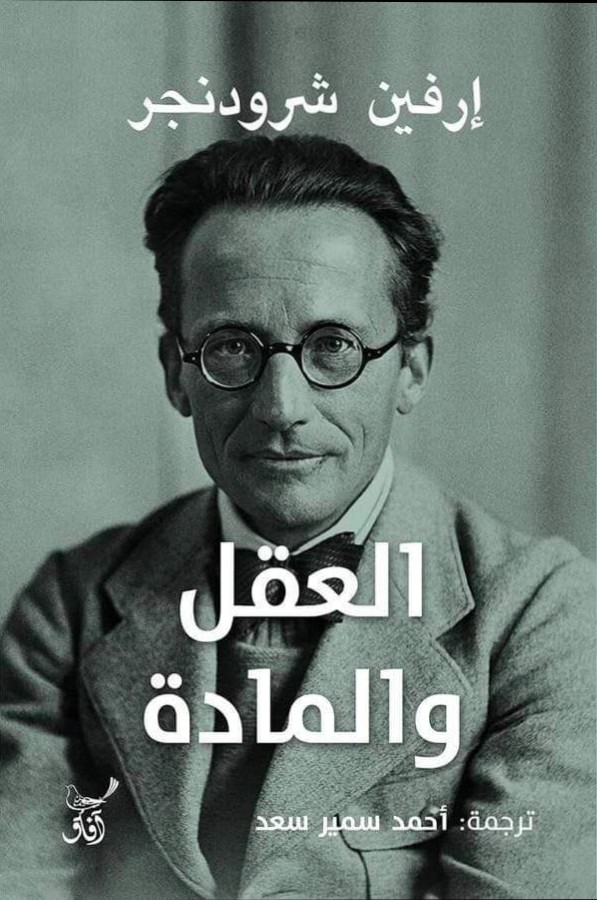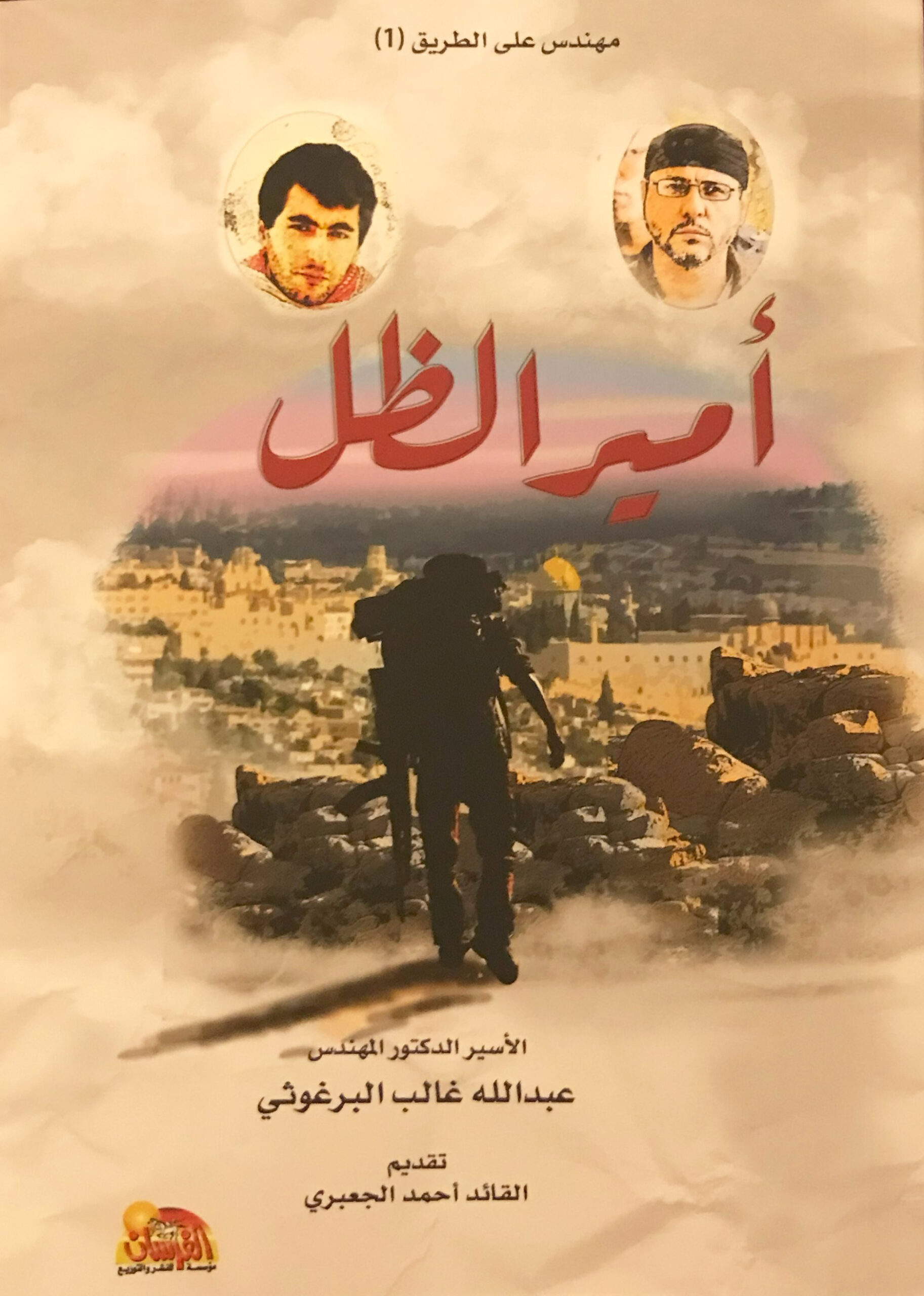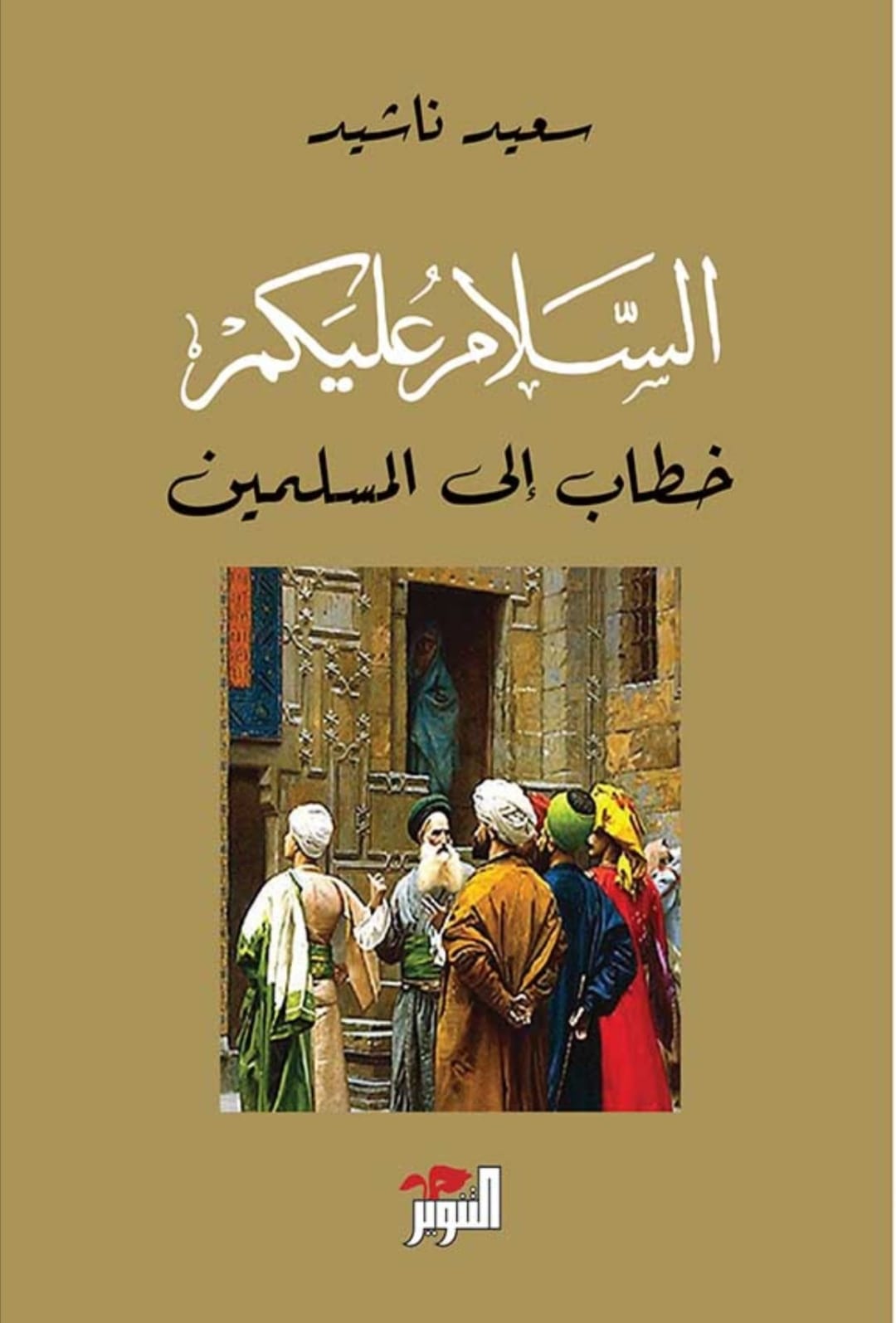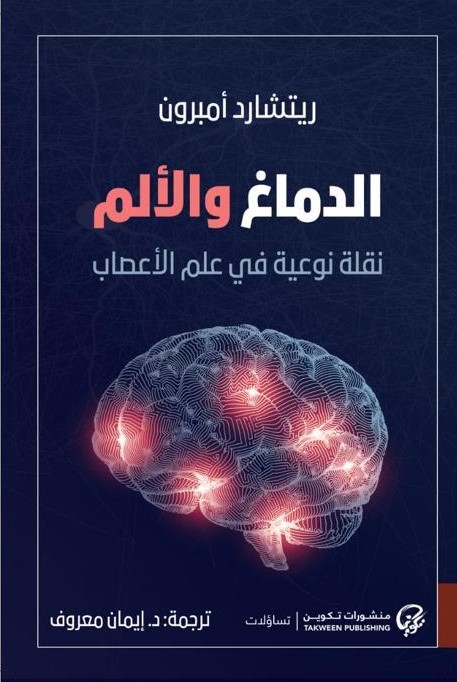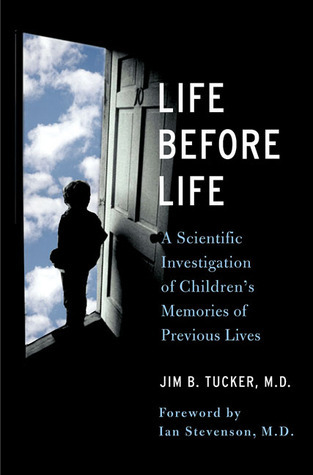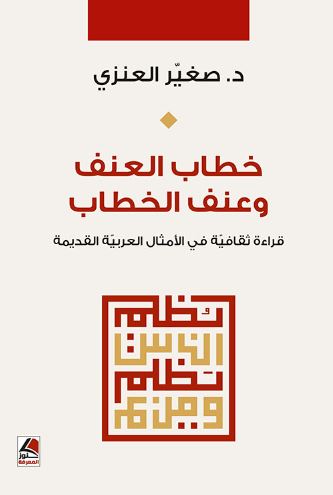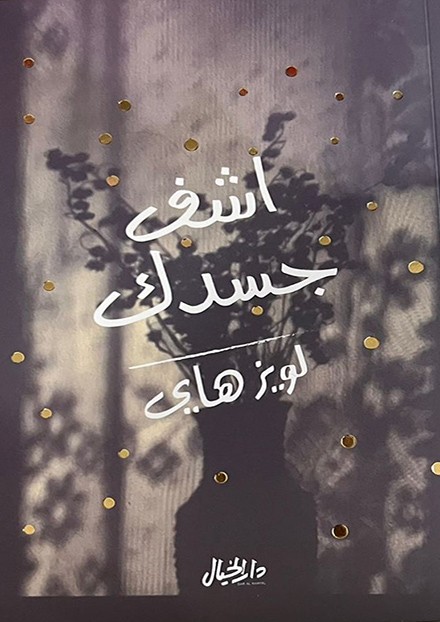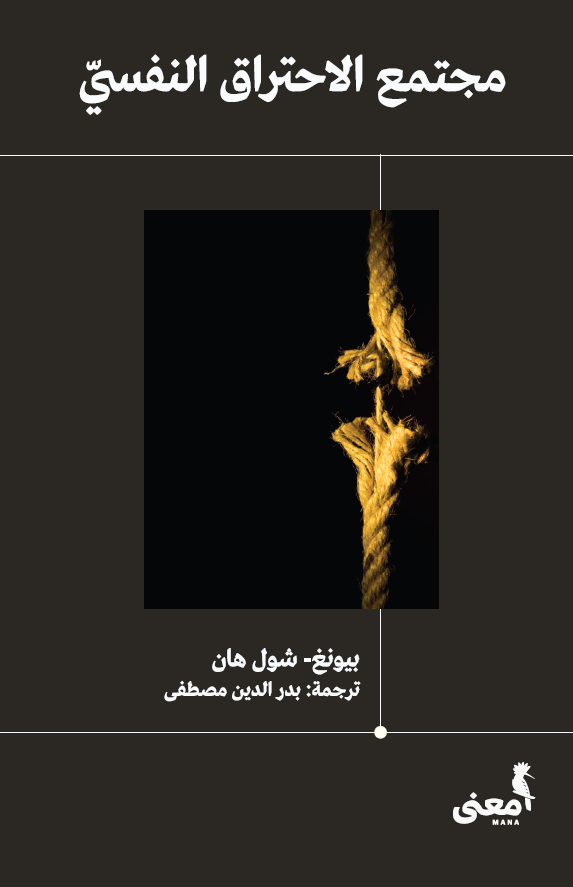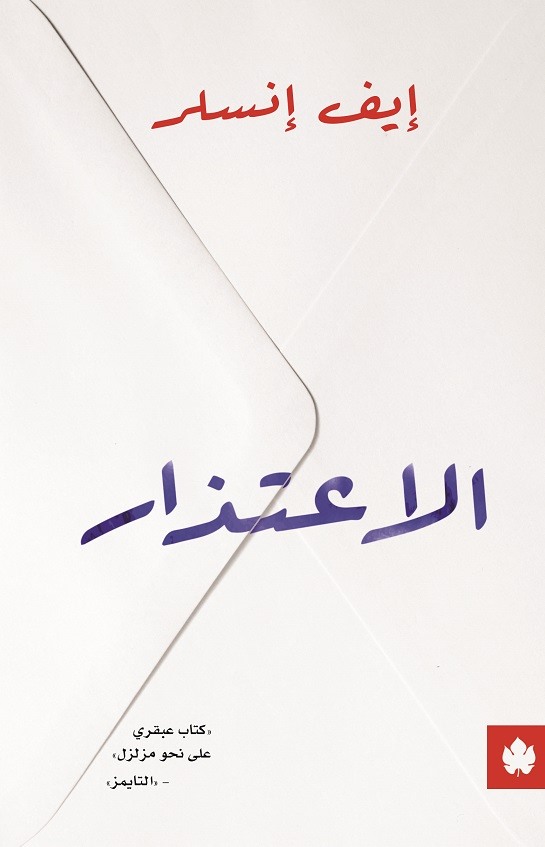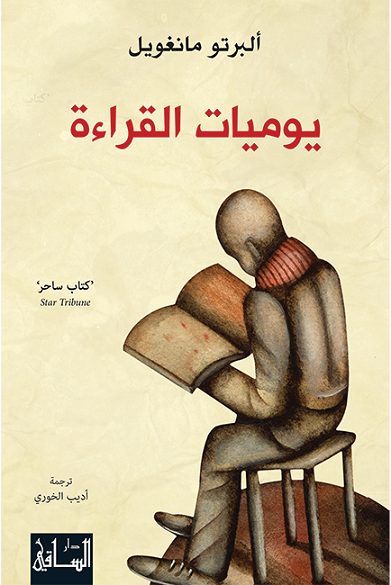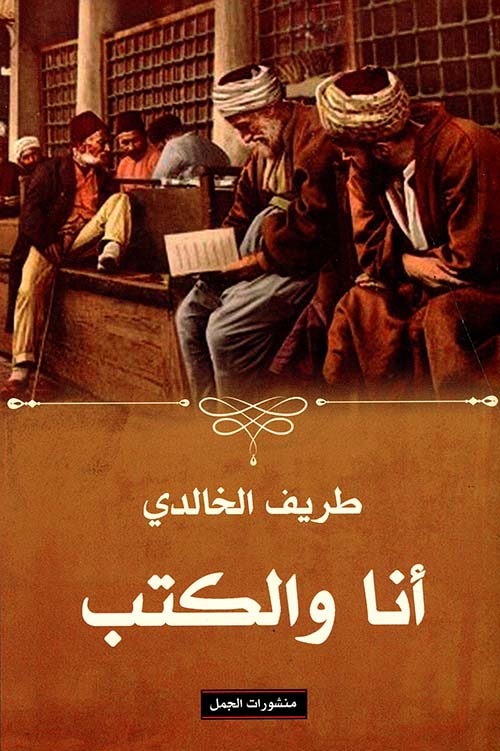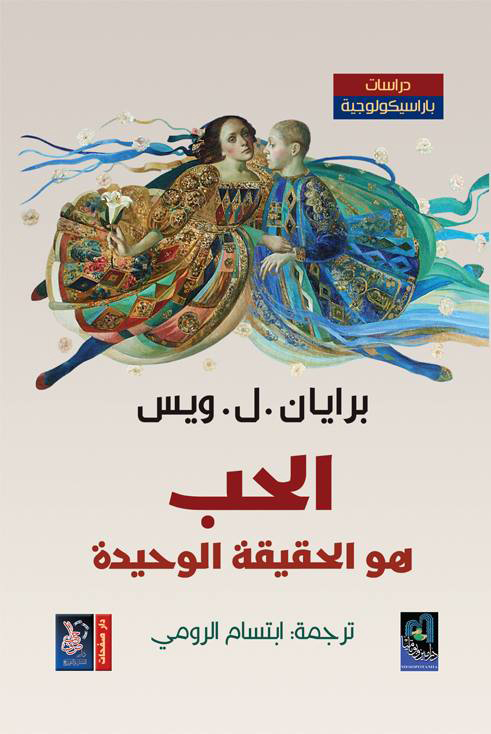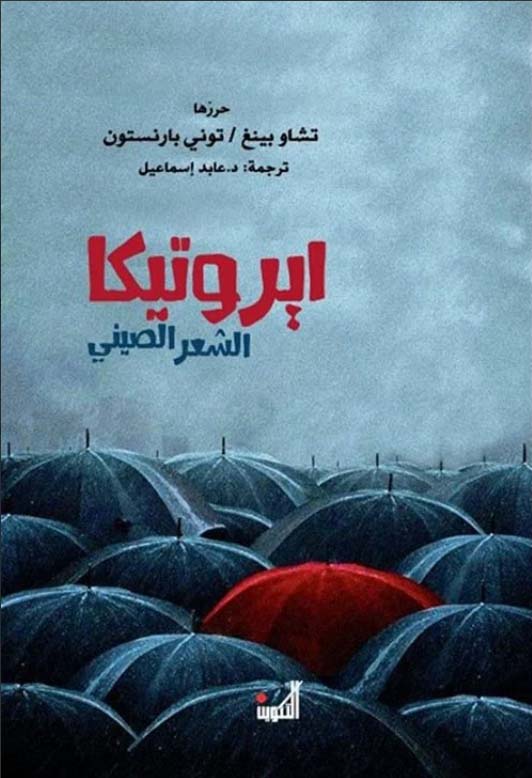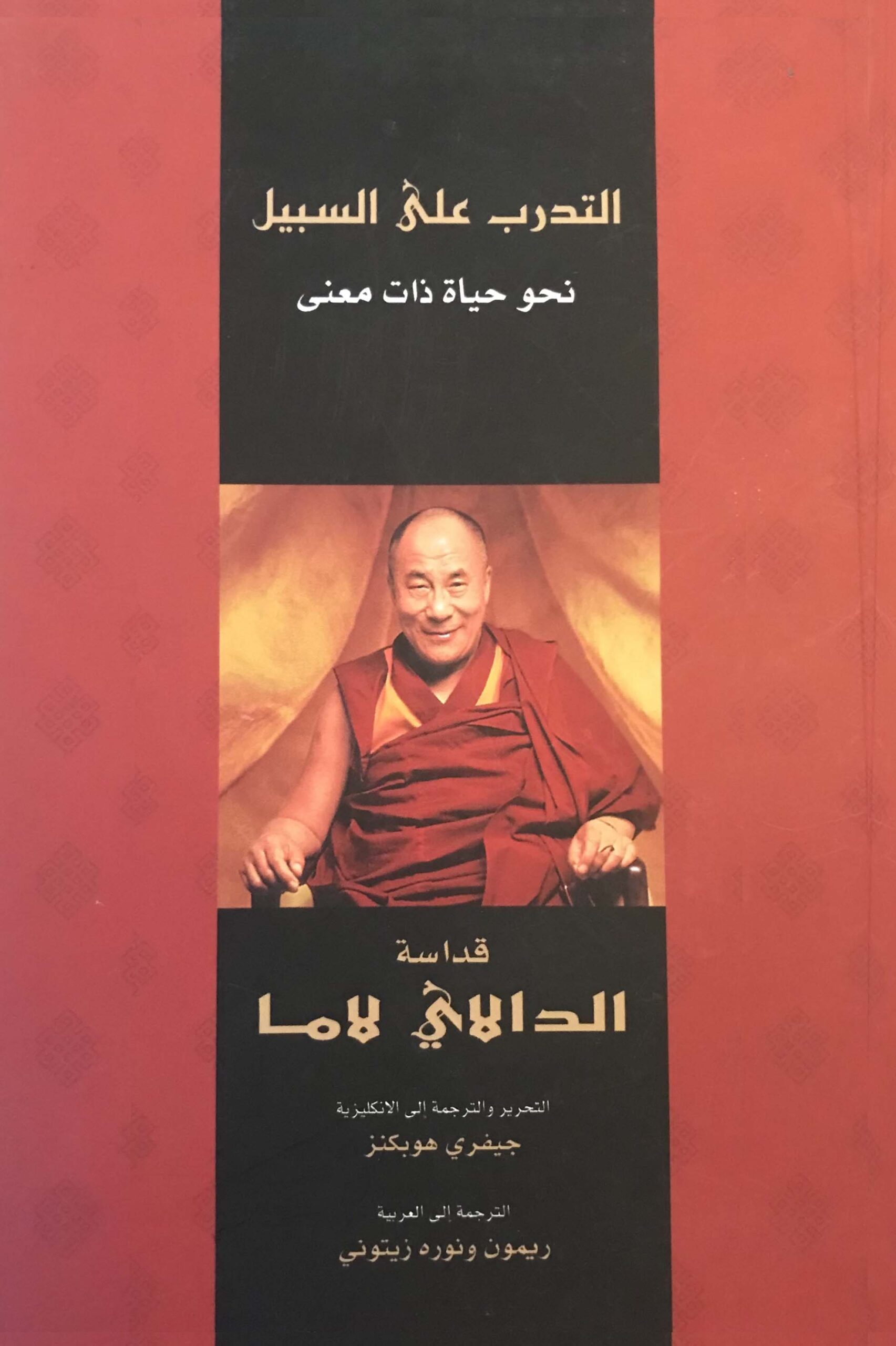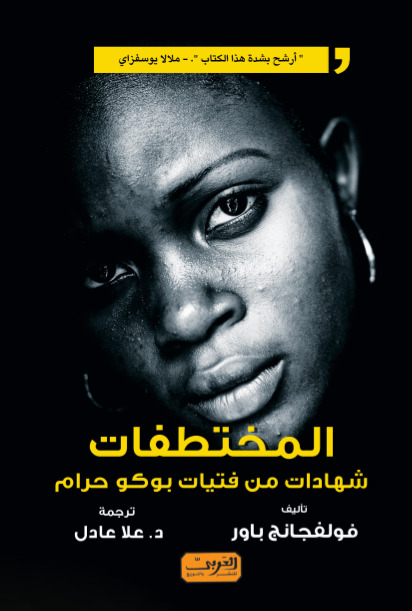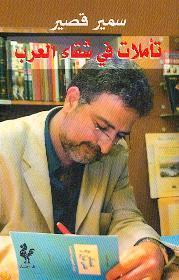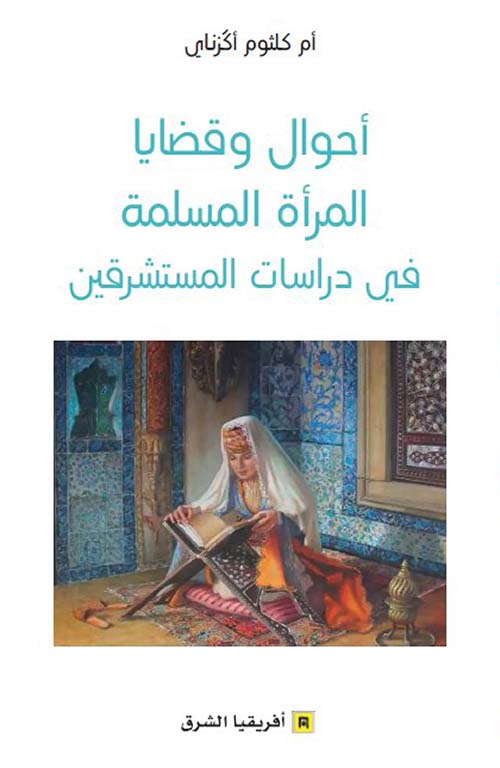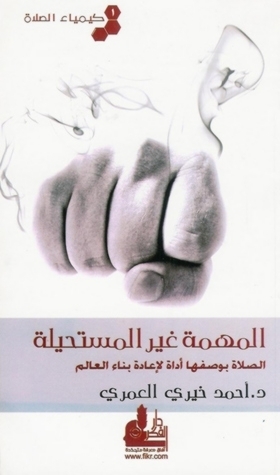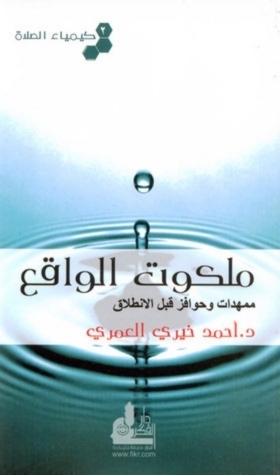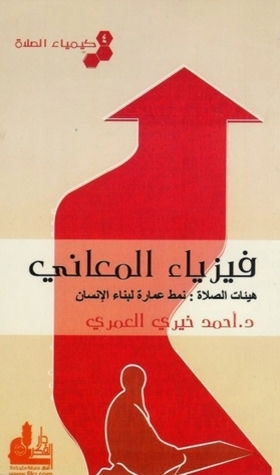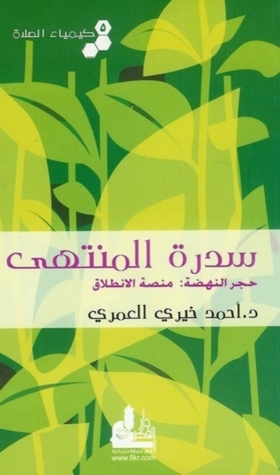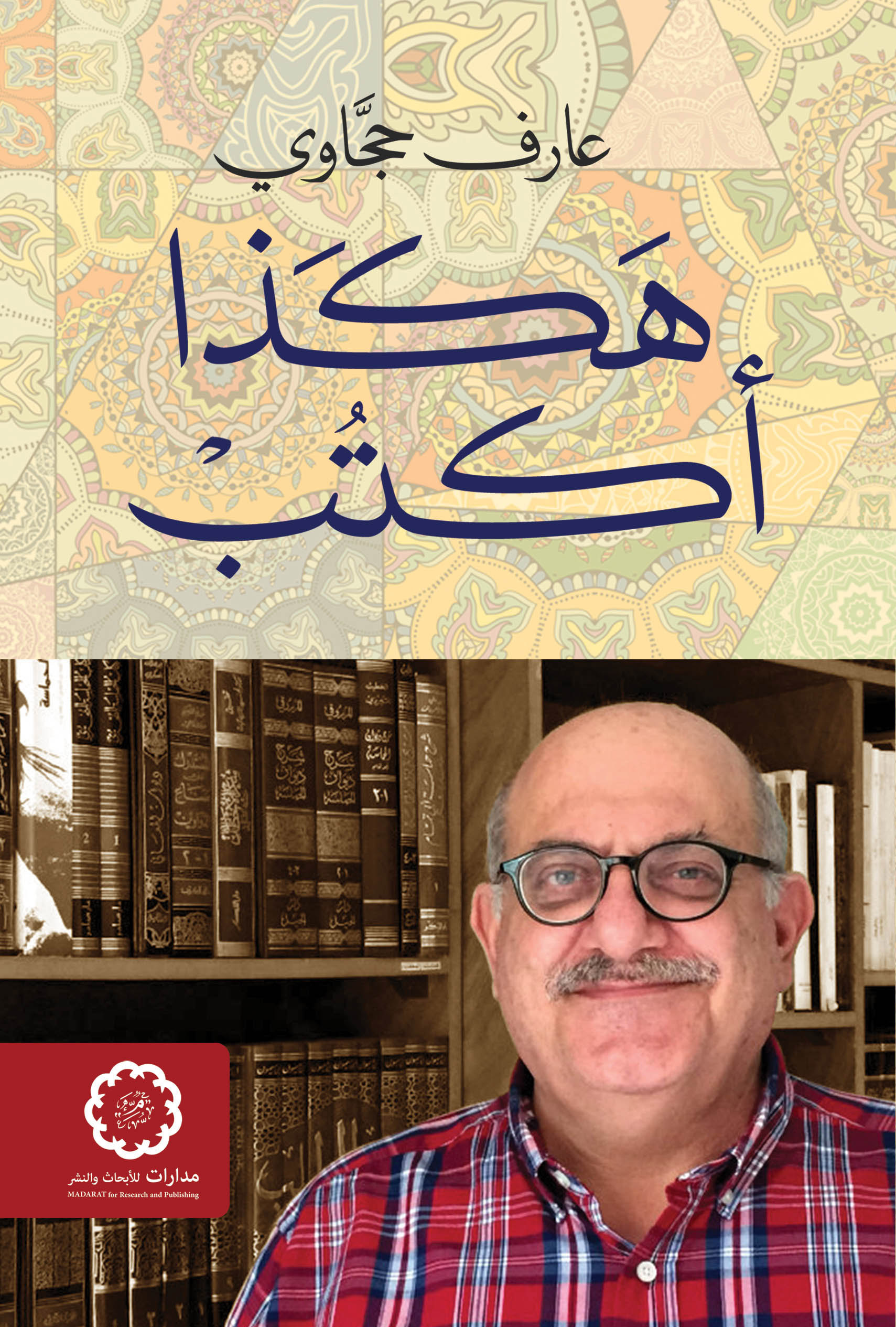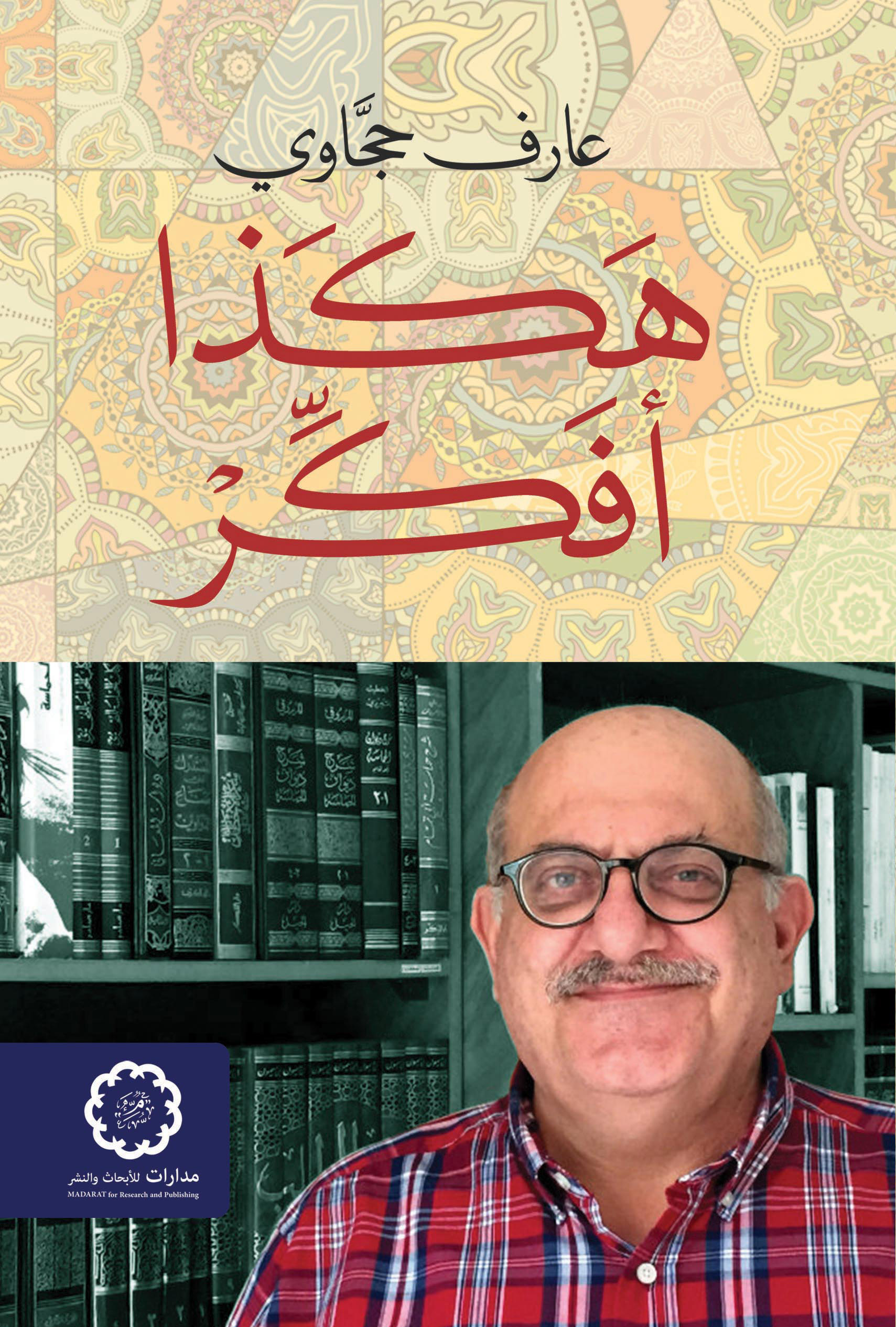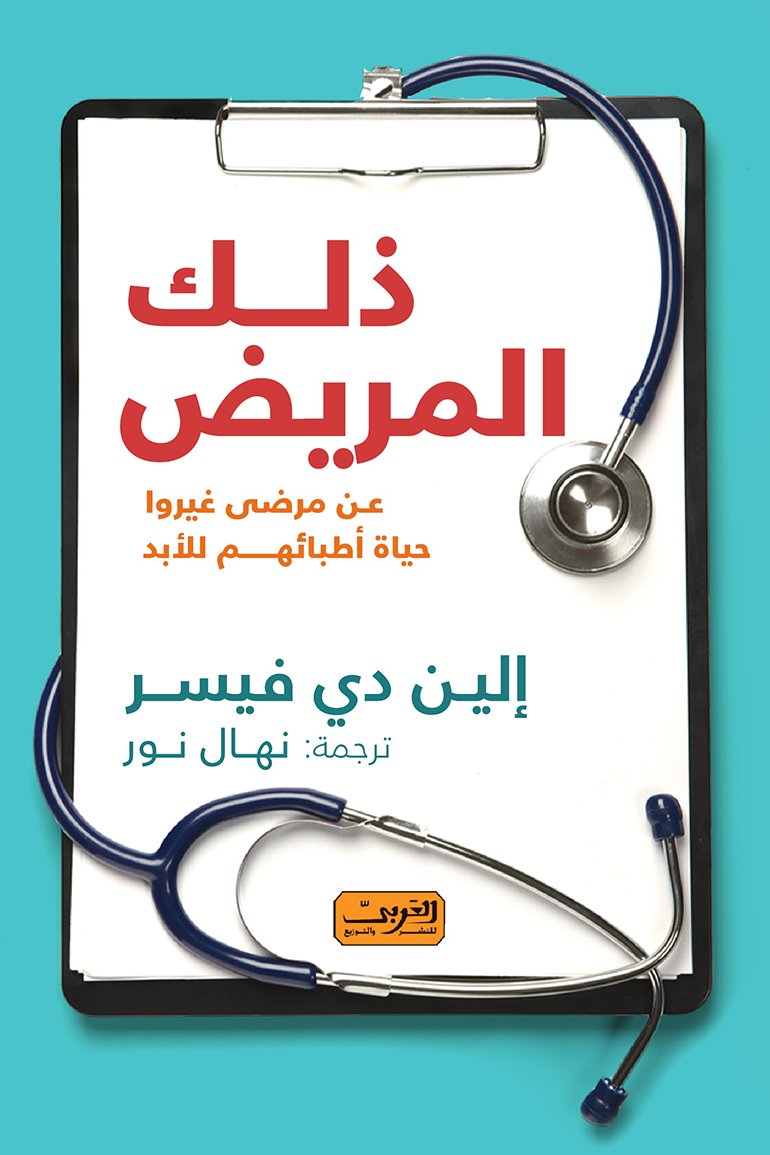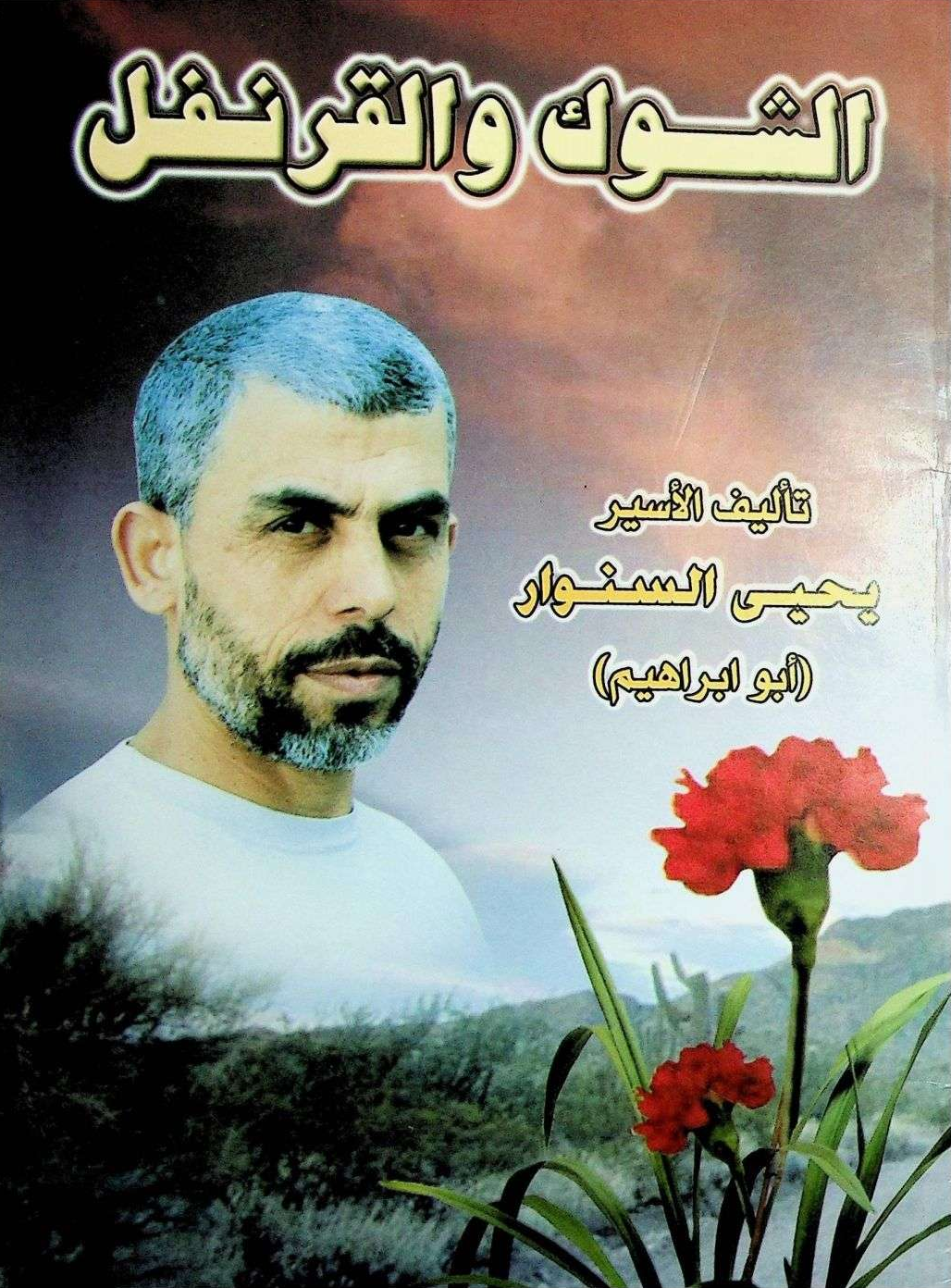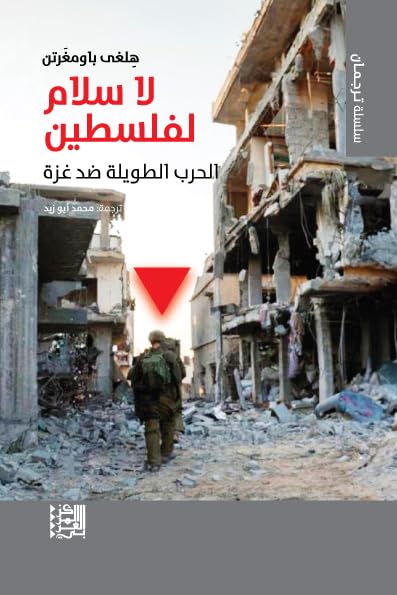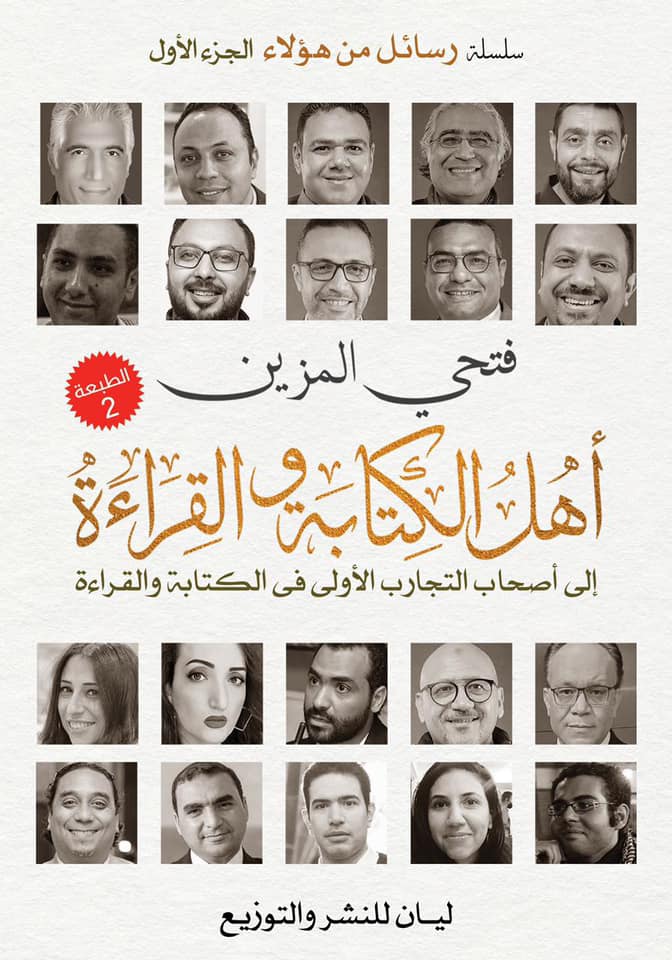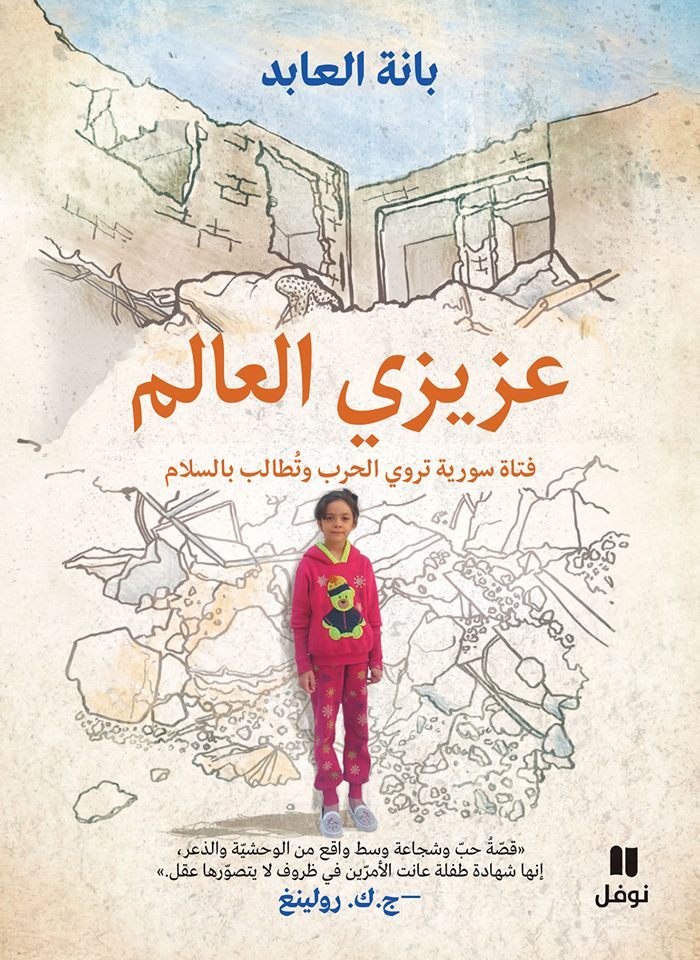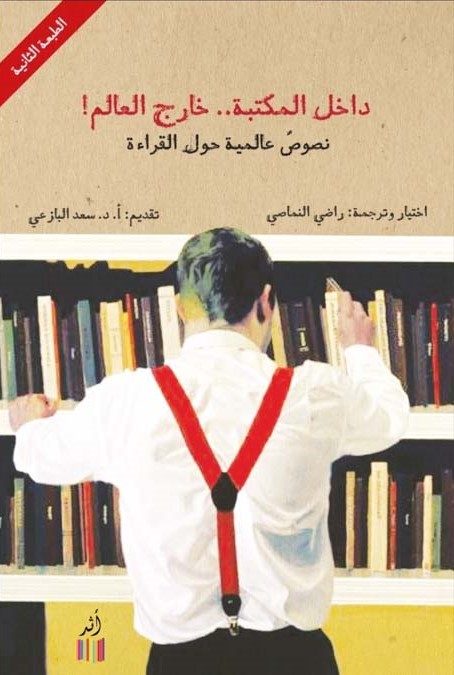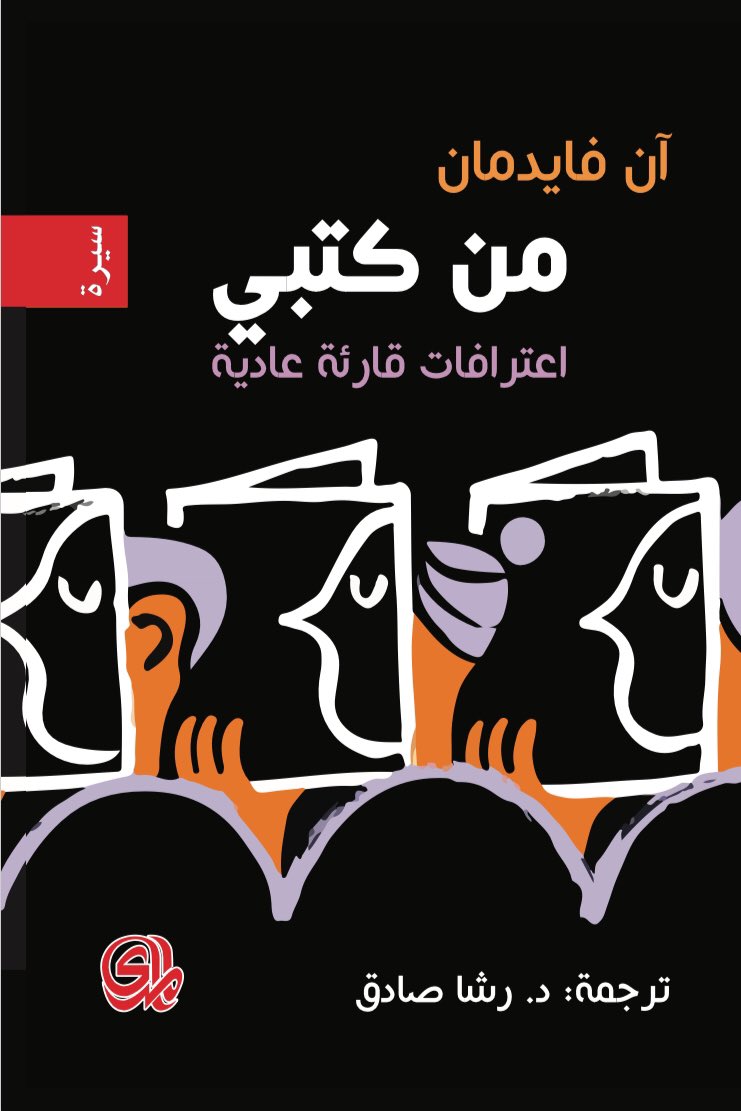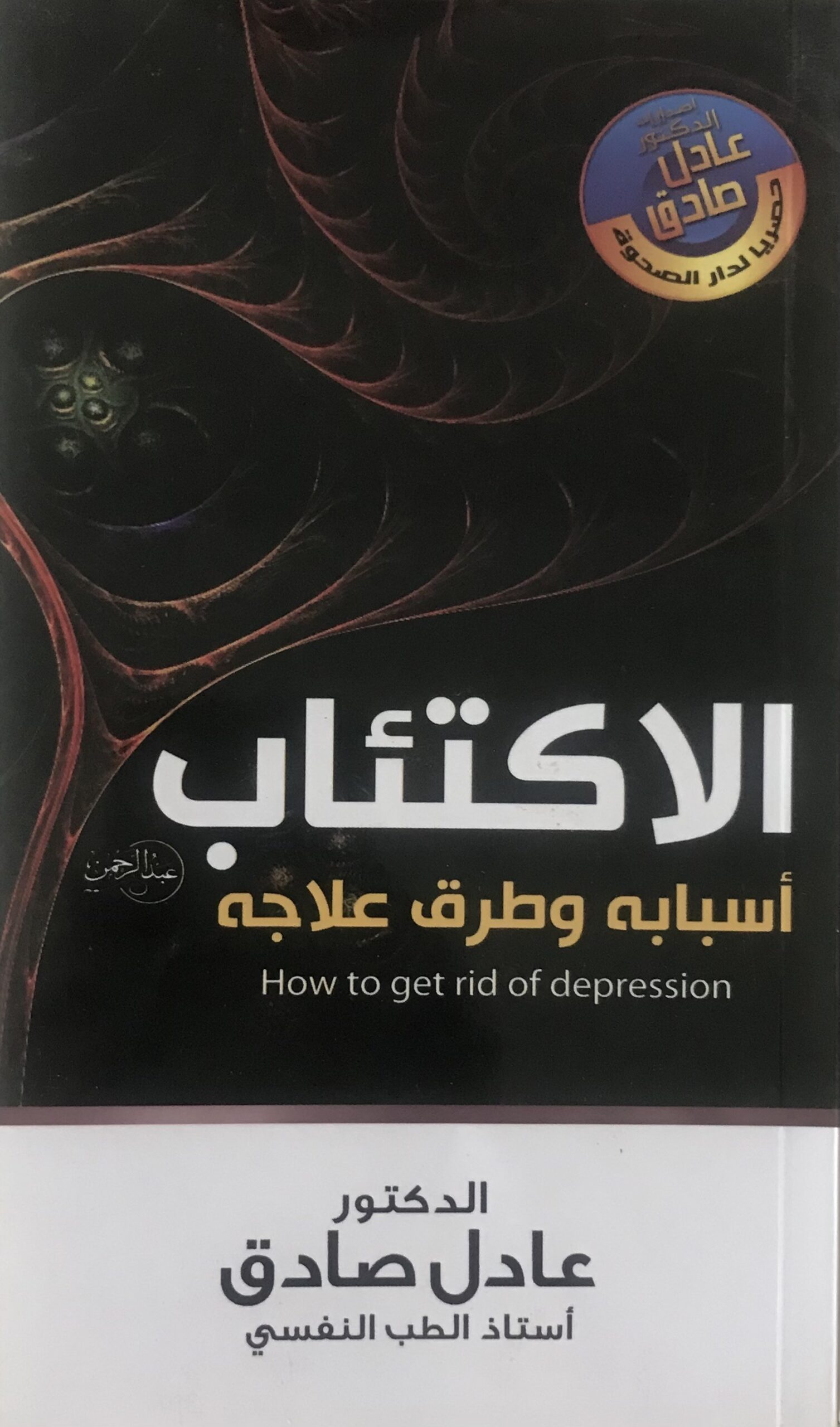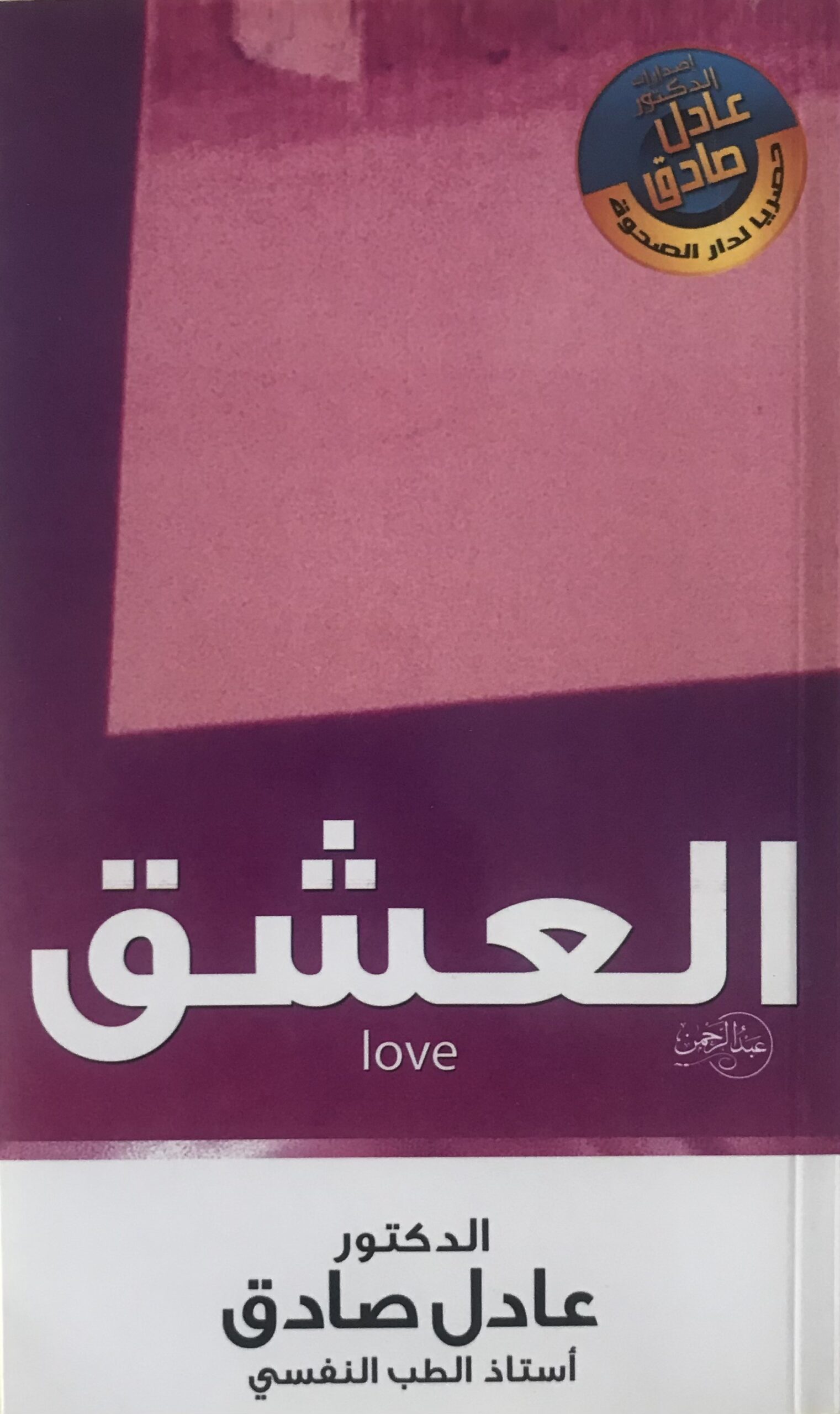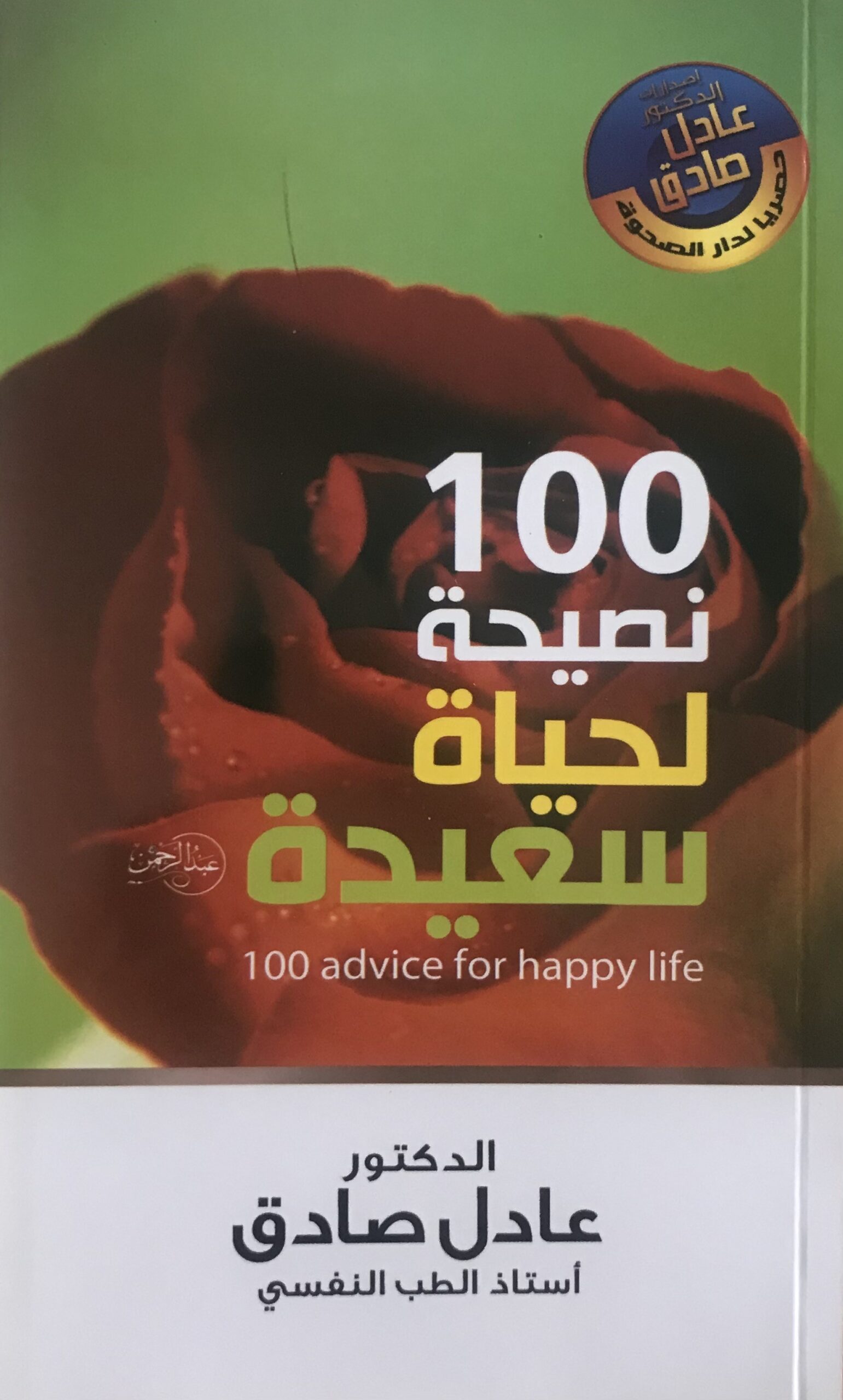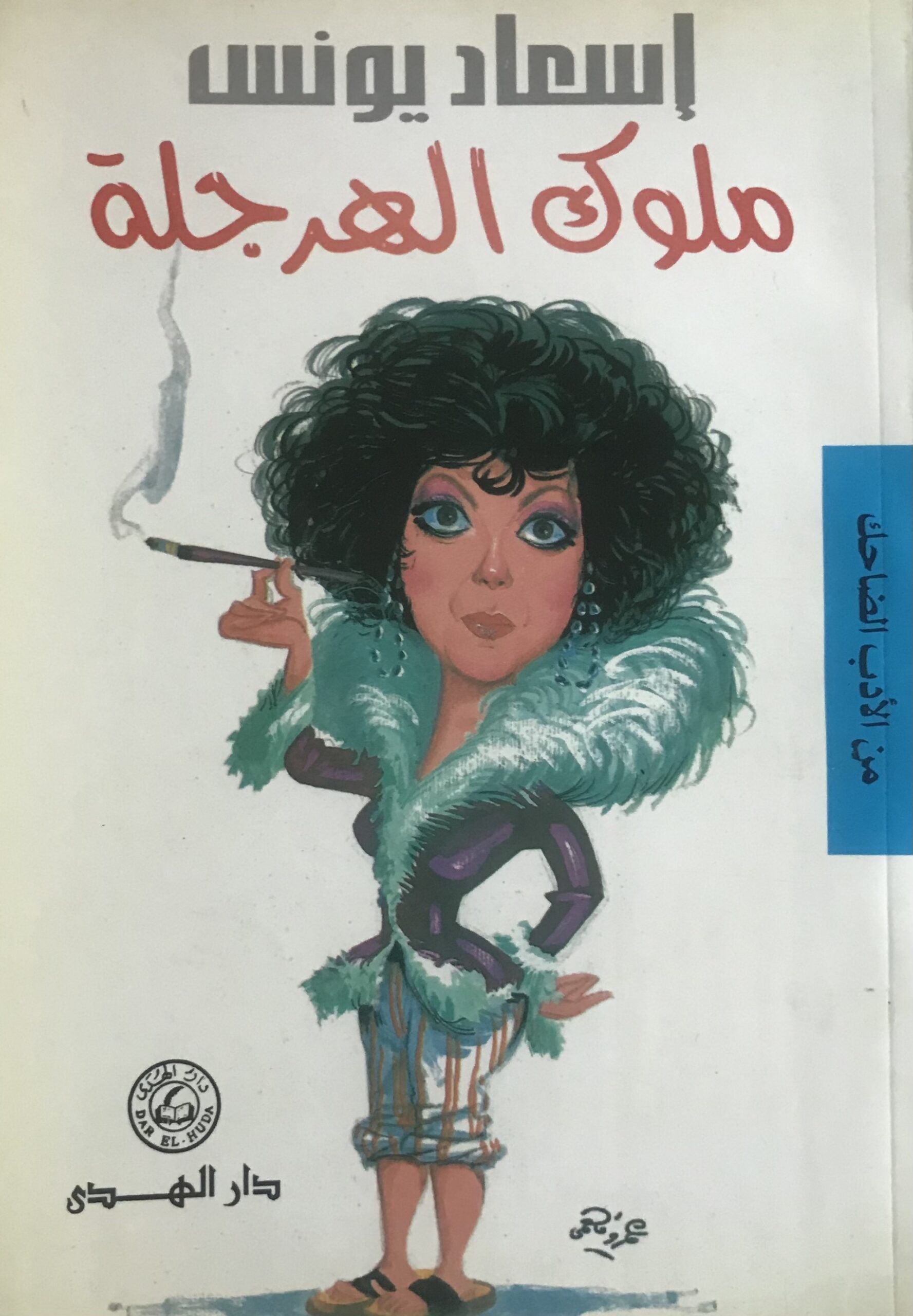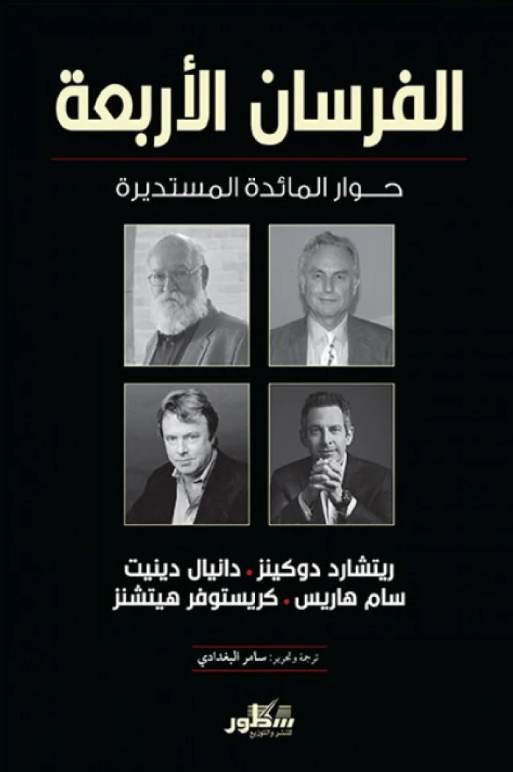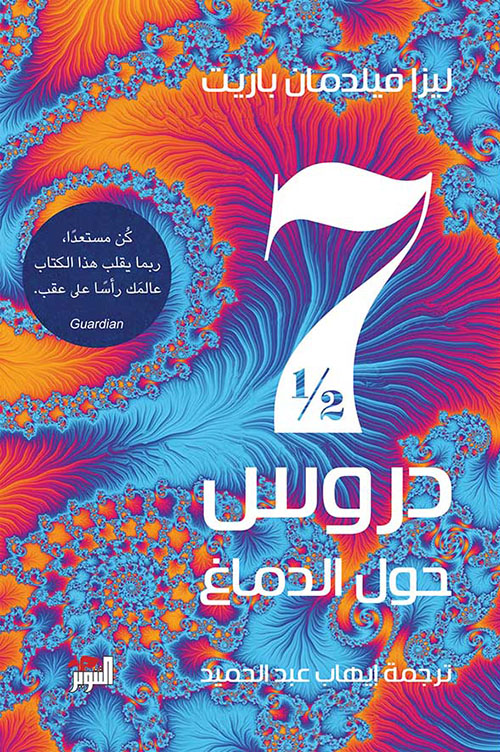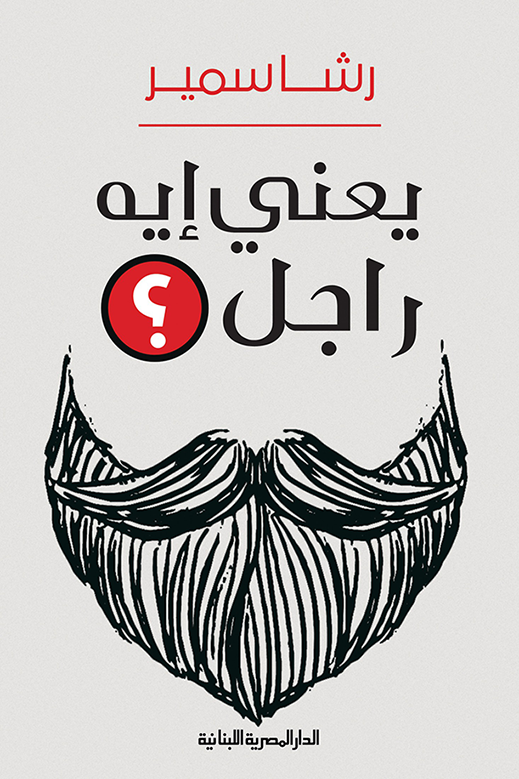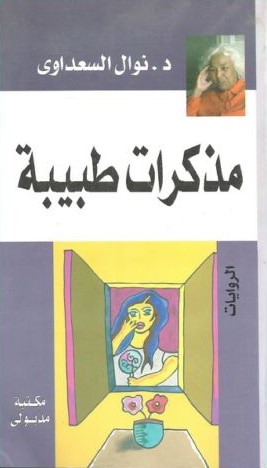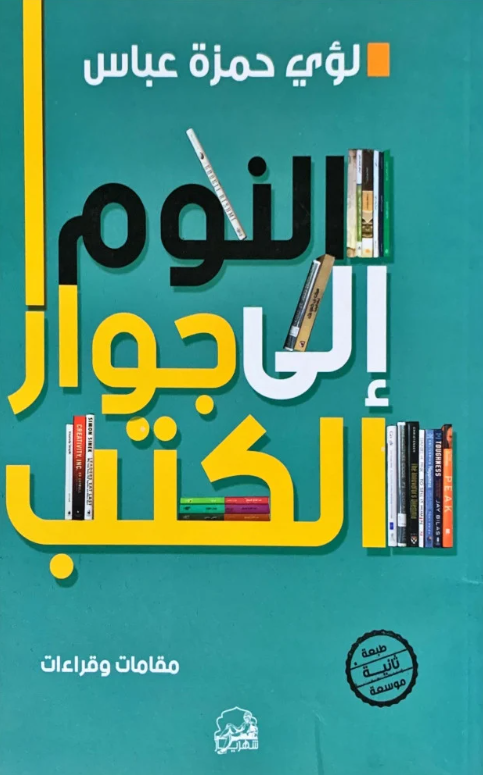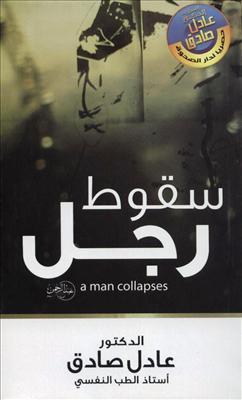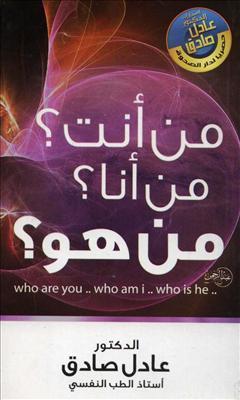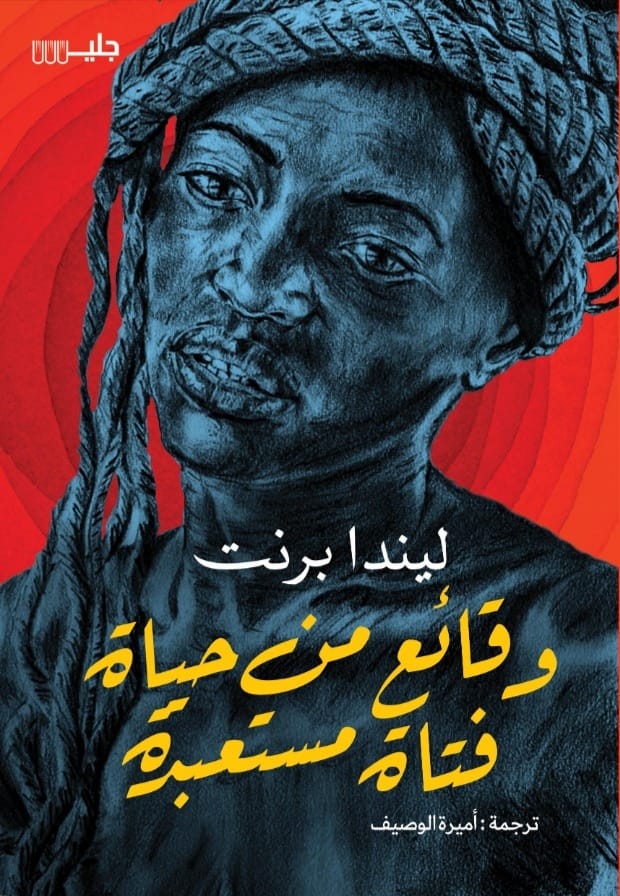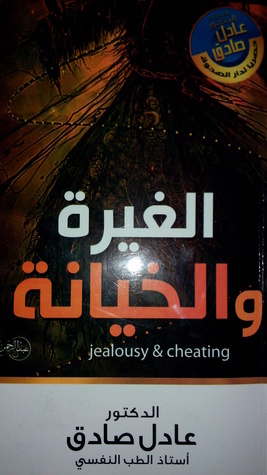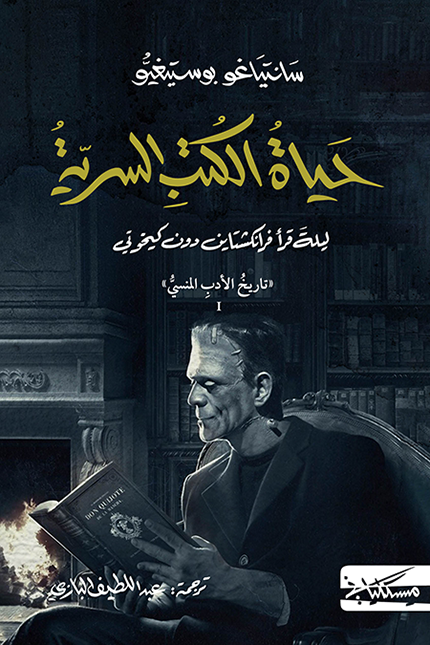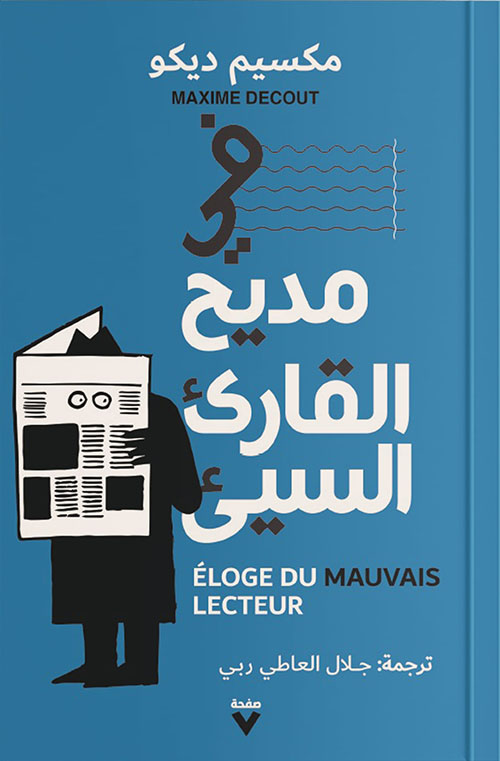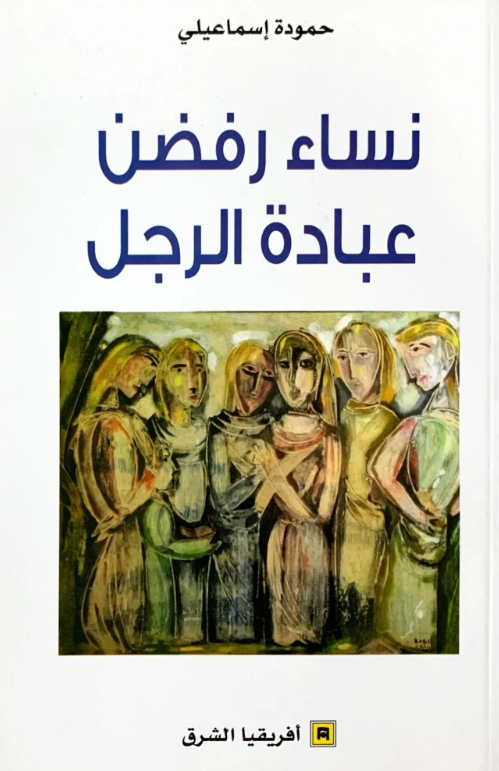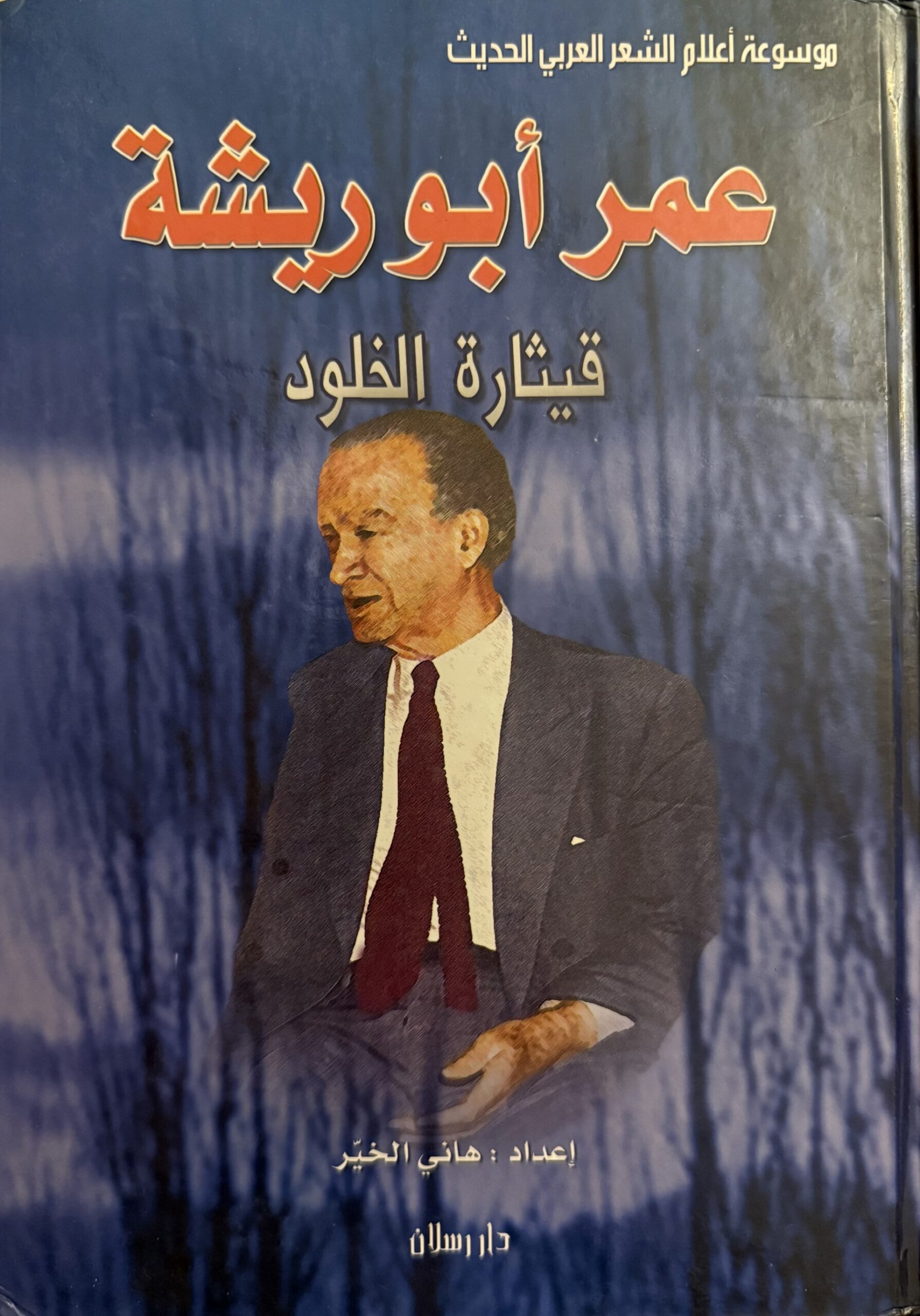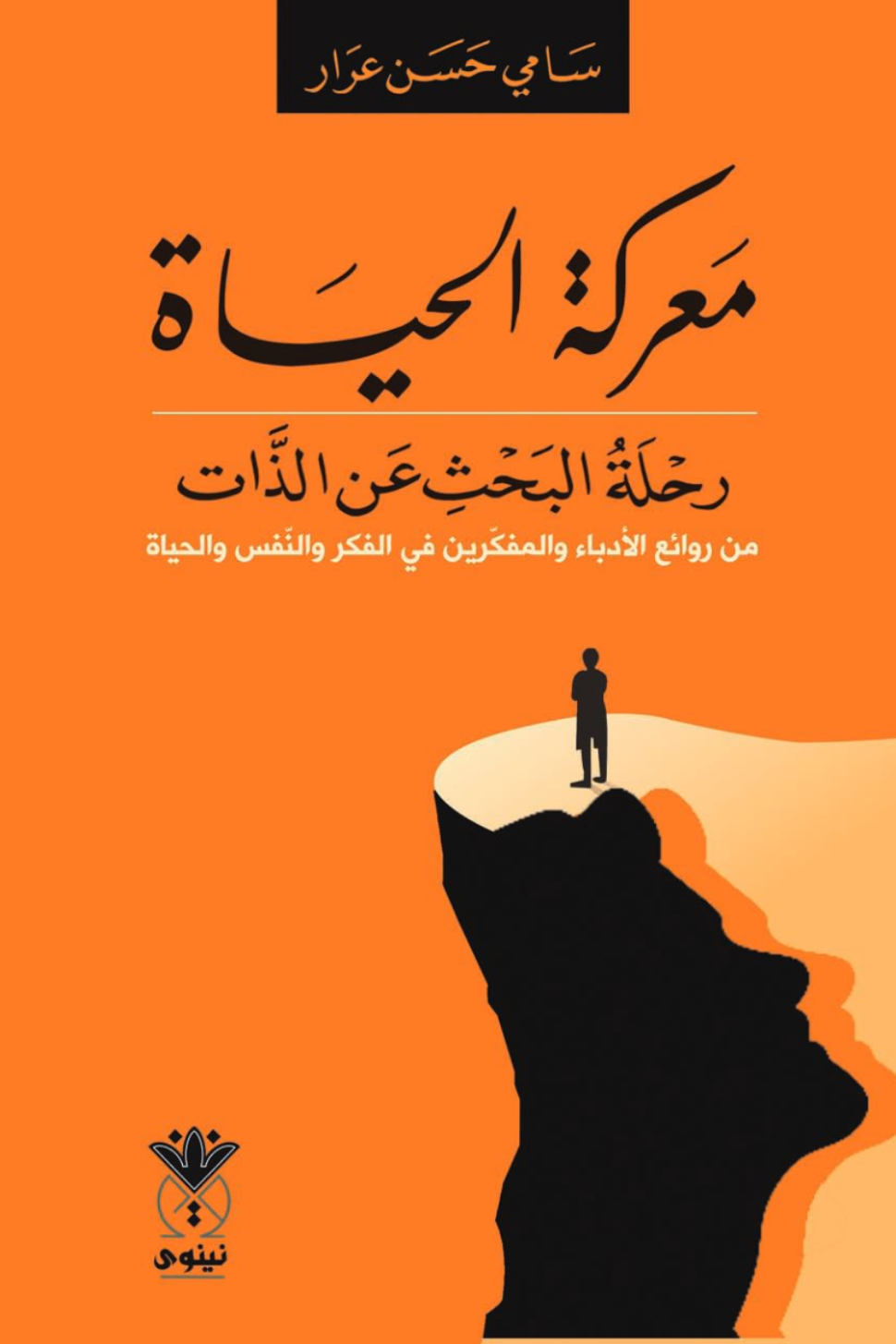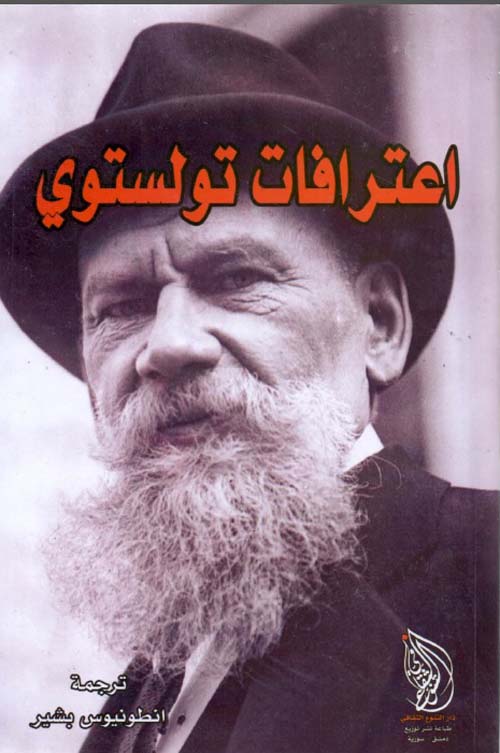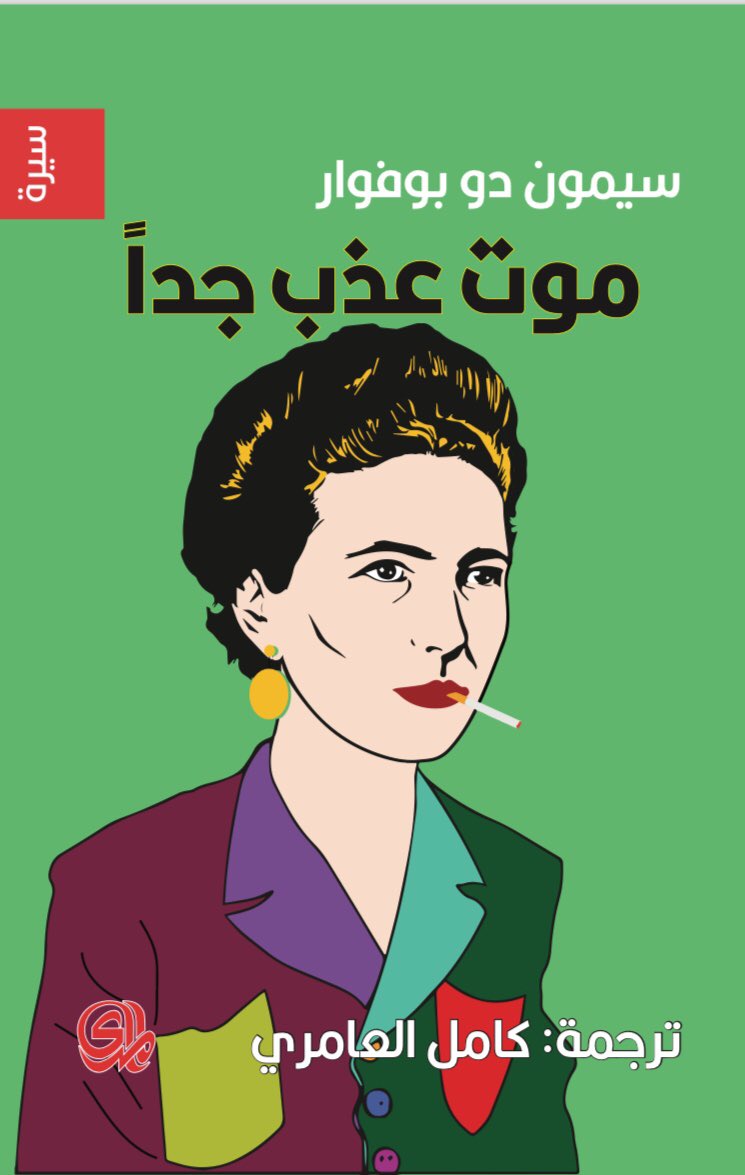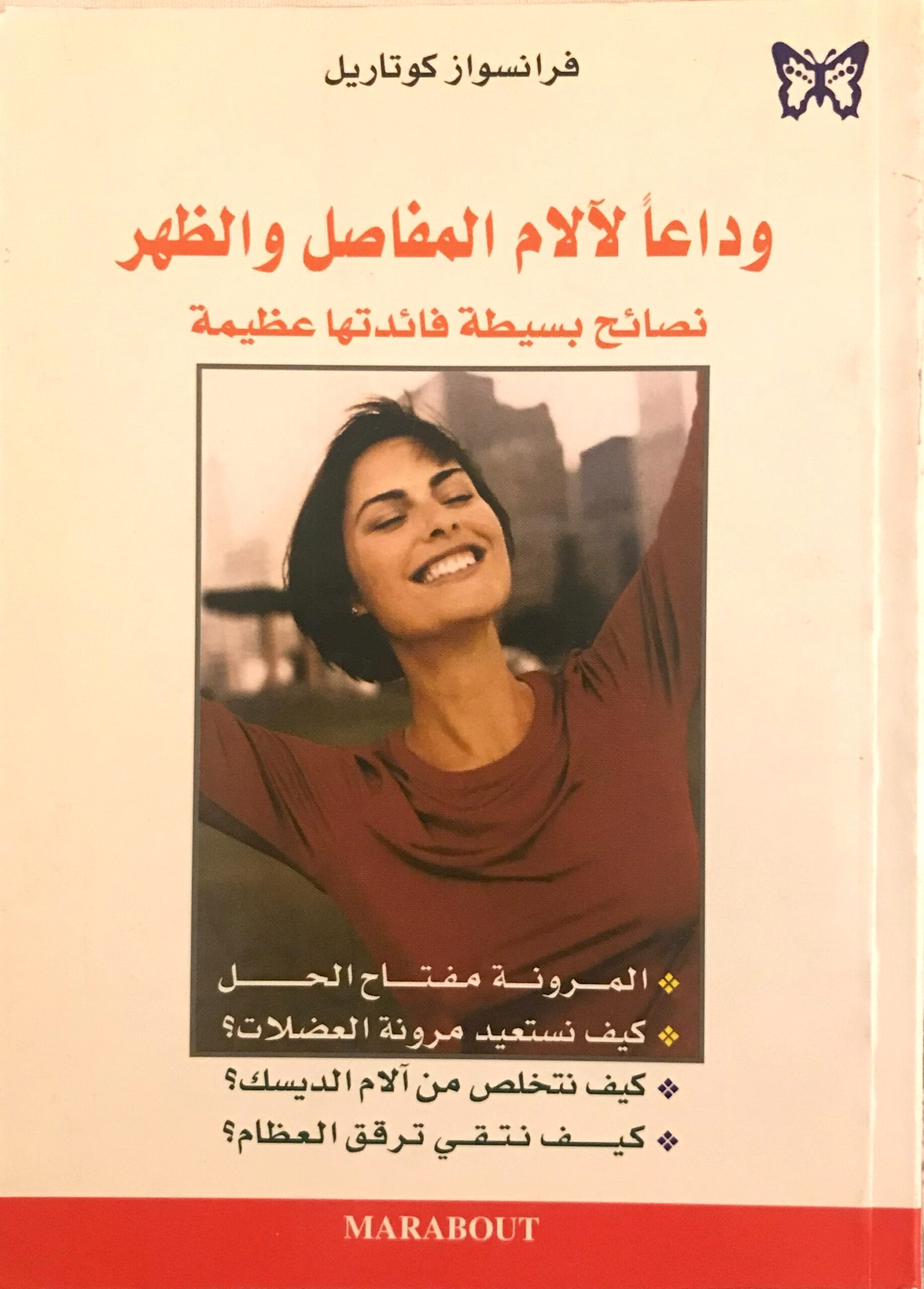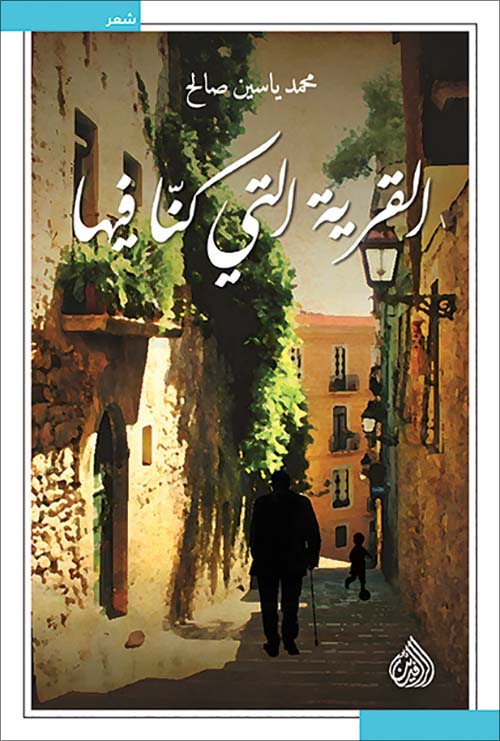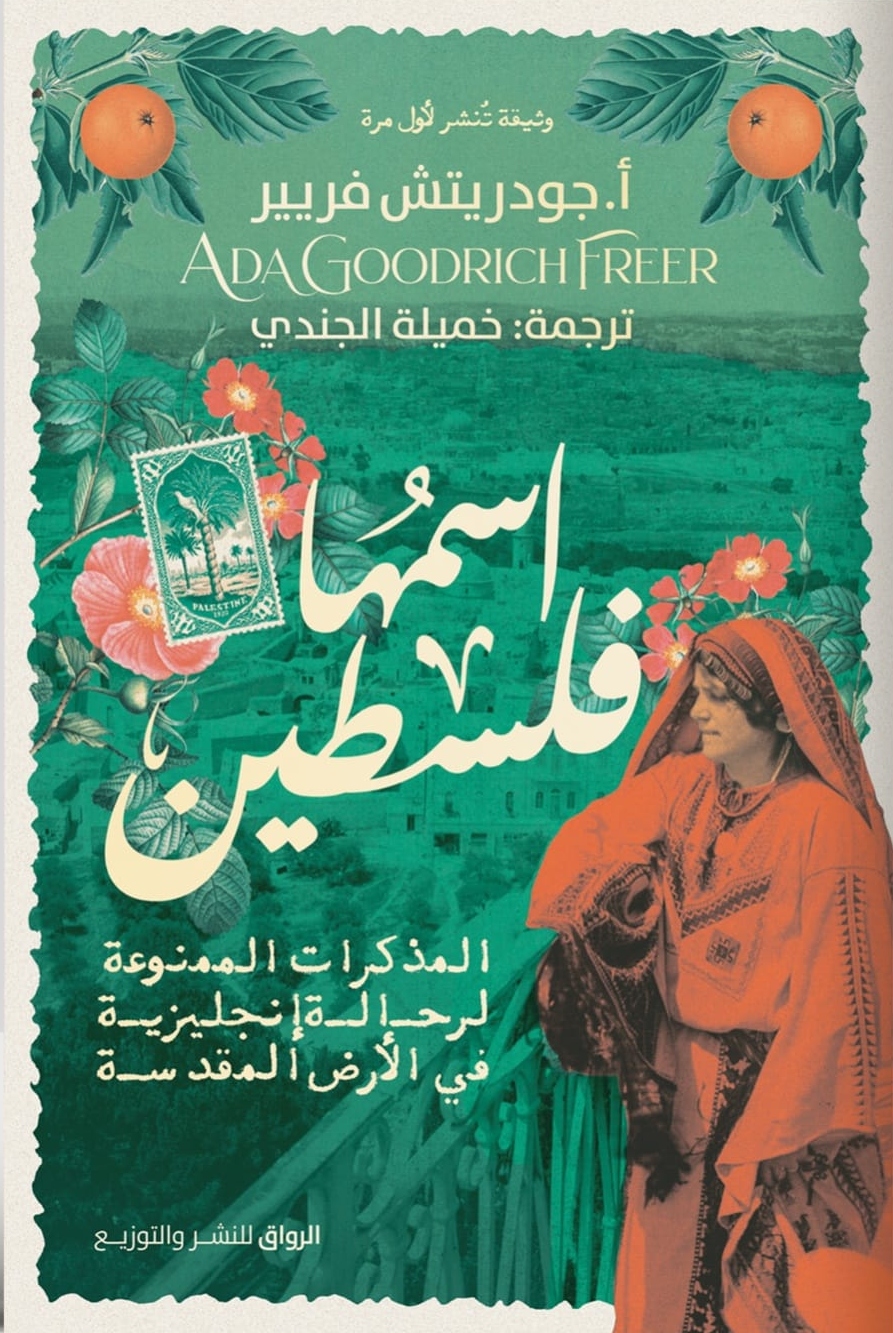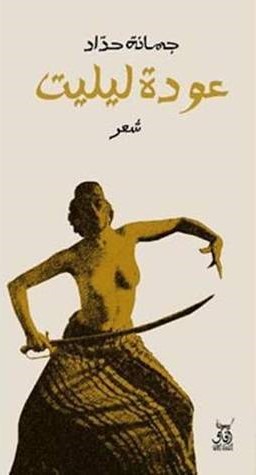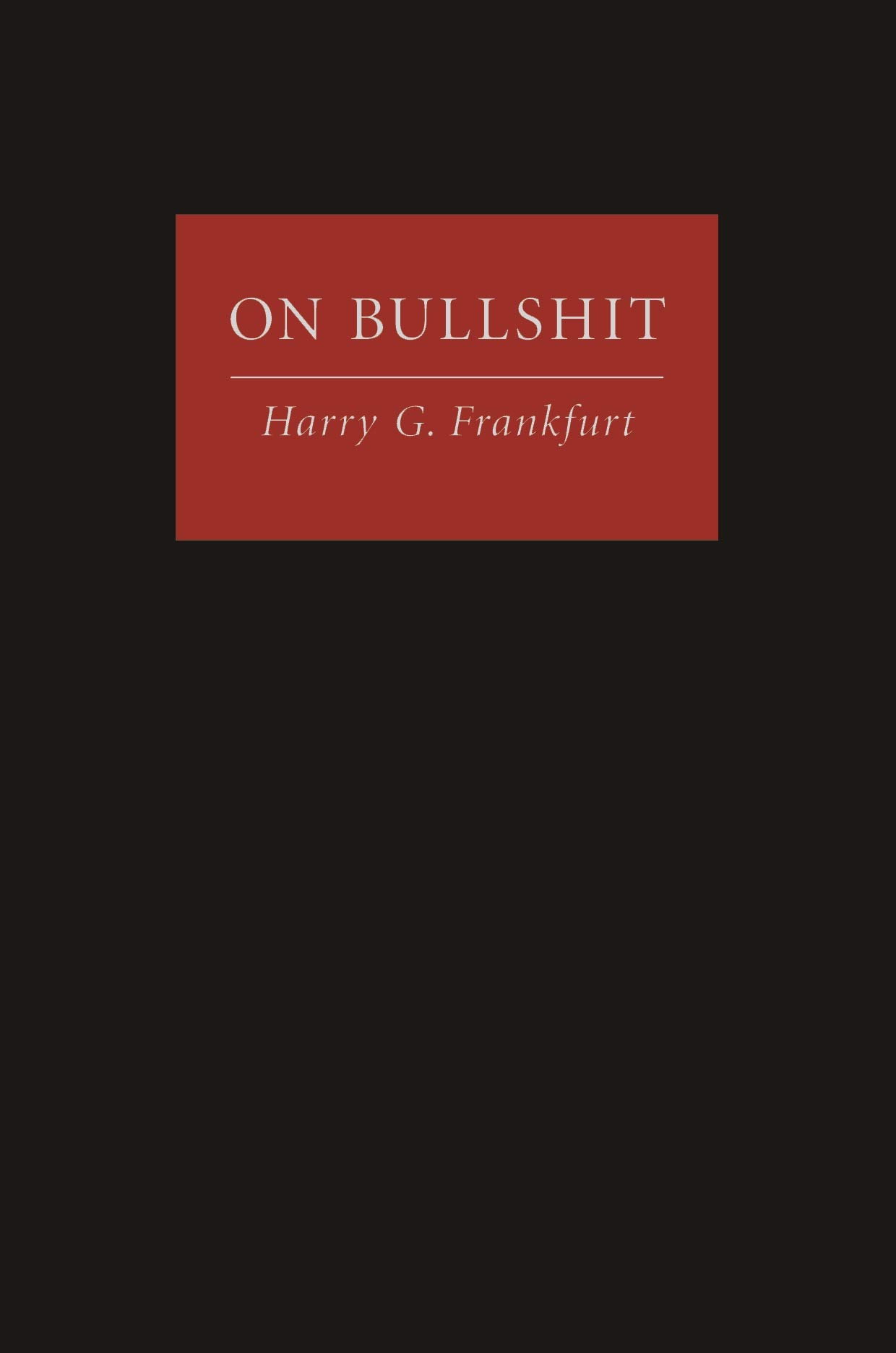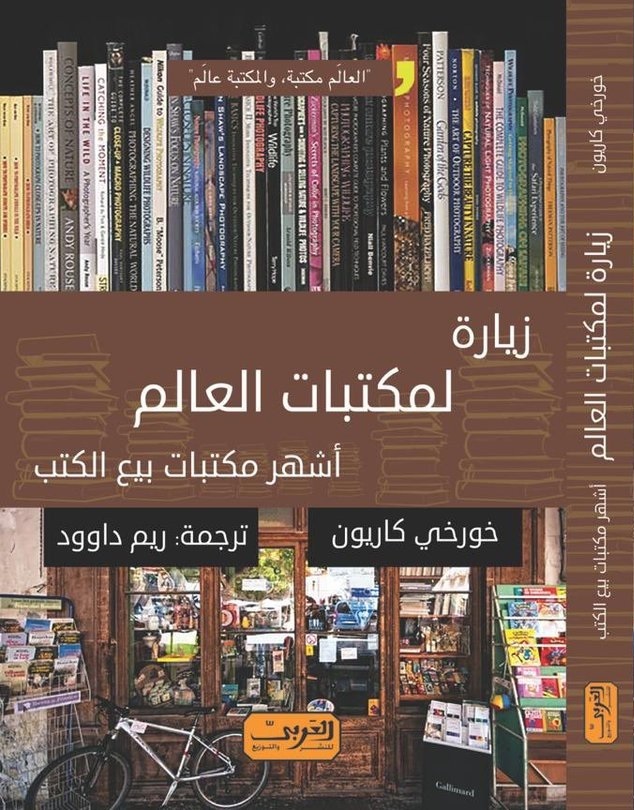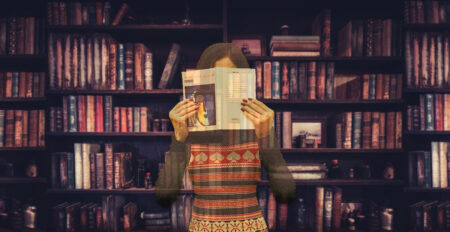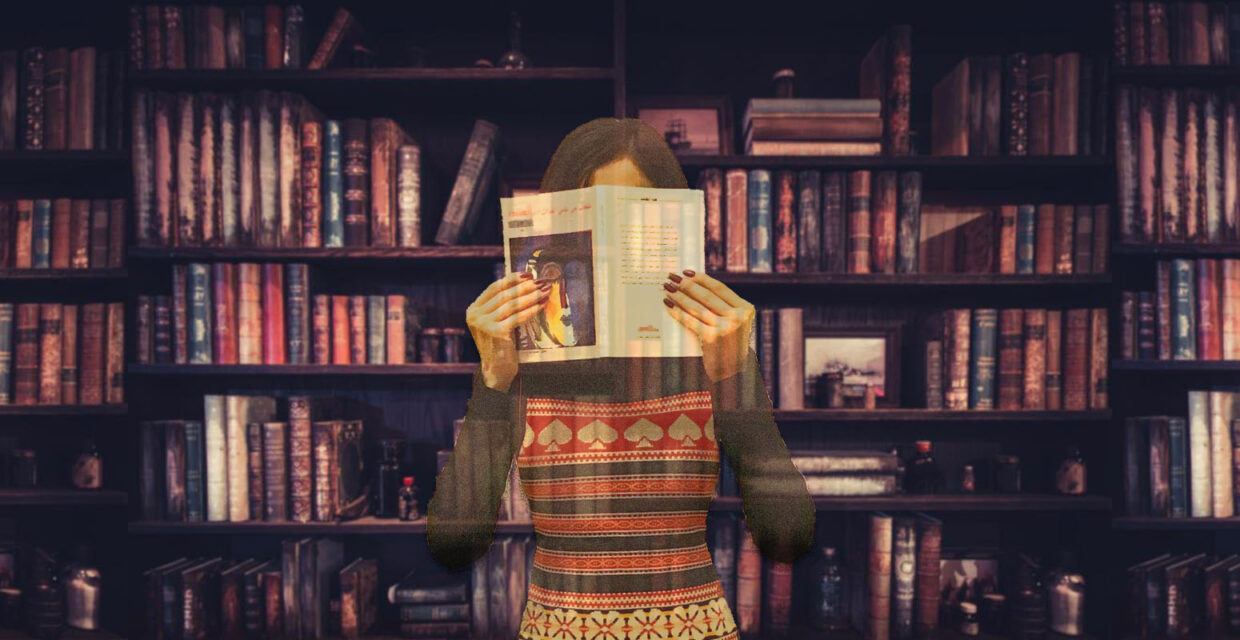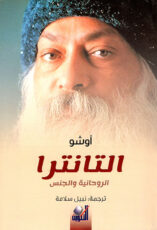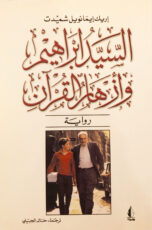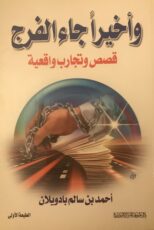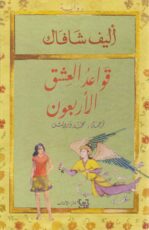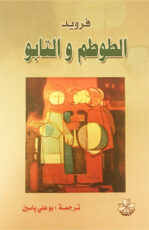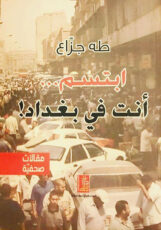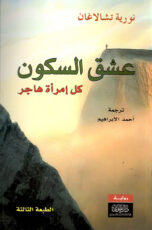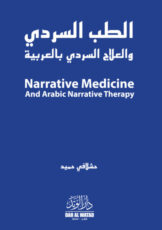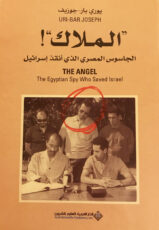| عدد |
اسم الكتاب |
المؤلف |
دار النشر |
|
|
|
|
| 1 |
دكتور مصطفى محمود والتصوف |
د. مصطفى محمود |
دار أخبار اليوم – مصر |
| 2 |
متصوفة بغداد |
عزيز السيد جاسم |
المركز الثقافي العربي |
| 3 |
طريق الحب |
أوشو |
دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |
| 4 |
الحياة والأبدية |
أوشو |
دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |
| 5 |
كتاب الحكمة |
أوشو |
دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |
| 6 |
لغة الوجود : ما وراء الحياة والموت |
أوشو |
دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |
| 7 |
الثورة لعبة العقائد |
أوشو |
دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |
| 8 |
هكذا تكلم ابن عربي |
د. نصر حامد أبو زيد |
دار التنوير للطباعة والنشر |
| 9 |
فيه ما فيه |
جلال الدين الرومي |
دار فاروس للطباعه والنشر |
| 10 |
المثنوي المعنوي – 1 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 11 |
المثنوي المعنوي – 2 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 12 |
المثنوي المعنوي – 3 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 13 |
المثنوي المعنوي – 4 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 14 |
المثنوي المعنوي – 5 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 15 |
المثنوي المعنوي – 6 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 16 |
رسالة حي بن يقظان |
أبو جعفر الأندلسي |
دار صادر للنشر – بيروت |
| 17 |
لا تصدق الكذبة: فلسفة الحب في زمن الكراهية |
كريشنا مورتي |
دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |
| 18 |
الحياة ليست سينما |
كريشنا مورتي |
دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |
| 19 |
سيكولوجية الإستنارة والأجساد السبعة |
أوشو |
دار كنعان للدراسات والنشر |
| 20 |
العلاقة الحميمة : لغز العلاقة الحامية |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 21 |
الشجاعة |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 22 |
الإبداع |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 23 |
الحدس: أبعد من أي حس |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 24 |
الفهم |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 25 |
النضج: عودة الإنسان إلى ذاته |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 26 |
الحرية: شجاعتك أن تكون كما أنت |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |
| 27 |
كتاب آلاترا |
آنا نوفيخ |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 28 |
التانترا: الروحانية والجنس |
أوشو |
دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |
| 29 |
سيكولوجية الإستنارة والأجساد السبعة |
أوشو |
دار كنعان للدراسات والنشر |
| 30 |
سر أسرار التنانترا: تقنيات النور والظلام – أسمى من الأنا |
أوشو |
دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |
| 31 |
سر أسرار التنانترا: السمع والجنس – الاستنارة المفاجئة |
أوشو |
دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |
| 32 |
بحثاً عن الشمس: من قونية إلى دمشق |
عطاء الله تدين |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 33 |
المركب الفارغ: لقاءات مع اللاشيء |
أوشو |
دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع |
| 34 |
الرحلة الداخلية |
أوشو |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 35 |
شمس المعارف الصغرى |
أحمد بن علي البوني |
مؤسسة النور للمطبوعات |
| 36 |
شمس المعارف الكبرى |
أحمد بن علي البوني |
دار الميزان |
| 37 |
منازل السائرين إلى الحق عز شأنه |
عبد الله الهروي |
الكرمة للنشر والتوزيع |
| 38 |
النبي |
جبران خليل جبران |
نوفل / هاشيت أنطوان |
| 39 |
حكمة الإشراق |
شهاب الدين السهروردي |
دار روافد للنشر والتوزيع |
| 40 |
مطمئنة |
أحمد الديب |
دار دون للنشر والتوزيع |
| 41 |
الحسين بن منصور: الحلاج |
طه سرور |
وكالة الصحافة العربية |
| 42 |
التأمل: فن النشوة الداخلية |
أوشو |
دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع |
| 43 |
رباعيات مولانا جلال الدين الرومي |
إيفا دوفيتري ميروفيتش |
دار مداد للطباعة والنشر |
| 44 |
رباعيات مولانا جلال الدين الرومي |
جلال الدين الرومي |
دار الفكر |
| 45 |
تصوف: منقذو الآلهة |
نيكوس كازنتاكيس |
دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع |
| 46 |
كتاب الصدق |
أبو سعيد الخراز |
المكتبة الصوفية الصغيرة |
| 47 |
درب الحب: محادثات عن أغاني كبير |
أوشو |
دار الخيال |
| 48 |
إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 1 |
إخوان الصفا وخلان الوفا |
منشورات عويدات |
| 49 |
إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 2 |
إخوان الصفا وخلان الوفا |
منشورات عويدات |
| 50 |
إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 3 |
إخوان الصفا وخلان الوفا |
منشورات عويدات |
| 51 |
إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 4 |
إخوان الصفا وخلان الوفا |
منشورات عويدات |
| 52 |
إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 5 |
إخوان الصفا وخلان الوفا |
منشورات عويدات |
| 53 |
وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق |
د. ألفة يوسف |
دار مسكيلياني للنشر والتوزيع |
| 54 |
حي بن يقظان: ابن سينا وابن طفيل والسهروردي |
أحمد أمين |
أقلام عربية للنشر والتوزيع |
| 55 |
في التصوف الإسلامي وتاريخه |
رينولد نيكولسون |
أقلام عربية للنشر والتوزيع |
| 56 |
من العلاج إلى التأمل |
أوشو |
دار الخيال |
| 57 |
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة |
د. أبو العلا عفيفي |
أقلام عربية للنشر والتوزيع |
| 58 |
التصوف: الثورة الروحية في الإسلام |
د. أبو العلا عفيفي |
أقلام عربية للنشر والتوزيع |
| 59 |
تعاليم المتصوفين |
حضرة عنايت خان |
دار الفرقد |
| 60 |
ترانيم الحلاج: تأملات صوفية |
د. رامز محمود |
دار الفرقد |
| 61 |
شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 1 |
عبدالله صلاح الدين |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 62 |
شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 2 |
عبدالله صلاح الدين |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 63 |
شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 3 |
عبدالله صلاح الدين |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 64 |
آبرا كادابرا: بئر الحكمة |
مصطفى اليوسف |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 65 |
التحولات: آي تشينغ |
سارة ديينغ |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 66 |
بين الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم |
توشيهيكو إيزوتسو |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 67 |
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 1 |
عبدالغني النابلسي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 68 |
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 2 |
عبدالغني النابلسي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 69 |
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 3 |
عبدالغني النابلسي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 70 |
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 4 |
عبدالغني النابلسي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 71 |
الكشف الأتم لمفاتيح كتاب فصوص الحكم لابن عربي |
عبدالباقي مفتاح |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 72 |
كتاب مشرب الأرواح |
أبو محمد البقلي الشيرازي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 73 |
آلام الحلاج – الجزء 1 |
لويس ماسينيون |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 74 |
آلام الحلاج – الجزء 2 |
لويس ماسينيون |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 75 |
آلام الحلاج – الجزء 3 |
لويس ماسينيون |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 76 |
آلام الحلاج – الجزء 4 |
لويس ماسينيون |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 77 |
الطريق إلى الله – مجلد 1 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 78 |
الطريق إلى الله – مجلد 2 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 79 |
الطريق إلى الله – مجلد 3 |
جلال الدين الرومي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 80 |
الرومي: ماضياً وحاضراً شرقاً وغرباً – جزء 1 |
فرانكلين لويس |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 81 |
الرومي: ماضياً وحاضراً شرقاً وغرباً – جزء 2 |
فرانكلين لويس |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 82 |
العرفان عبر تاريخ الملل الكبرى |
عبدالفتاح مفتاح |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 83 |
قصة القصص: أقدم رواية لما جرى بين شمس تبريز ومولانا الرومي |
محمد علي موحد |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 84 |
المصطلح الصوفي في الإسلام |
د. نظلة الجبوري |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 85 |
اللغة التي يخاطب بها الله |
أ. د. عيسى العاكوب |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 86 |
منطق الطير-1 |
فريد الدين العطار |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 87 |
منطق الطير-2 |
فريد الدين العطار |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 88 |
كتاب الأسرار |
فريد الدين العطار |
دار التكوين |
| 89 |
من الجنس إلى أعلى مراحل الوعي |
أوشو |
دار الخيال |
| 90 |
محادثات عن التصوف |
أوشو |
دار الخيال |
| 91 |
أسرار الحياة |
أوشو |
دار الخيال |
| 92 |
الإخلاص للحقيقة: محادثات عن التصوف |
أوشو |
دار الخيال |
| 93 |
ألف باء التنوير: القاموس الروحي لكل الأزمان |
أوشو |
دار الخيال |
| 94 |
بحار الحب عند الصوفية |
أحمد بهجت |
دار الشروق للنشر |
| 95 |
الذكاء: العيش في الوقت الحاضر |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت |
| 96 |
الفرح: السعادة النابعة من الداخل |
أوشو |
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت |
| 97 |
الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف |
آنا ماري شيمل |
منشورات الجمل |
| 98 |
كتاب أخبار الحلاج |
لوي ماسنيون |
منشورات الجمل |
| 99 |
بحار الحب عند الصوفية |
أحمد بهجت |
دار الشروق للنشر |
| 100 |
تقويم الحكمة: خواطر يومية لإثراء الروح |
ليو تولستوي |
جليس |
| 101 |
الدامابادا: سبيل البوذا |
تعاليم البوذا |
دار الكرمة للنشر والتوزيع |
| 102 |
جلال الدين الرومي والتصوف |
إيفادي فيتراي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 103 |
العشق الإلهي: تعاليم من التقليد الصوفي |
اميد صفي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 104 |
الانفتاح على الآخر لدى المتصوفة |
ماجدة حمود |
دار الساقي |
| 105 |
سلطان الأولياء |
نورية تشالاغان |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 106 |
محيي الدين ابن عربي: وارث الأنبياء |
وليم تشيتيك |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 107 |
الخلافة الباطنة: أولياء صوفيون أبعد من السند وجيحون |
وليد زياد |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 108 |
الدرويش الباكي عشقاً |
يونس إمرة |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 109 |
العمق الإنساني: التواصل .. العشق .. التطور |
إلهام فندقجي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 110 |
خلع النعلين: اقتباس النور من موضع القدمين |
أبي القاسم الأندلسي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 111 |
حب الله |
وليم |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 112 |
الموسيقا القديمة لأشجار الصنوبر |
أوشو |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 113 |
النعيم والجحيم: العدالة الإلهية حسب الأرواحية |
آلان كارديك |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 114 |
فصوص الحكم |
محيي الدين ابن عربي |
آفاق للنشر والتوزيع – مصر |
| 115 |
مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 1 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 116 |
مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 2 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 117 |
مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 3 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 118 |
مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 4 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 119 |
رسائل ابن العربي – مجلد 1 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 120 |
رسائل ابن العربي – مجلد 2 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 121 |
رسائل ابن العربي – مجلد 3 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 122 |
شروح على التفسير الإشاري – جزء1 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 123 |
شروح على التفسير الإشاري – جزء2 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 124 |
شروح على التفسير الإشاري – جزء3 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 125 |
شروح على التفسير الإشاري – جزء4 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 126 |
شرح كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 127 |
التجليات الإلهية |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 128 |
رسائل ابن العربي – مجلد 1 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 129 |
رسائل ابن العربي – مجلد 2 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
| 130 |
رسائل ابن العربي – مجلد 3 |
محيي الدين ابن عربي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |