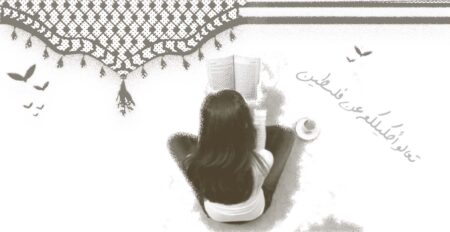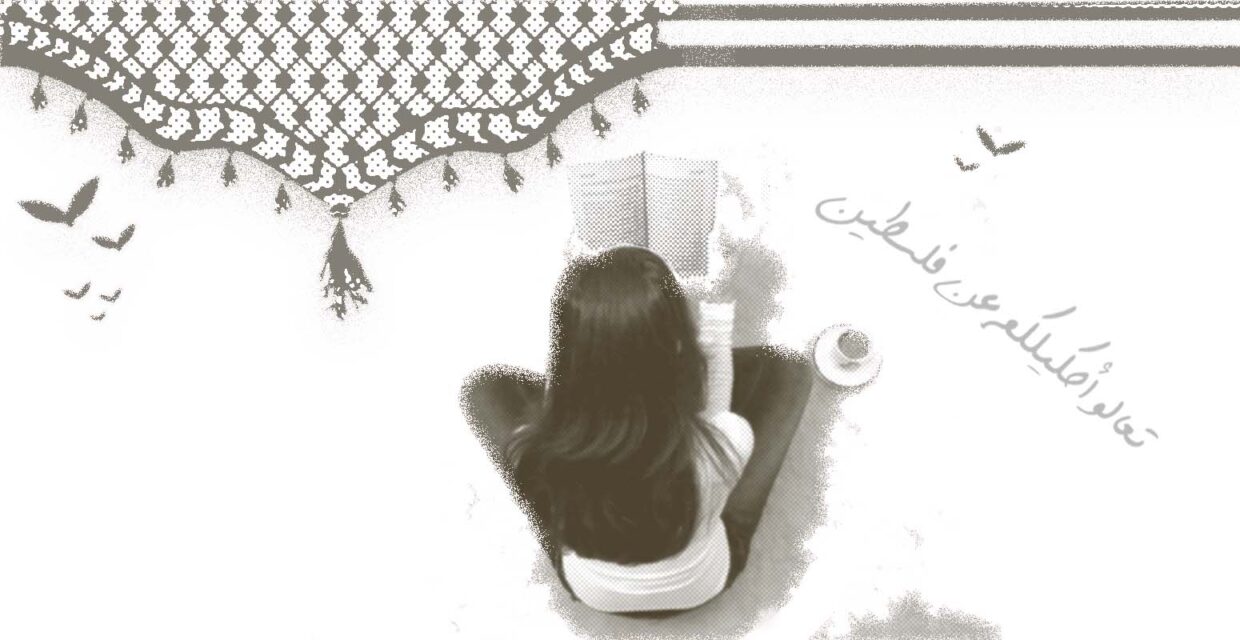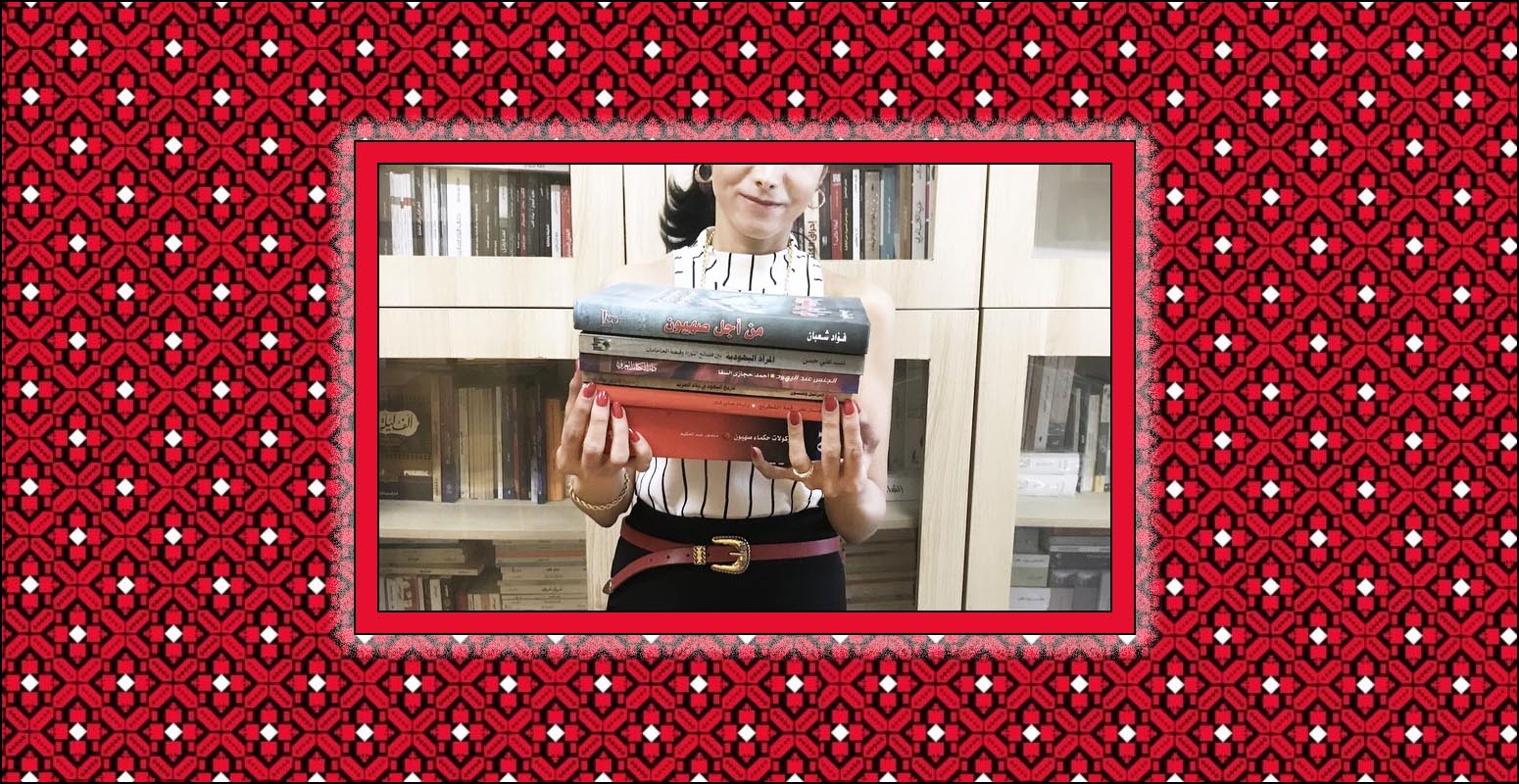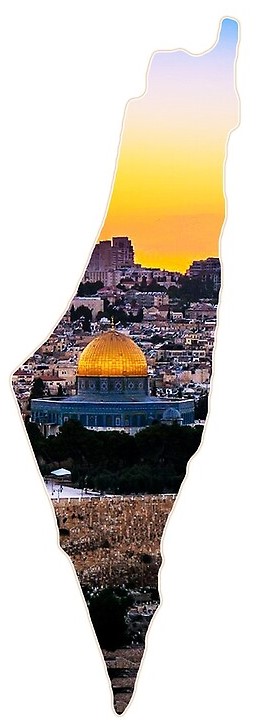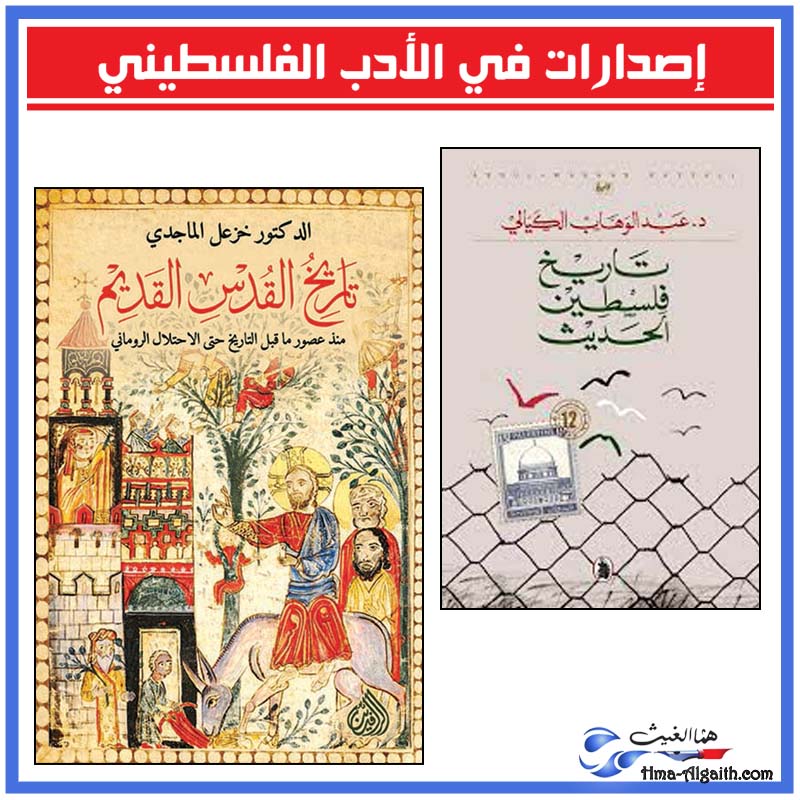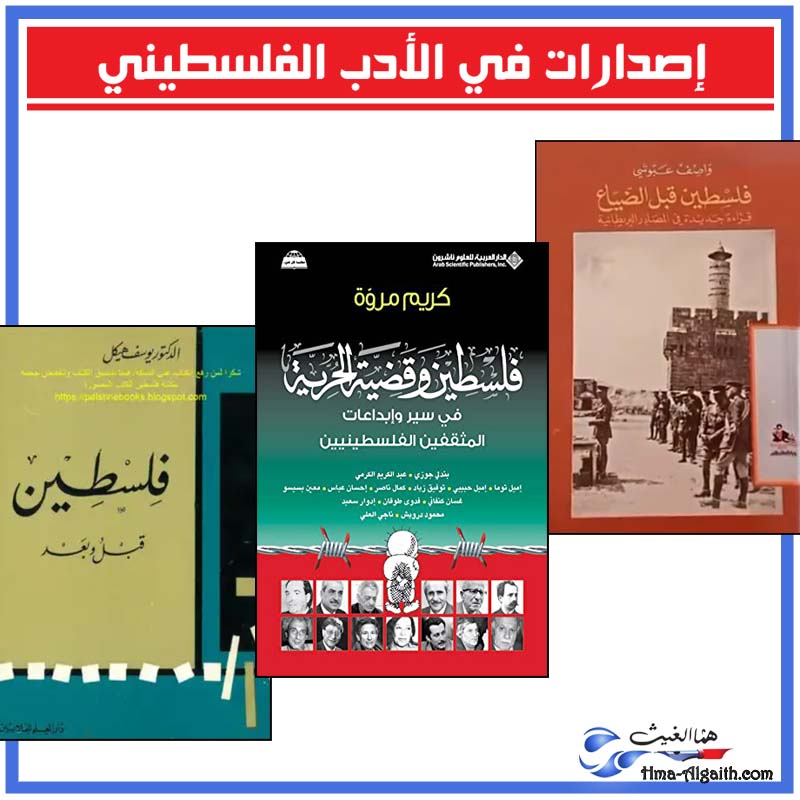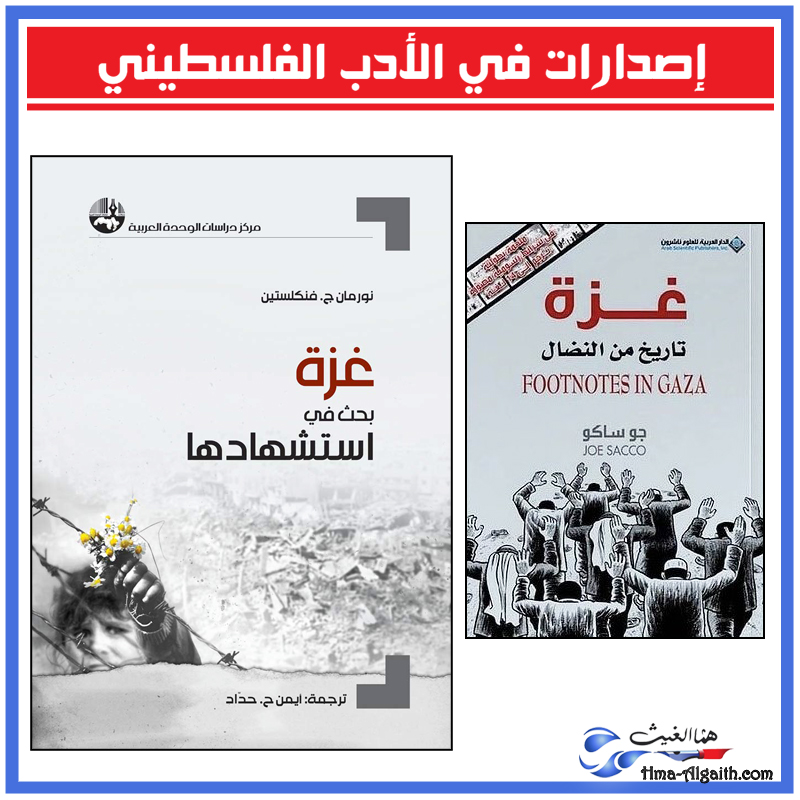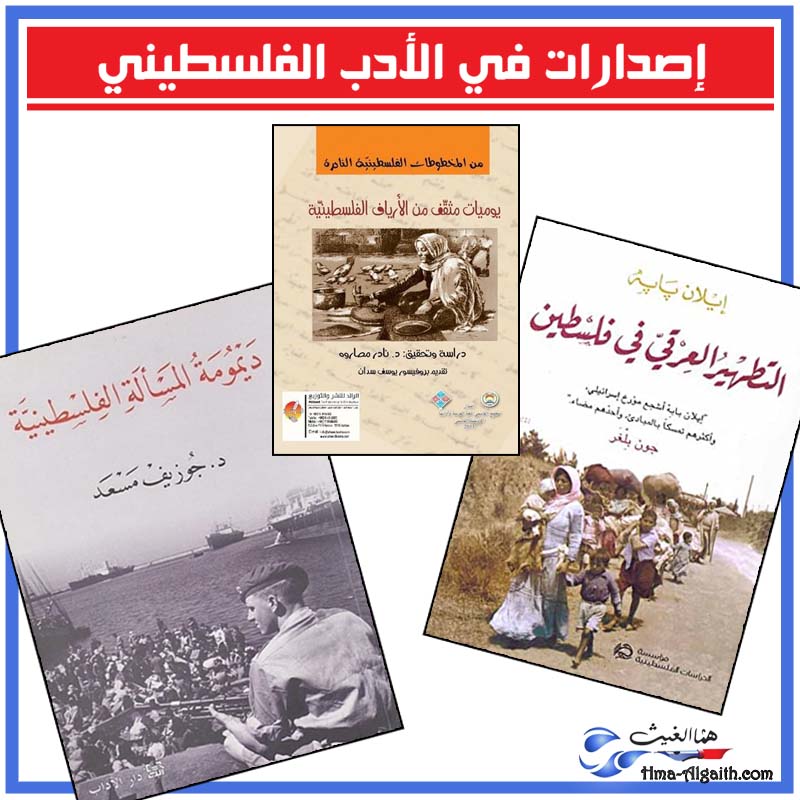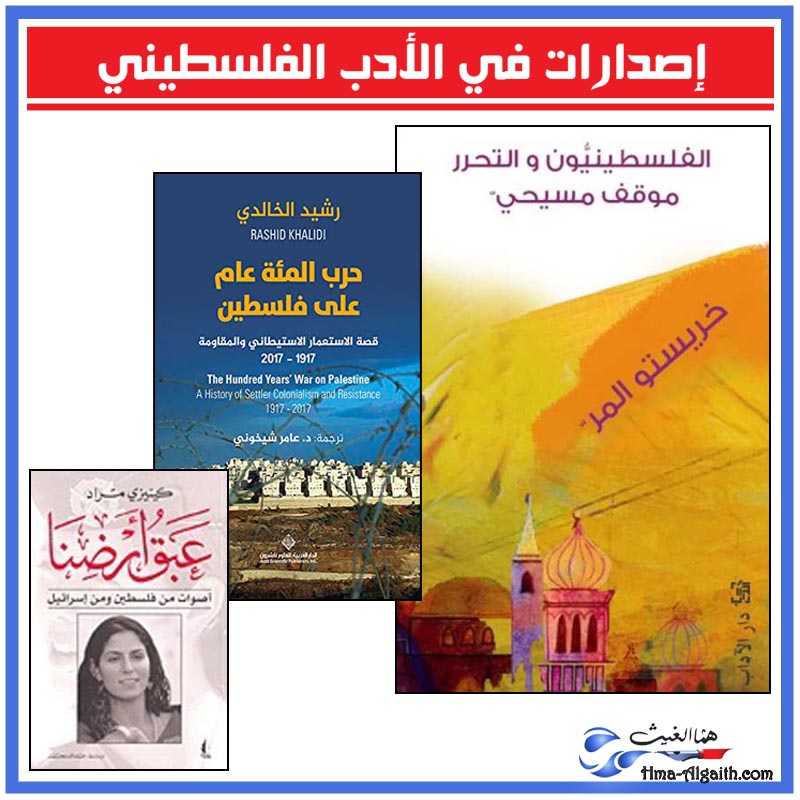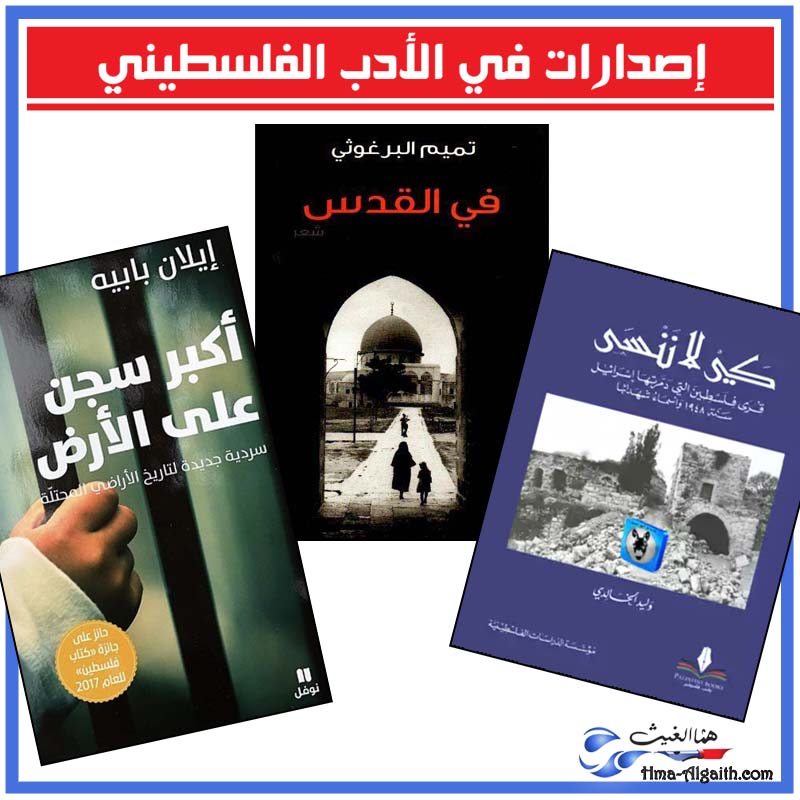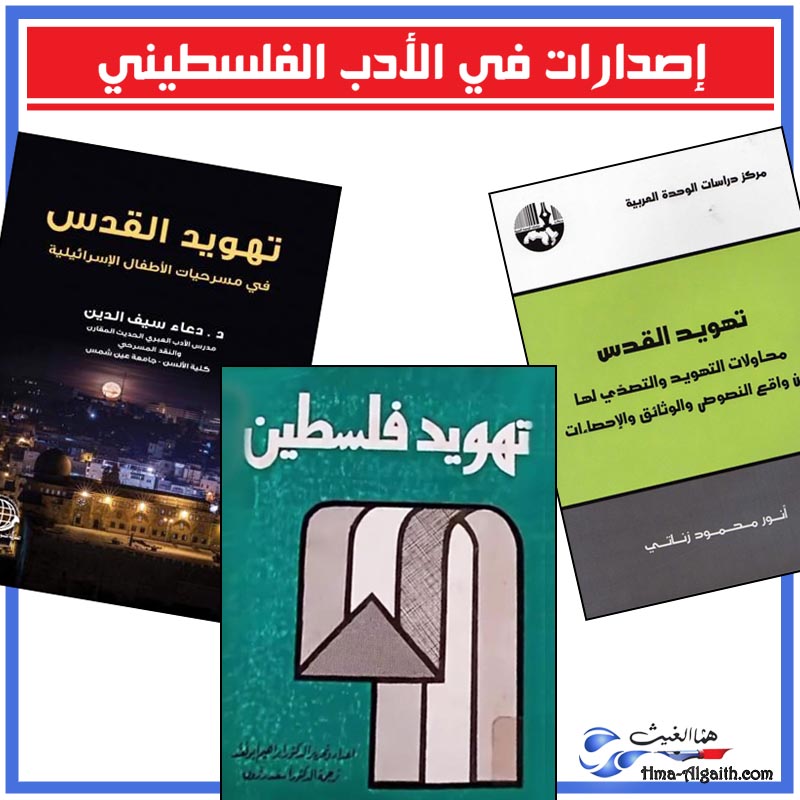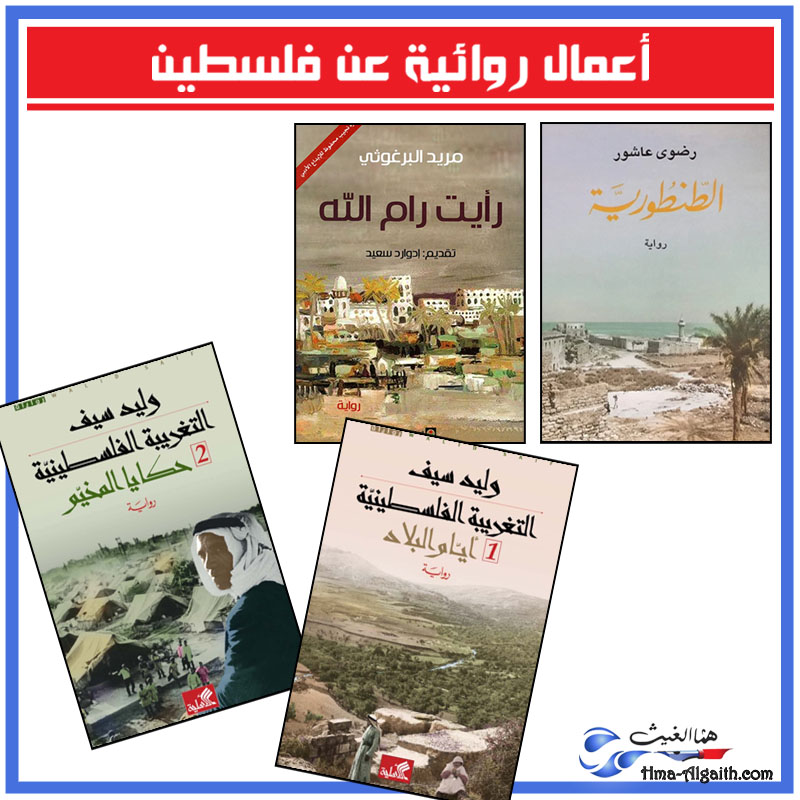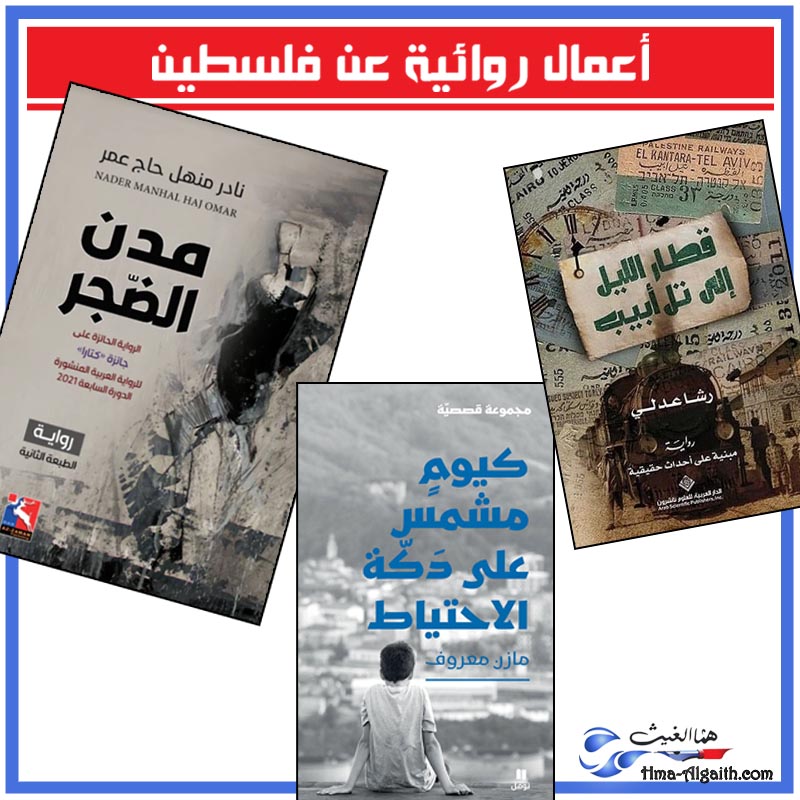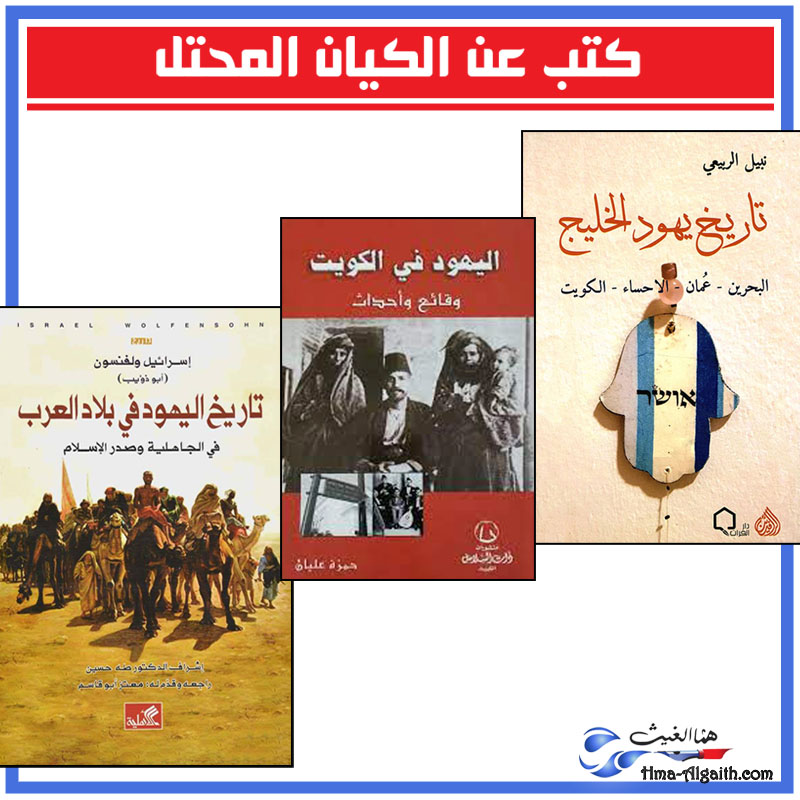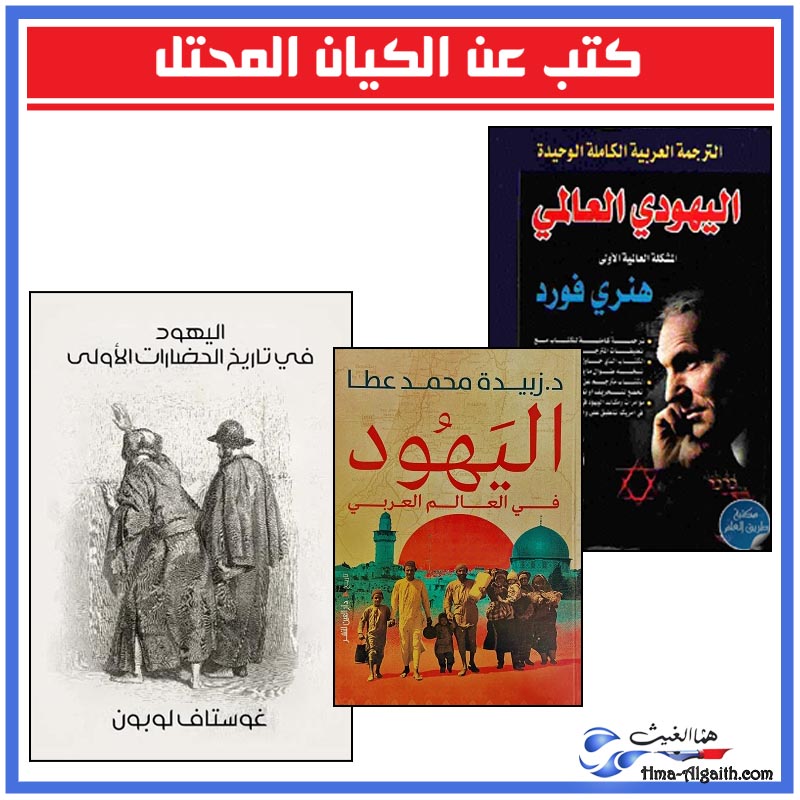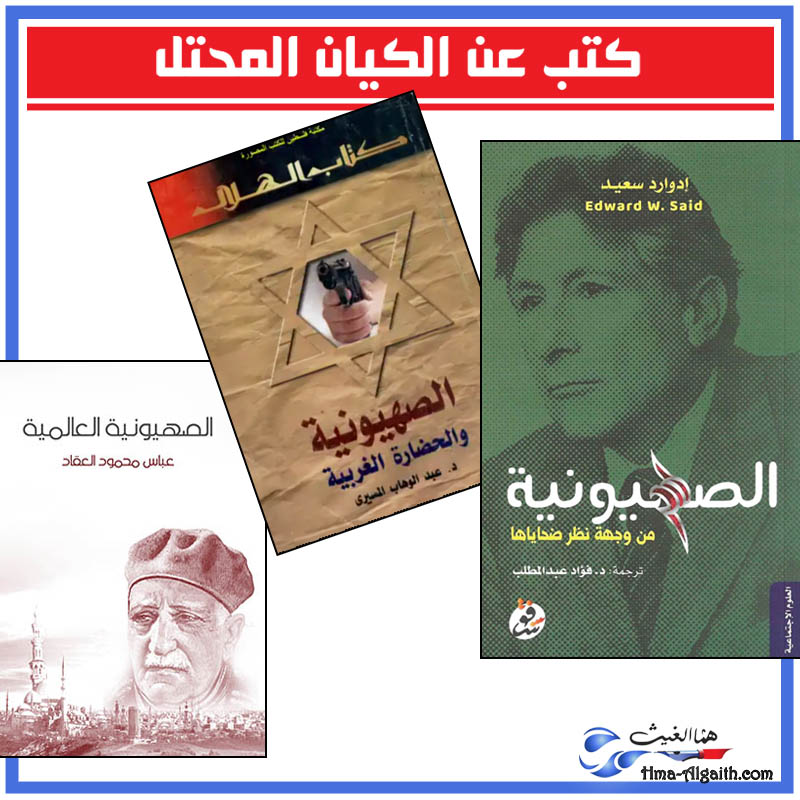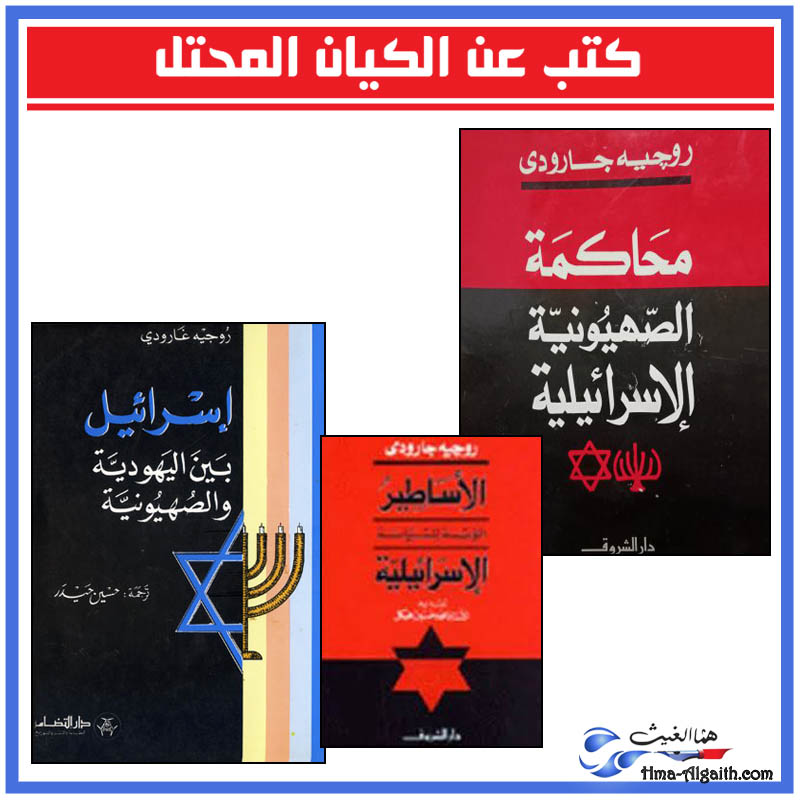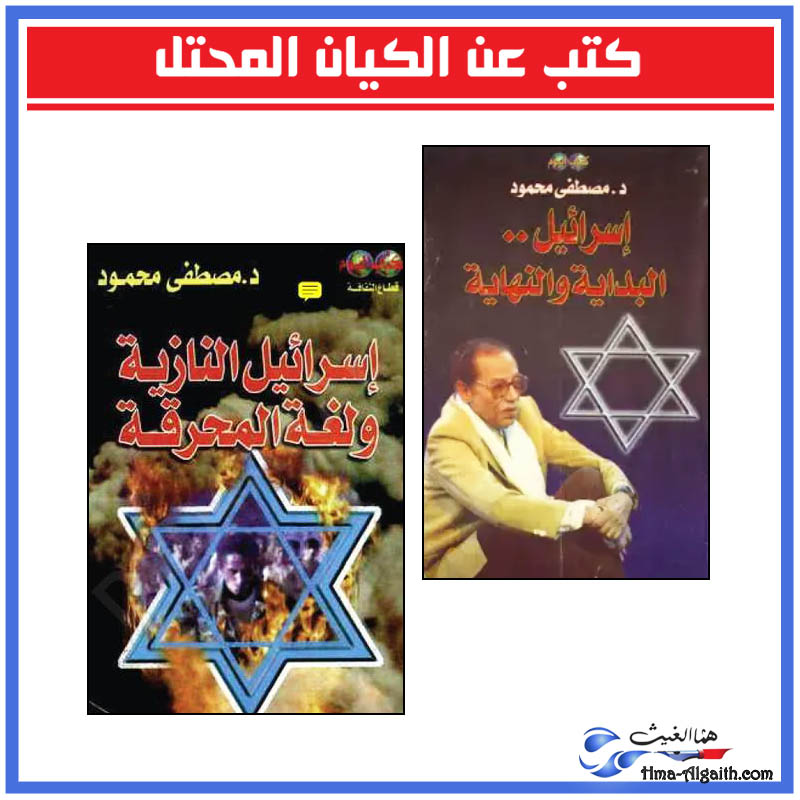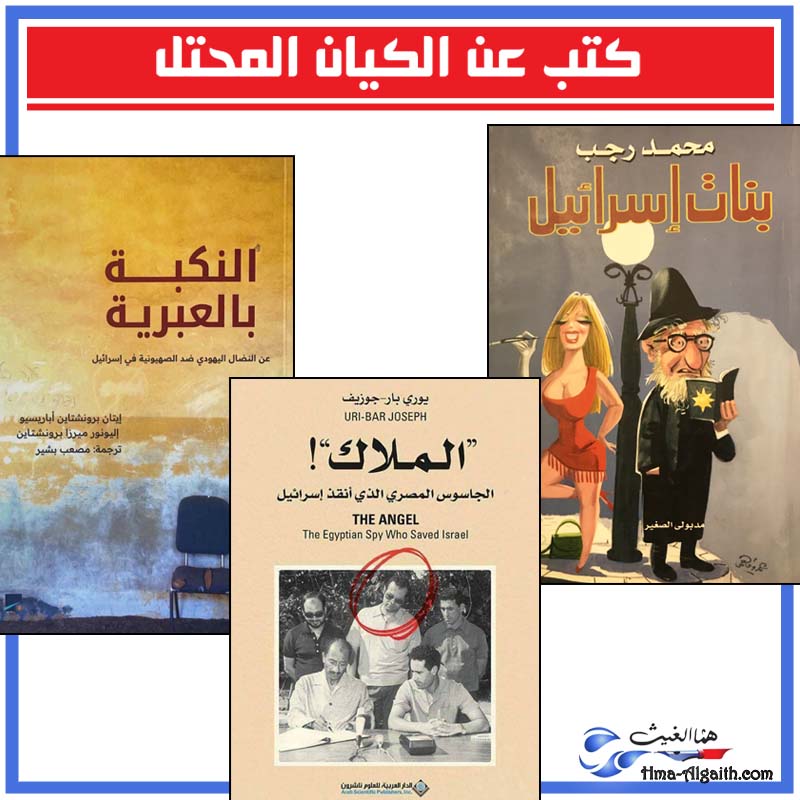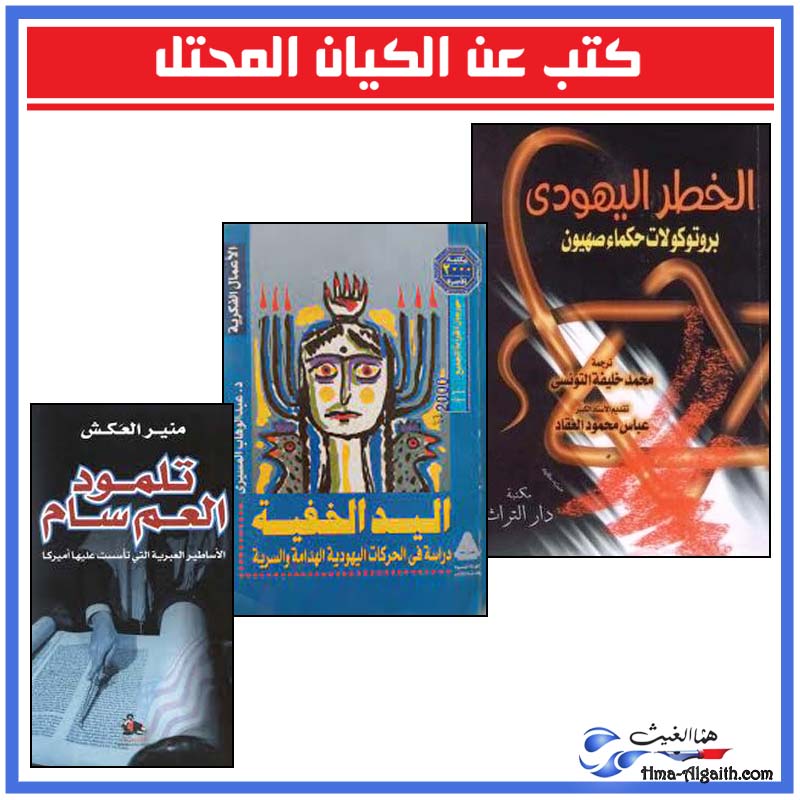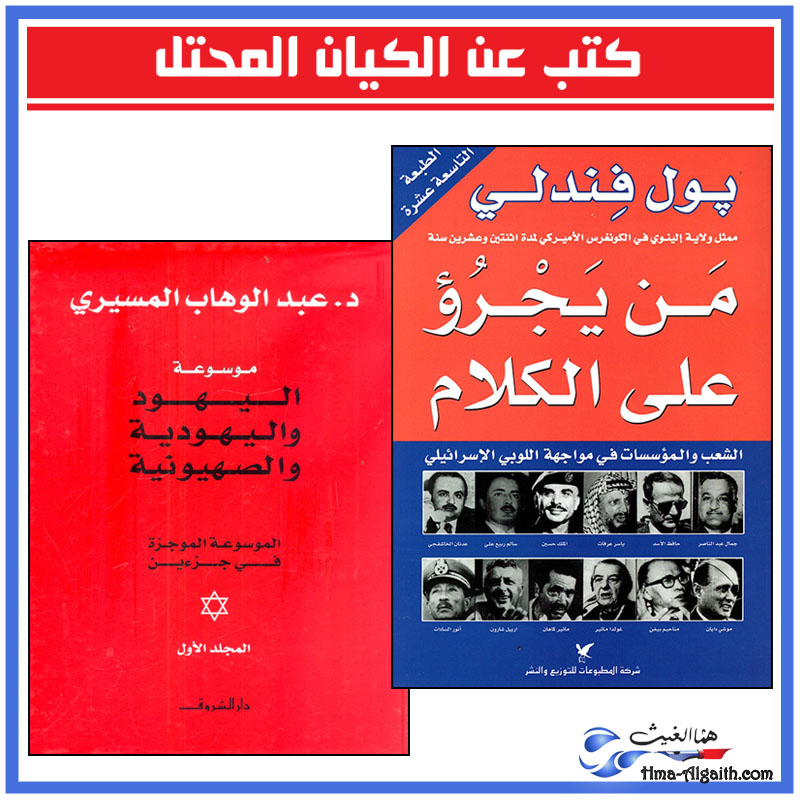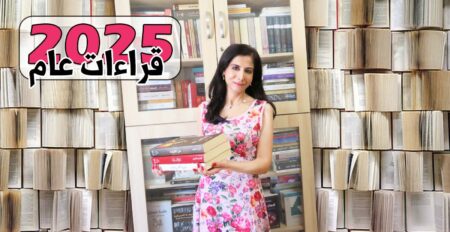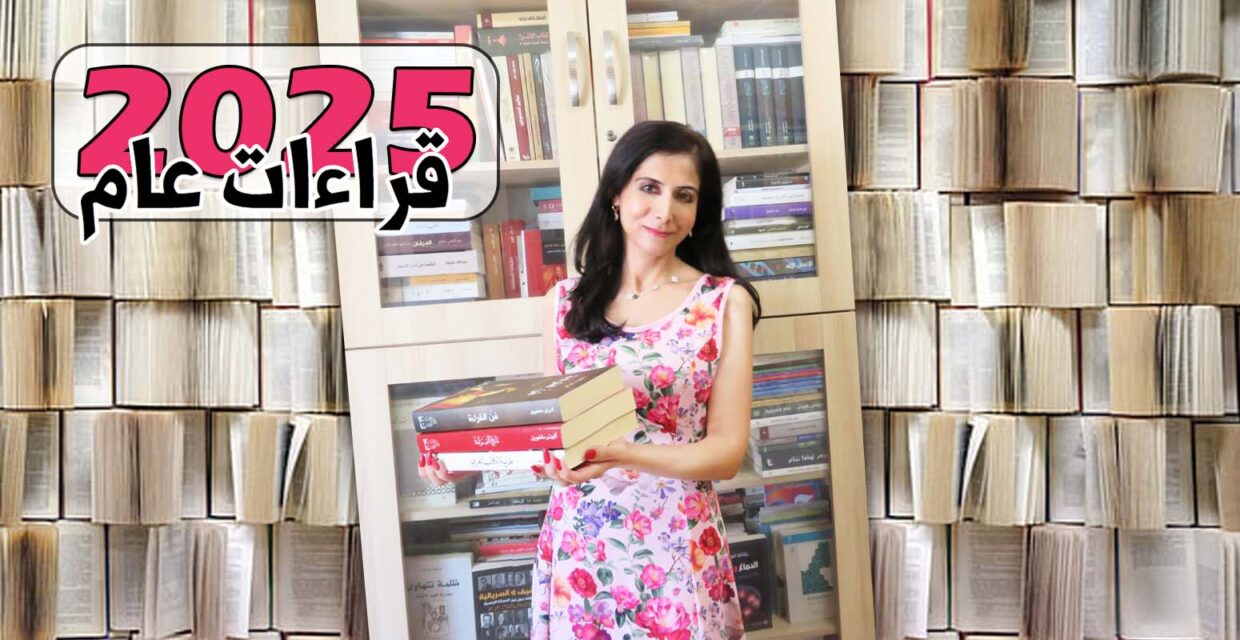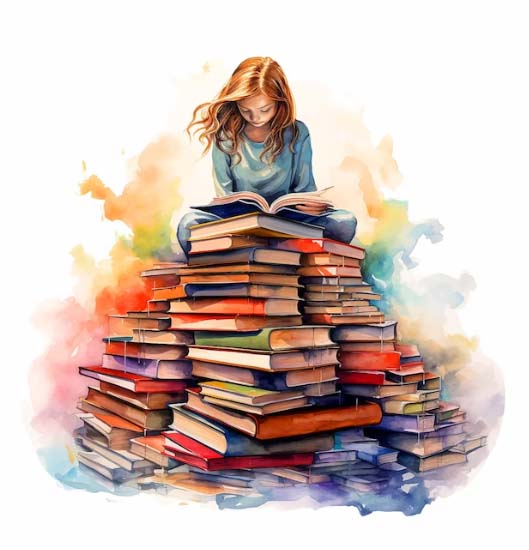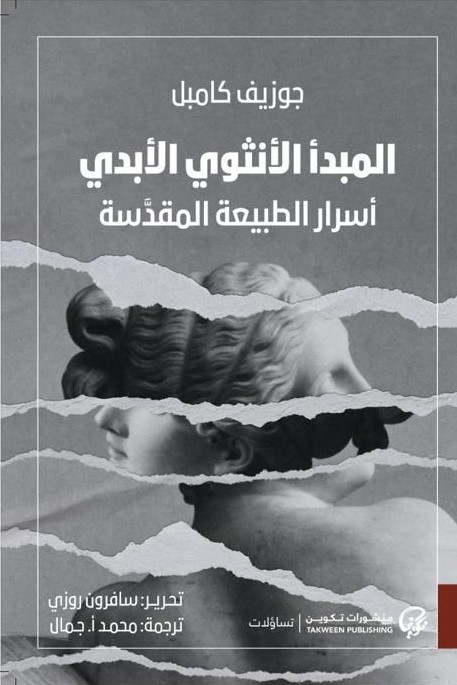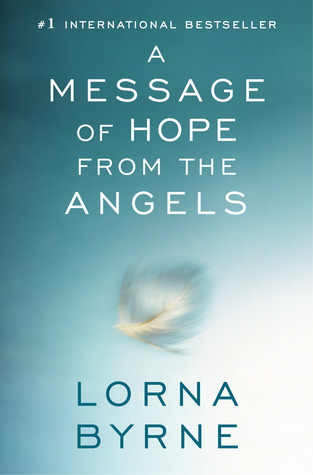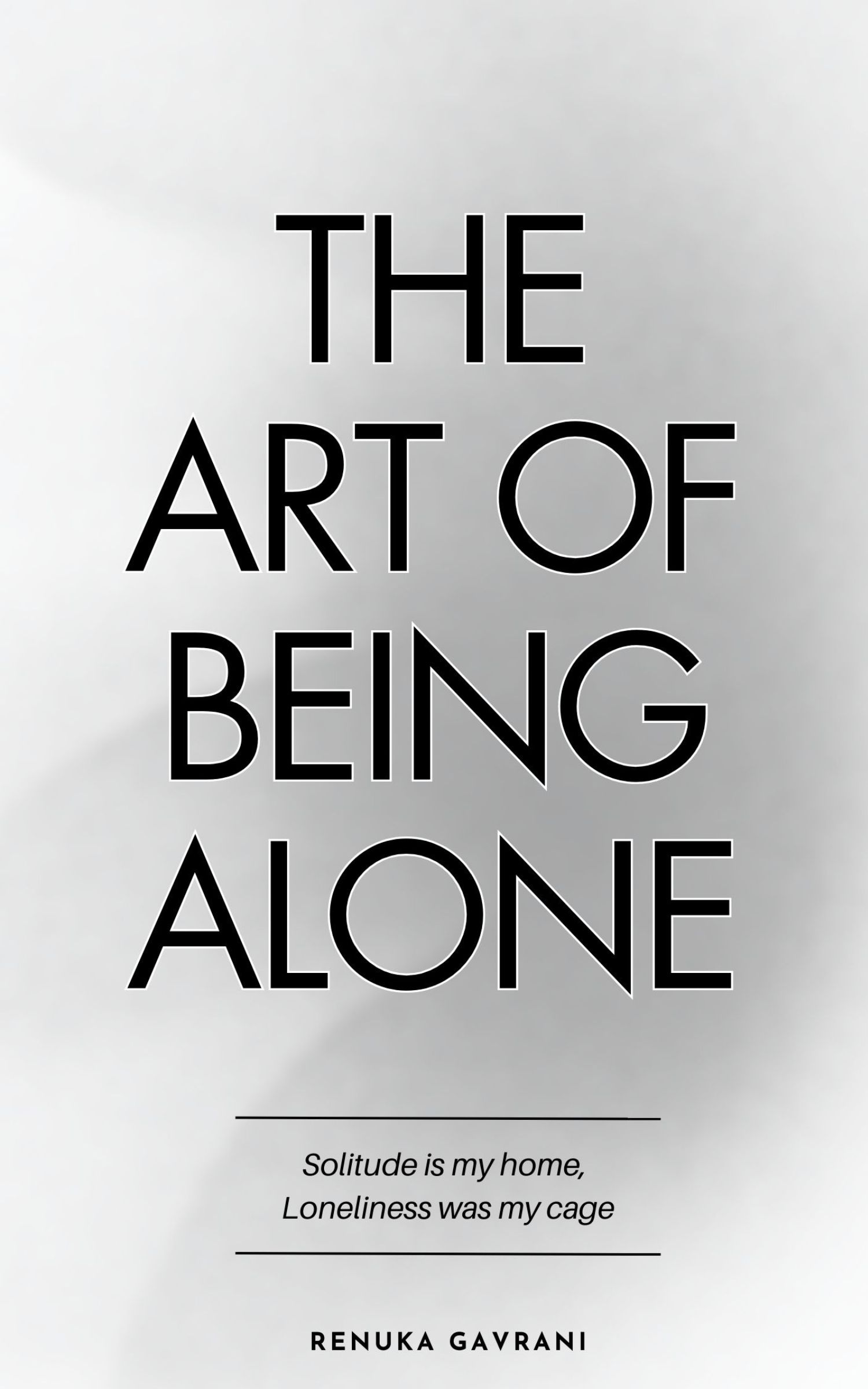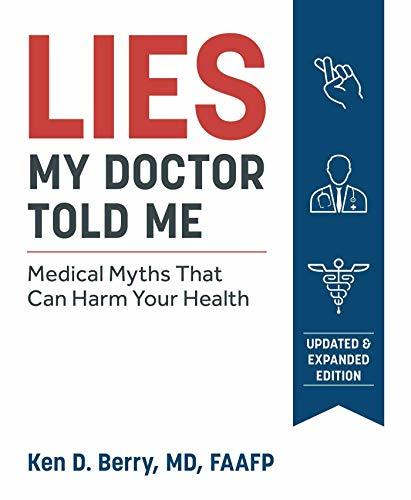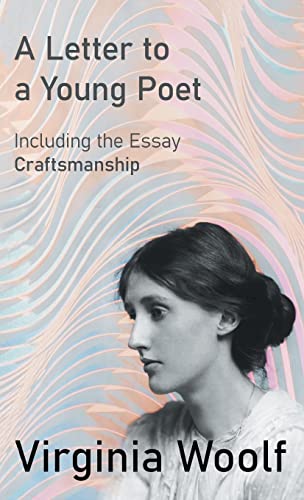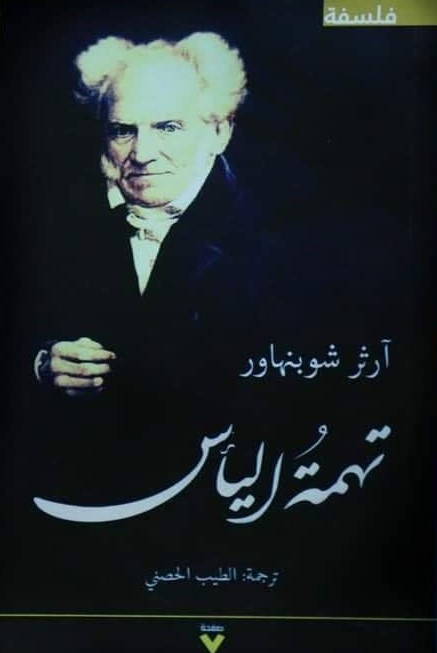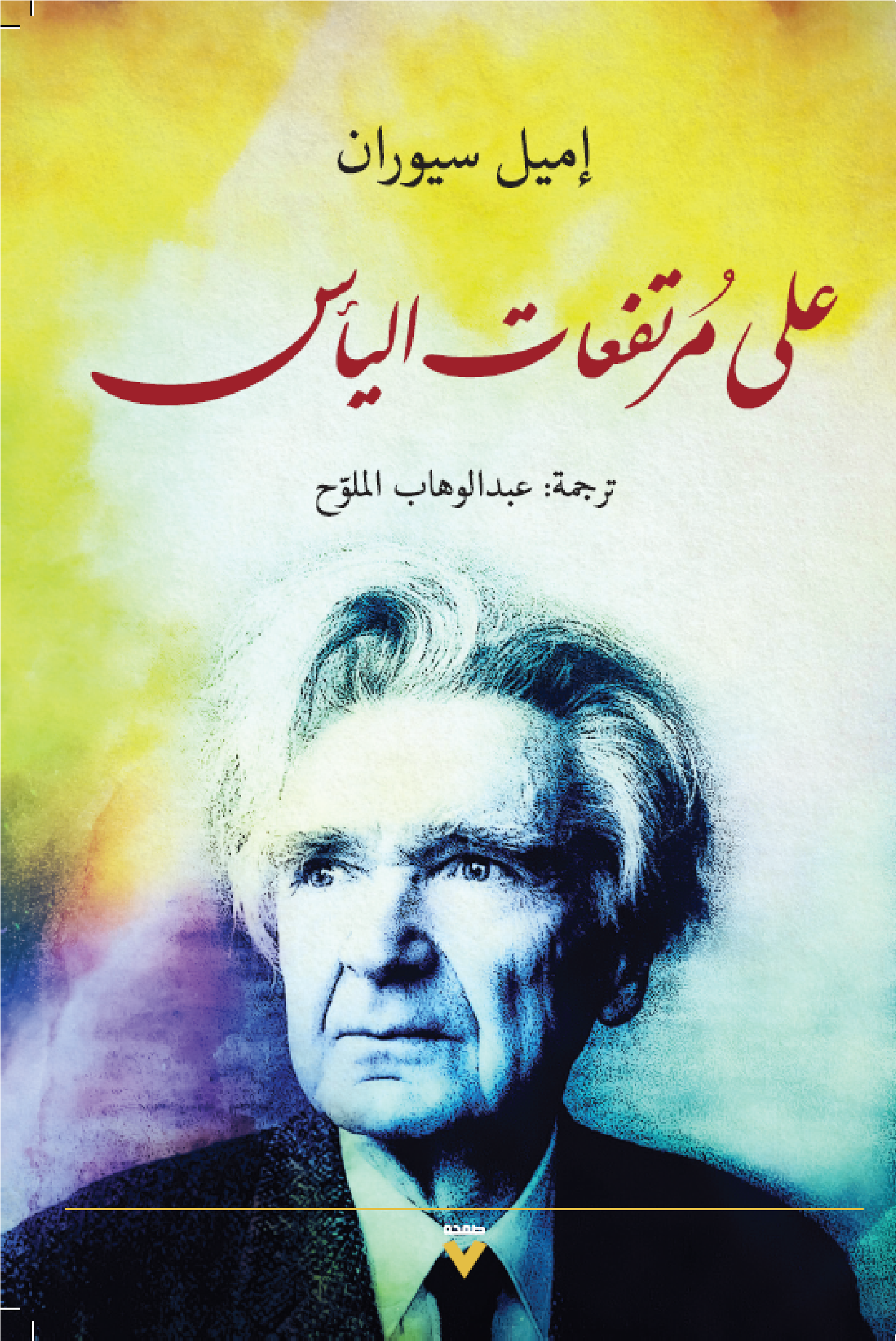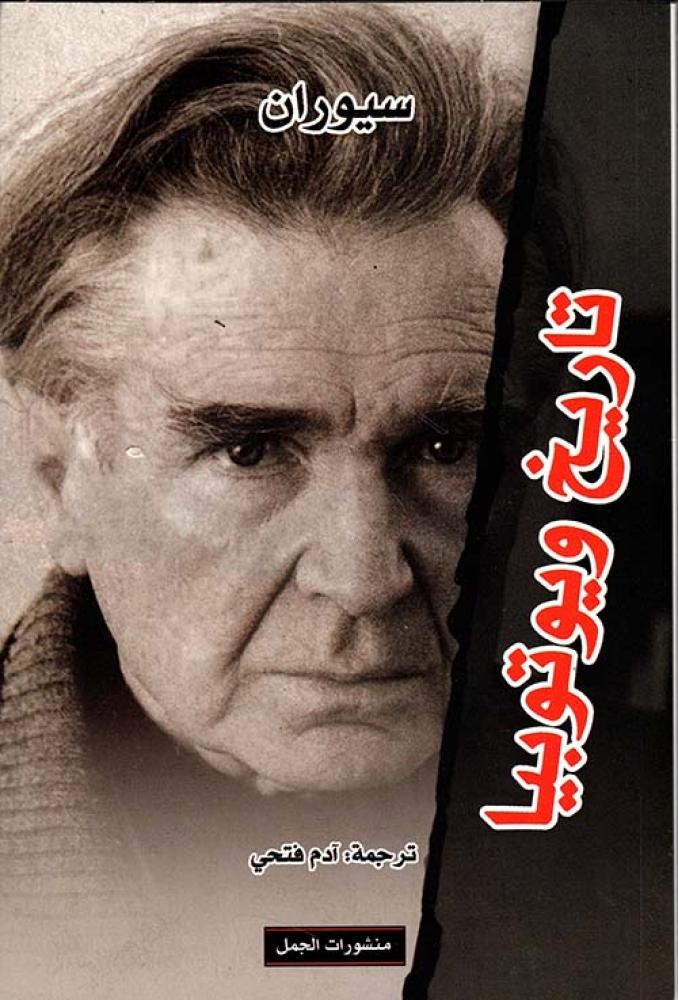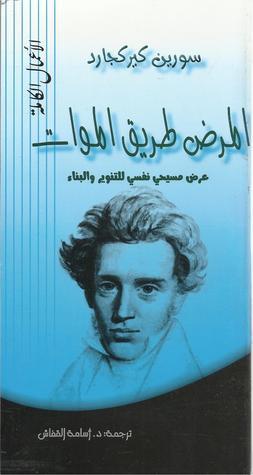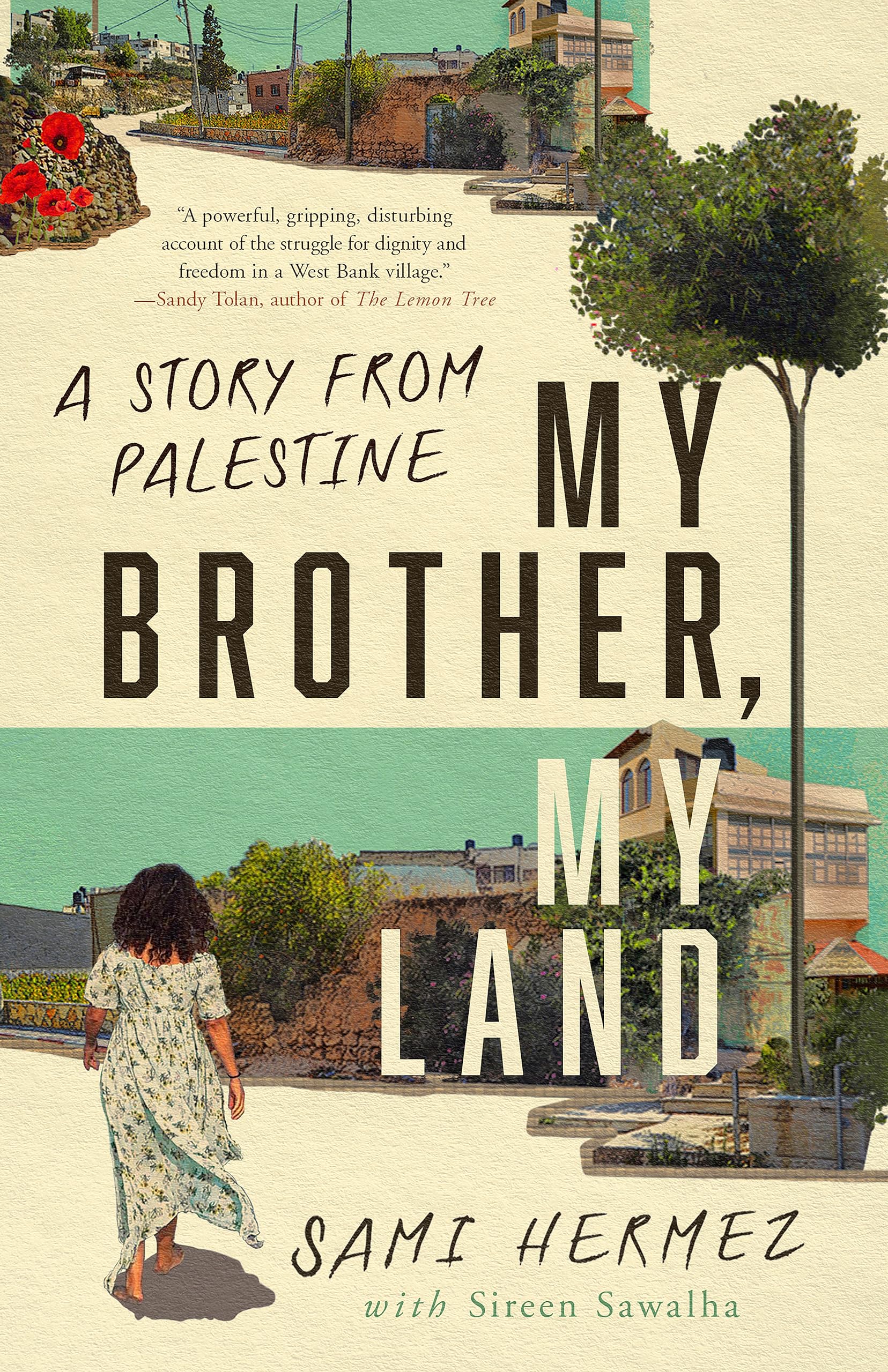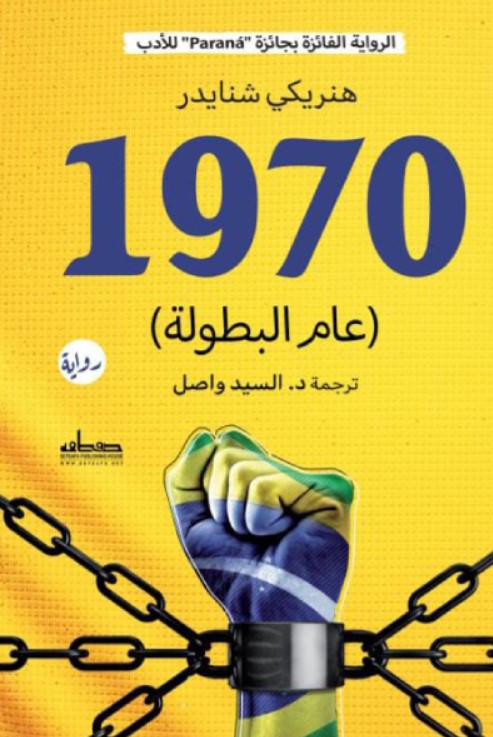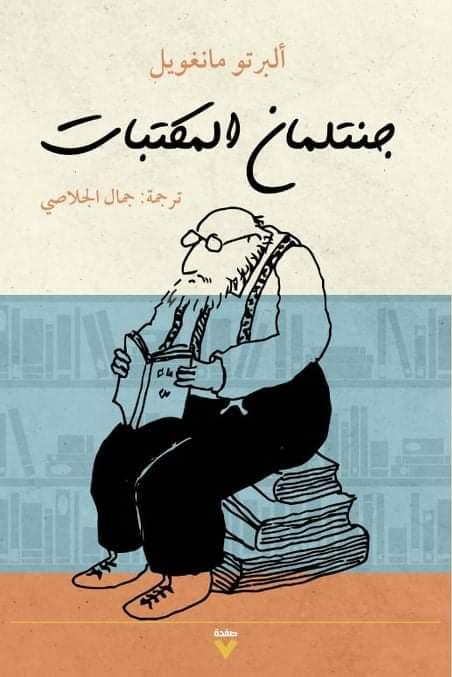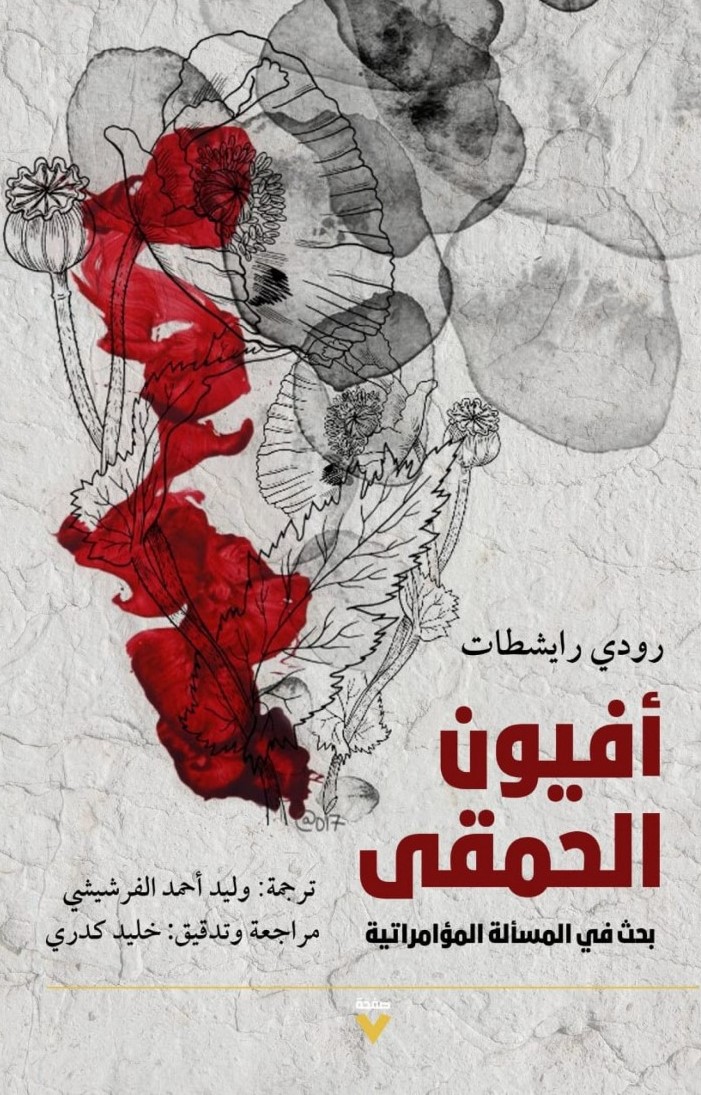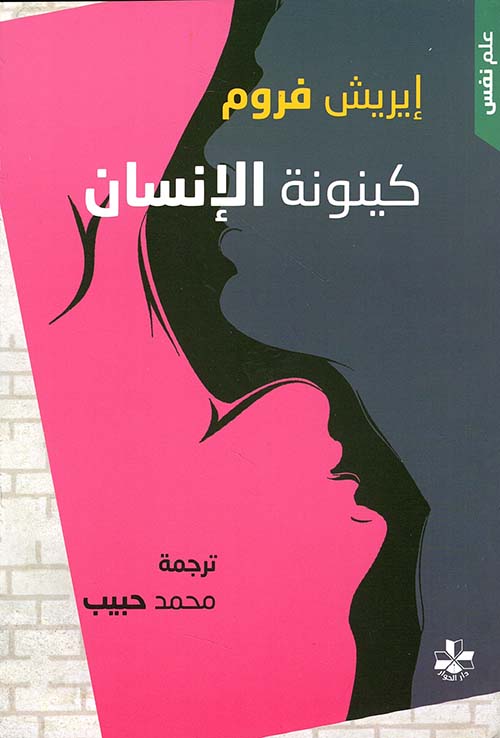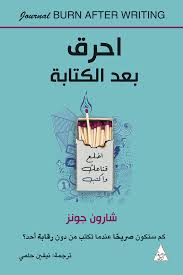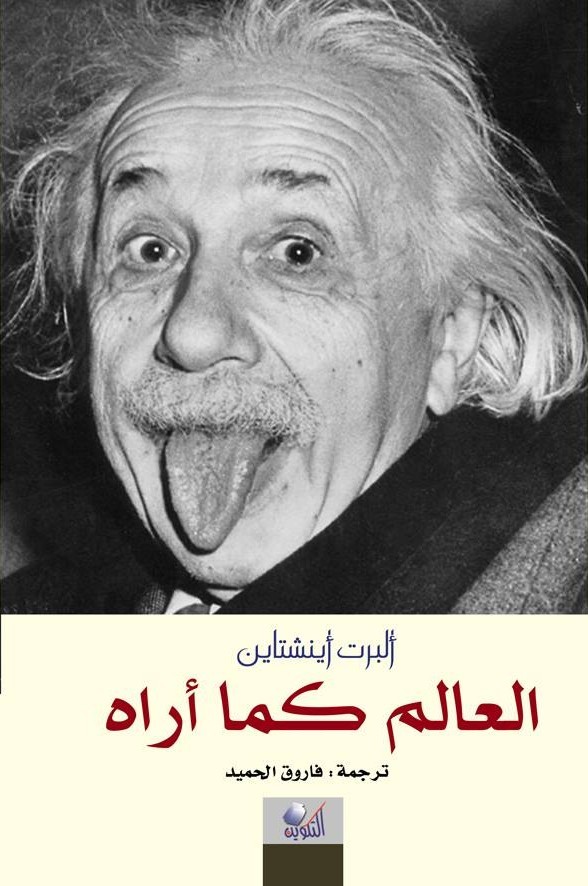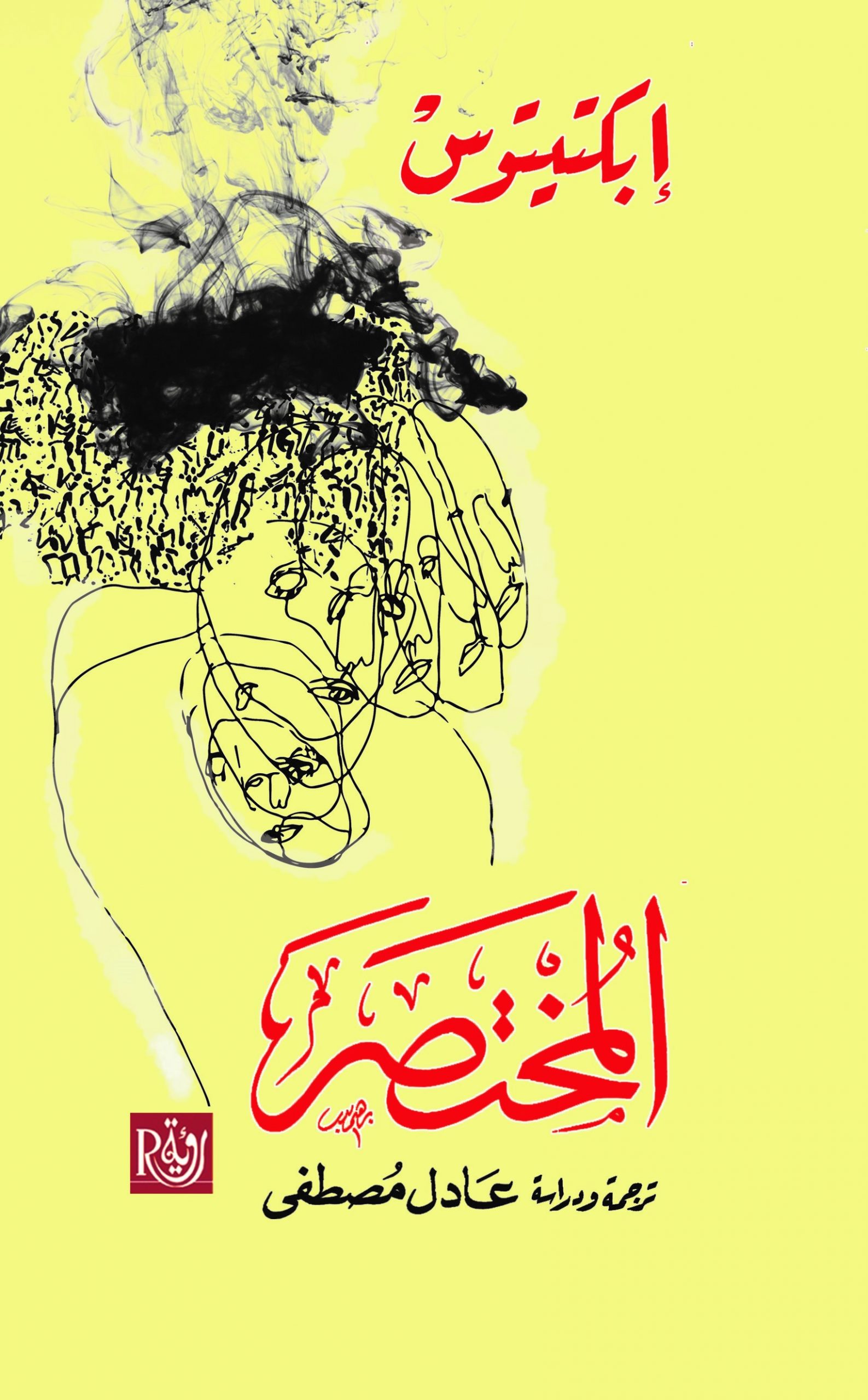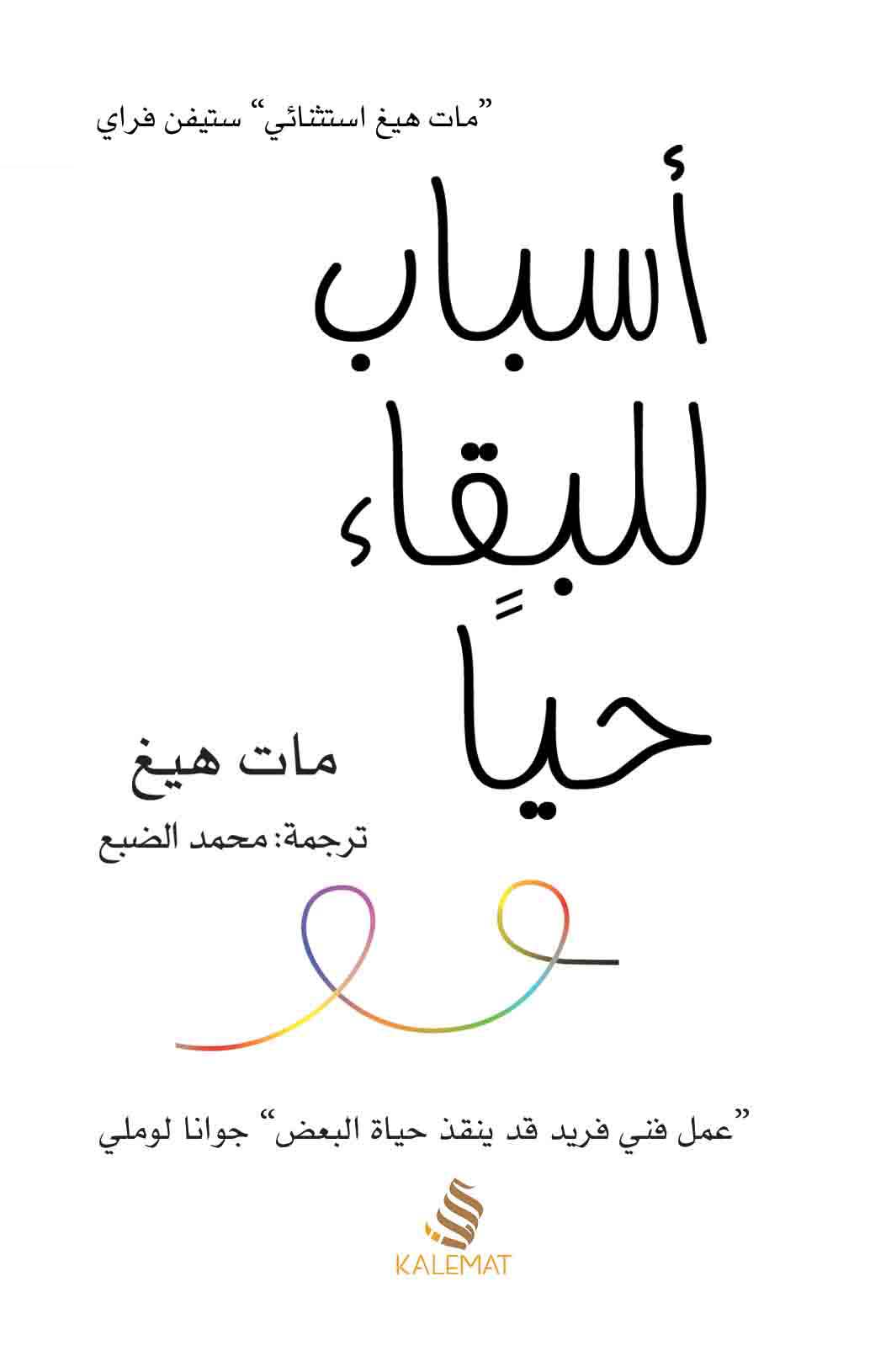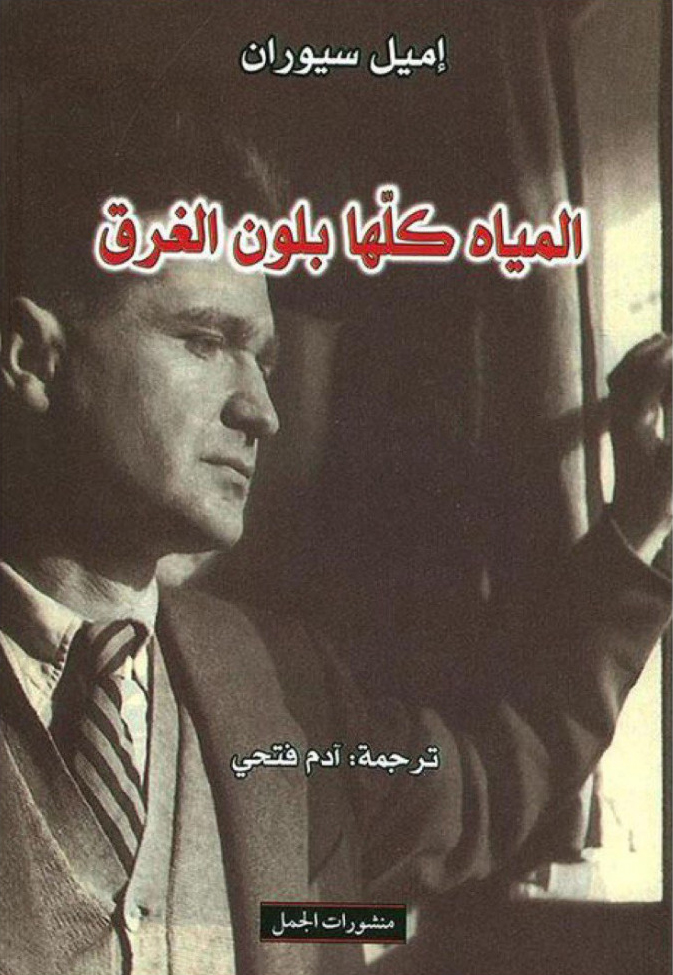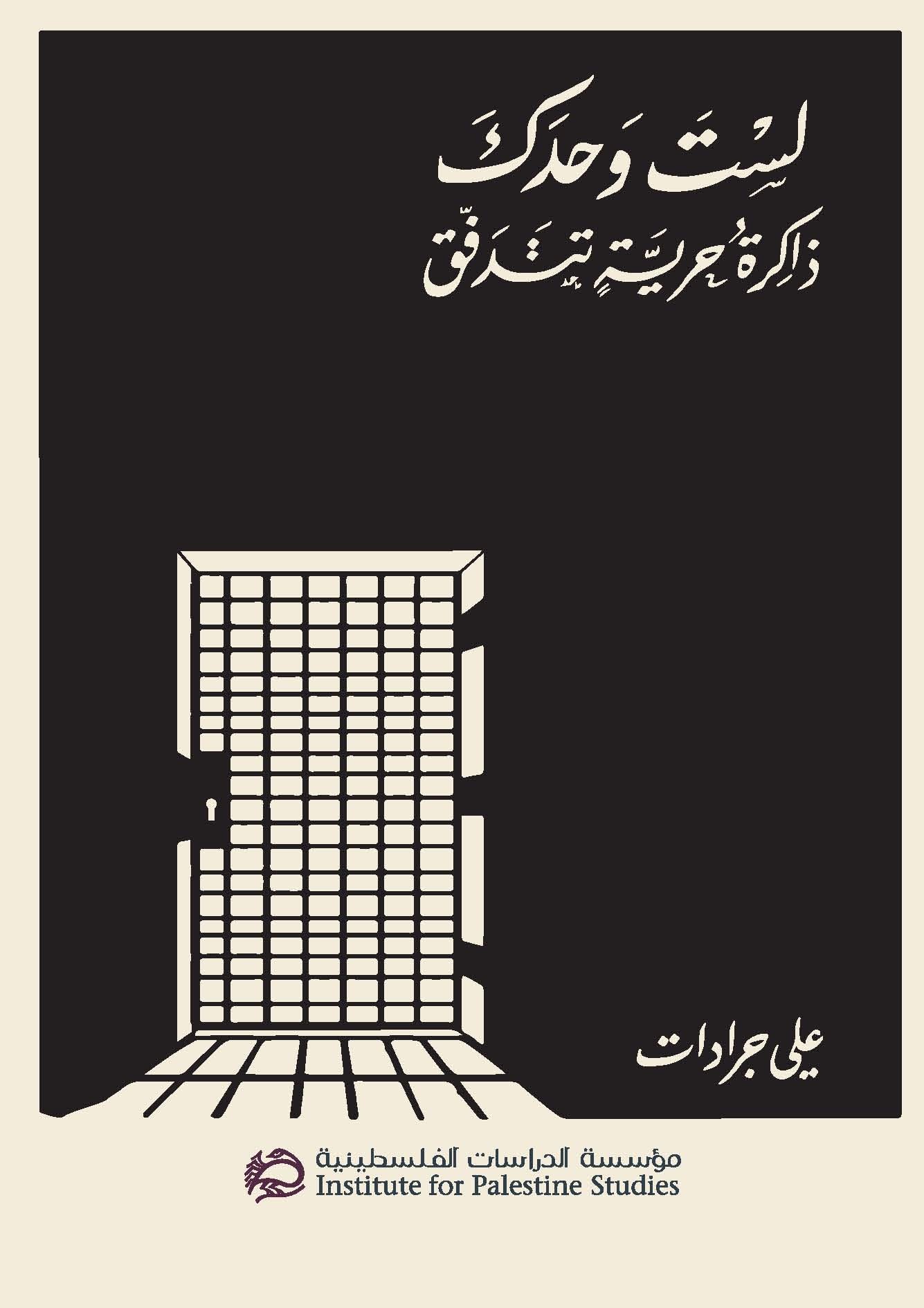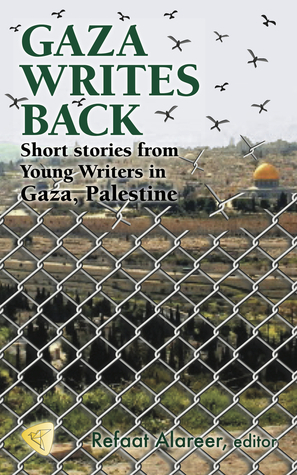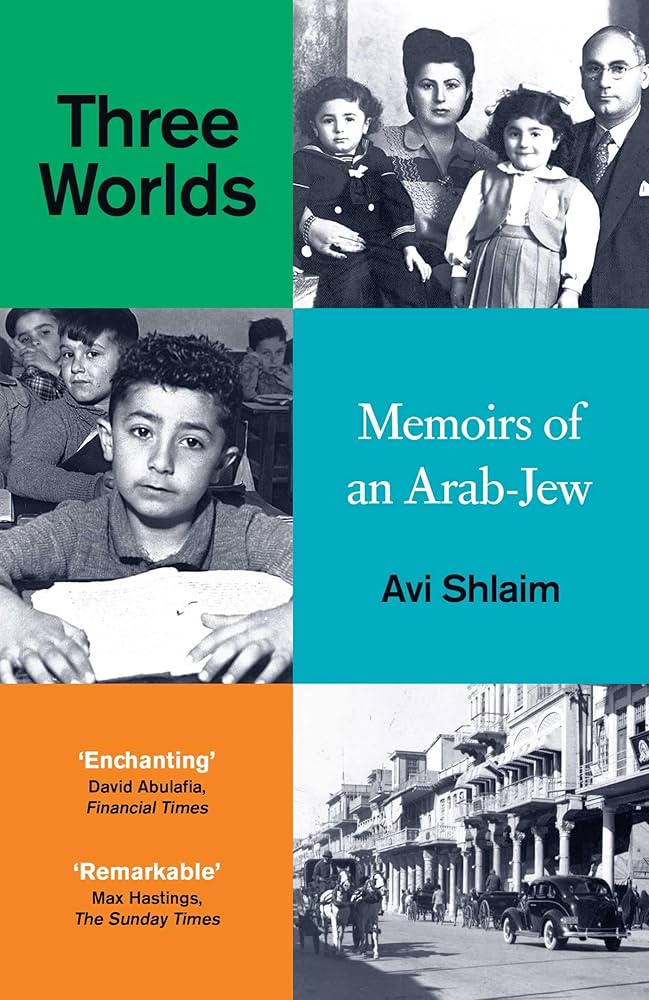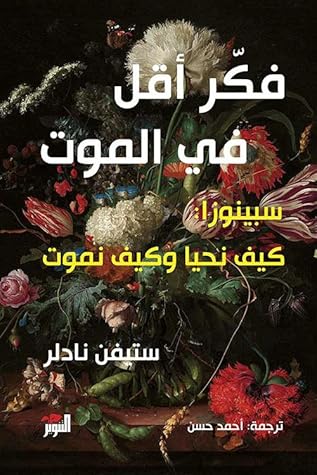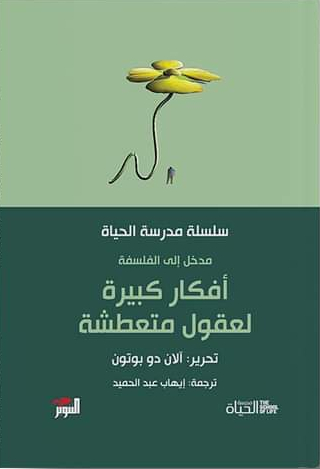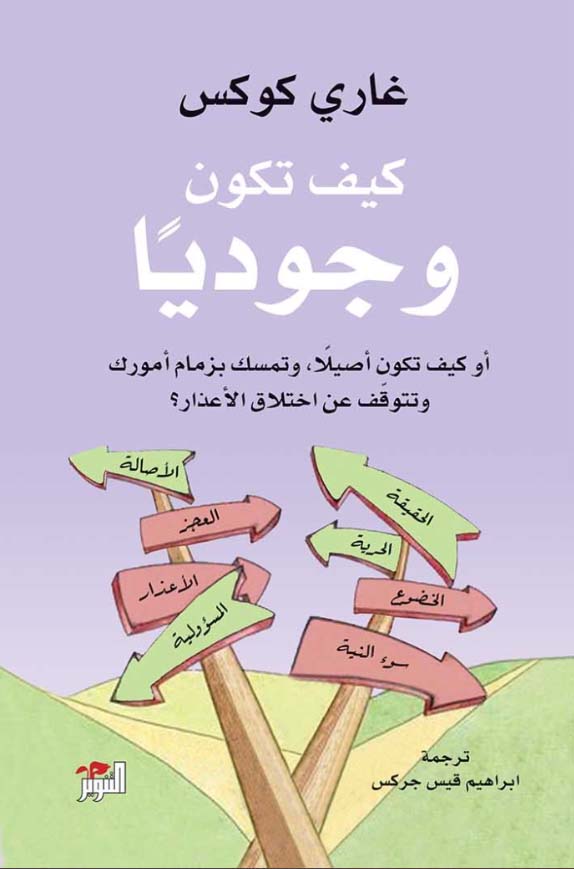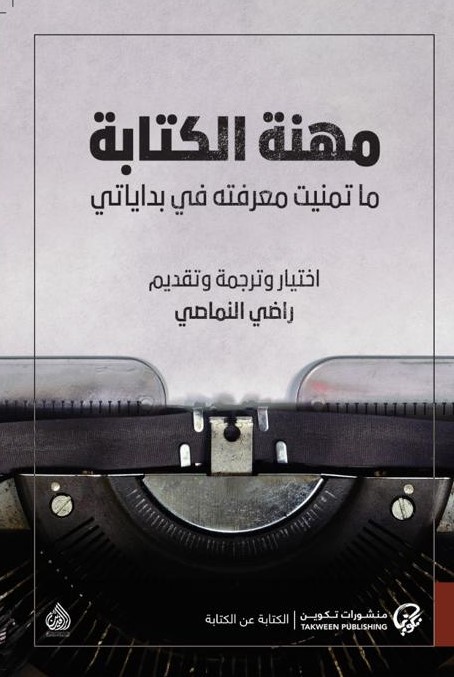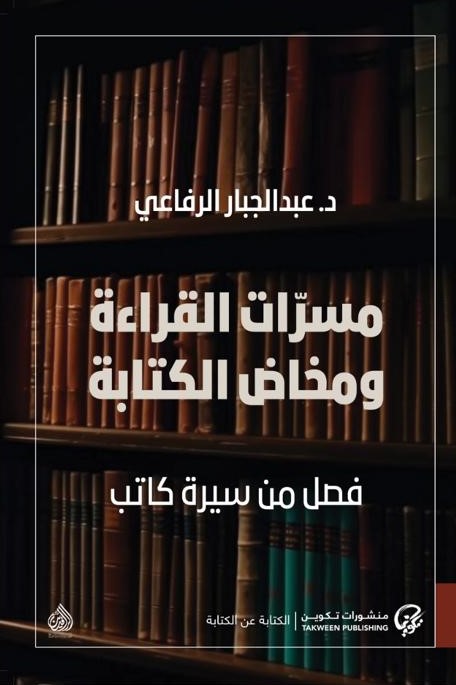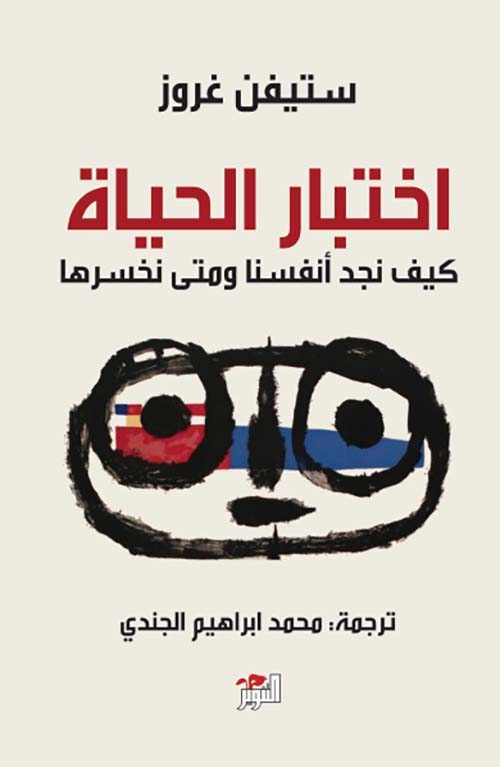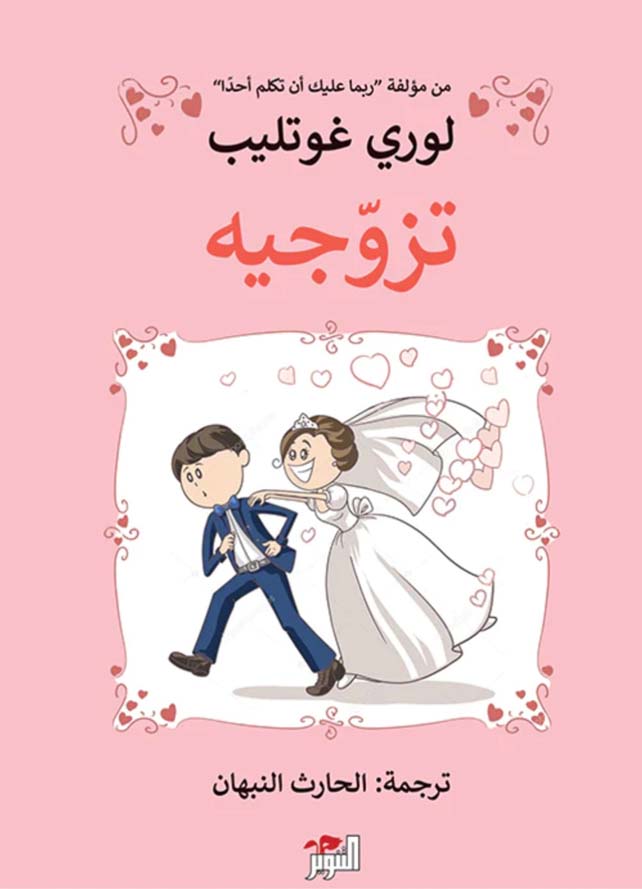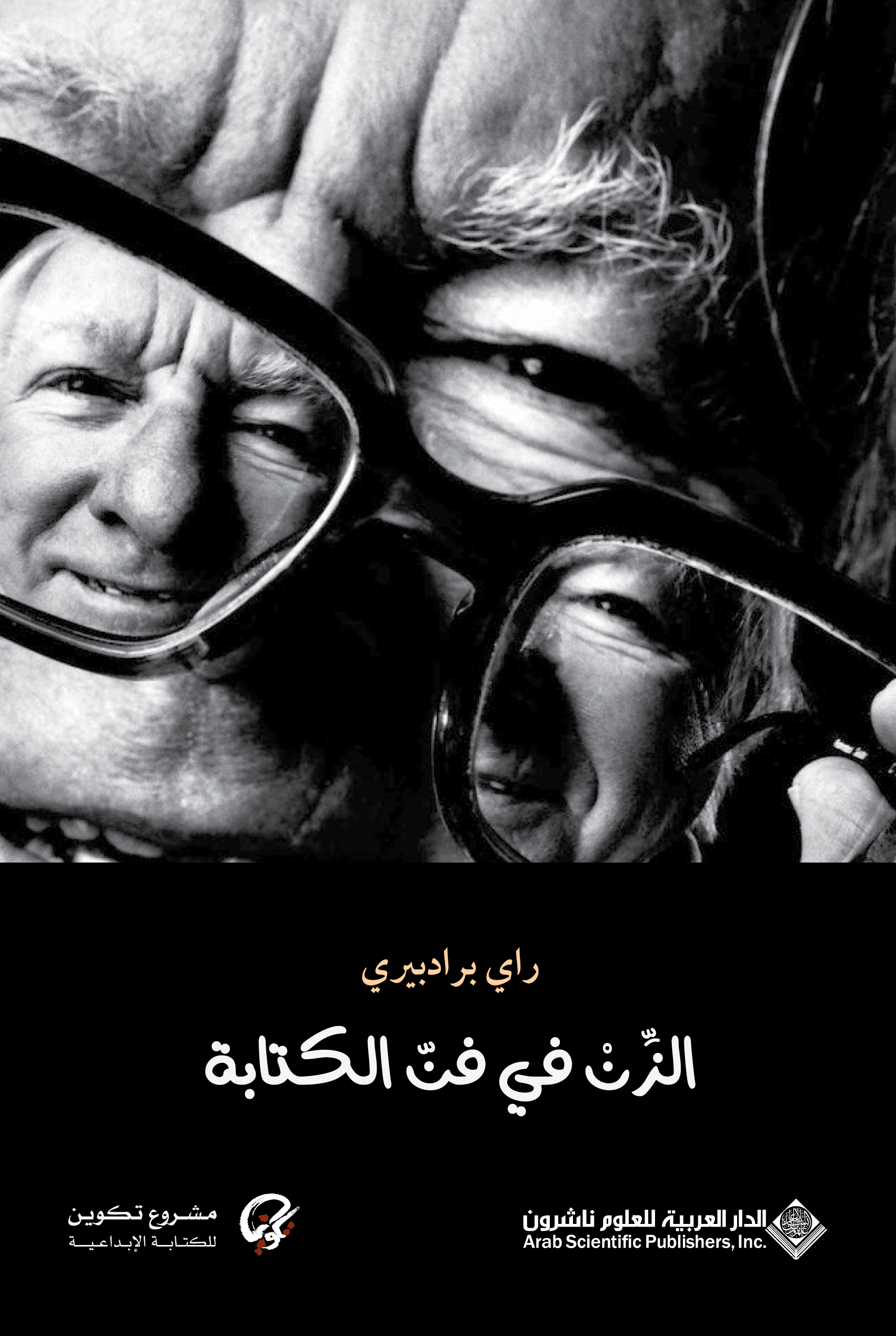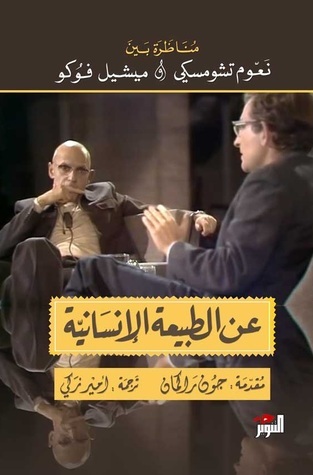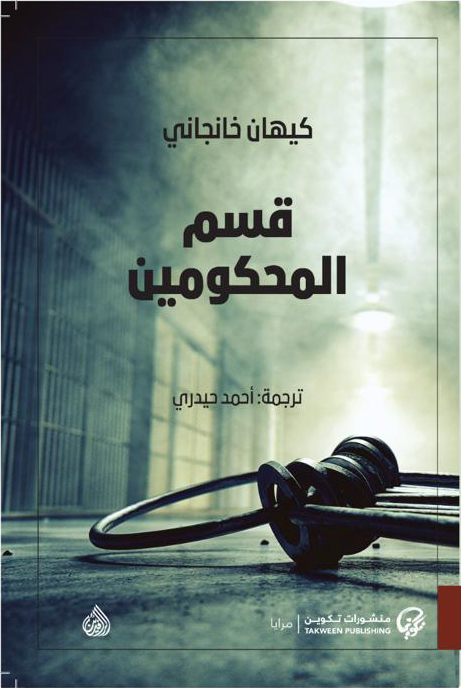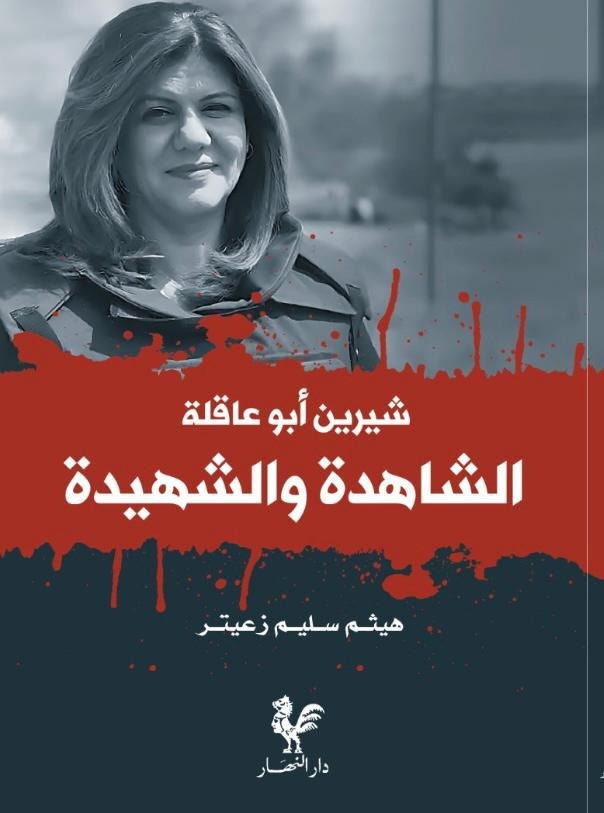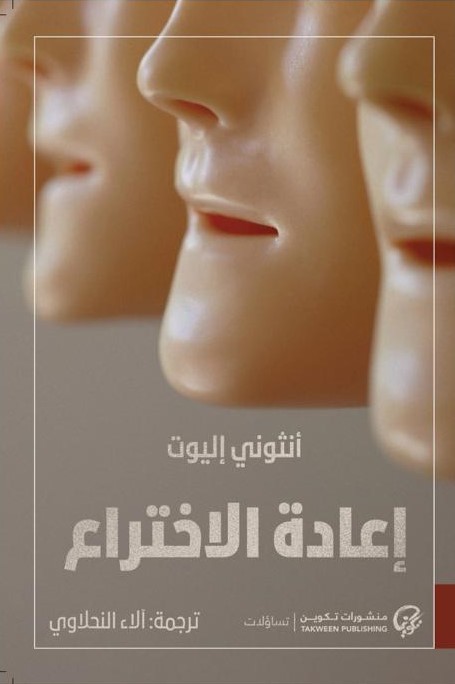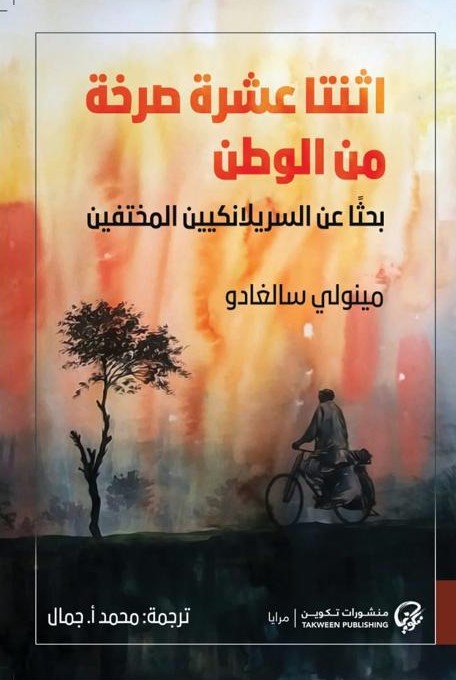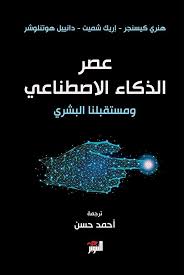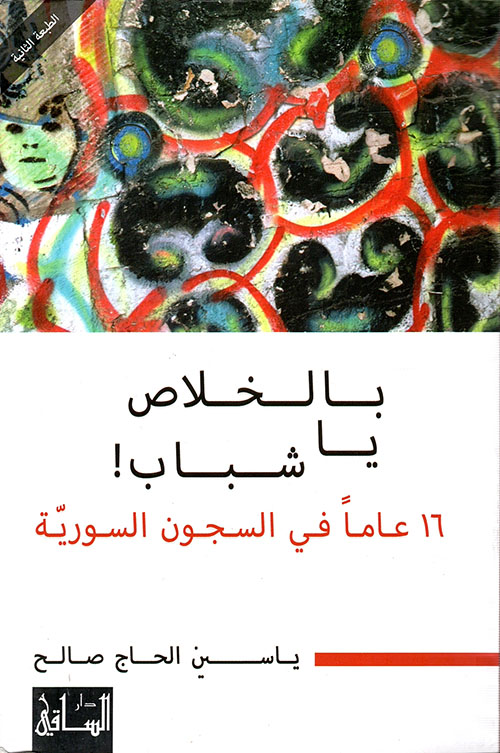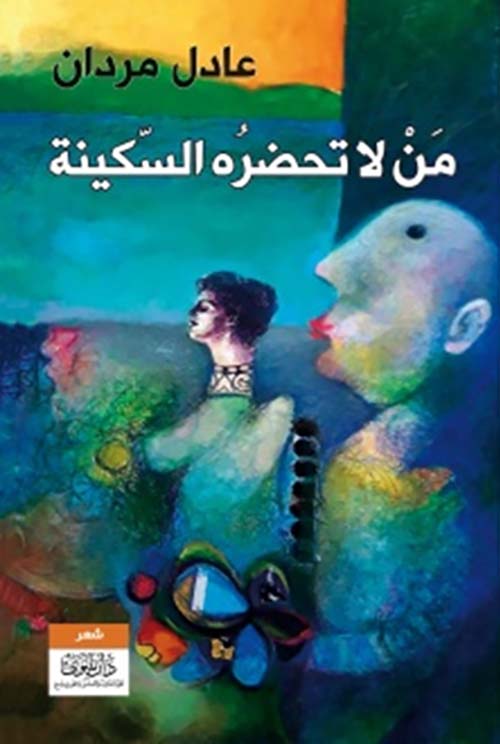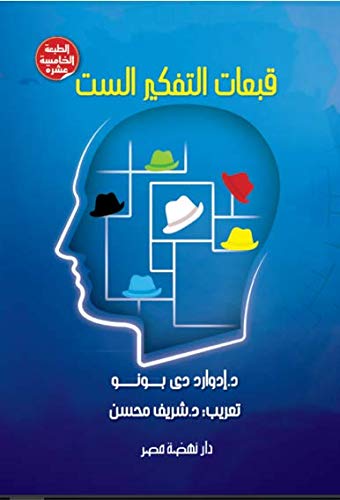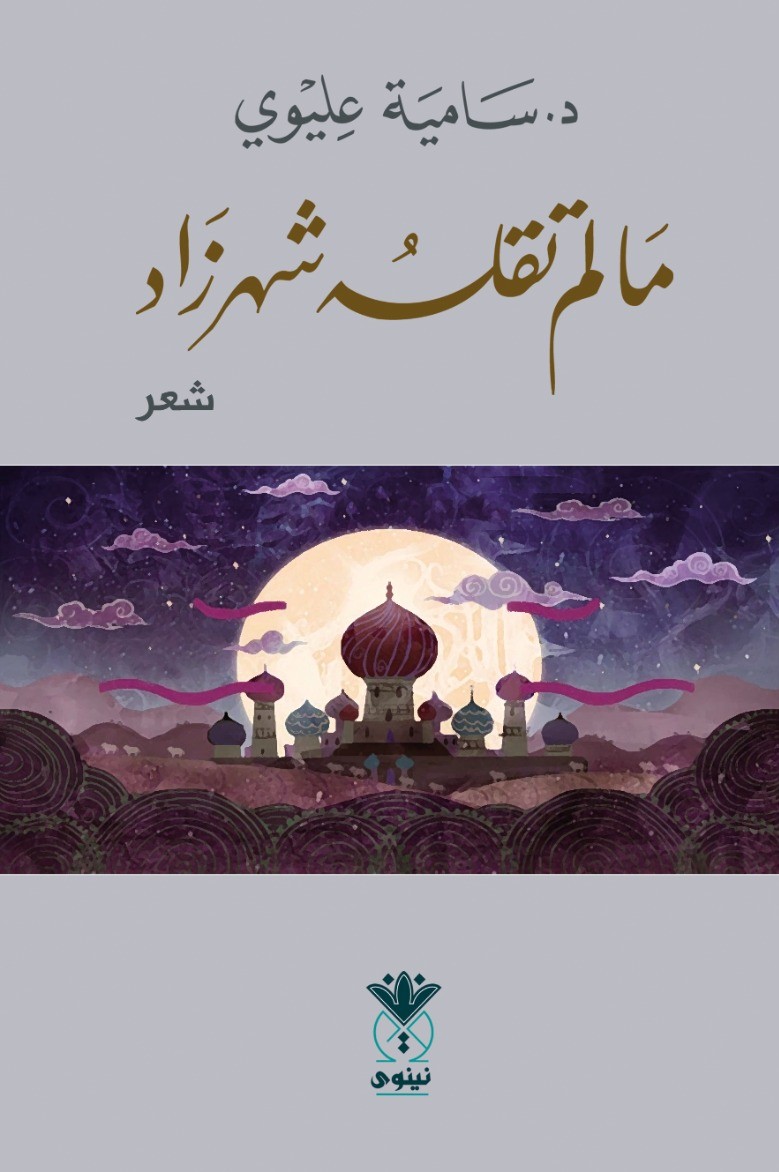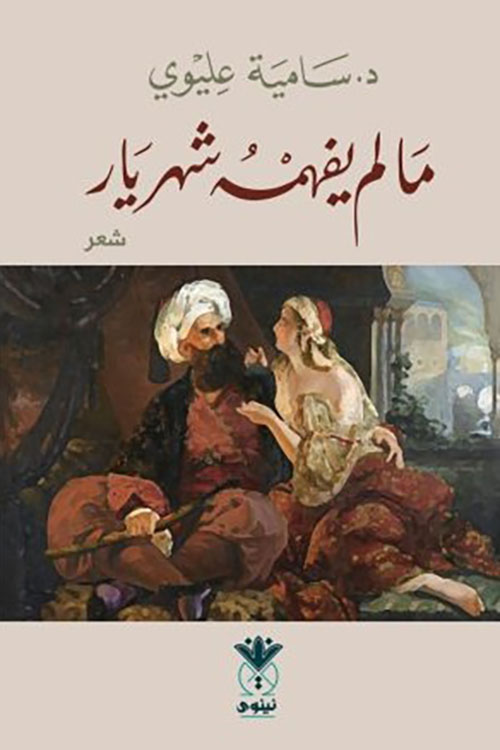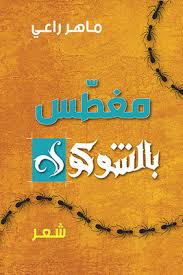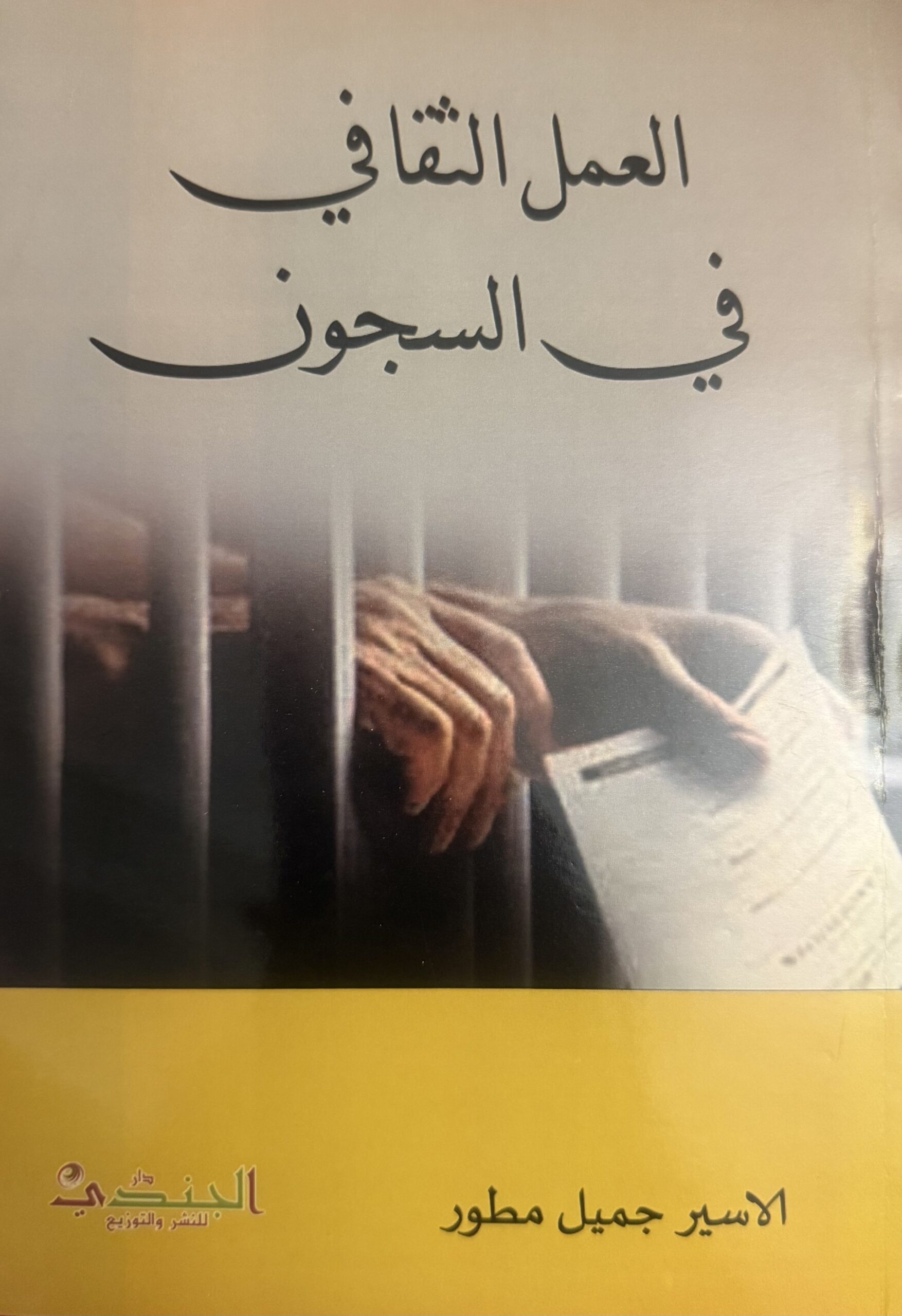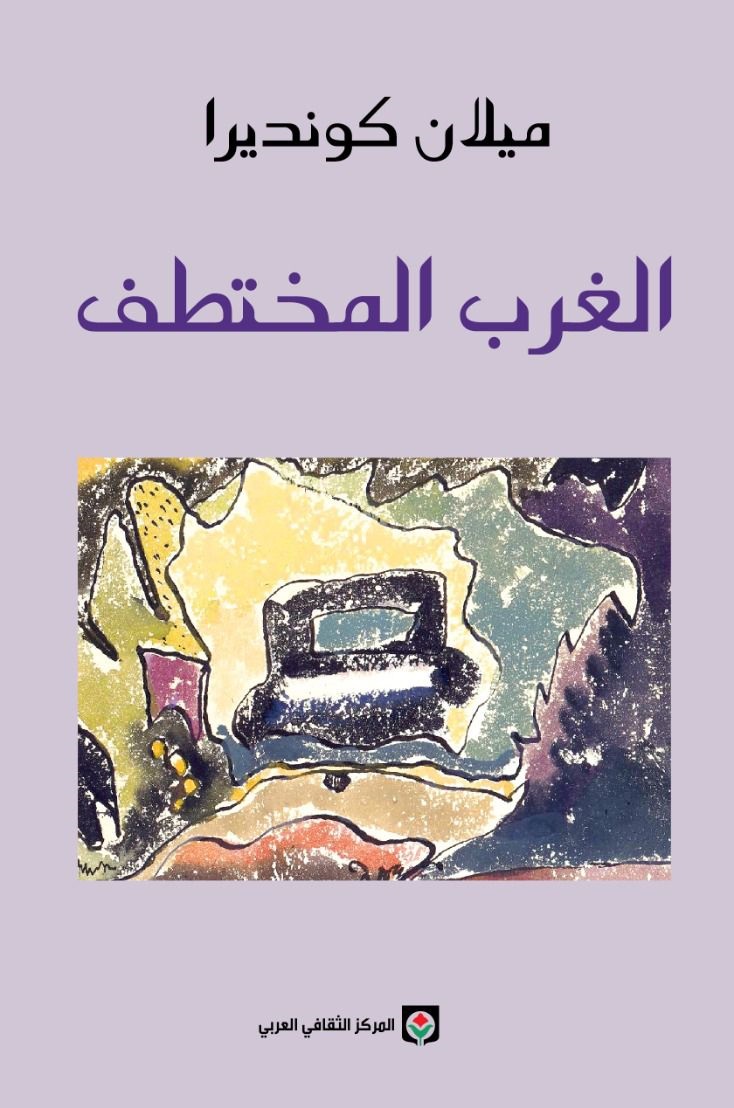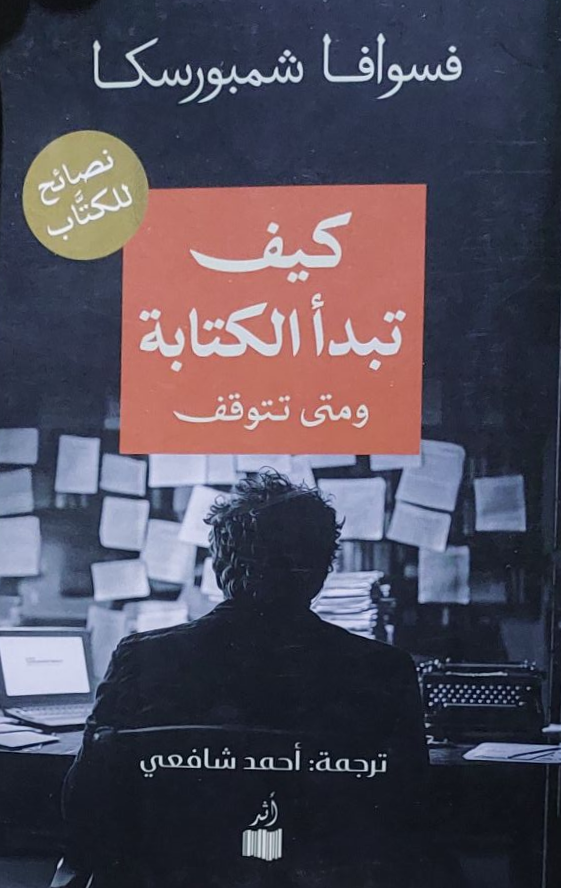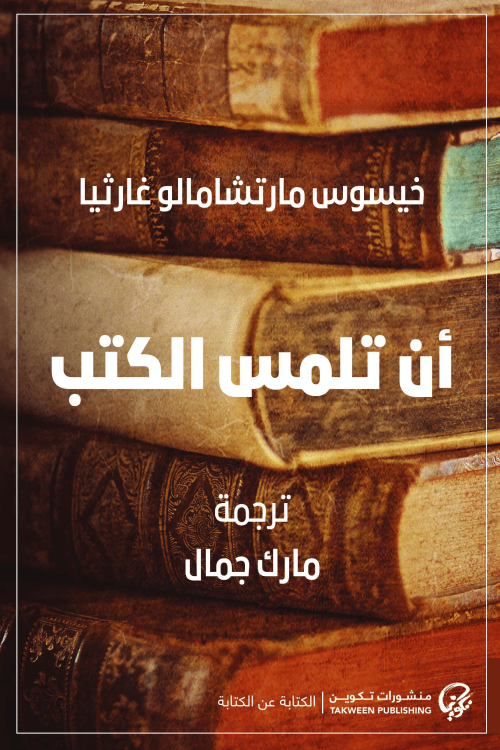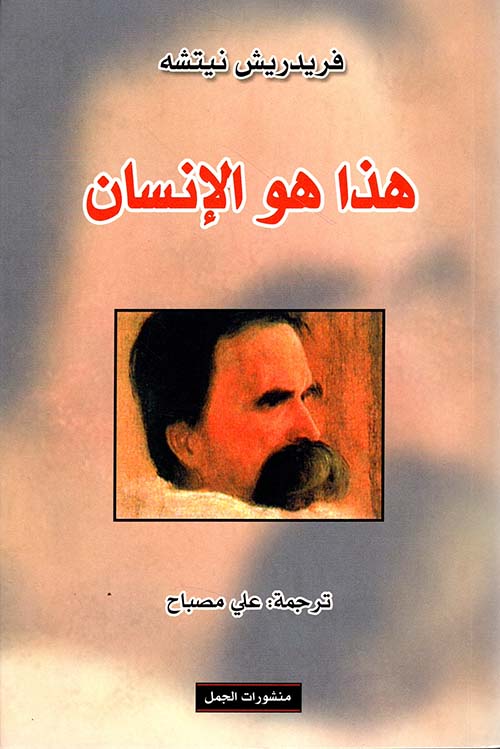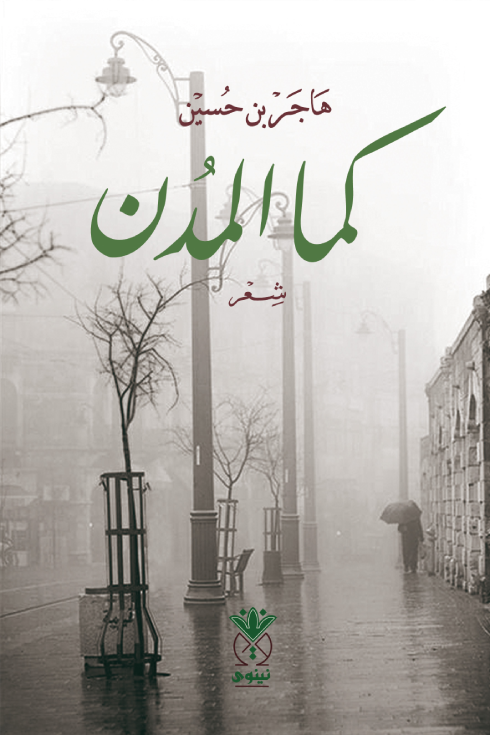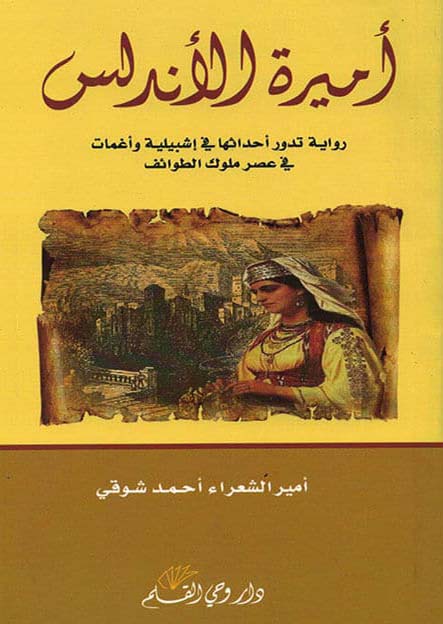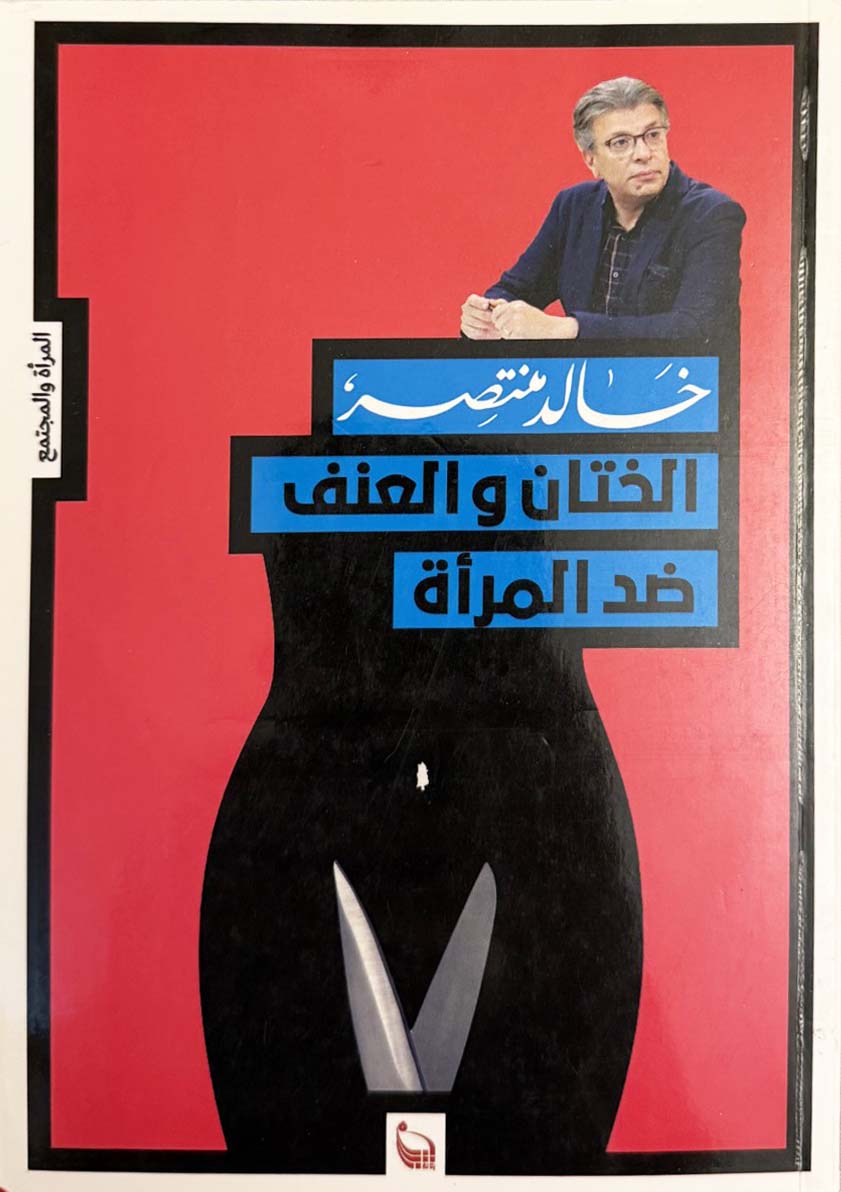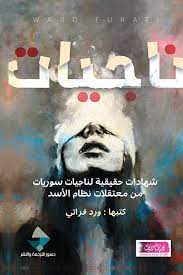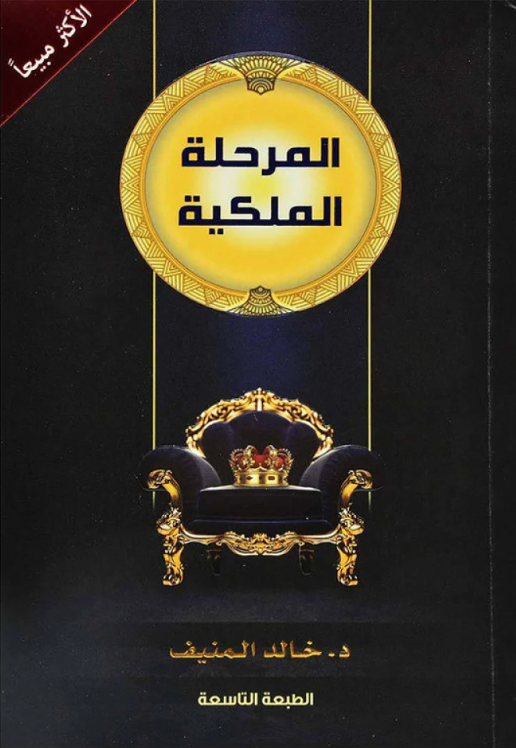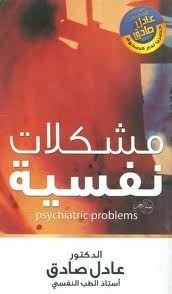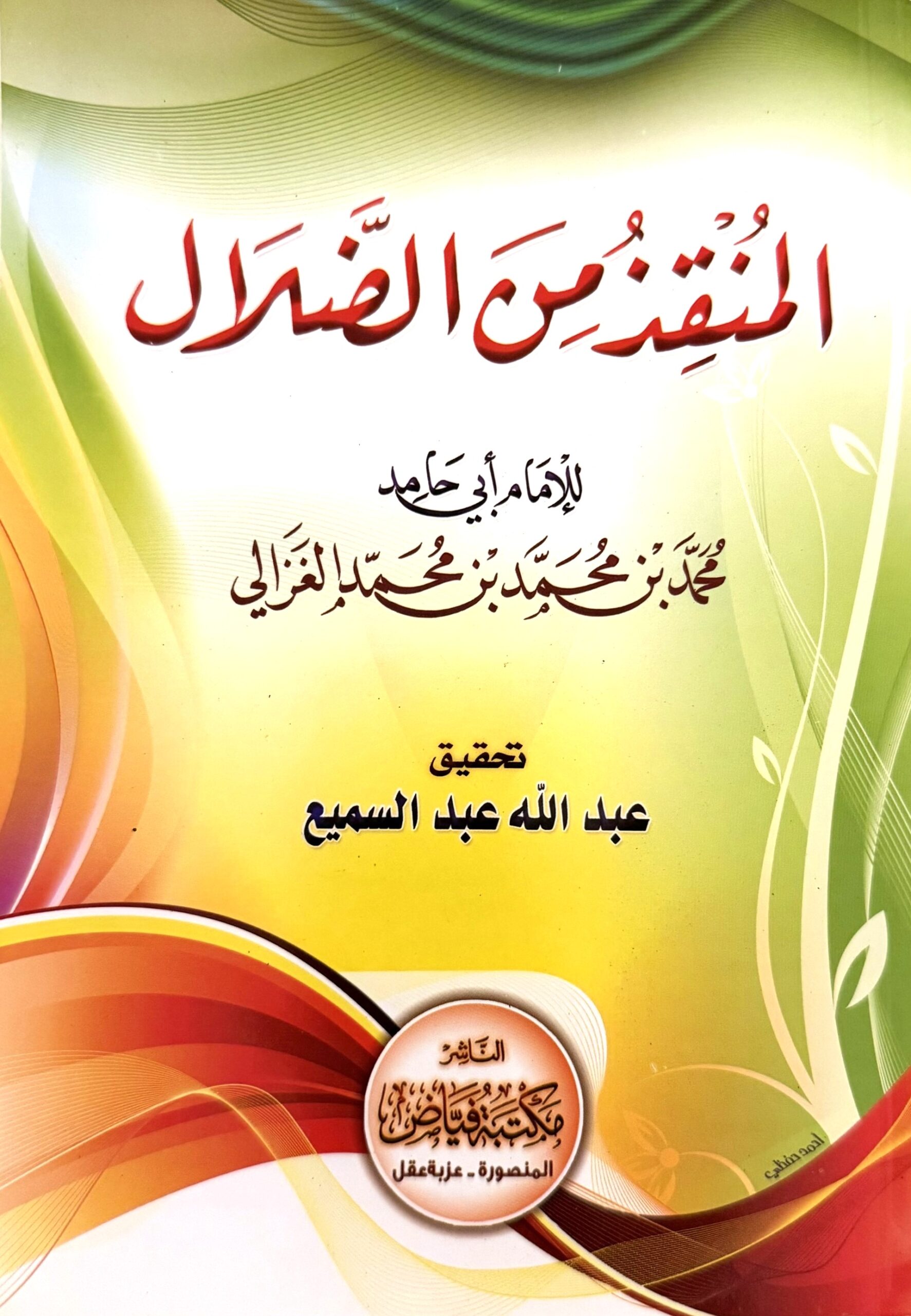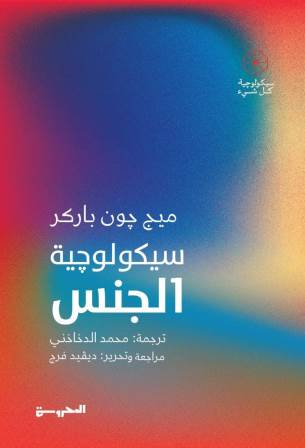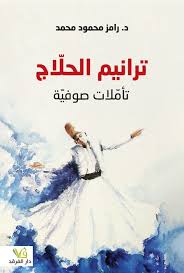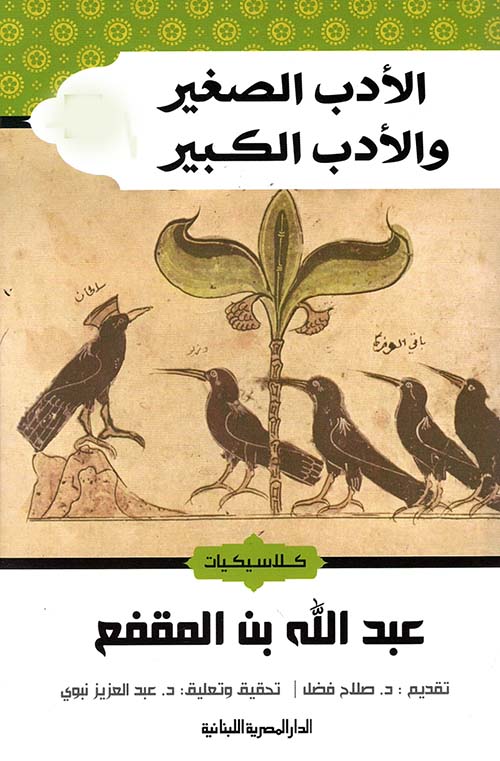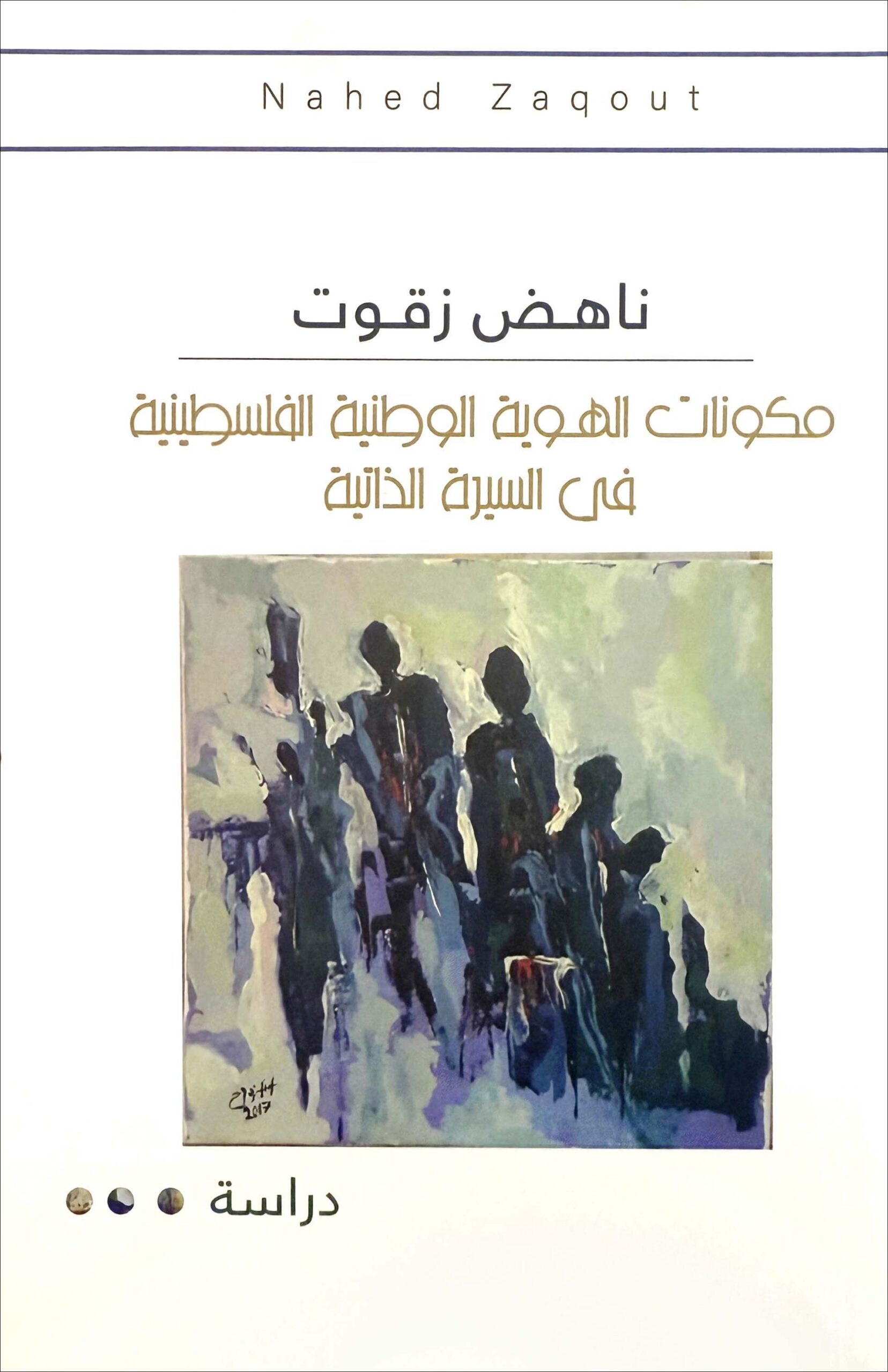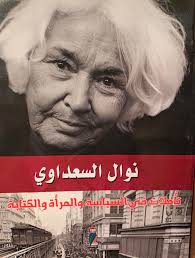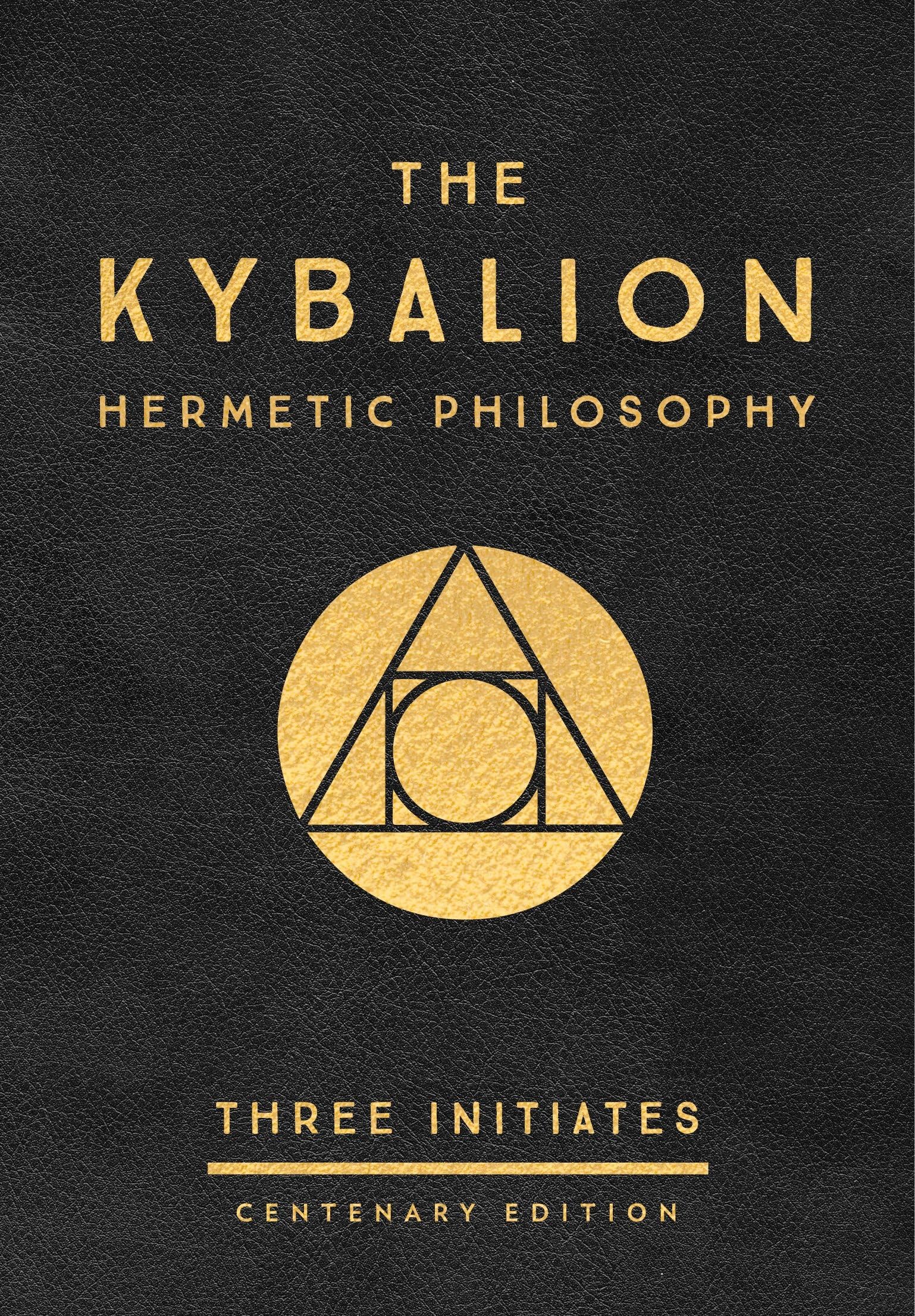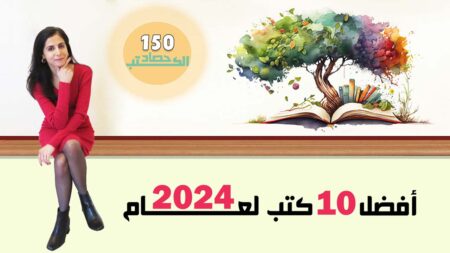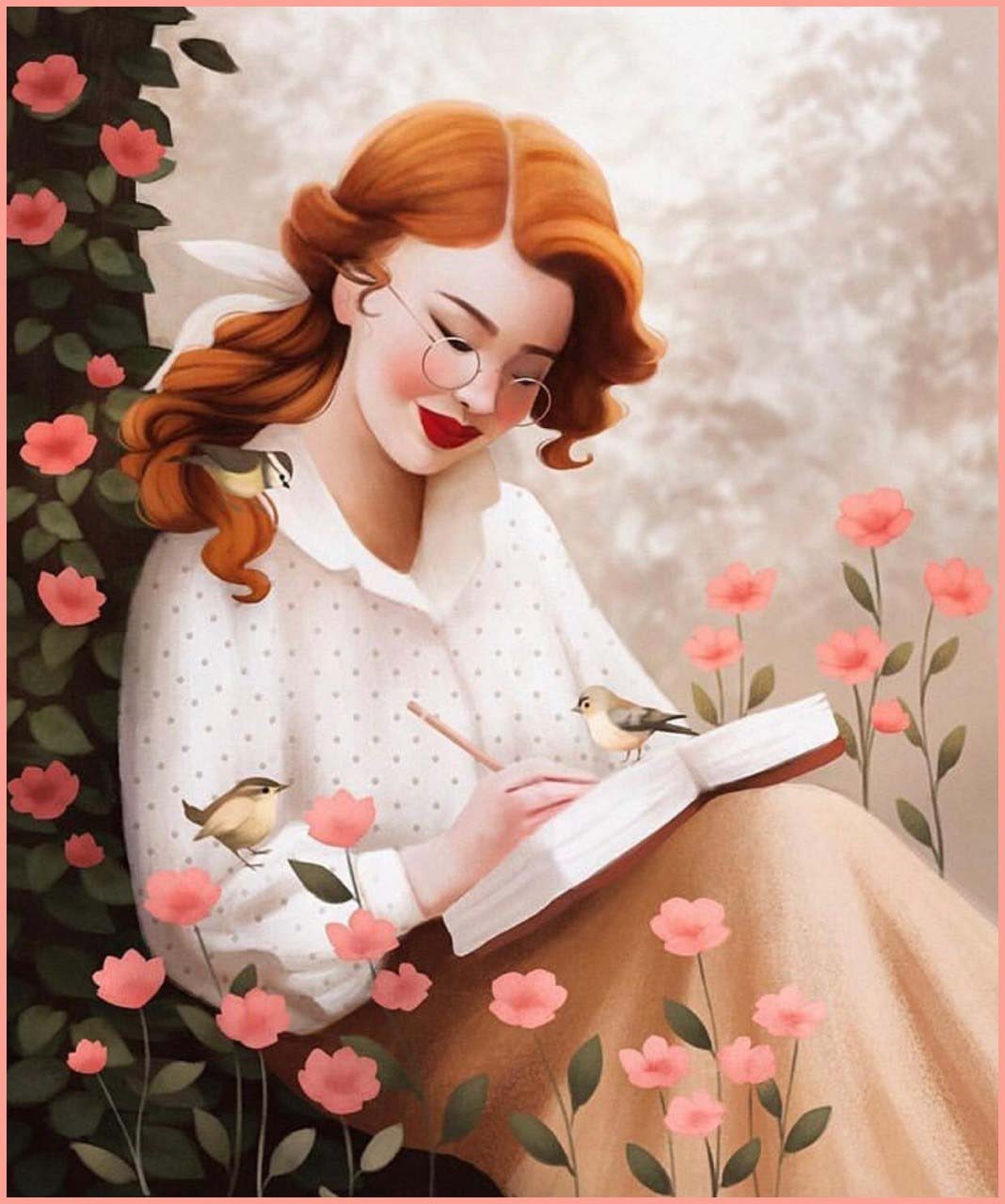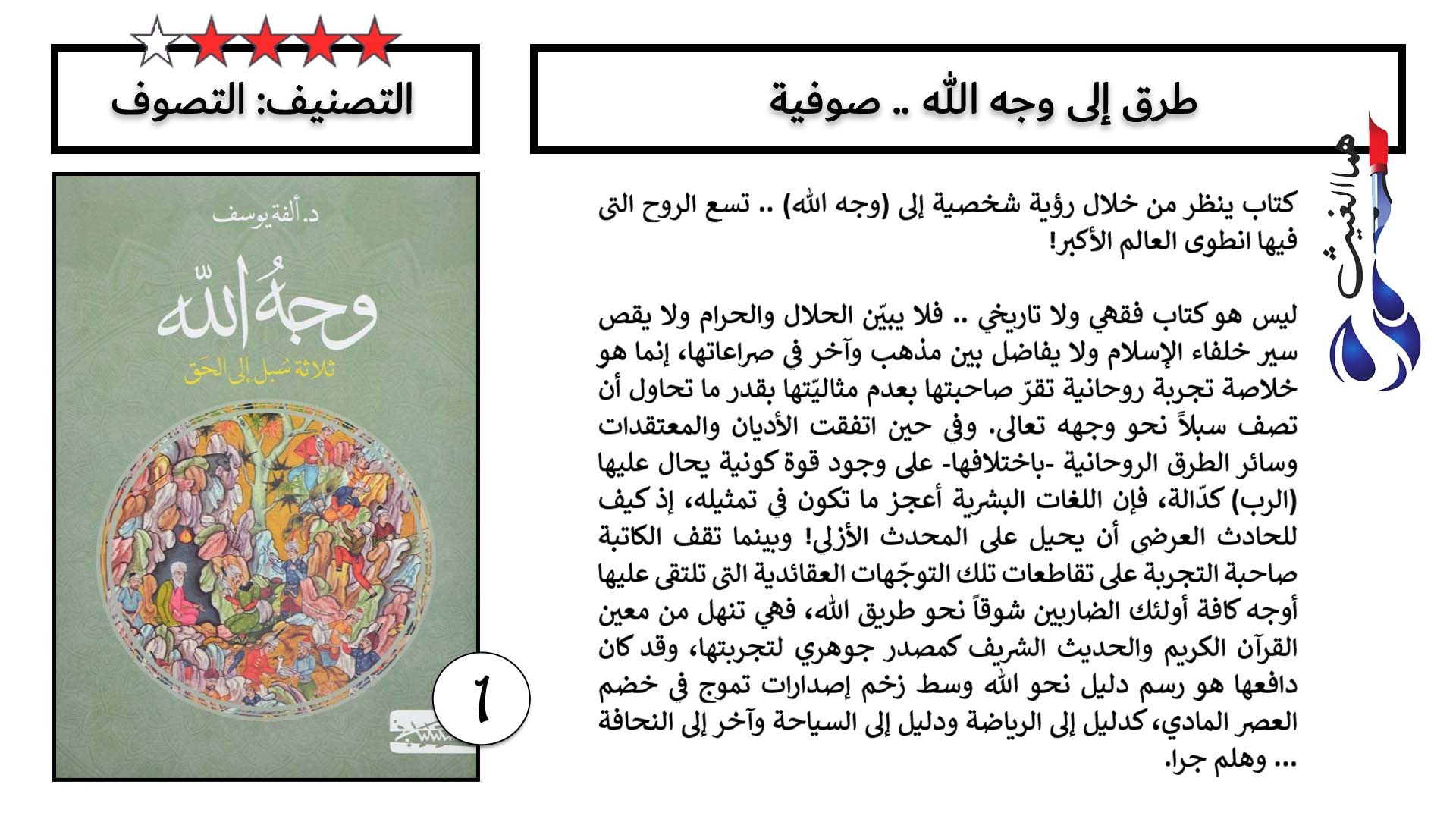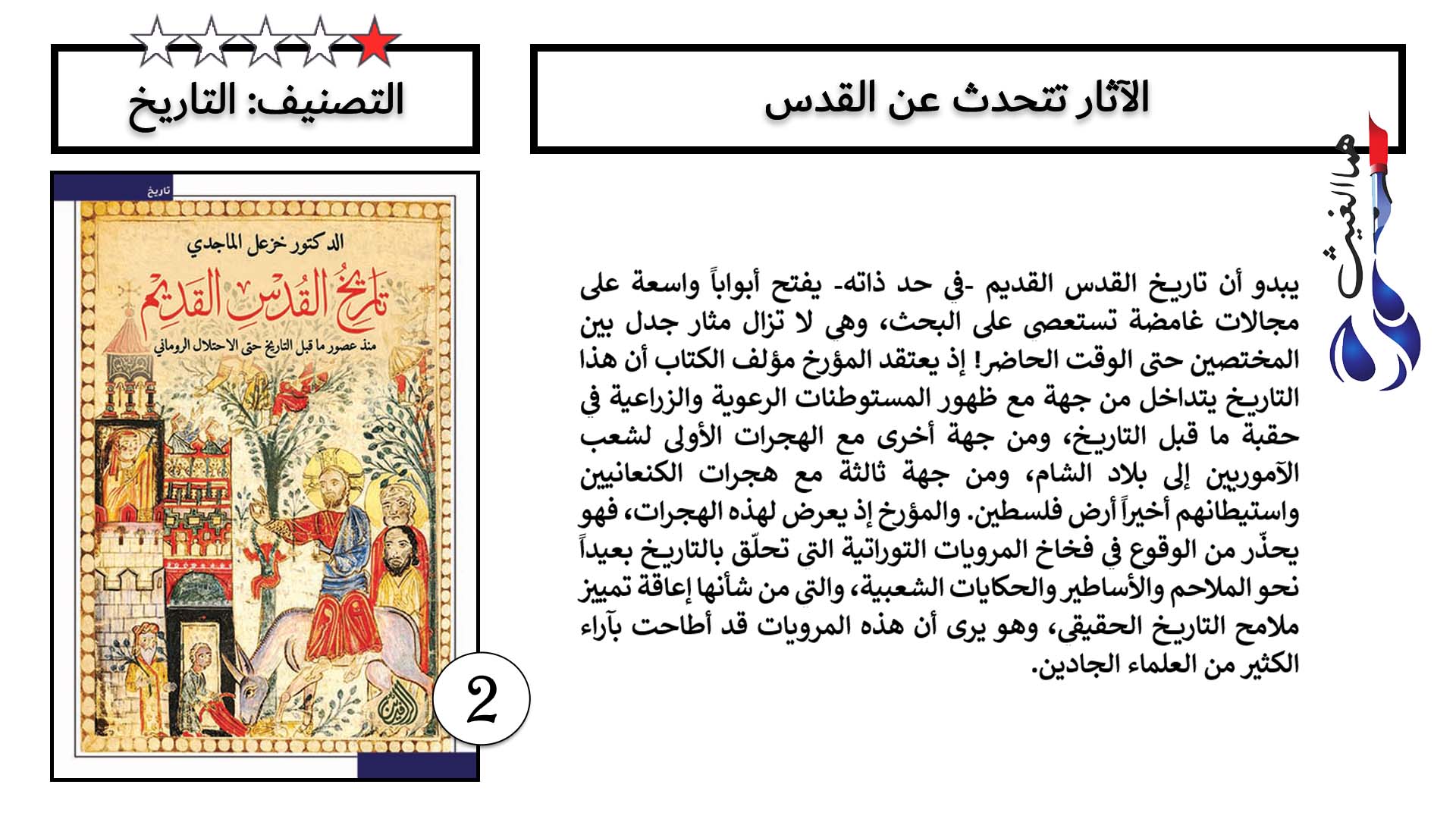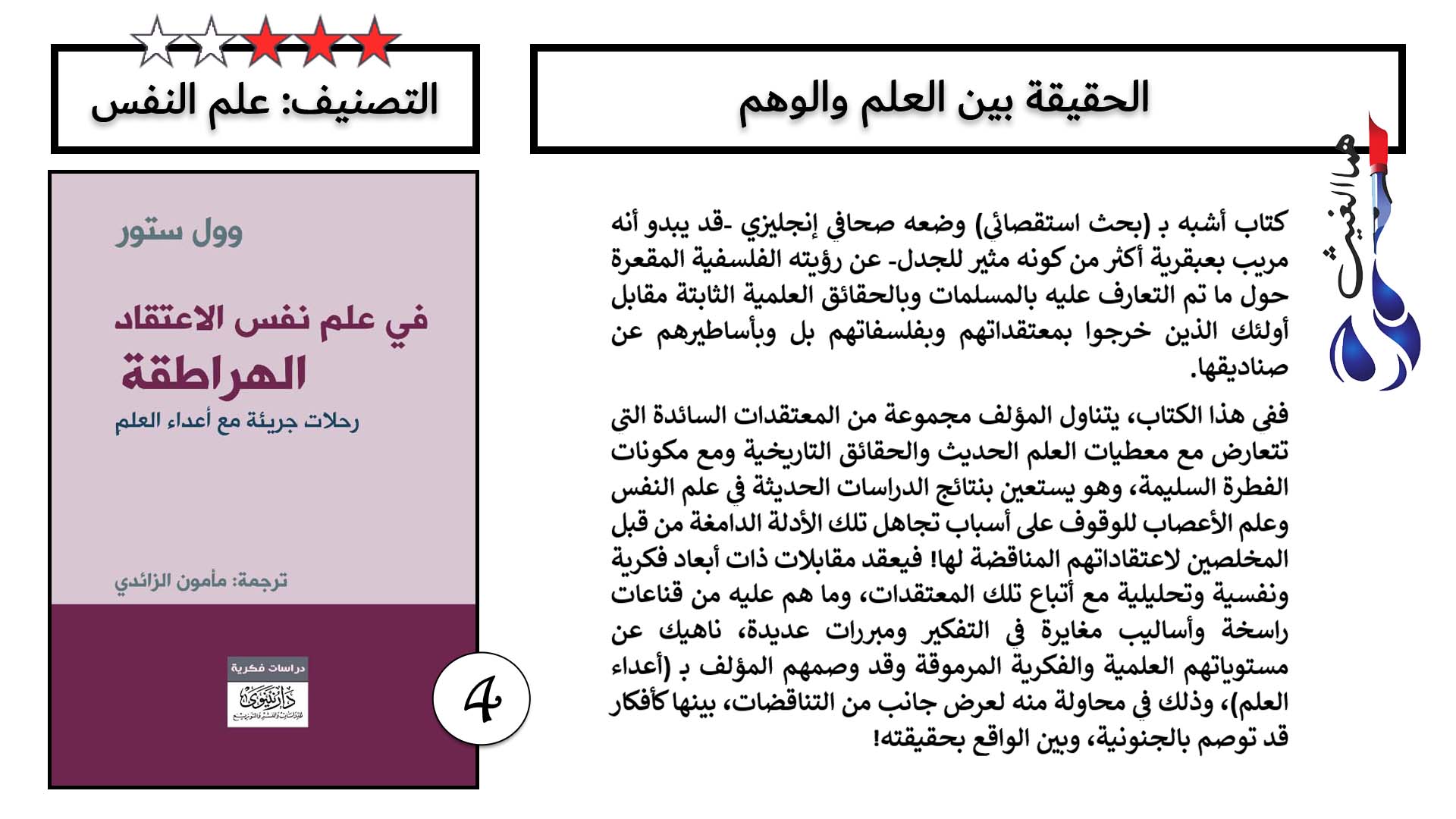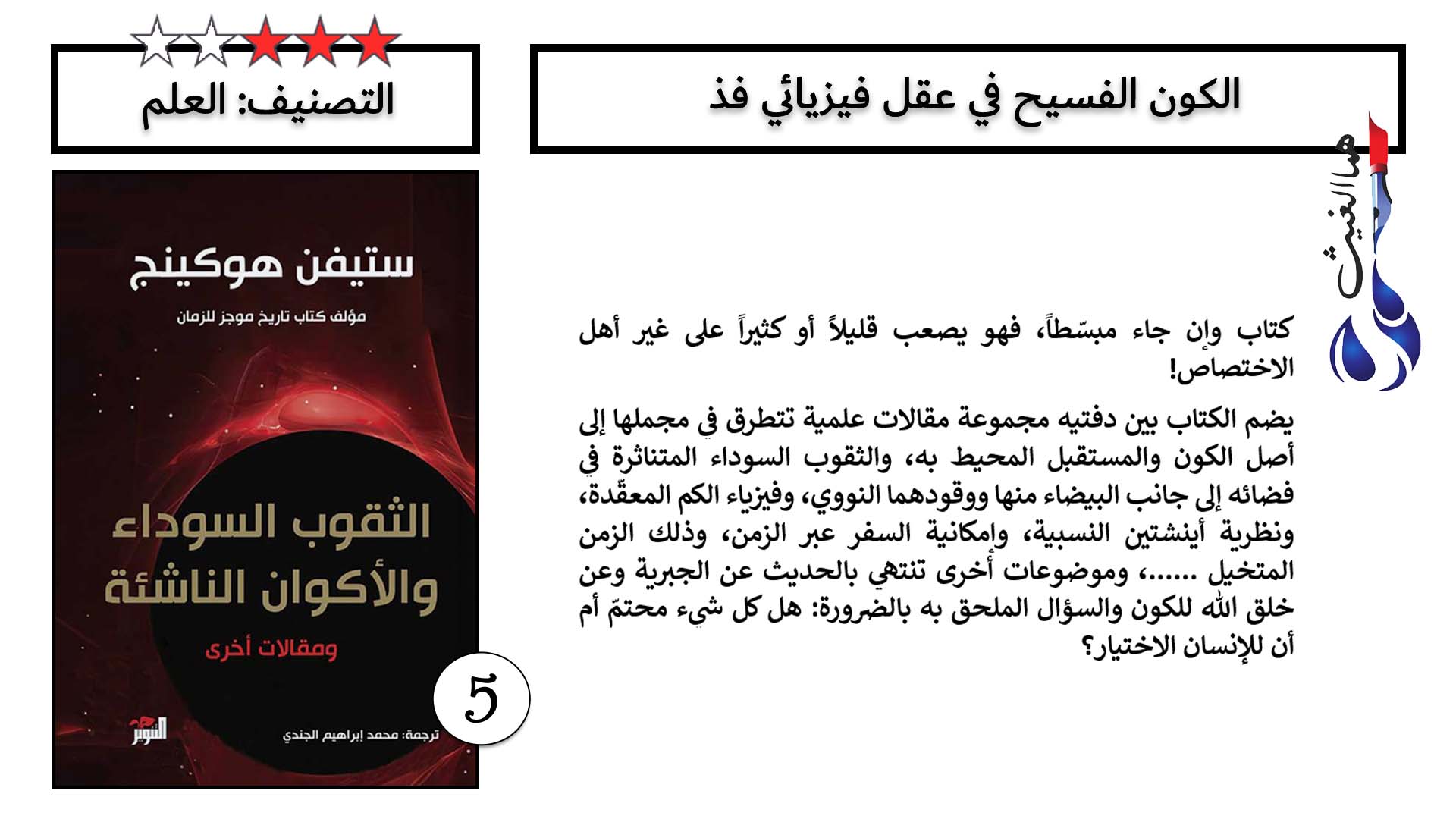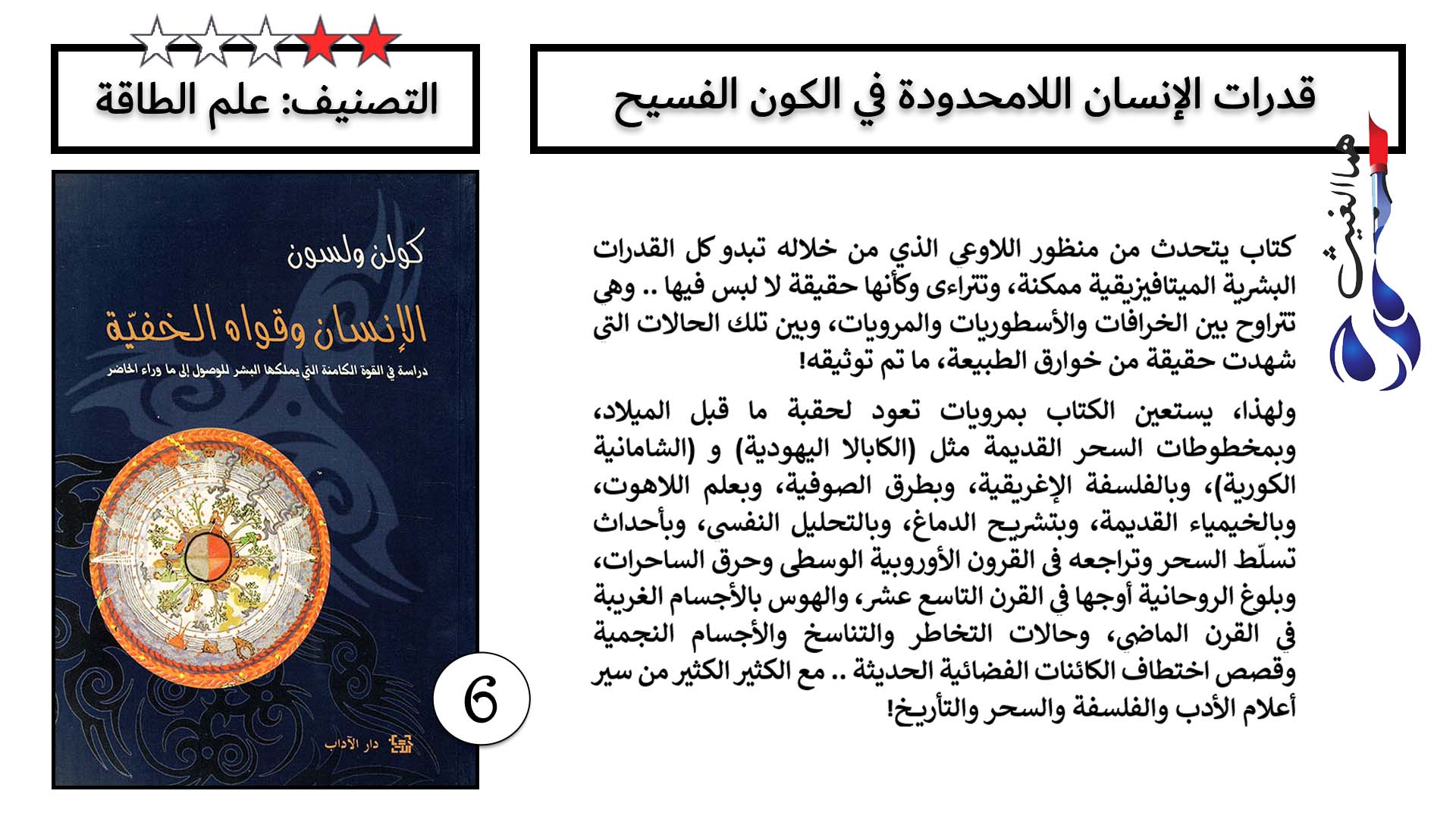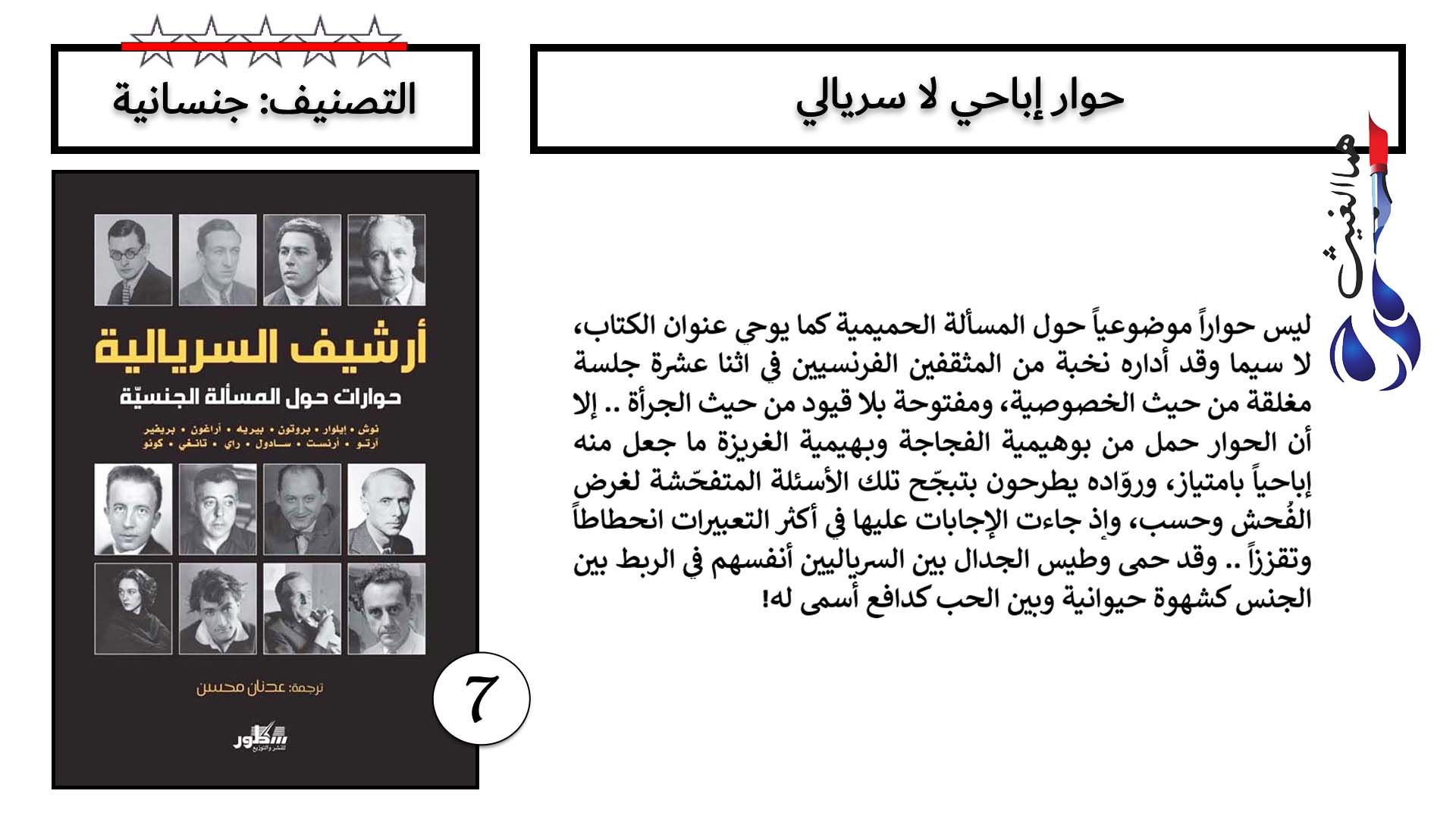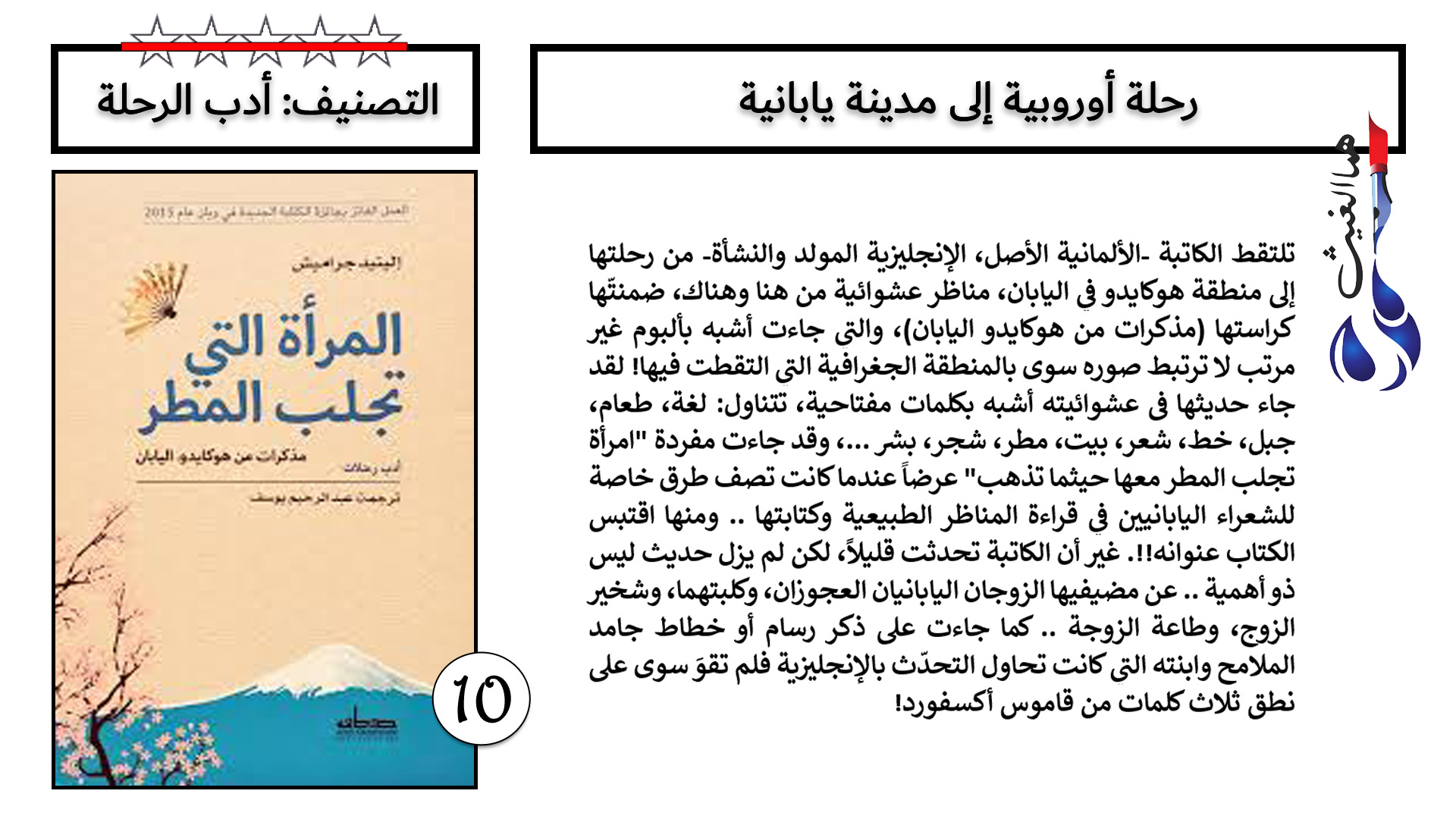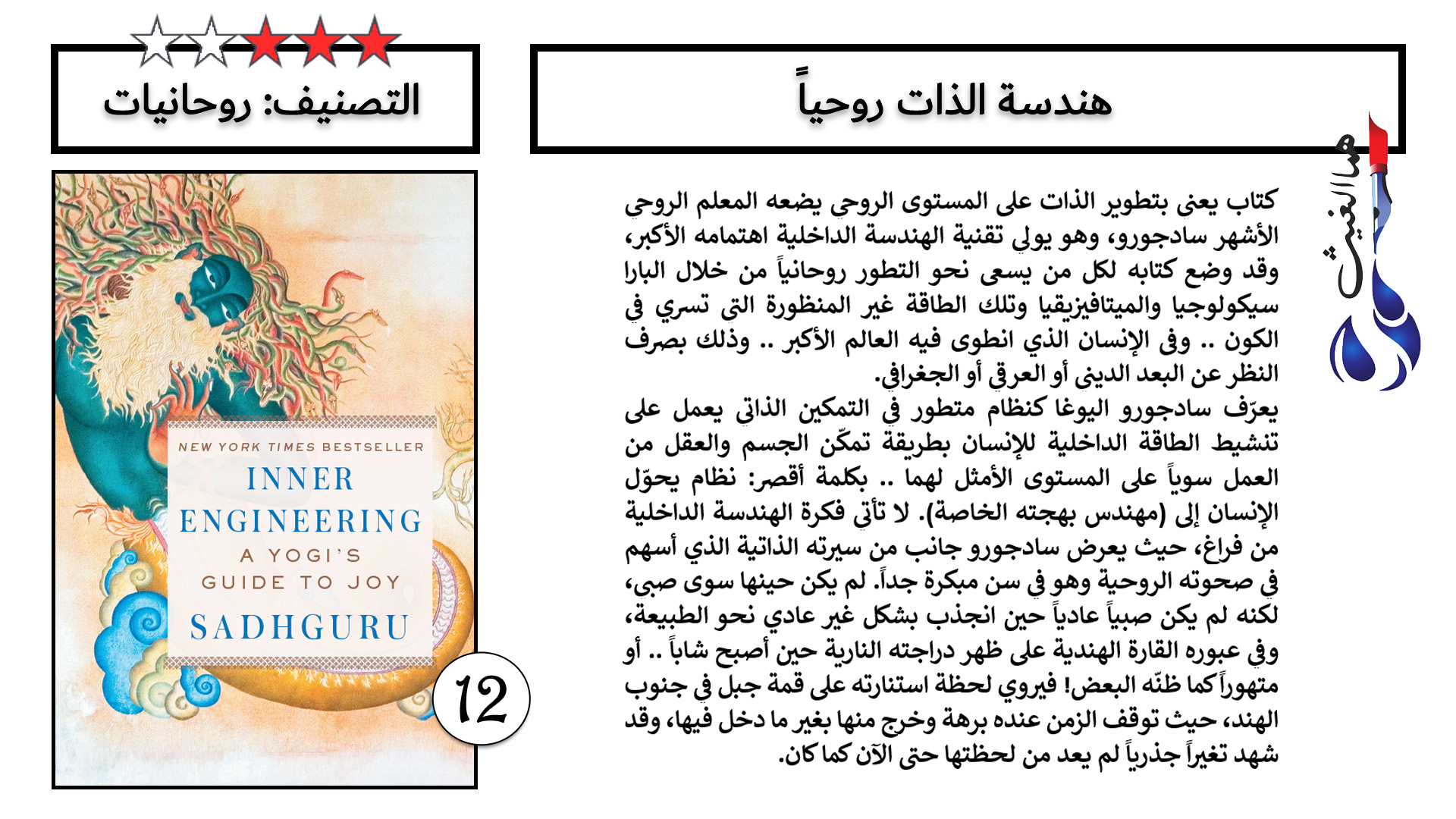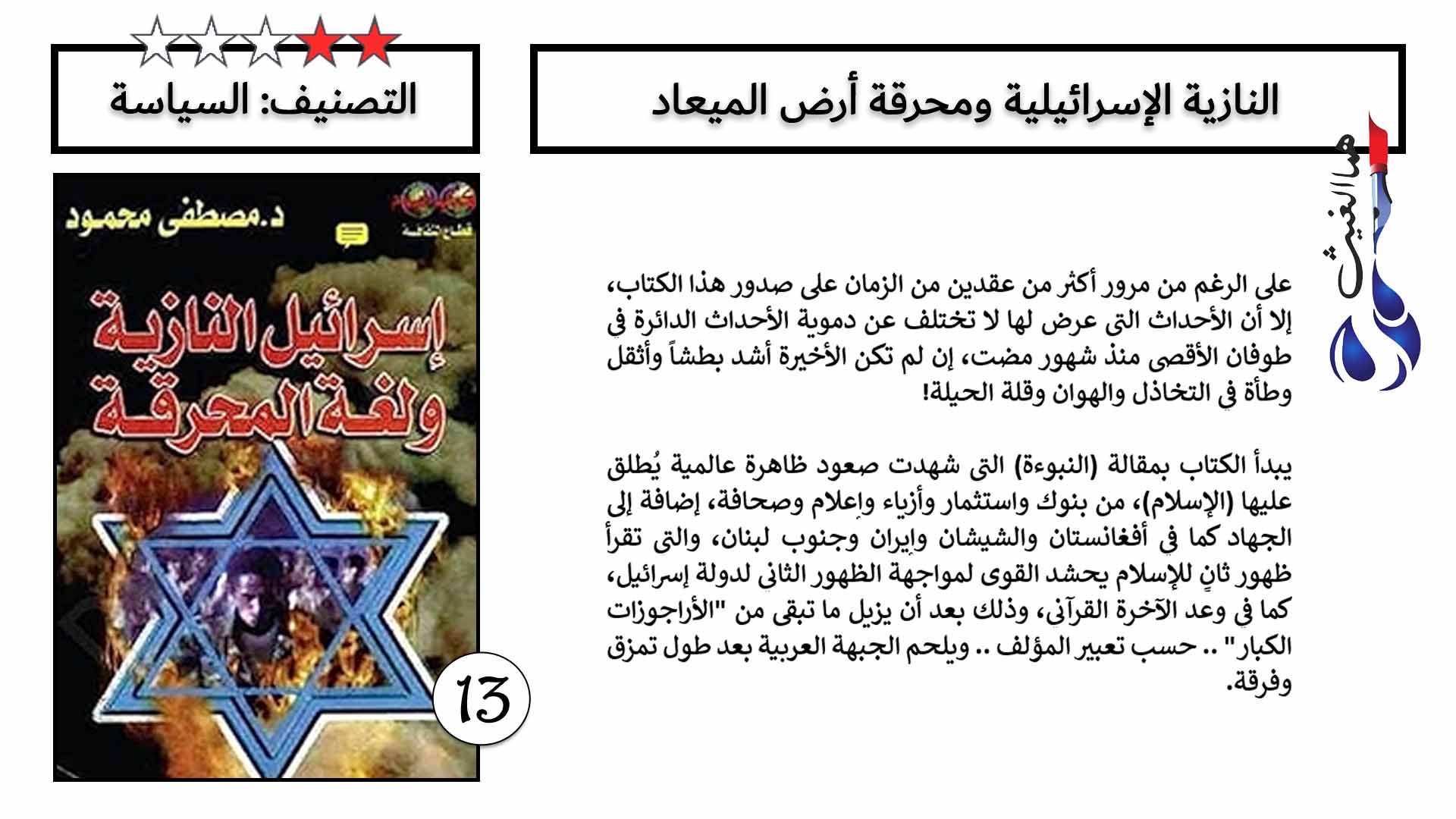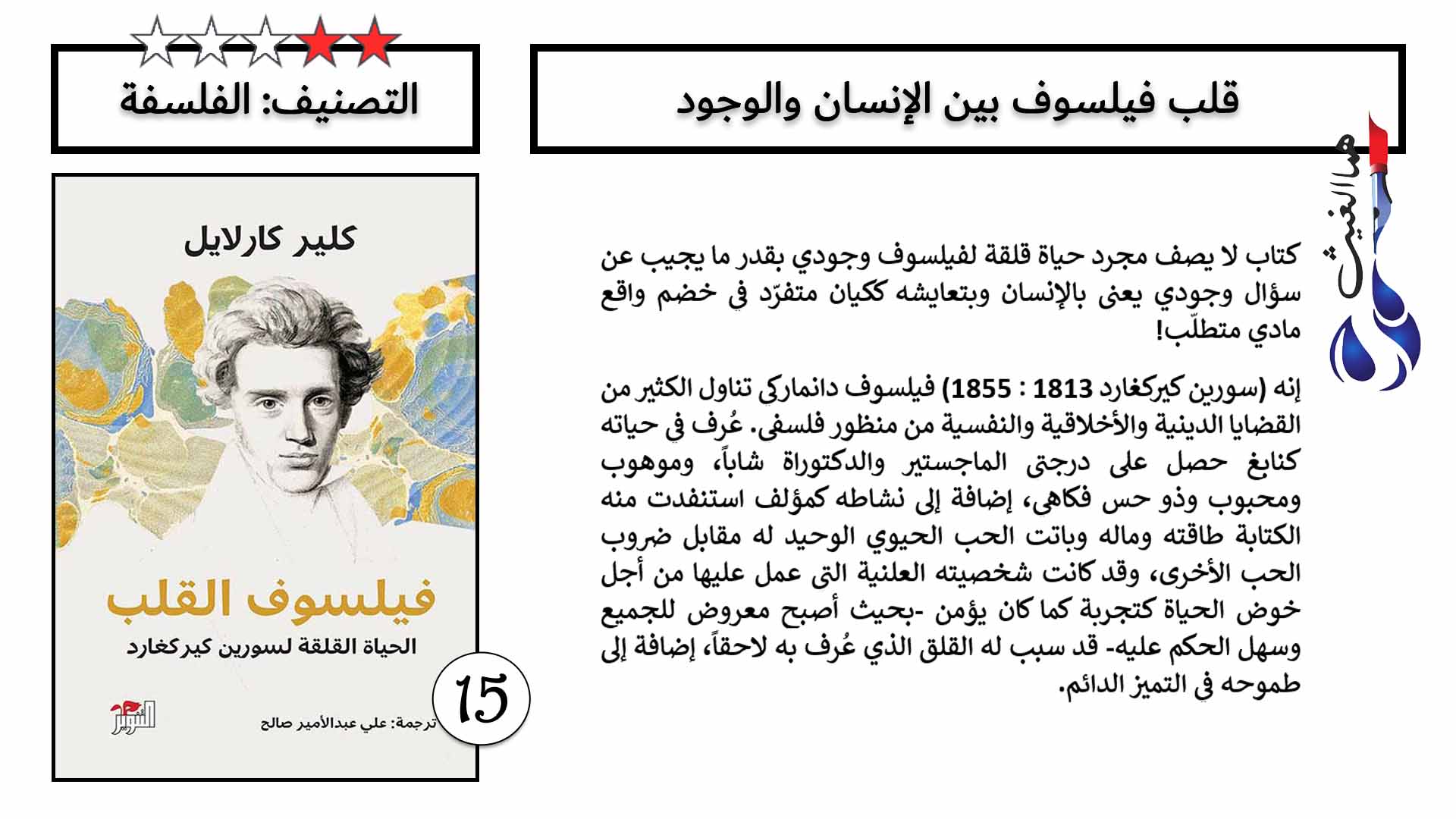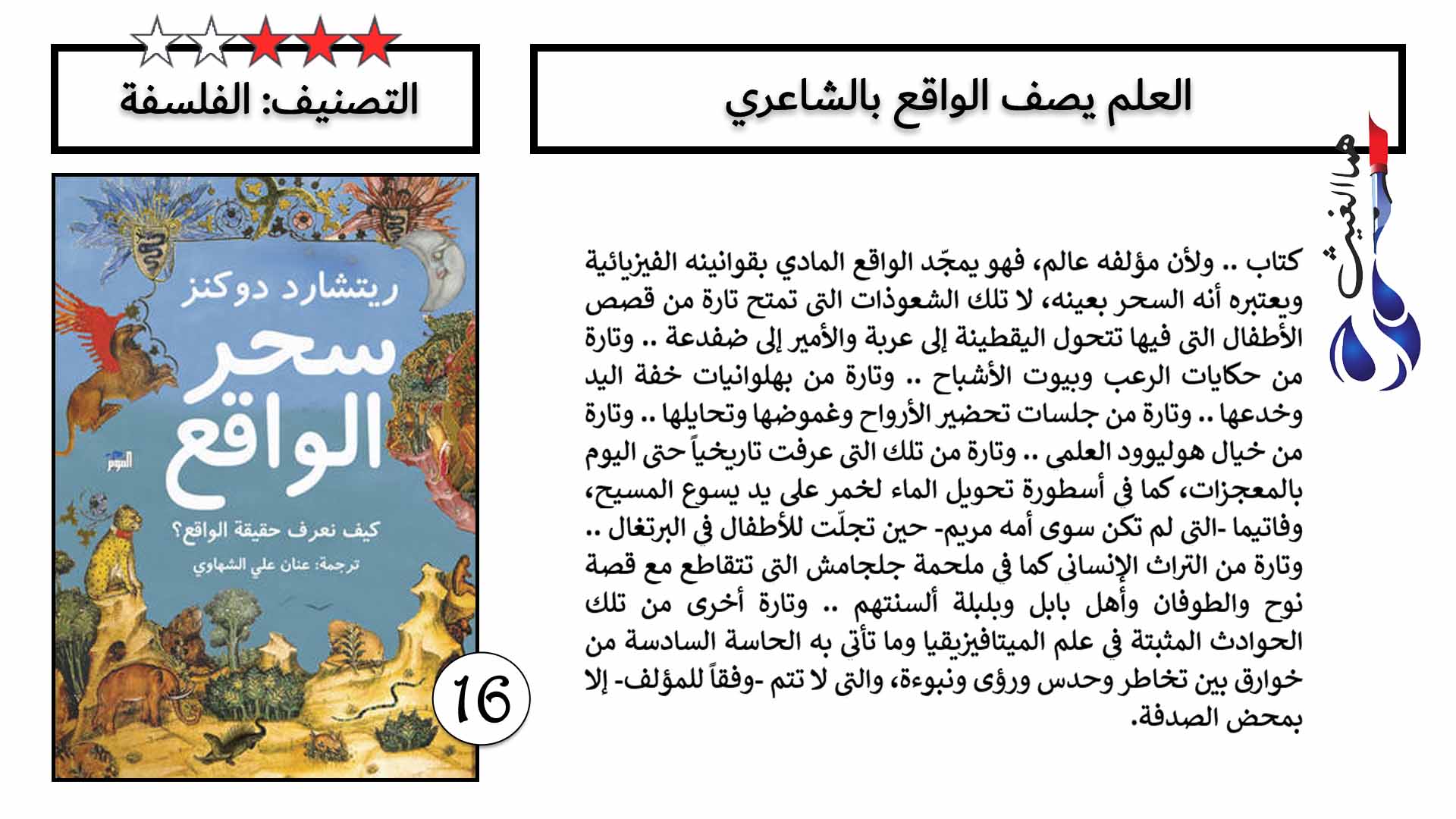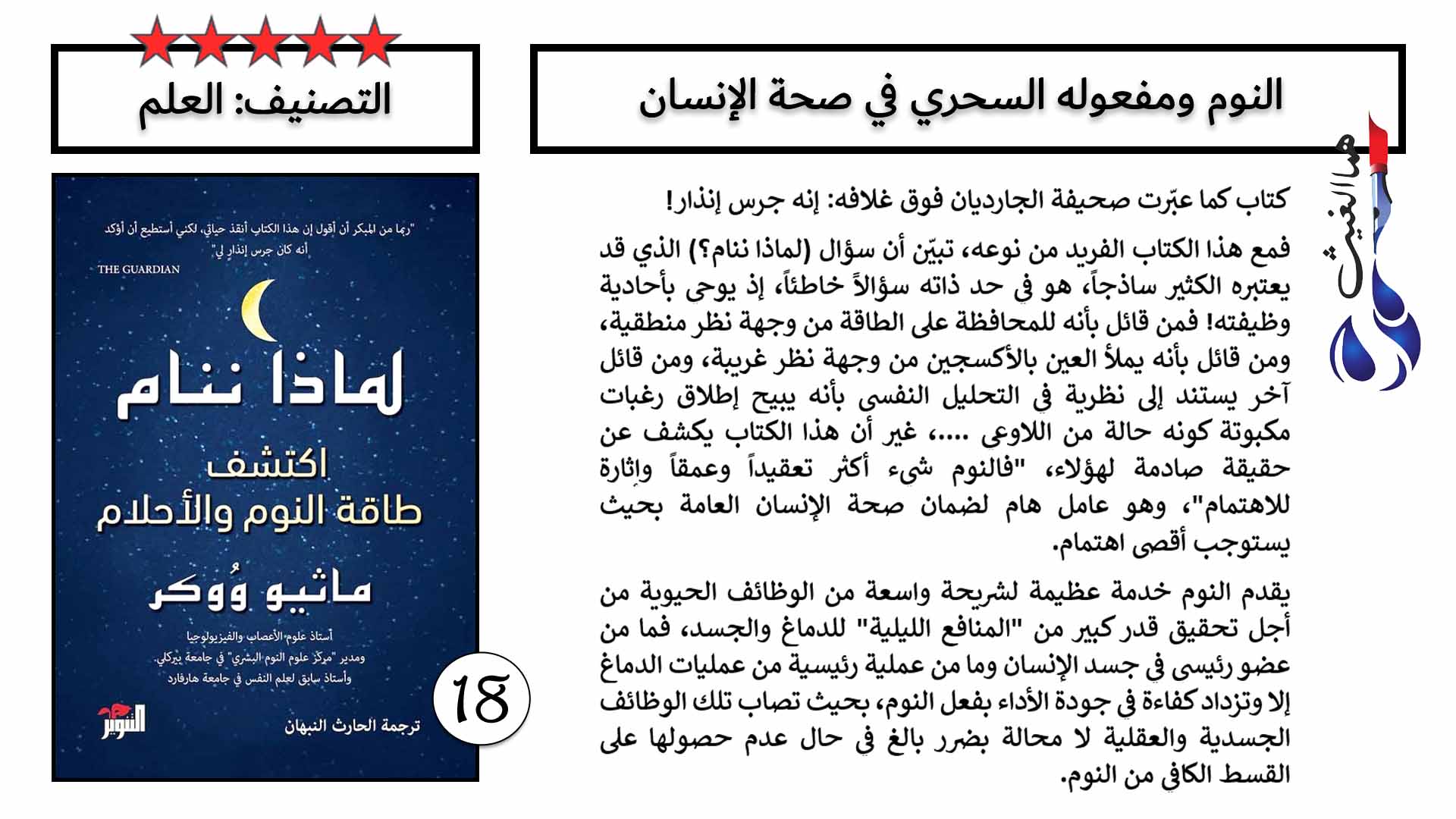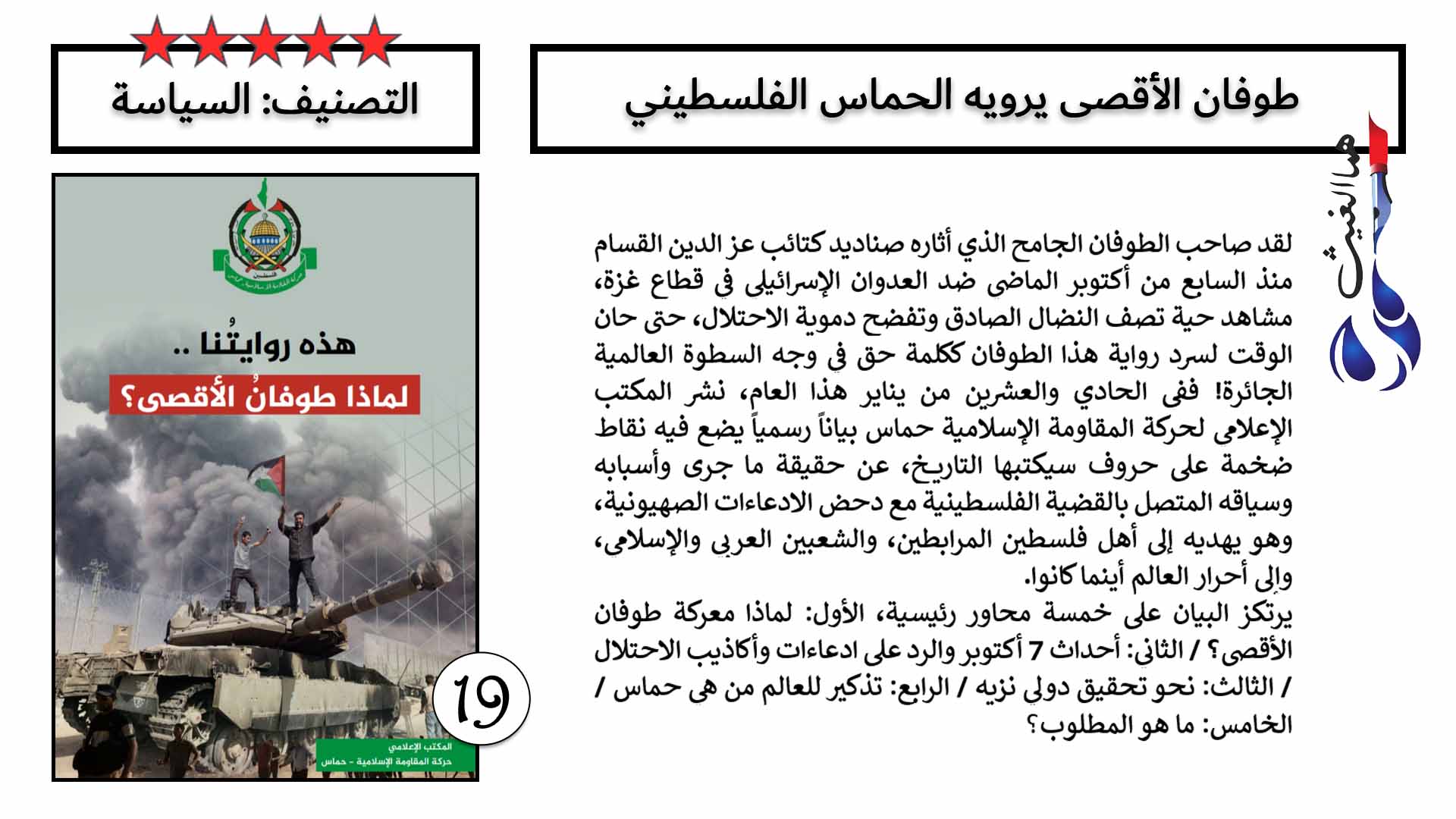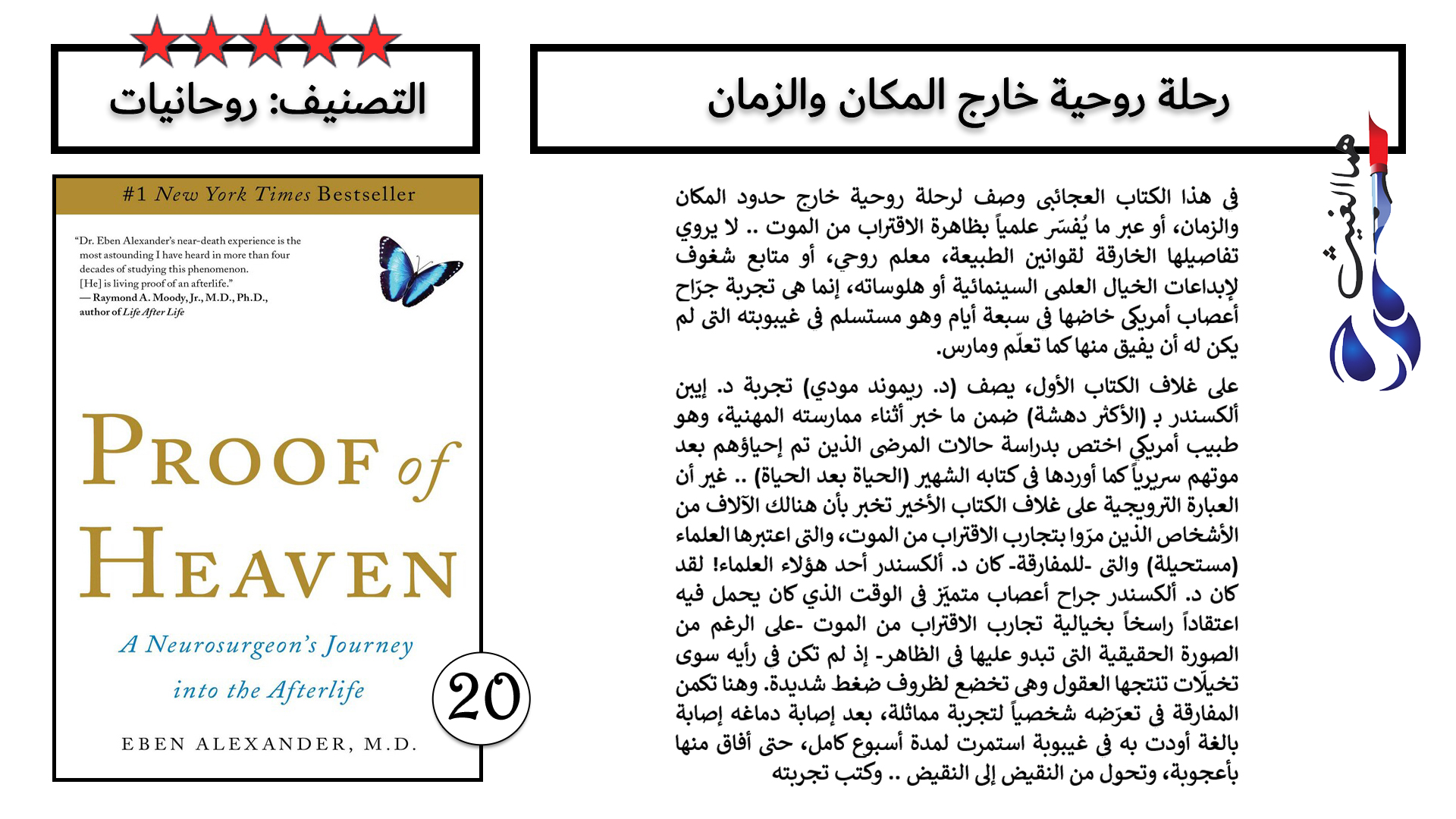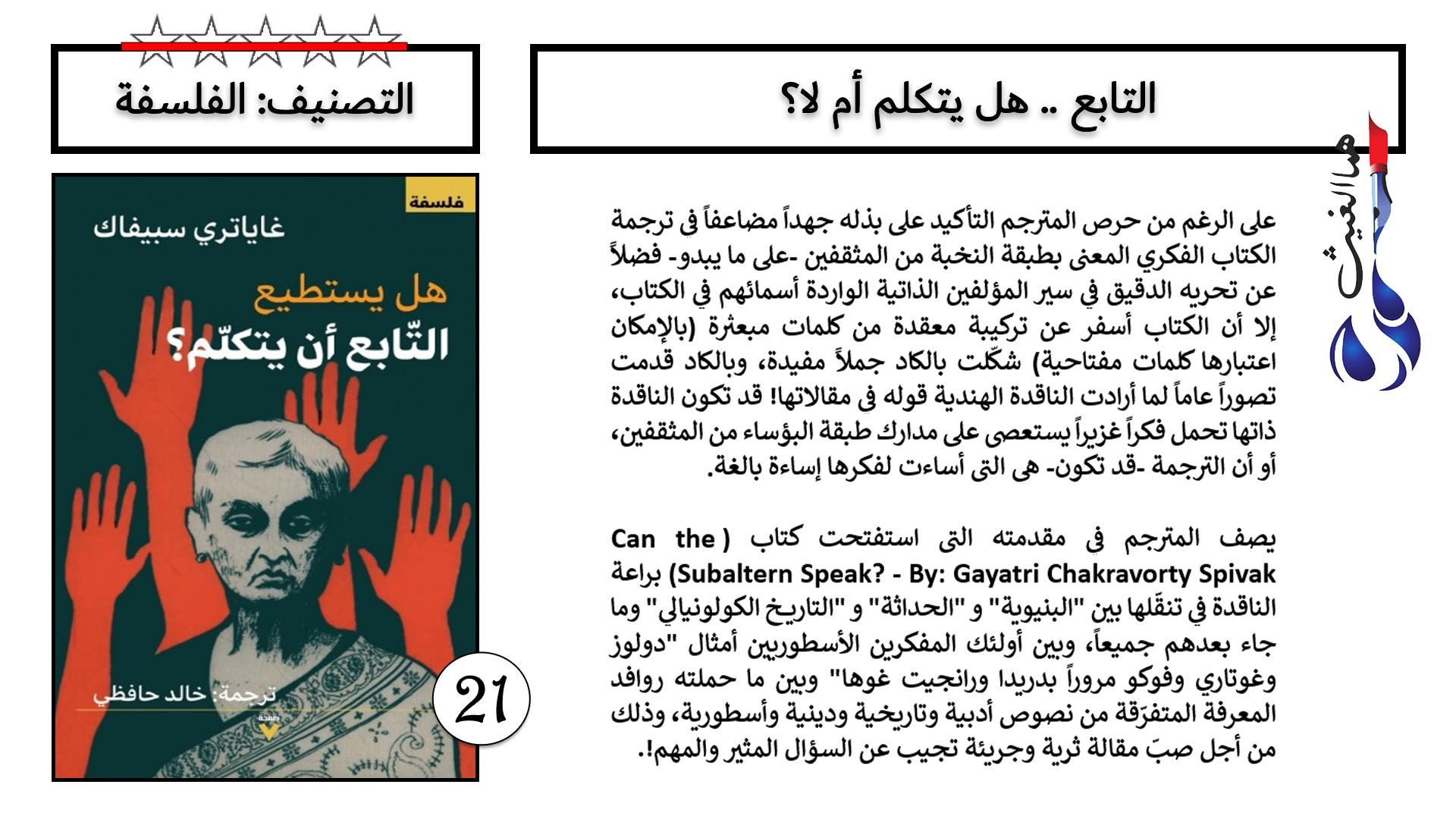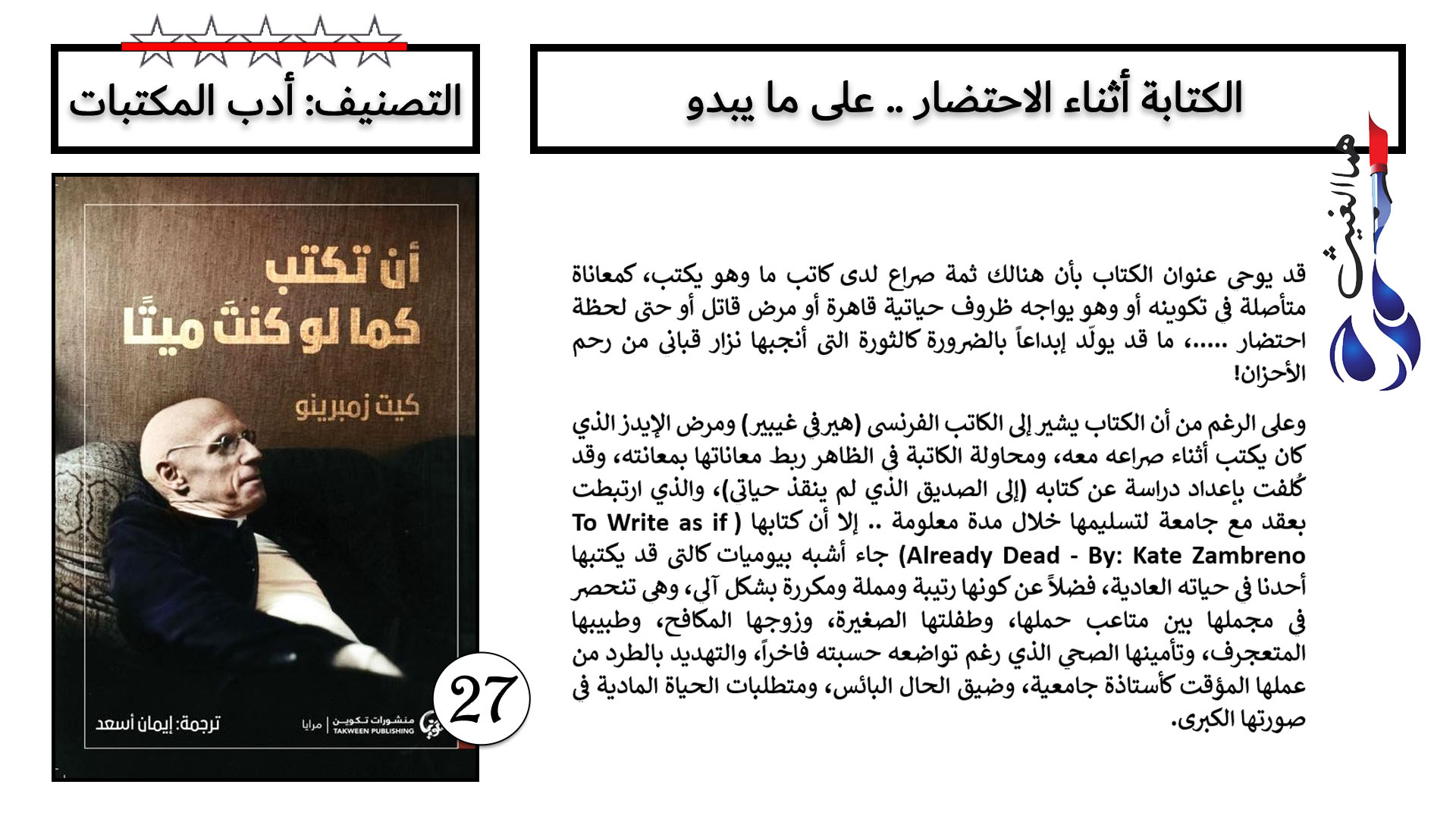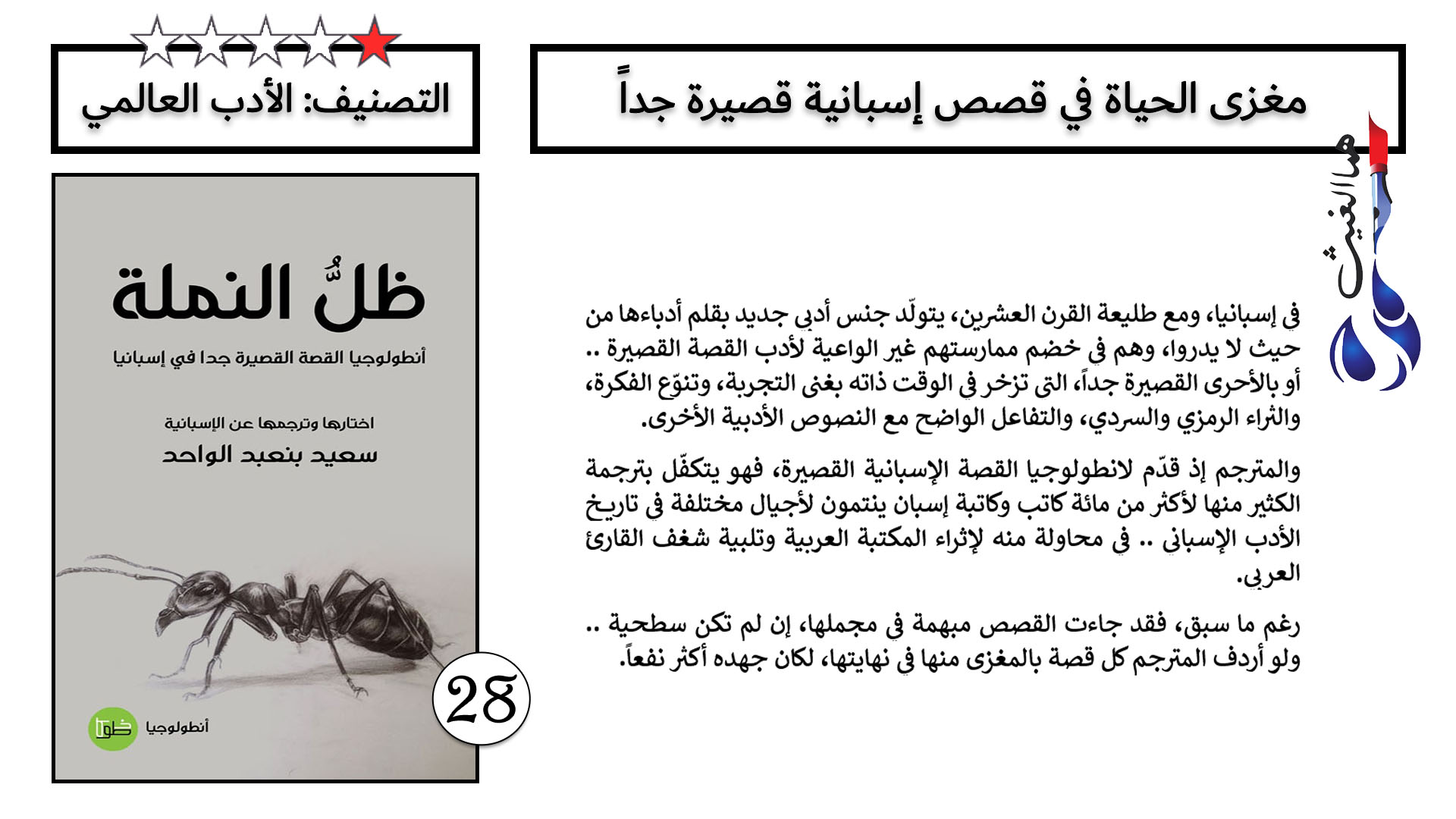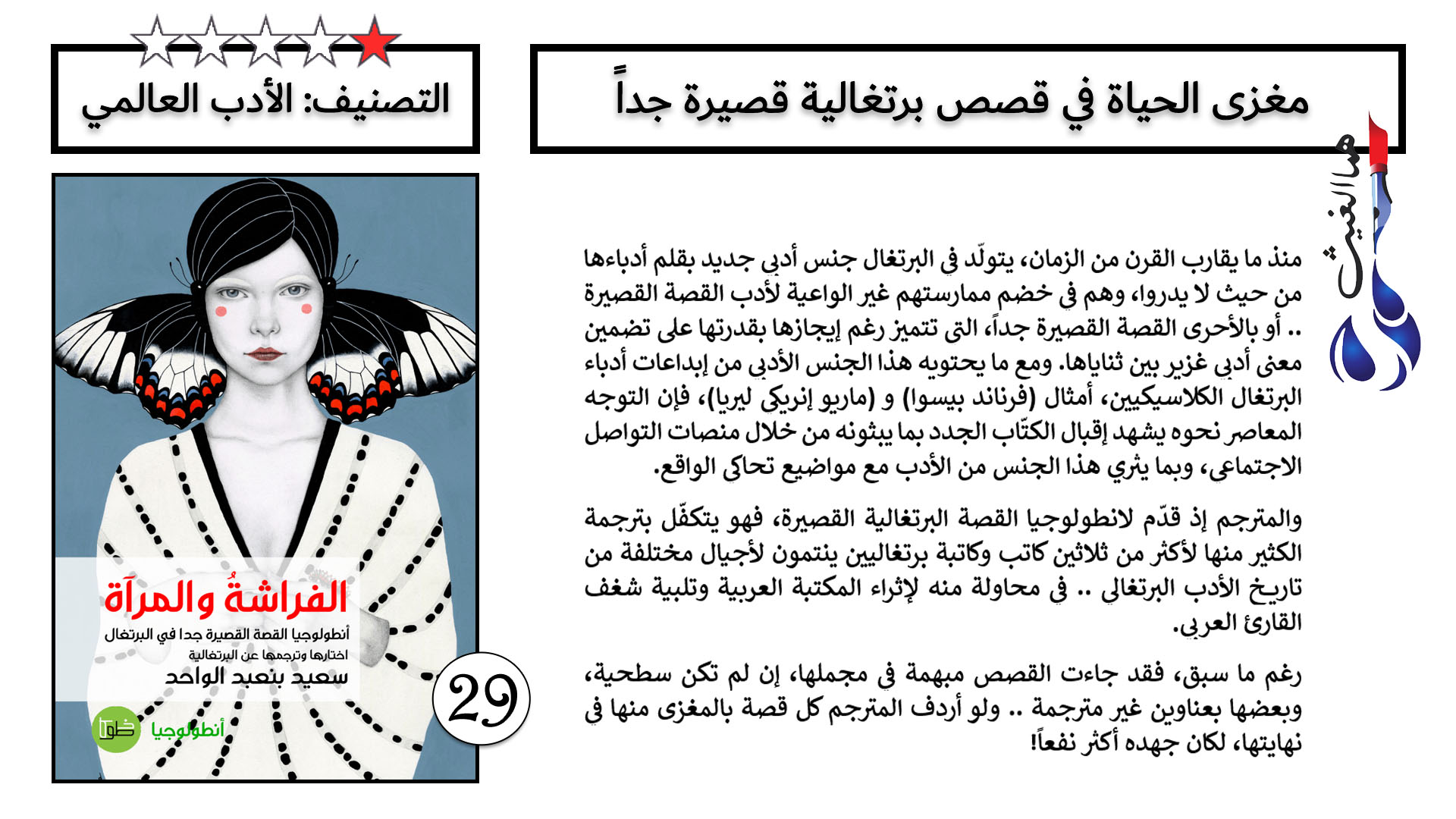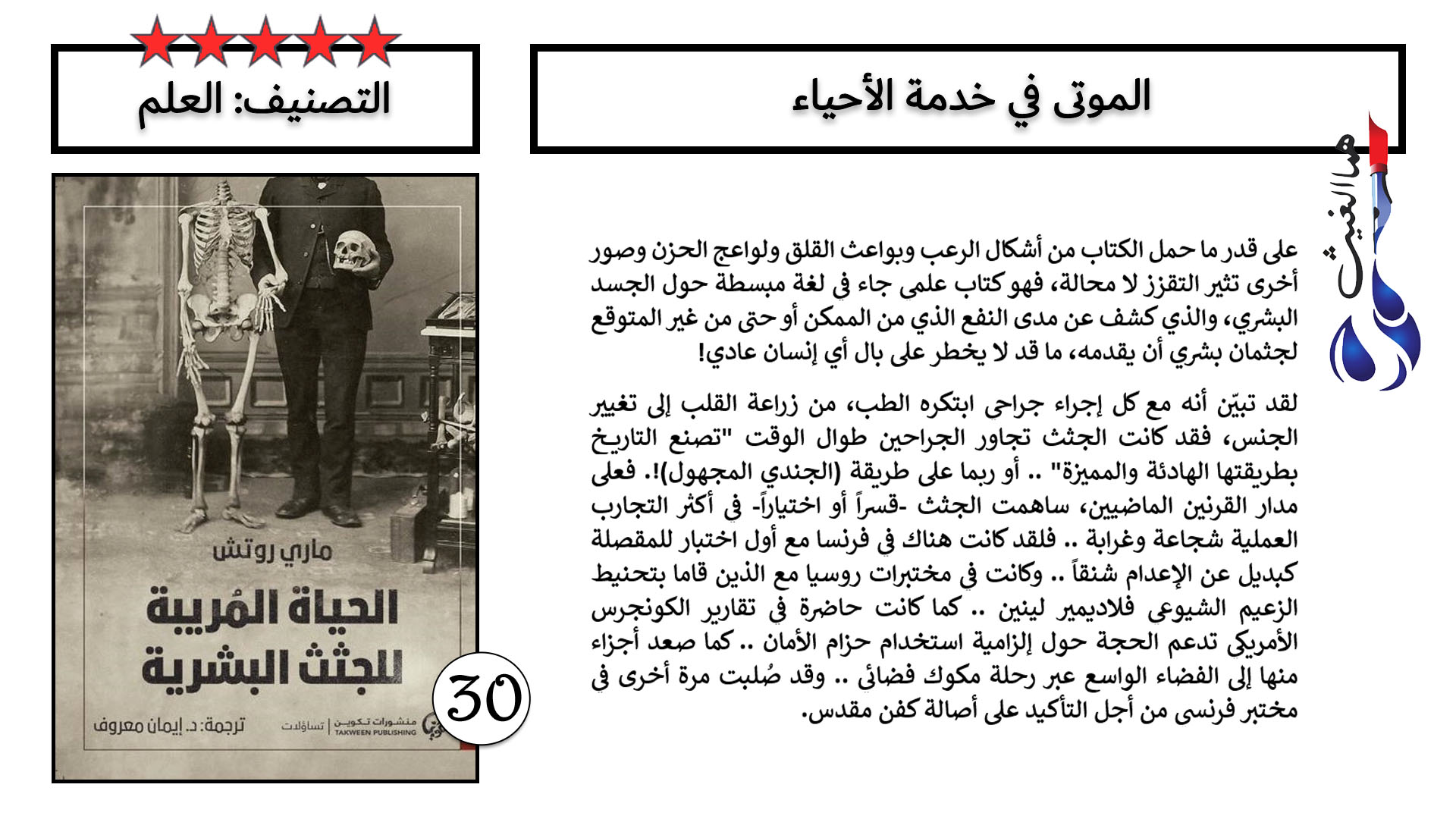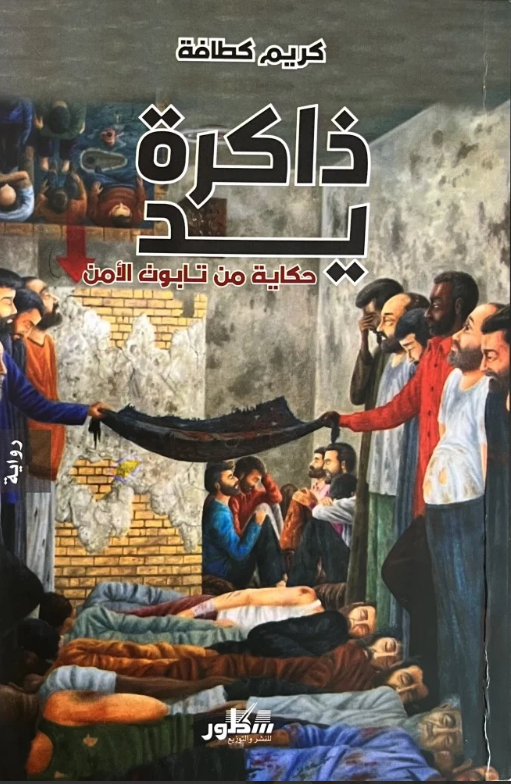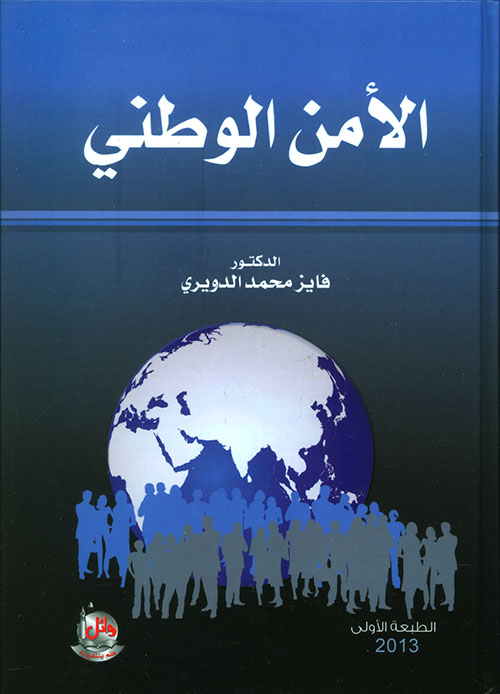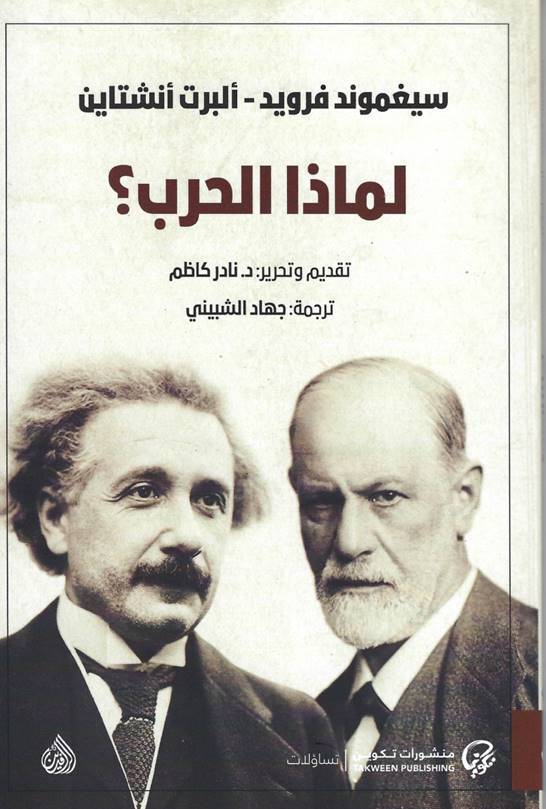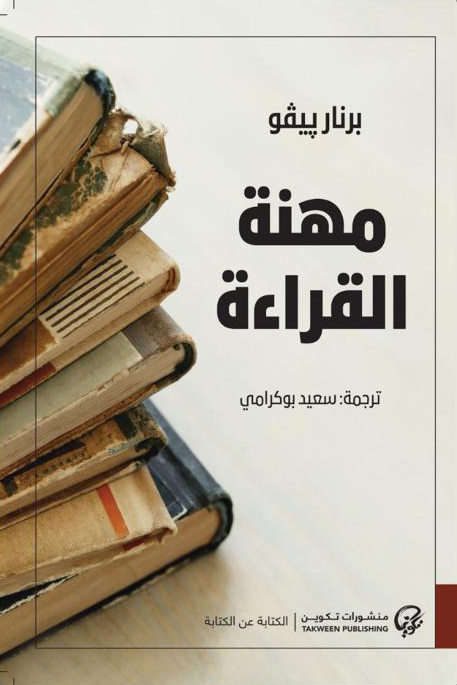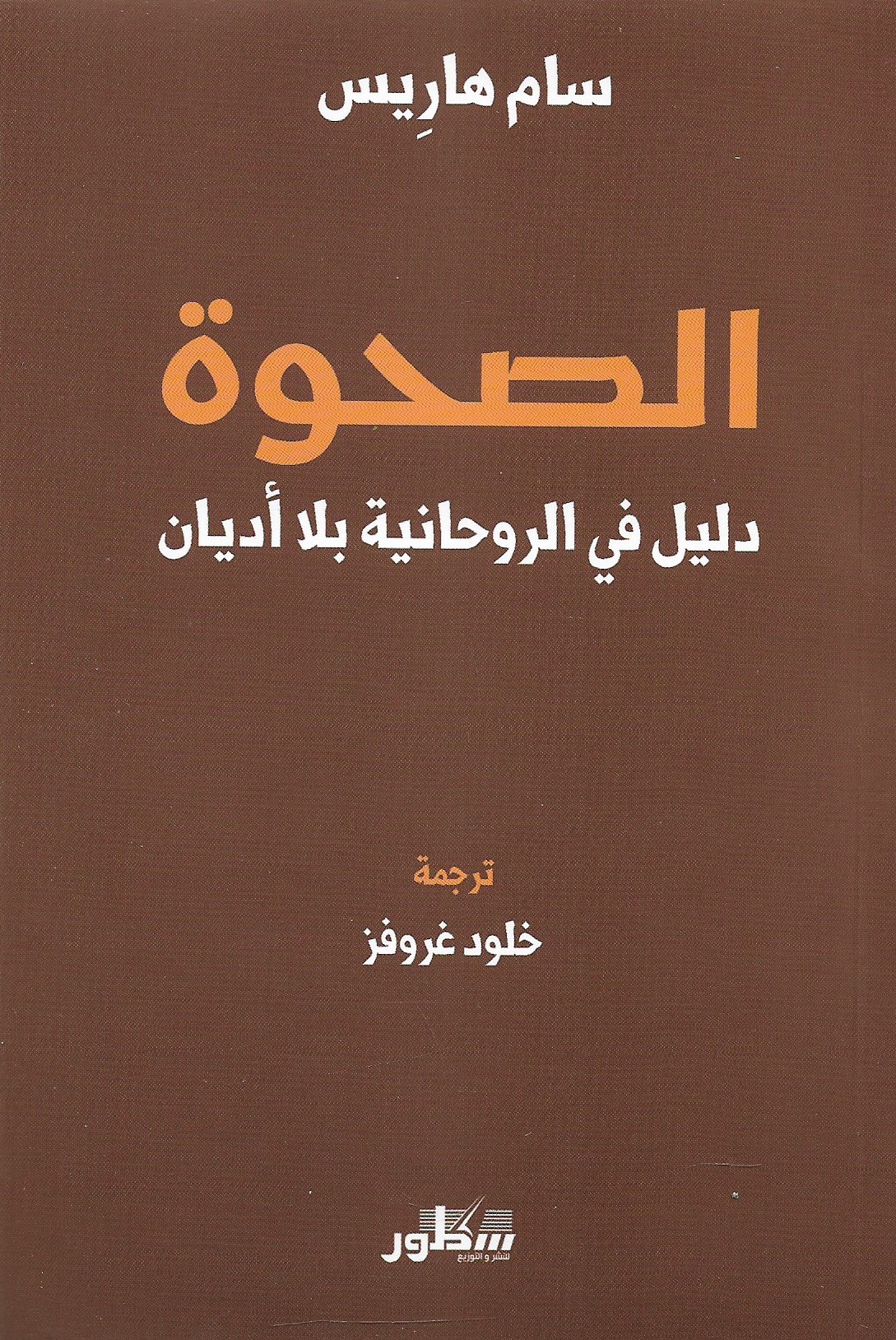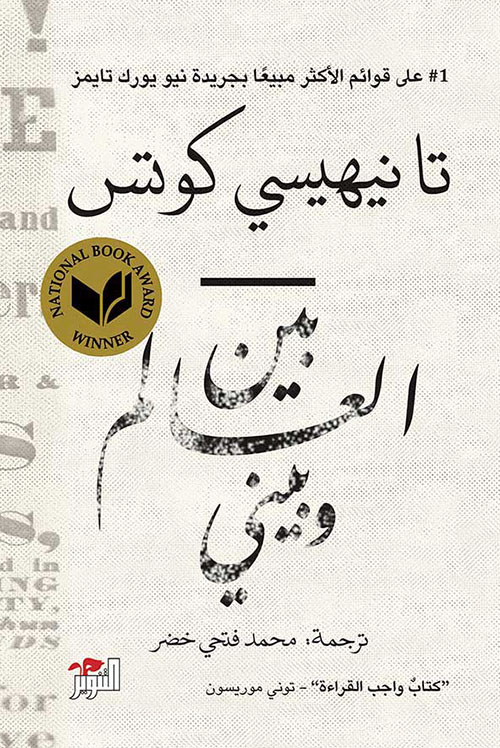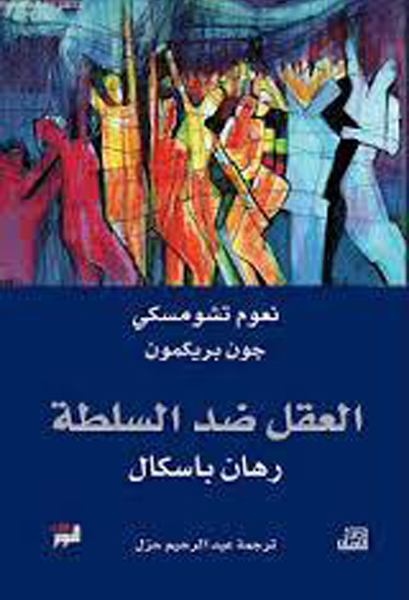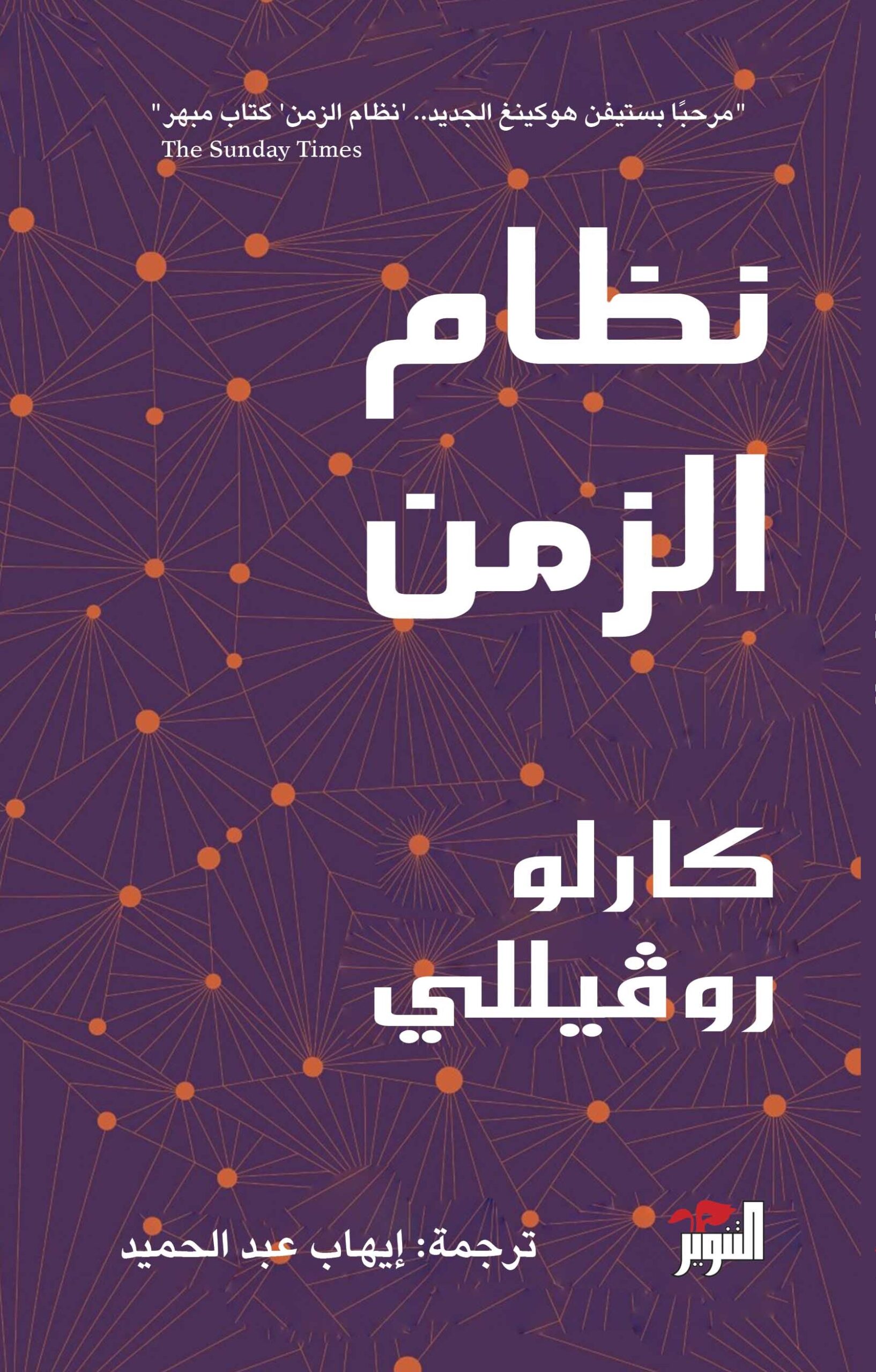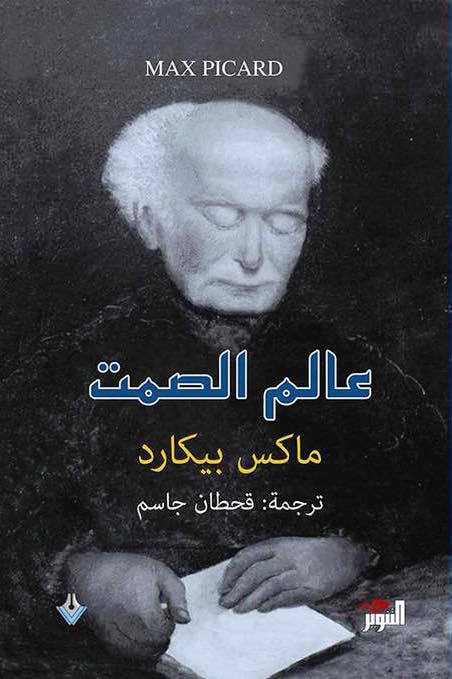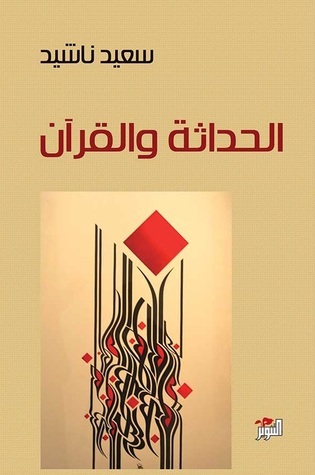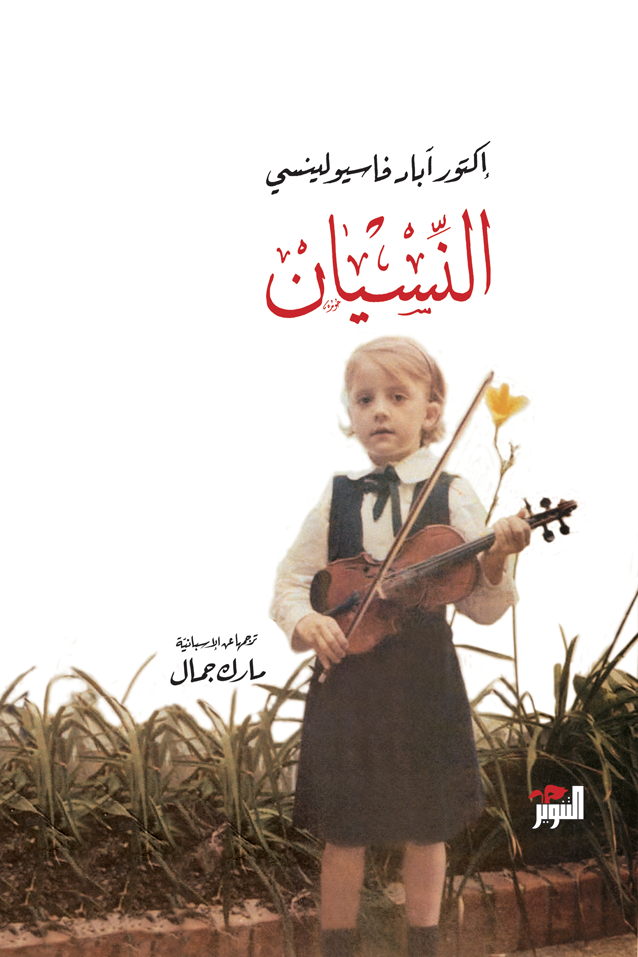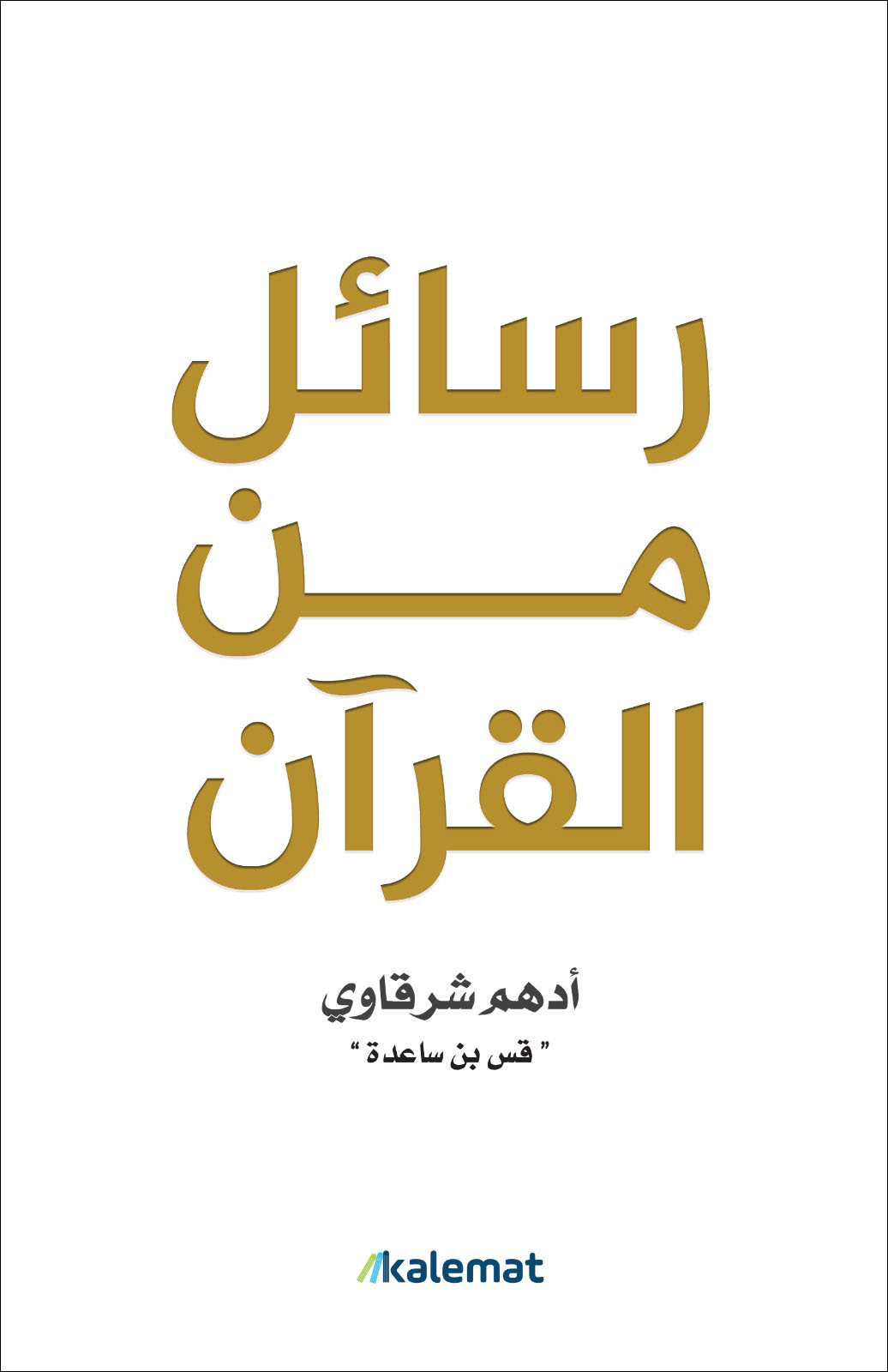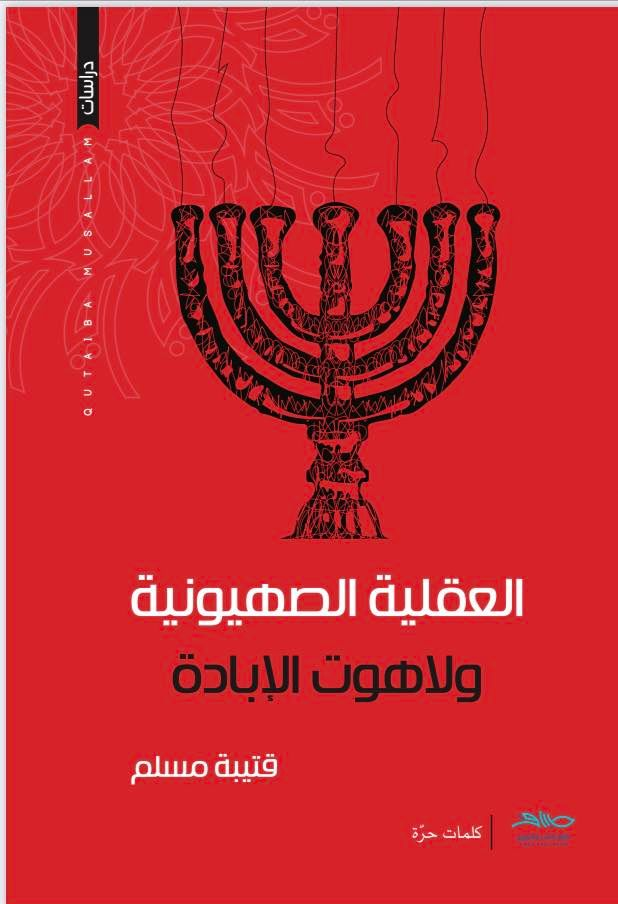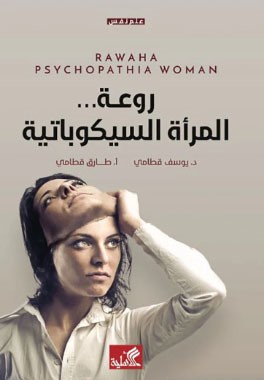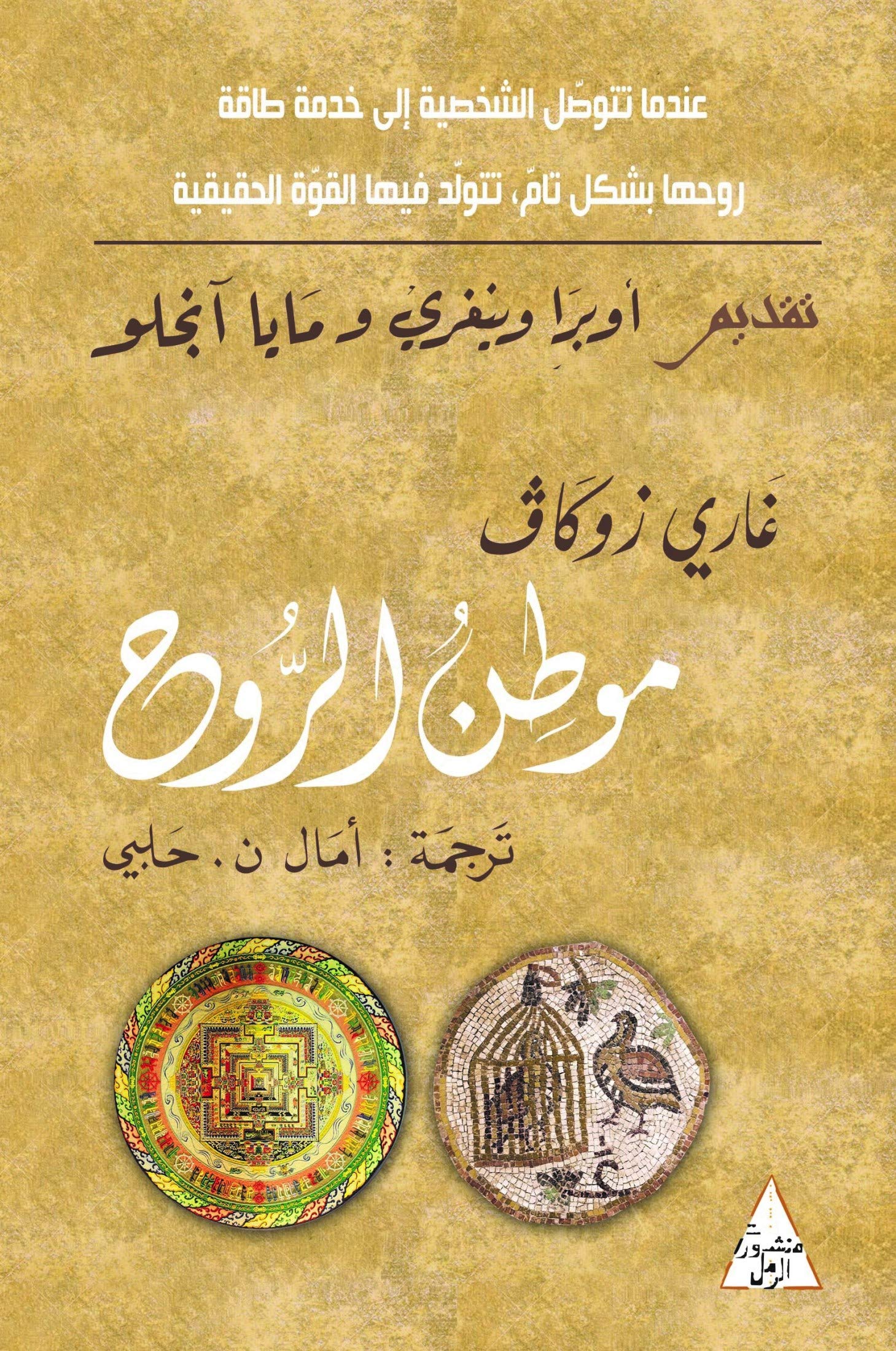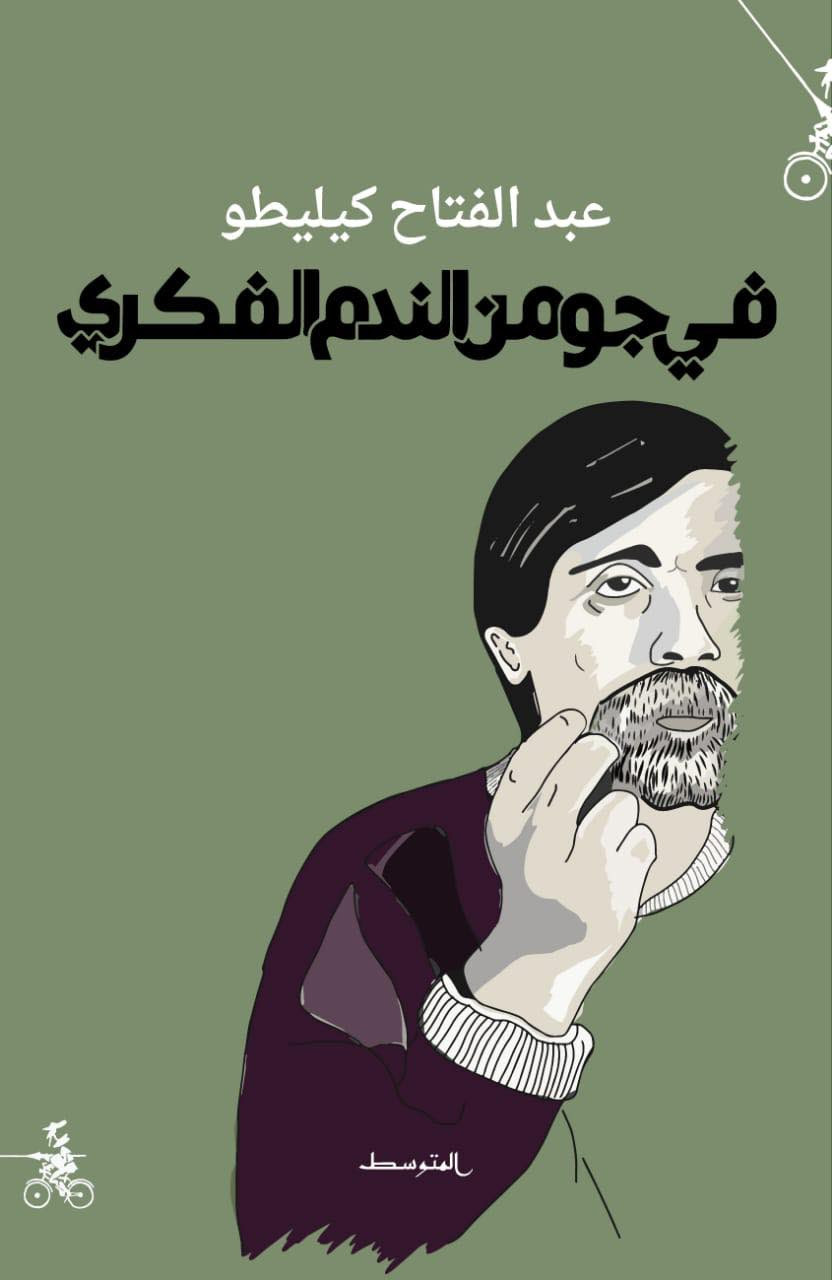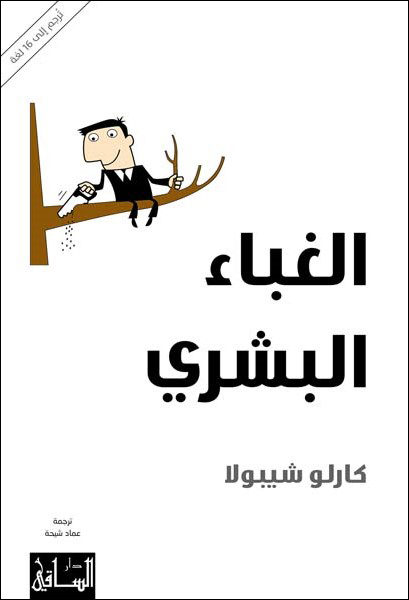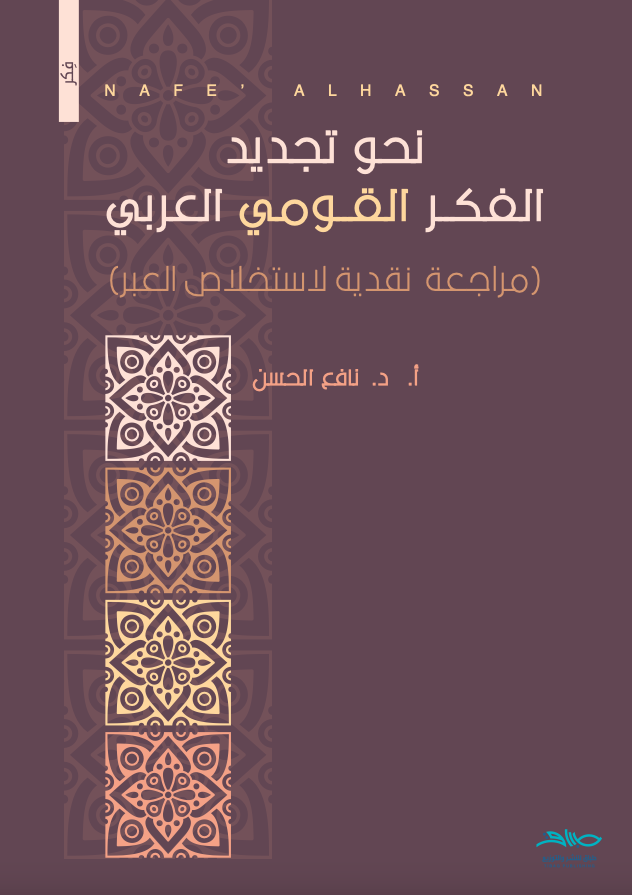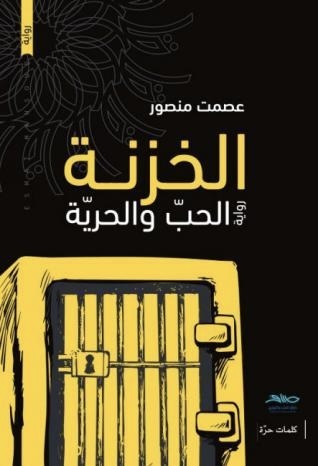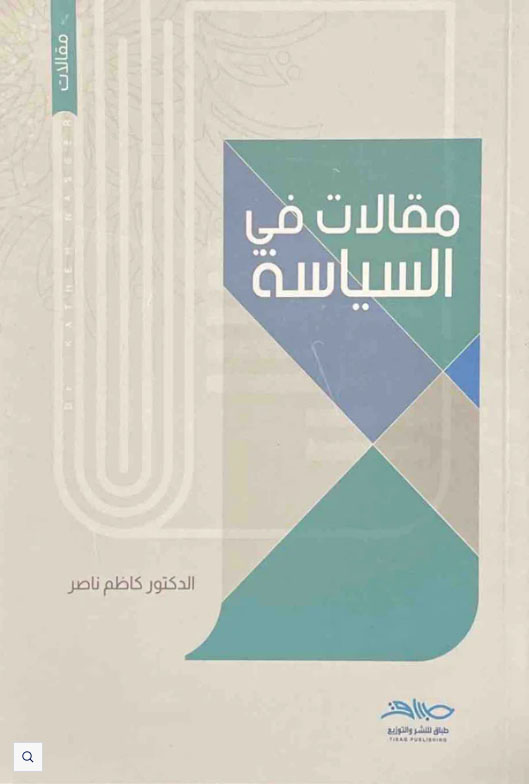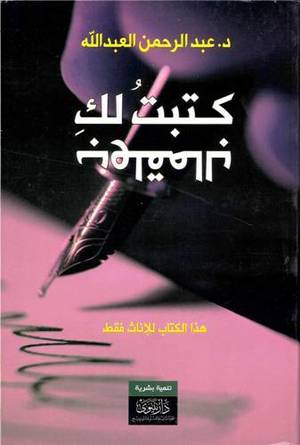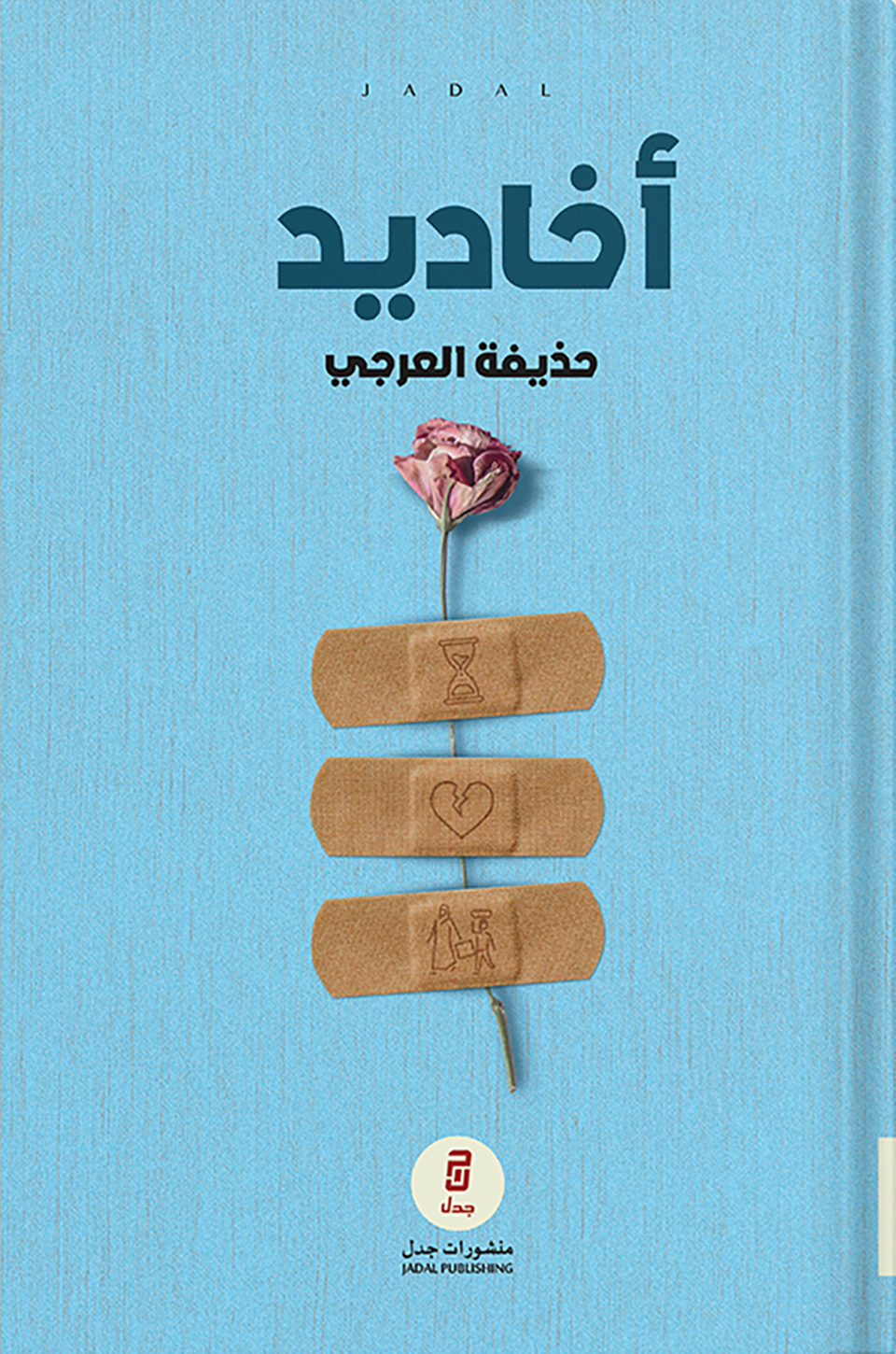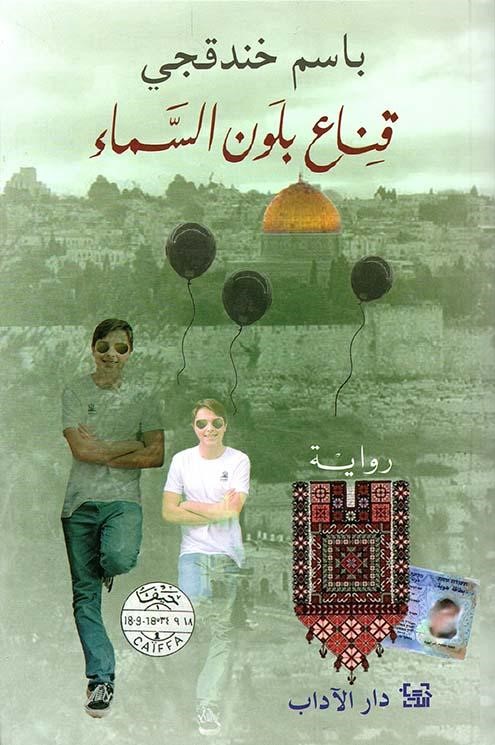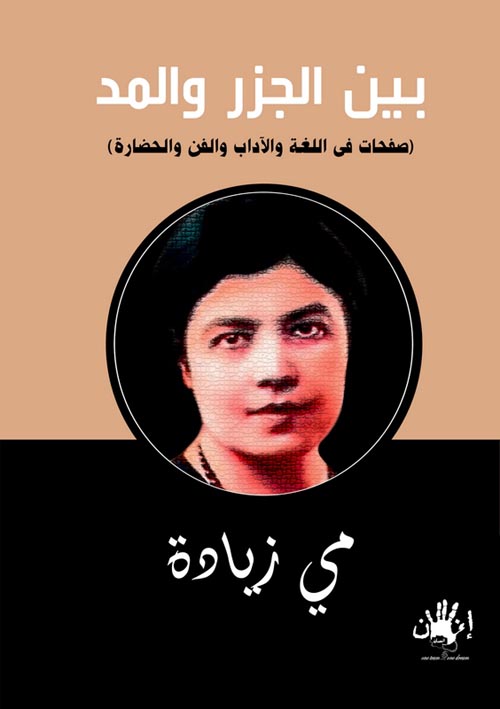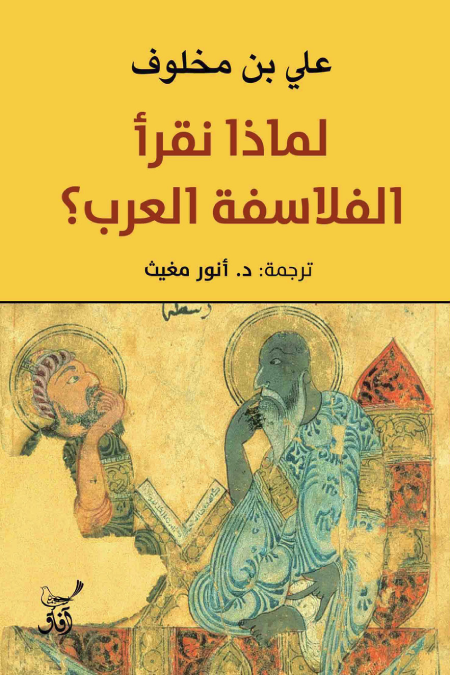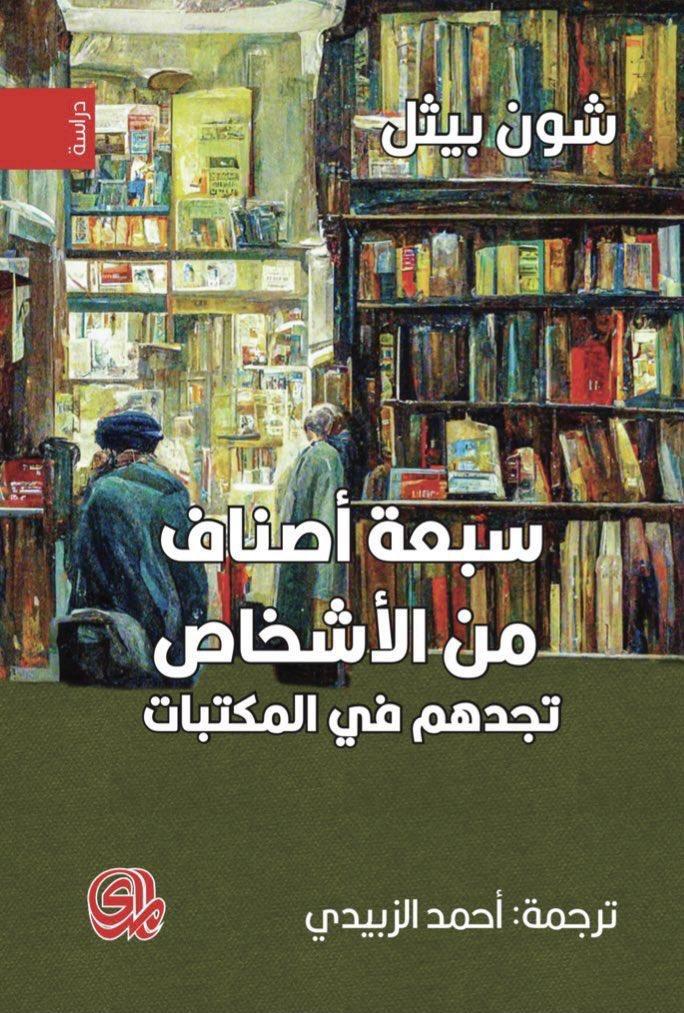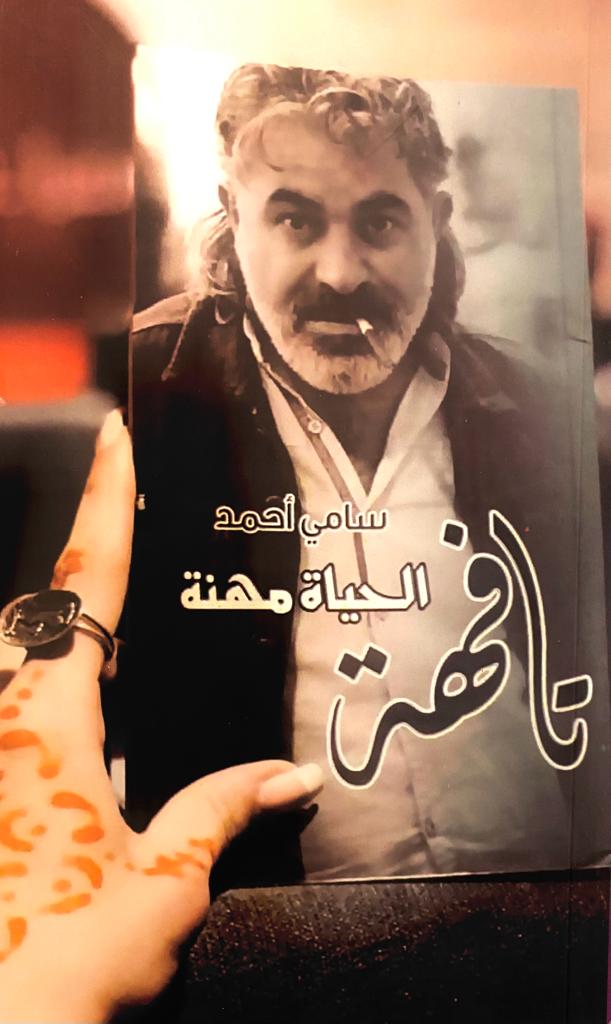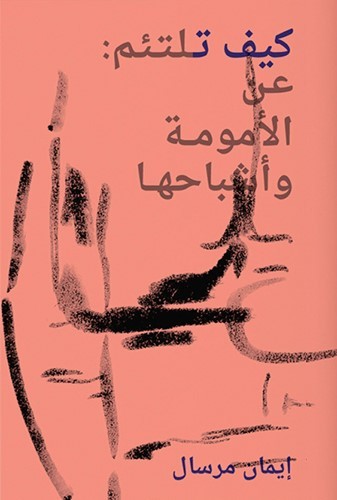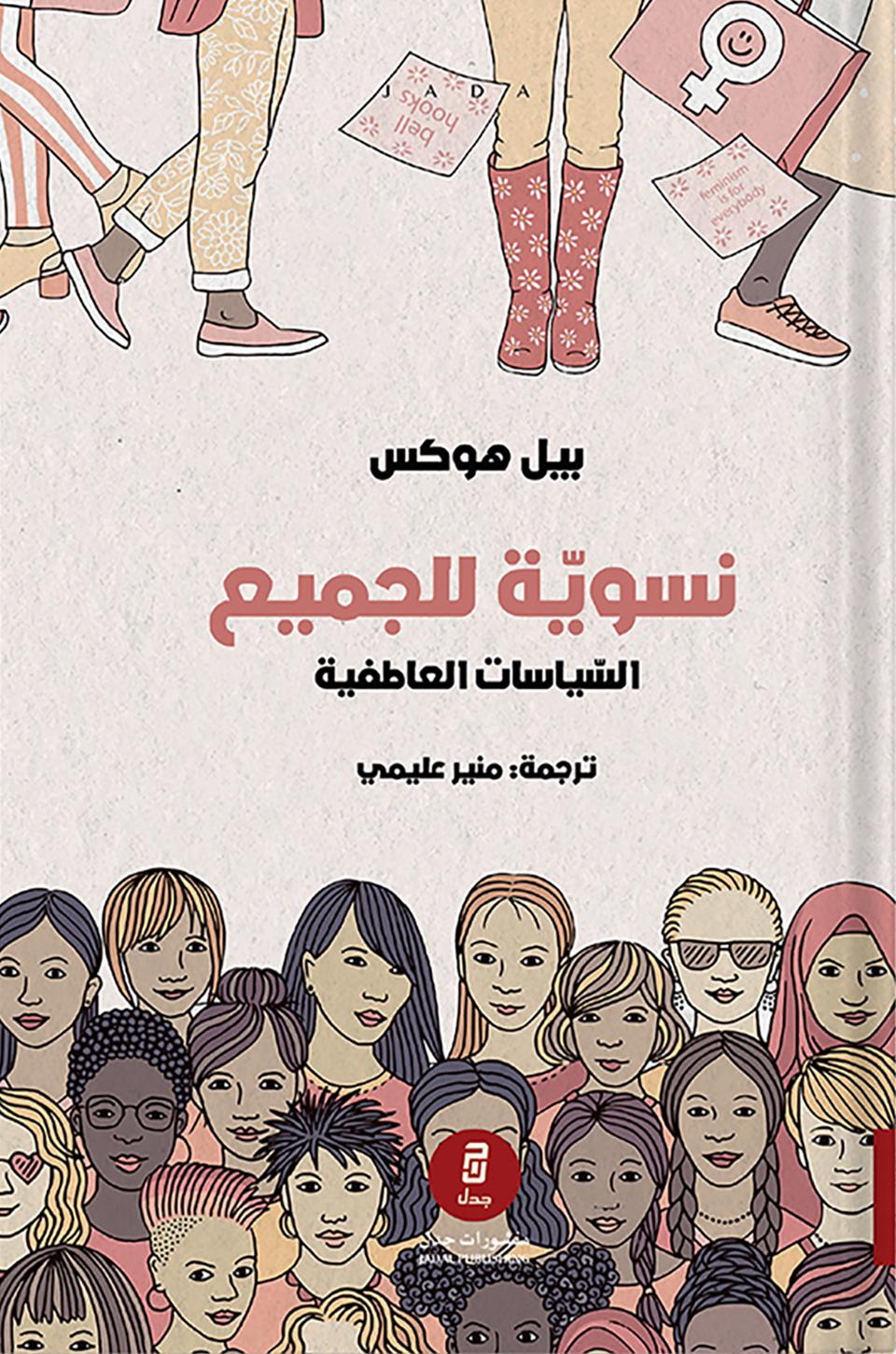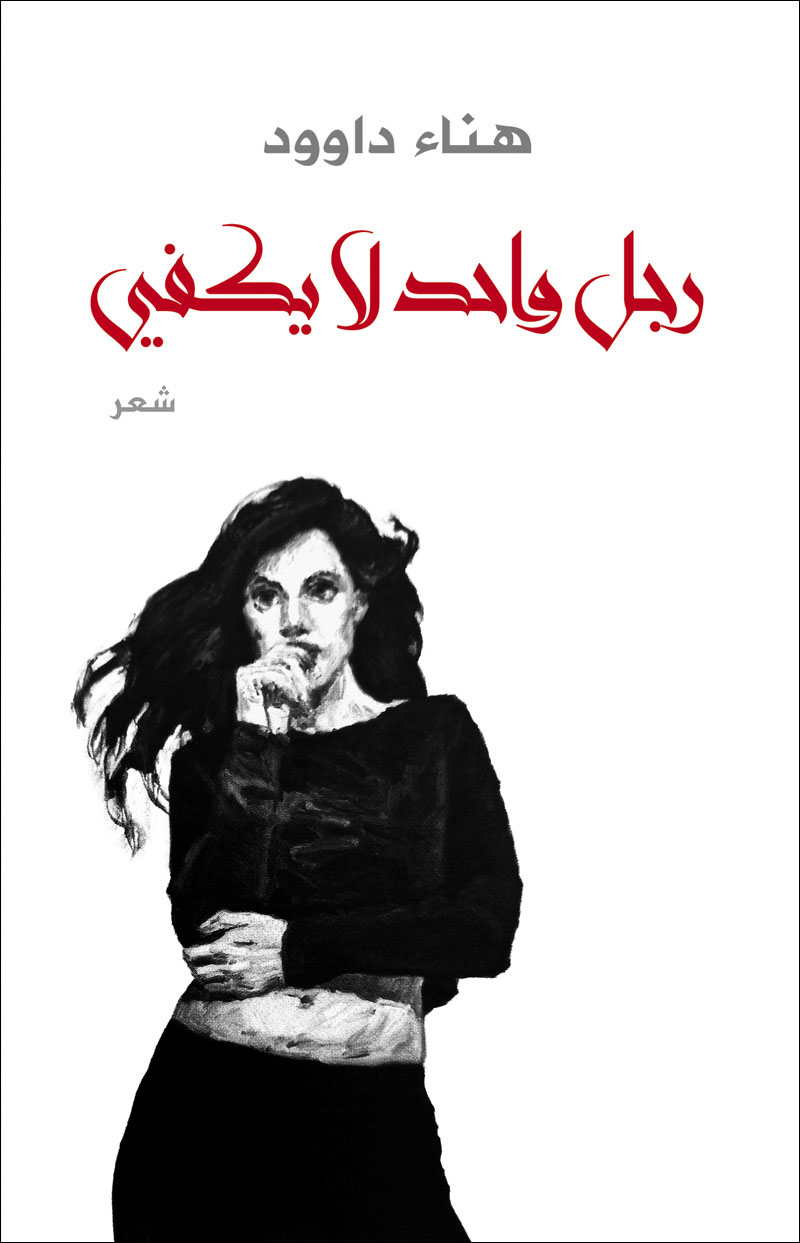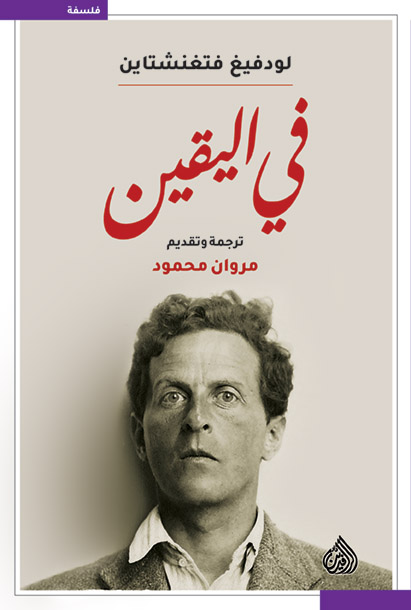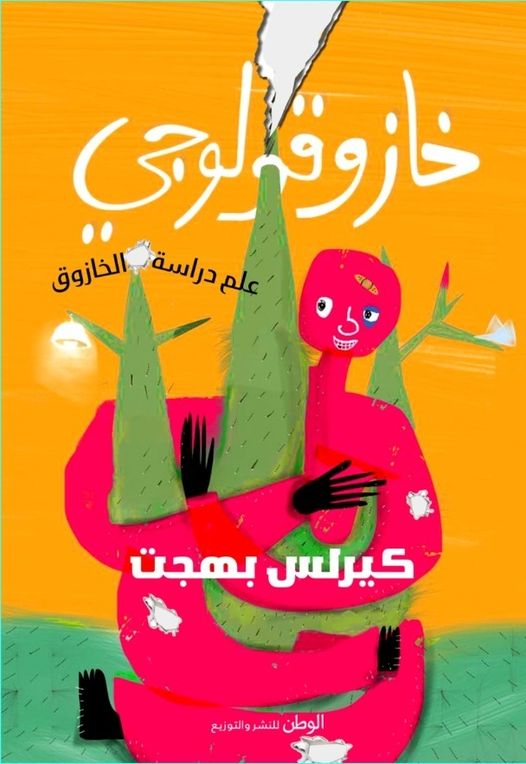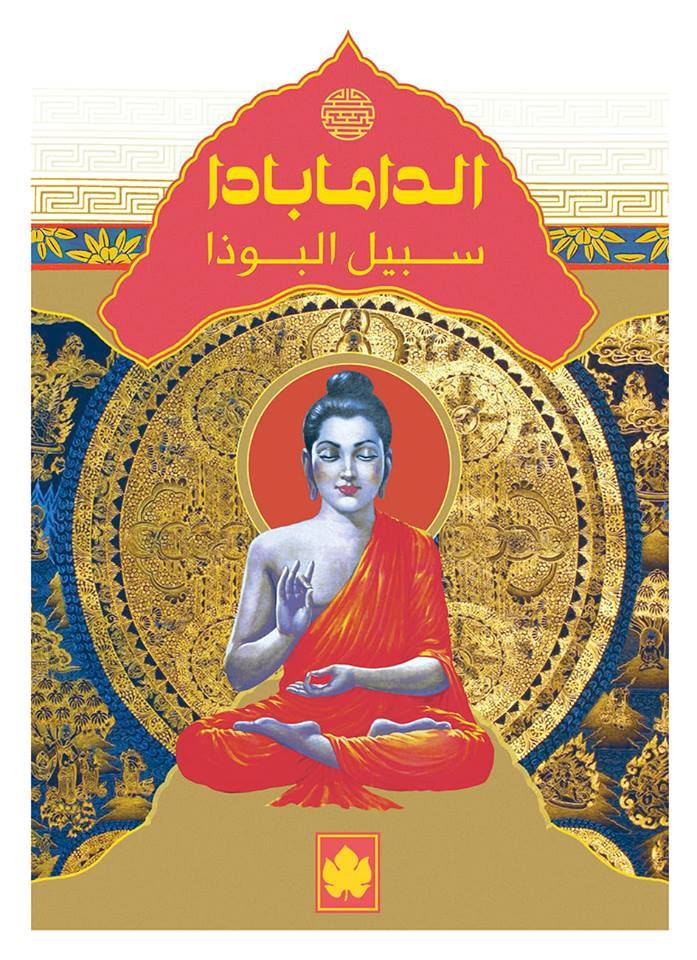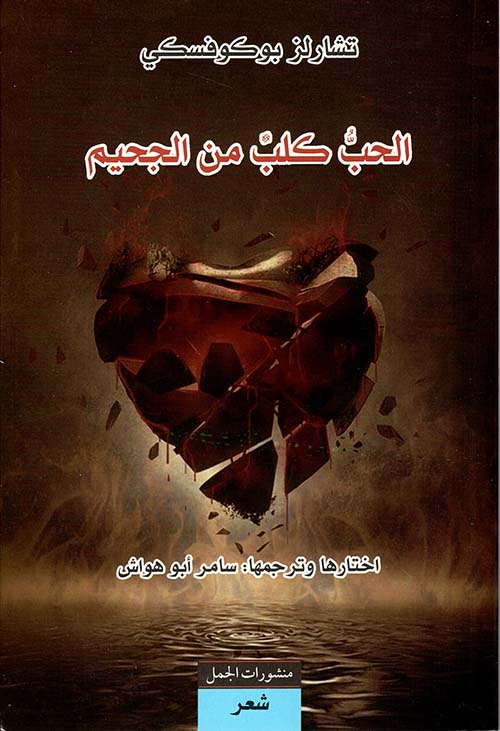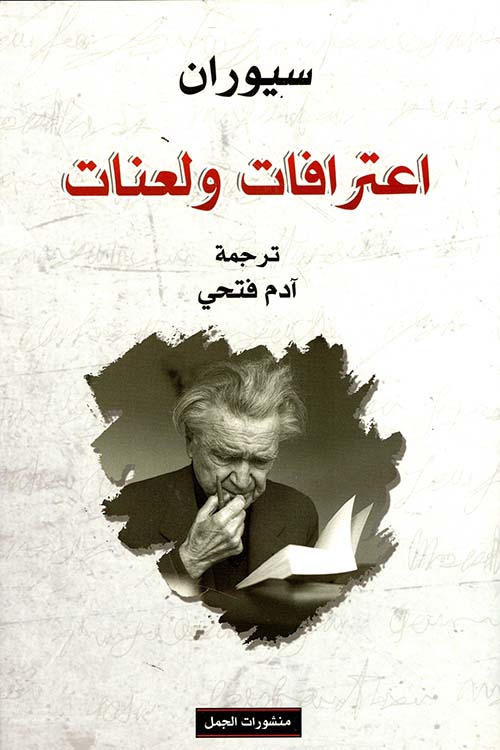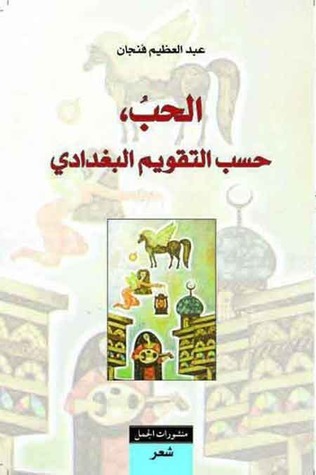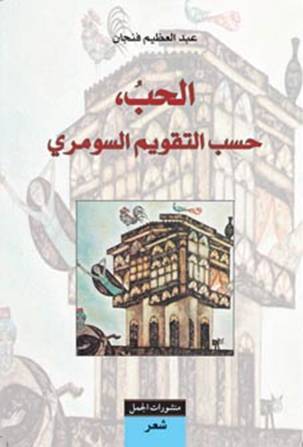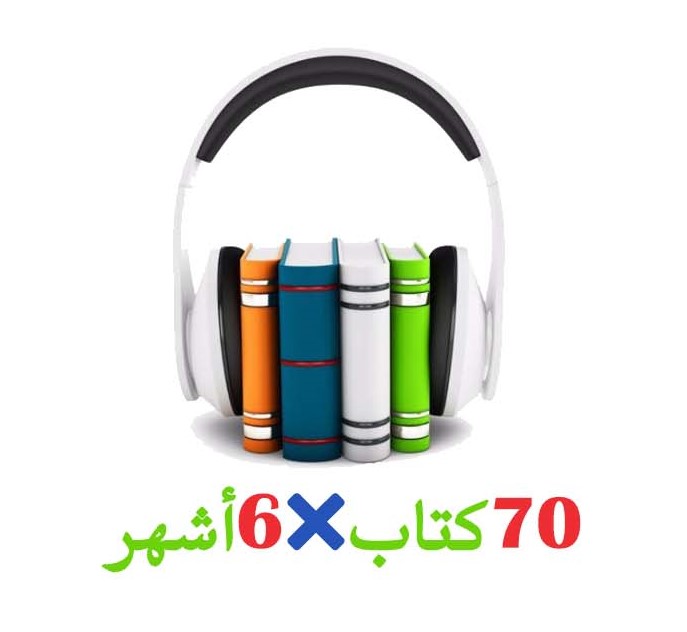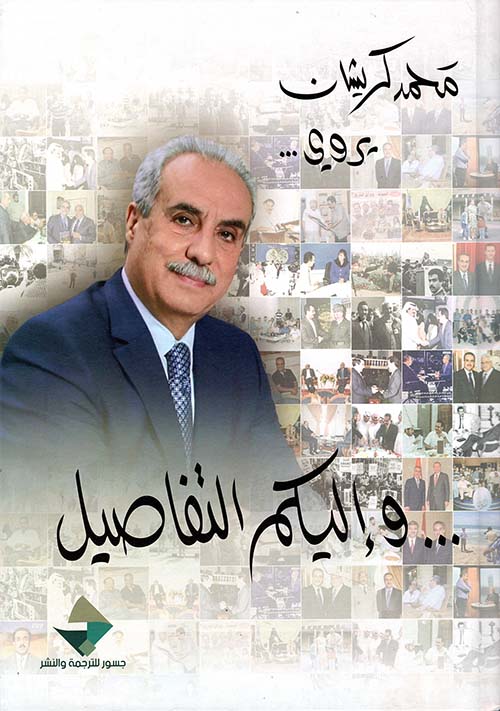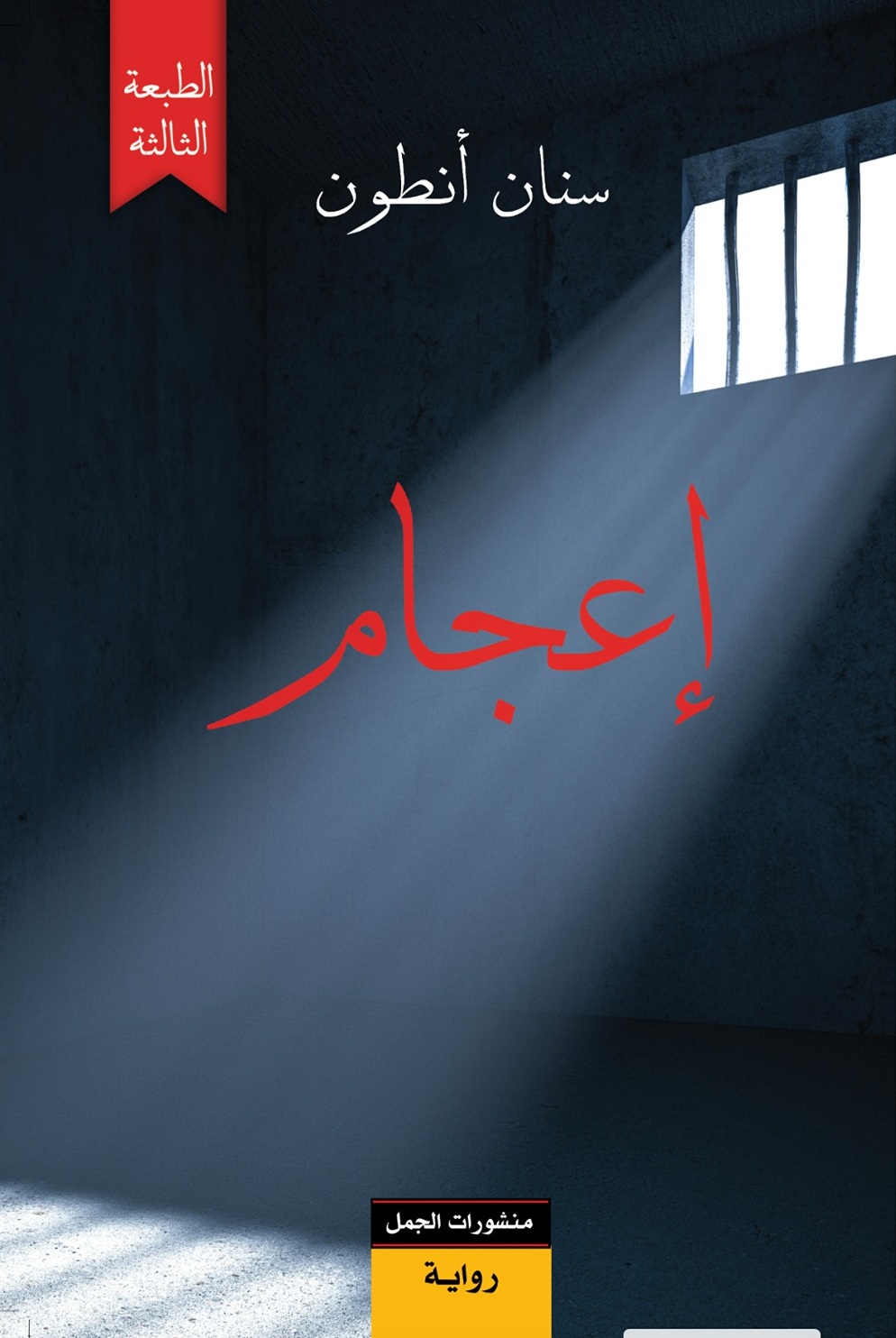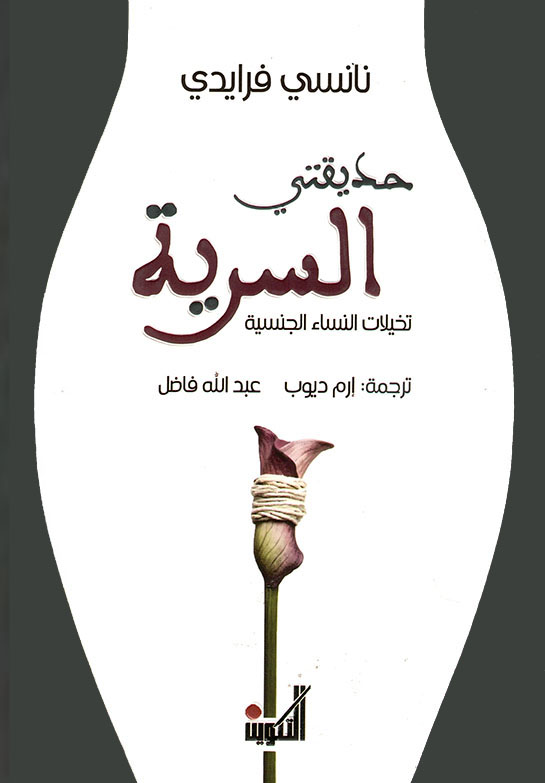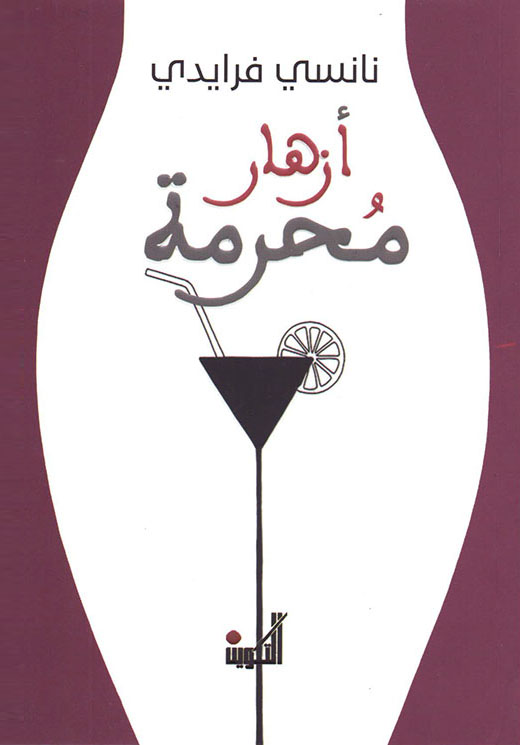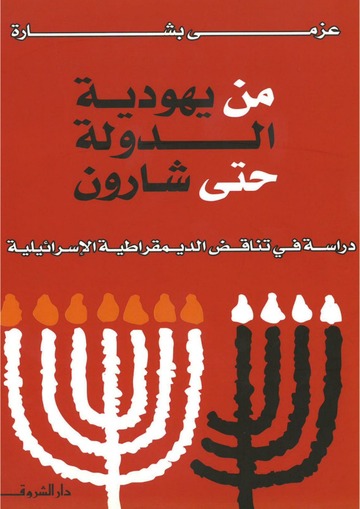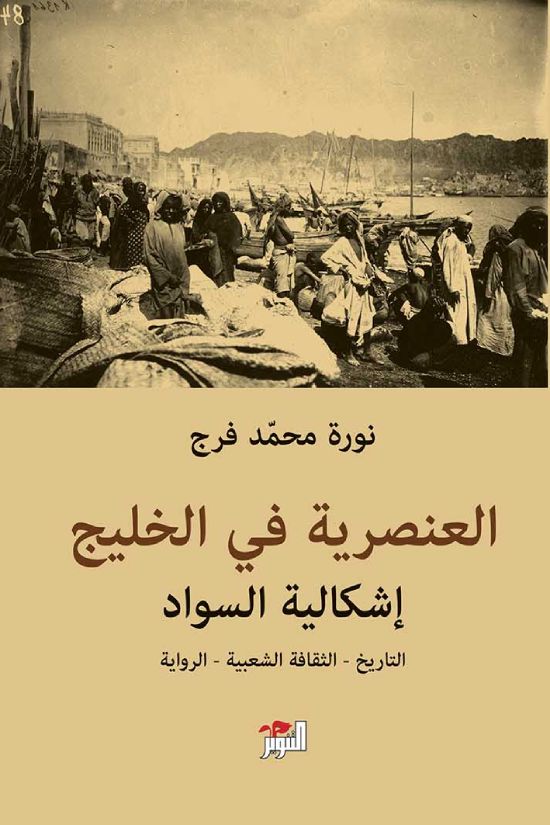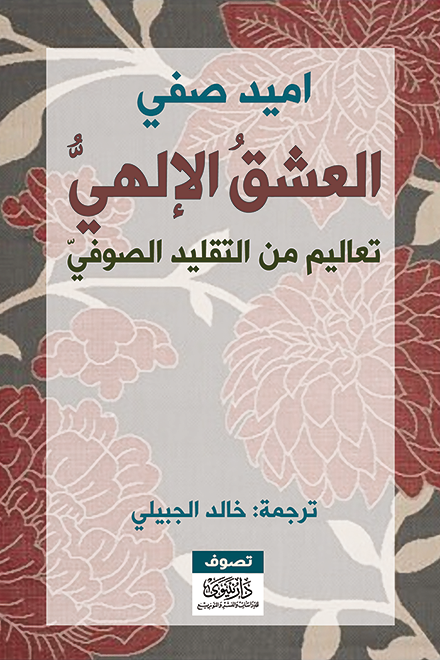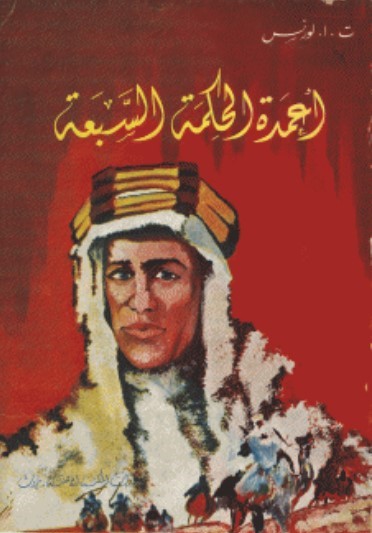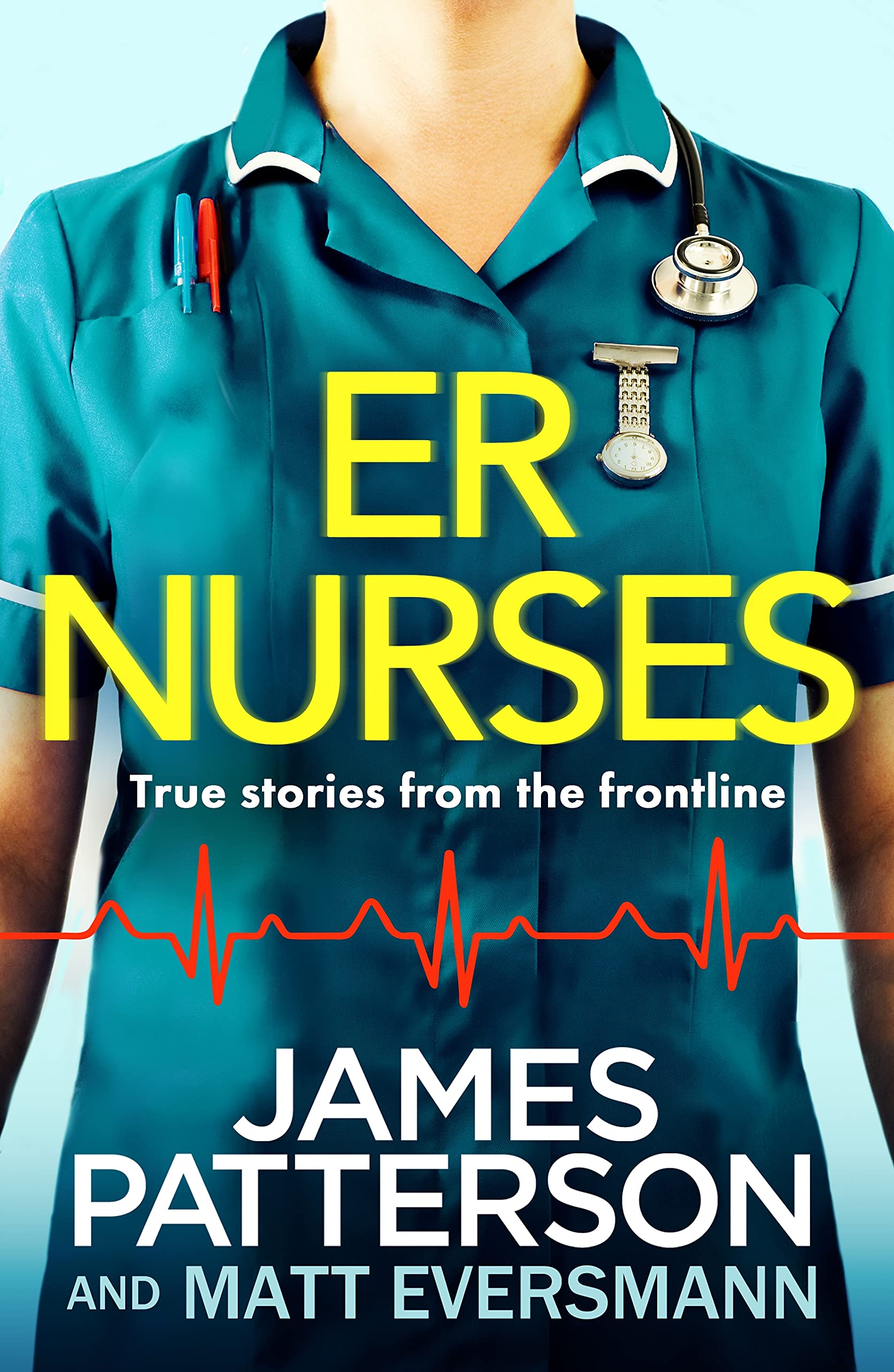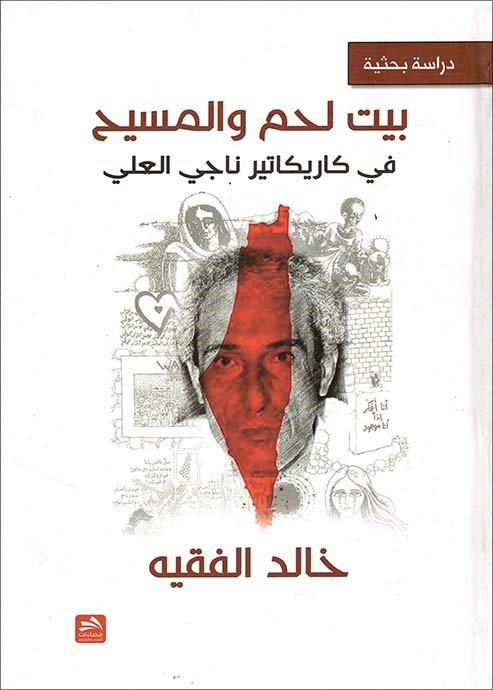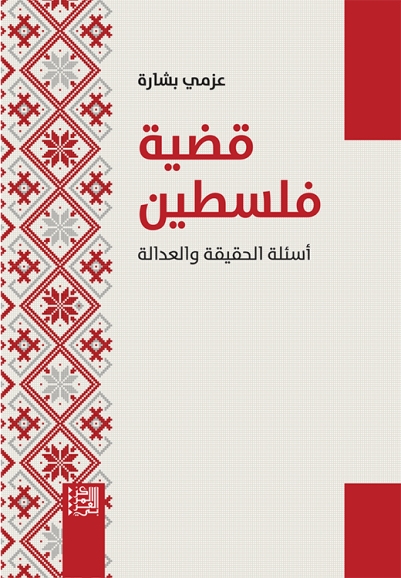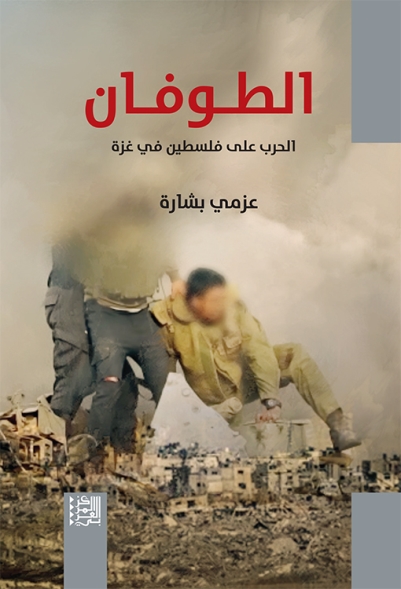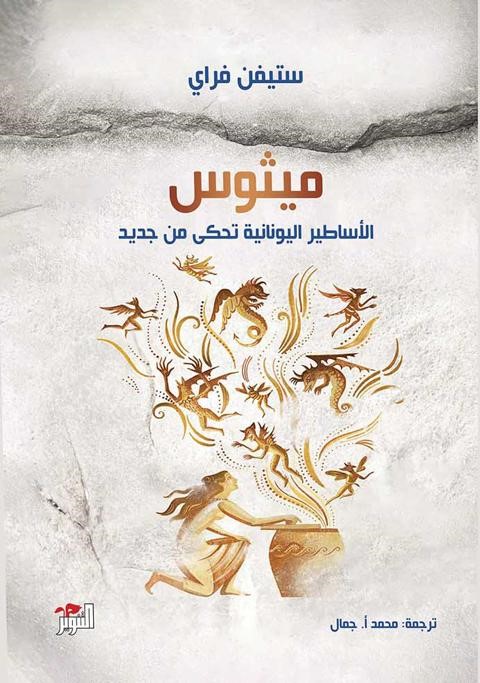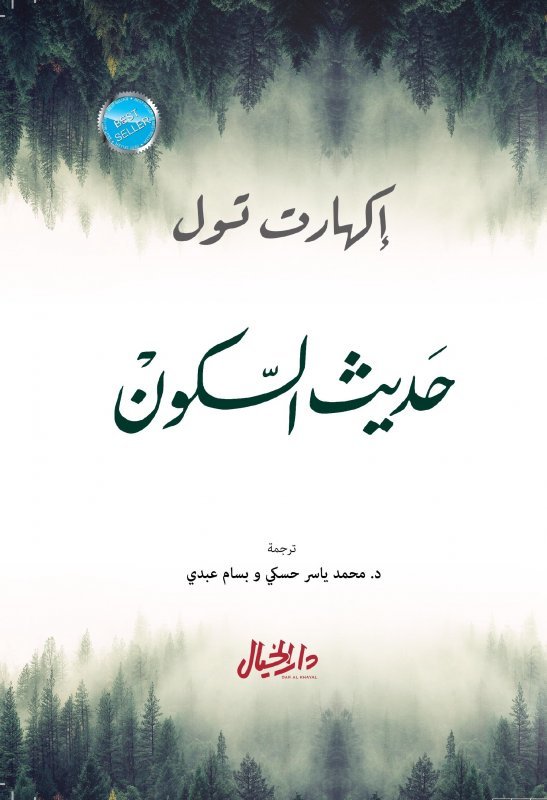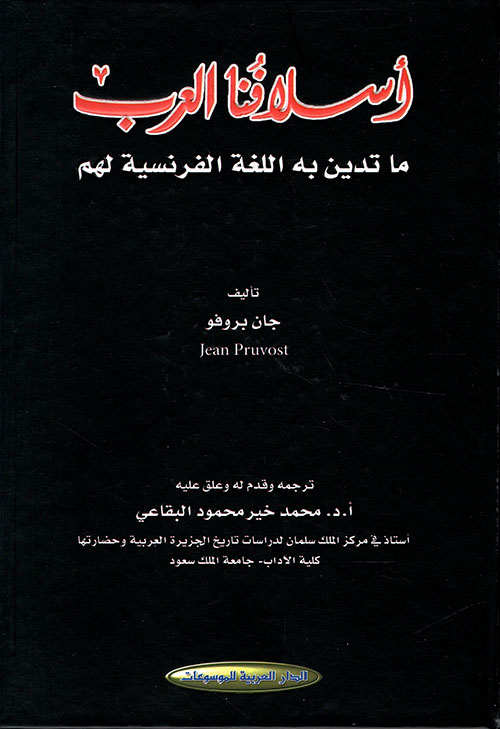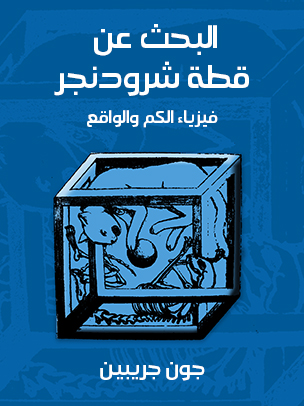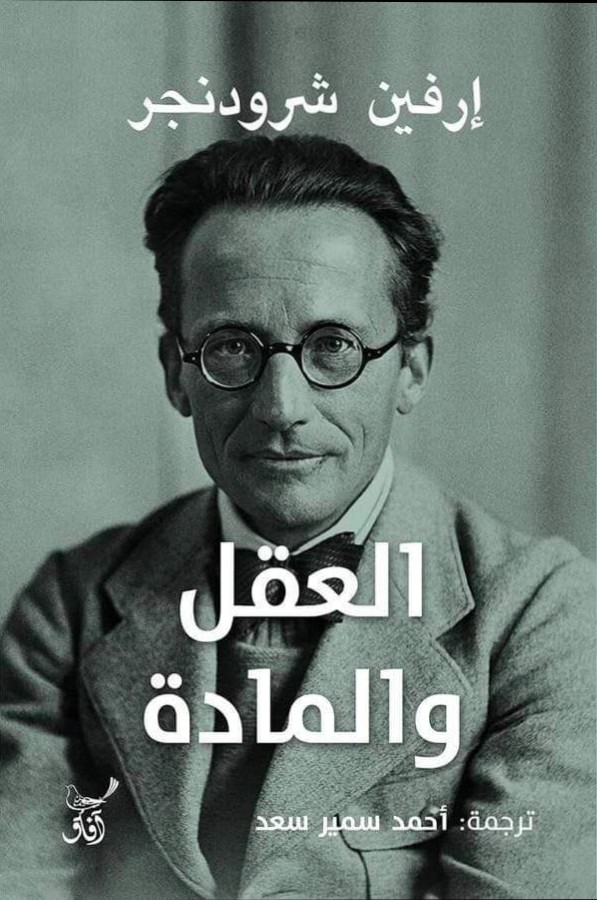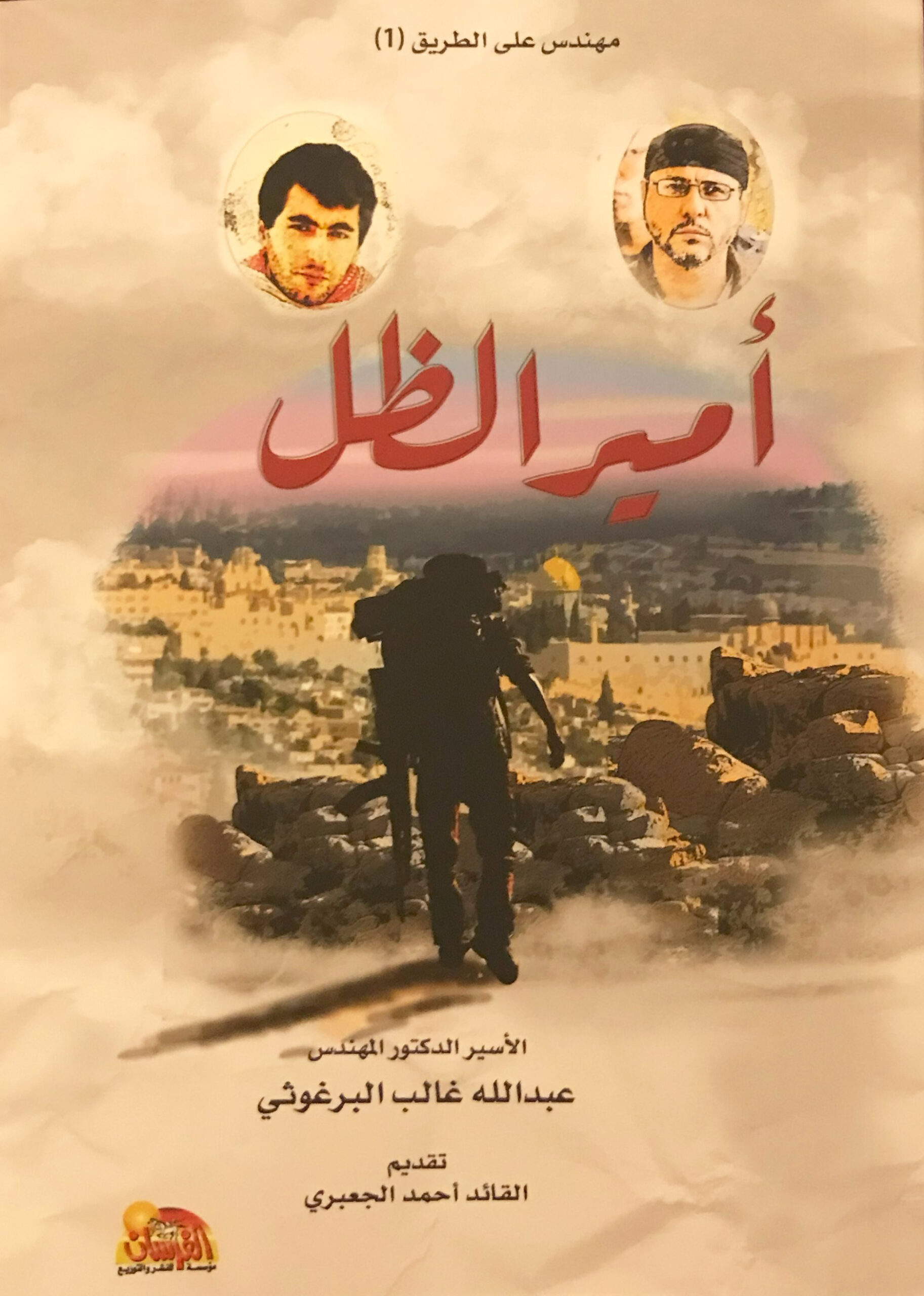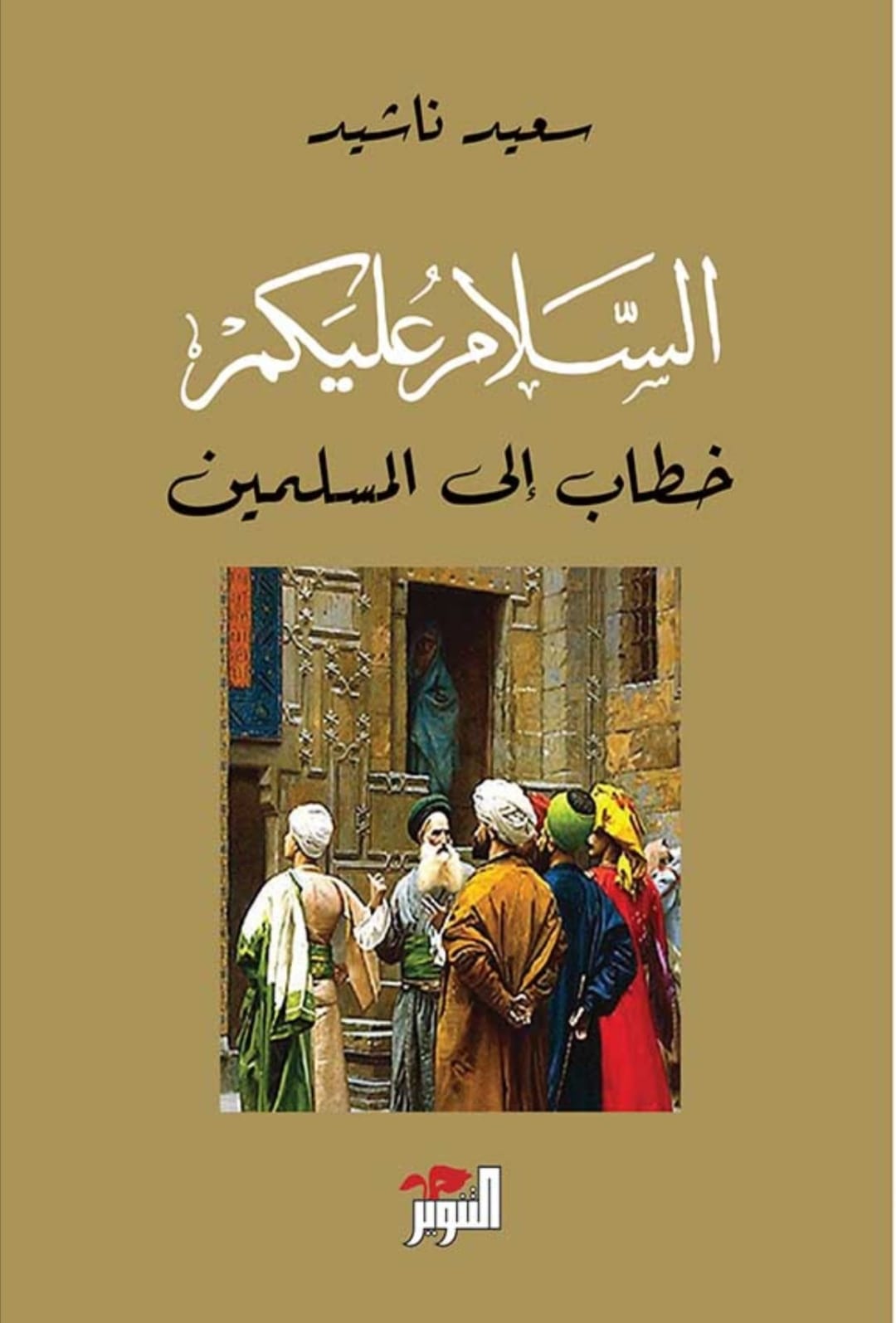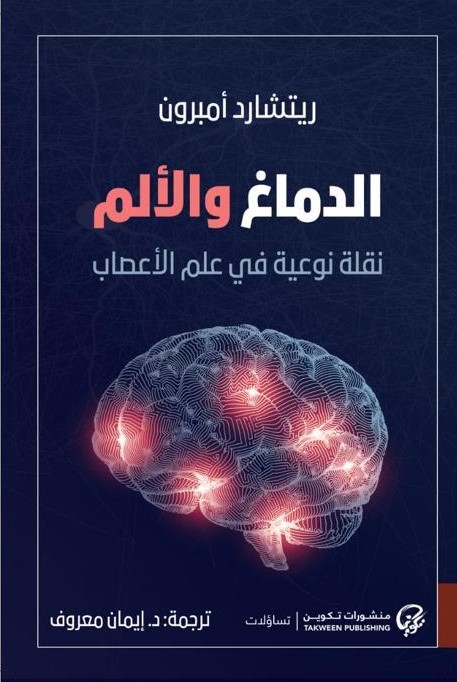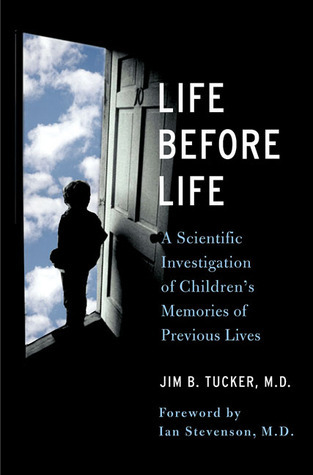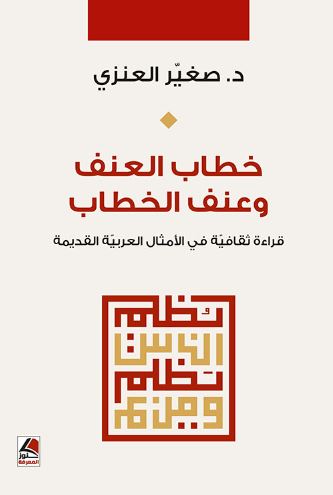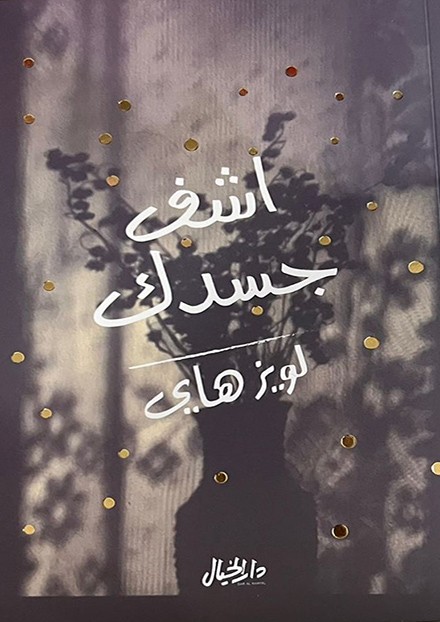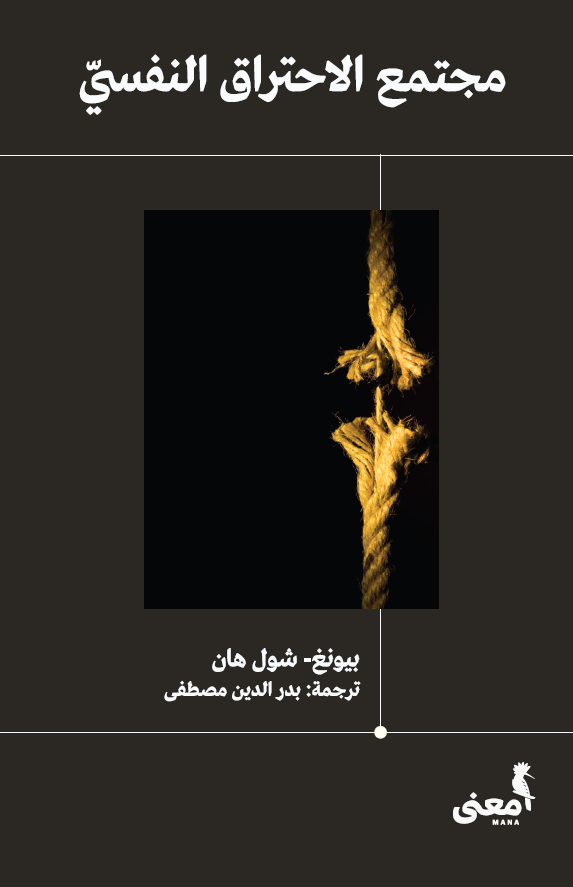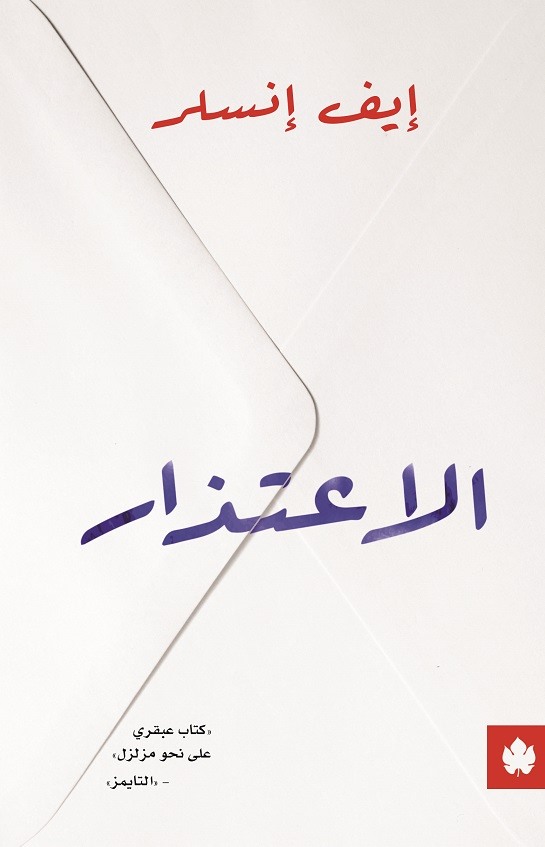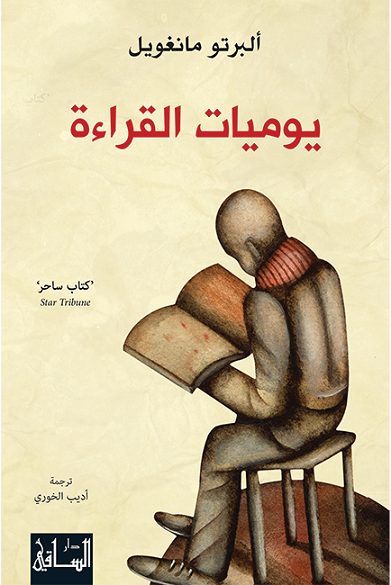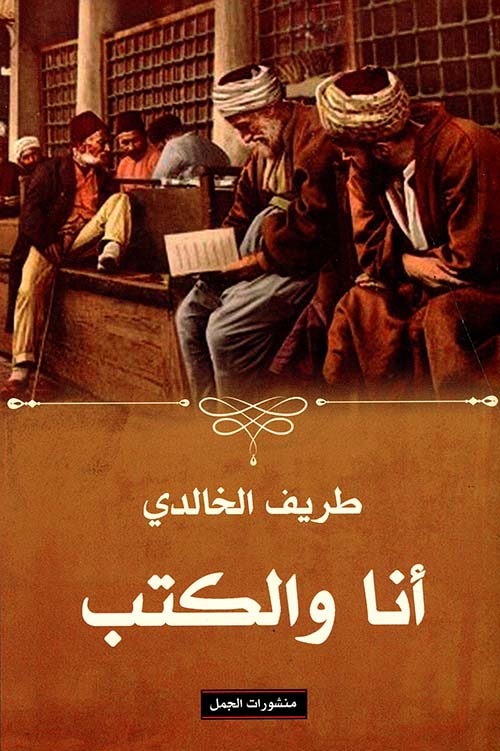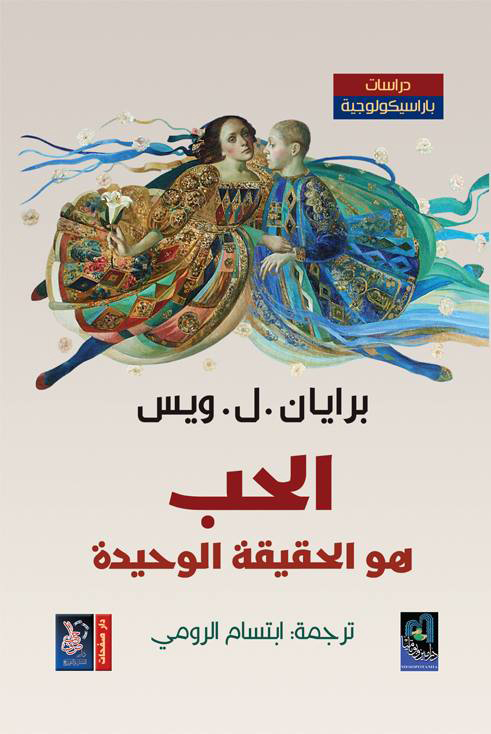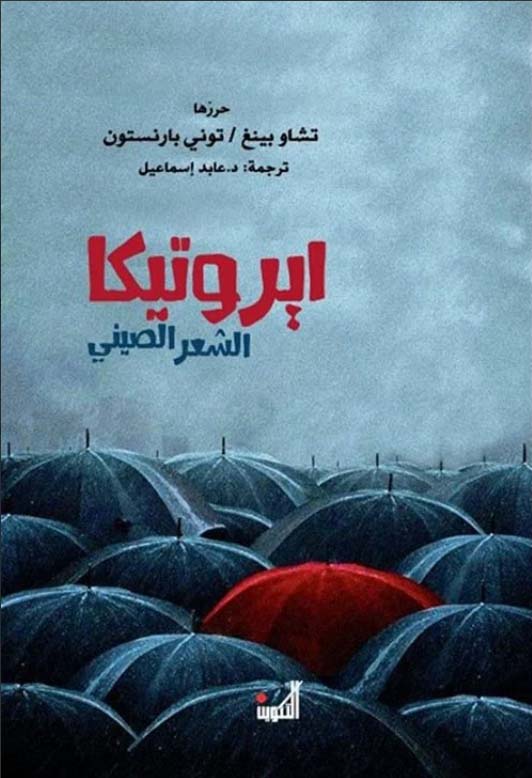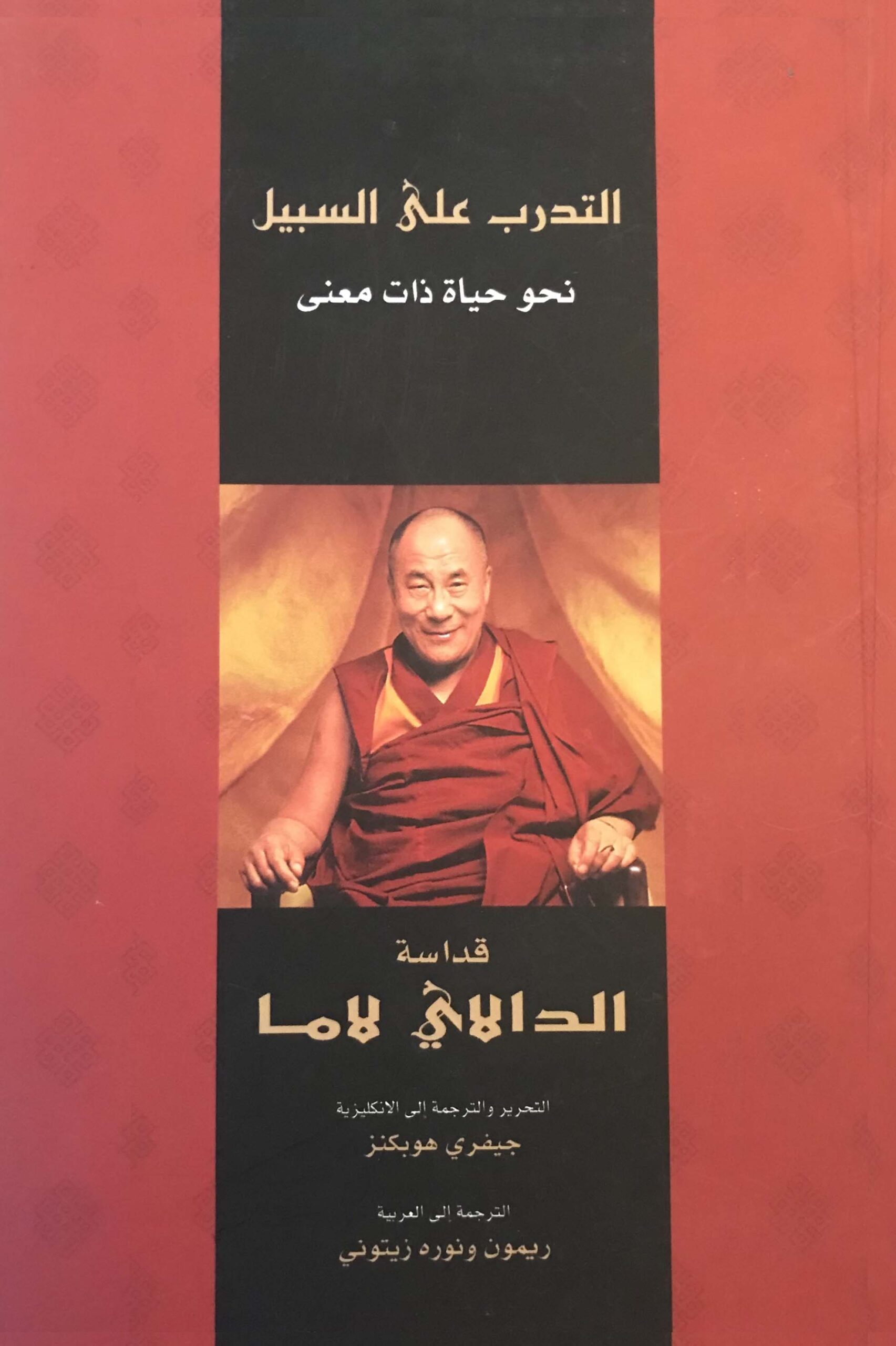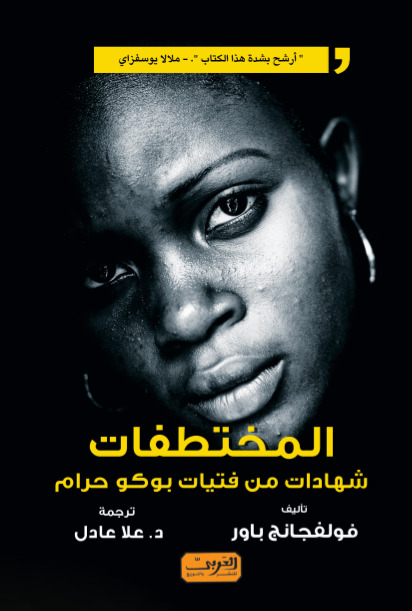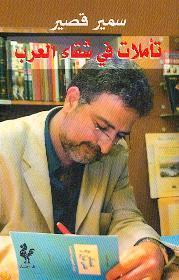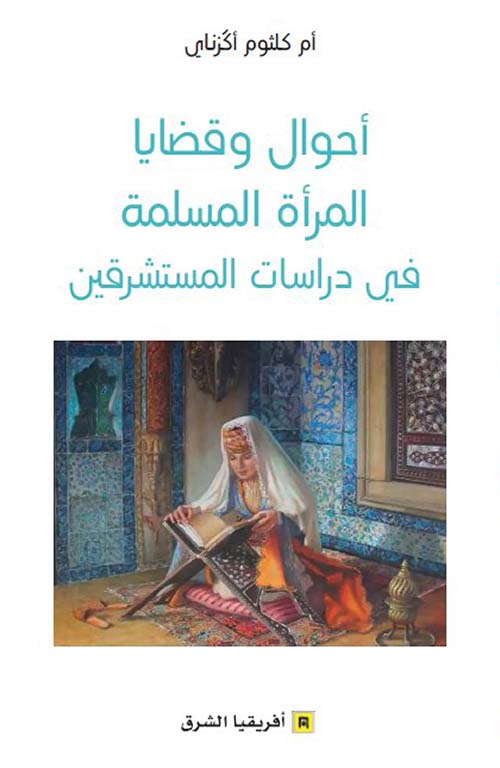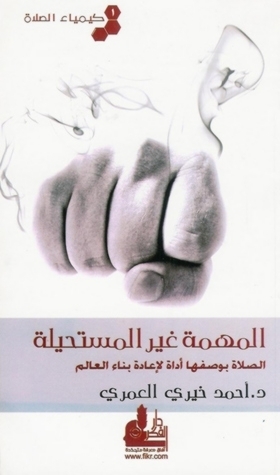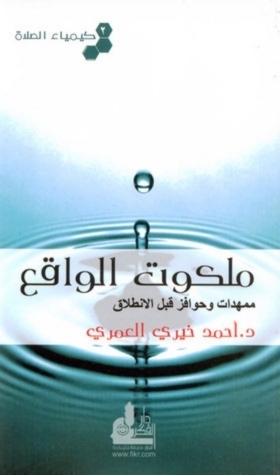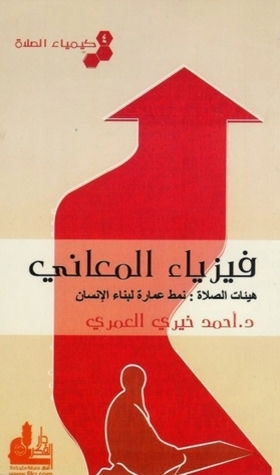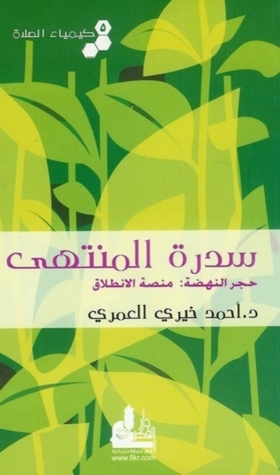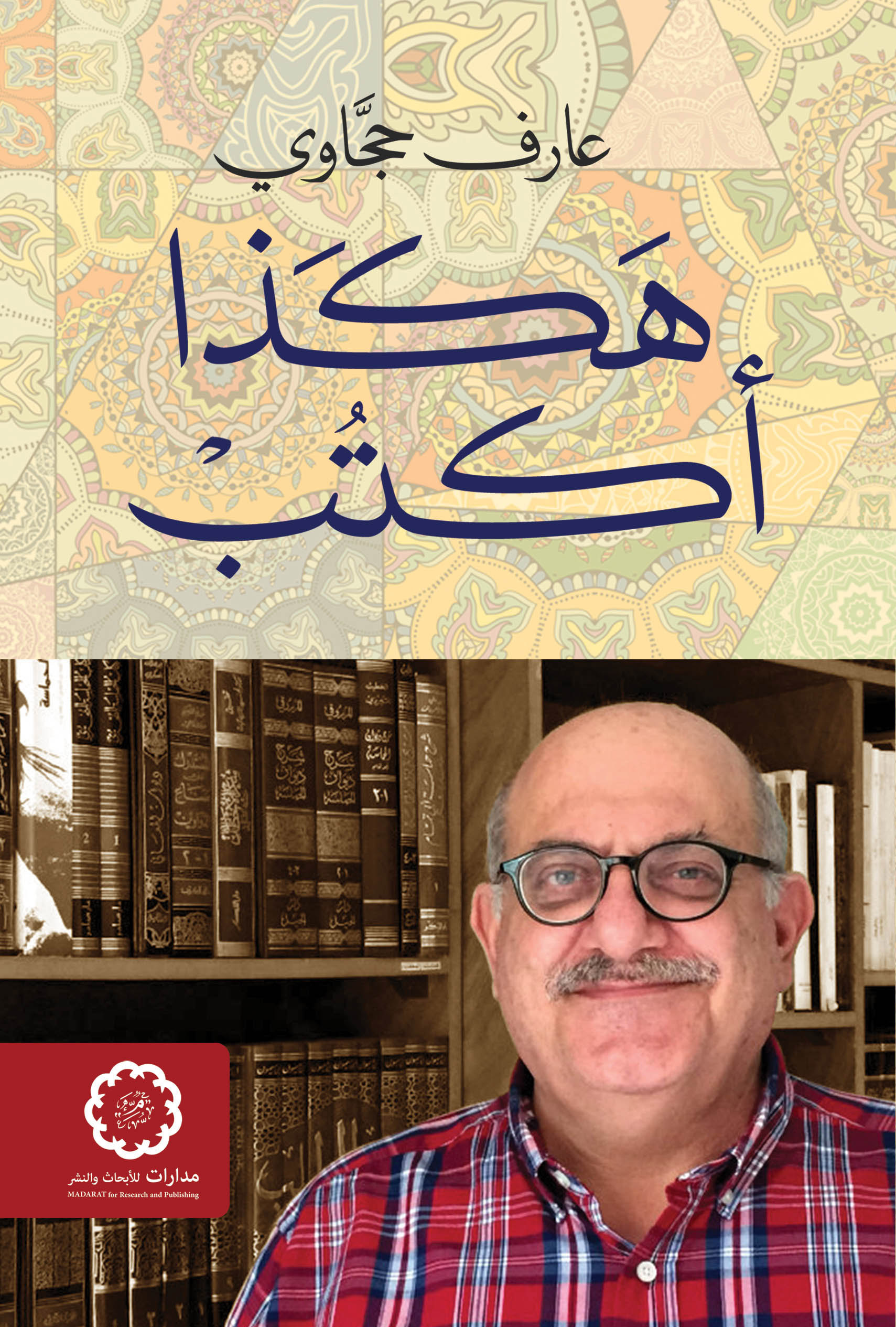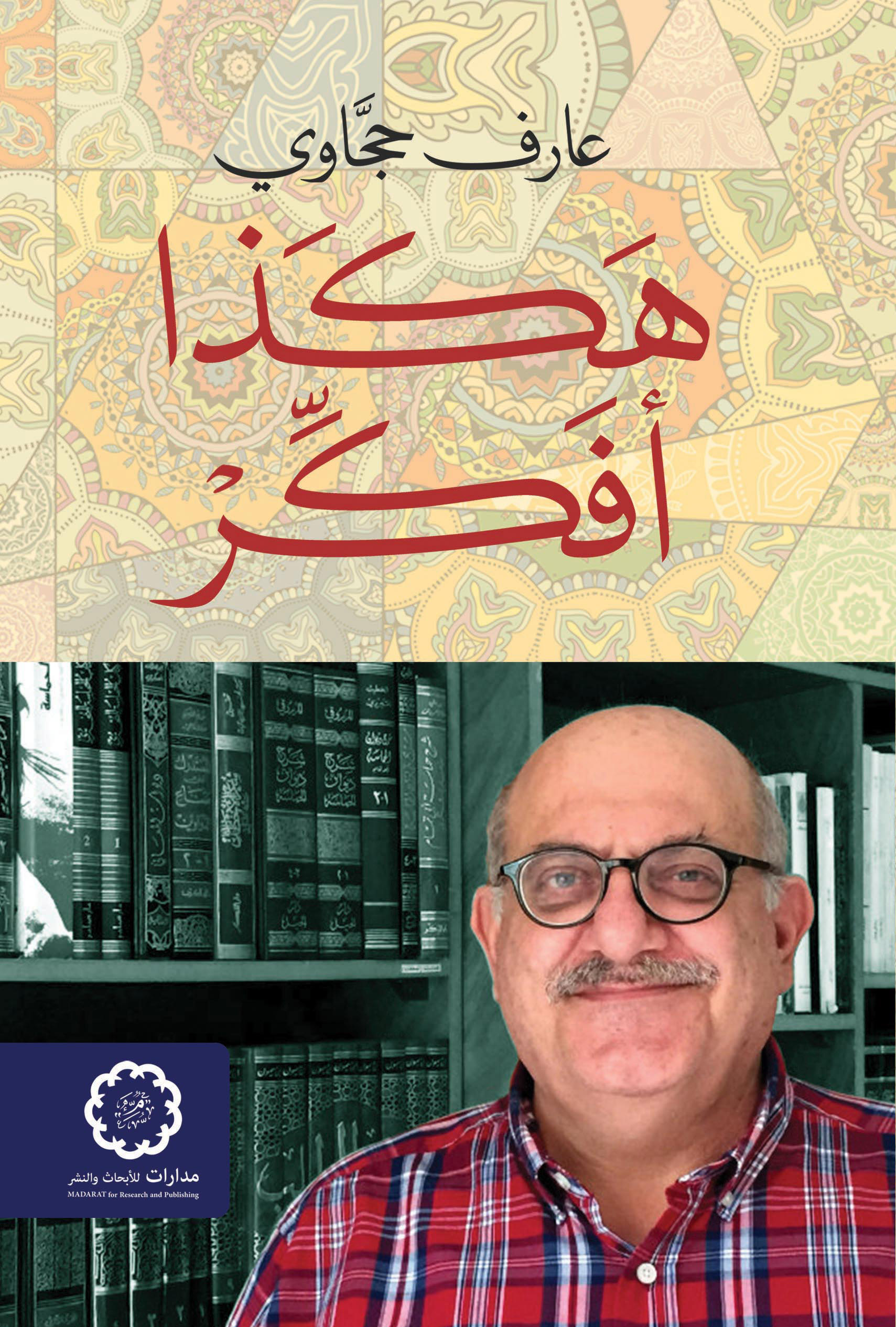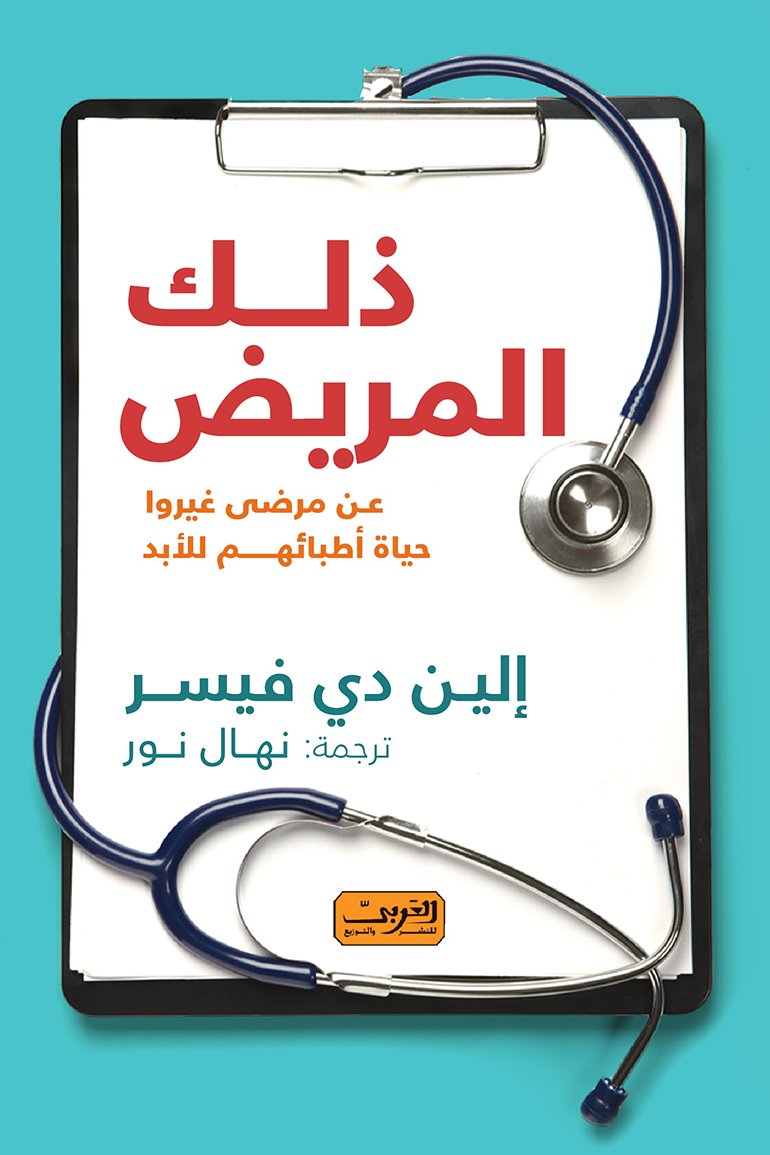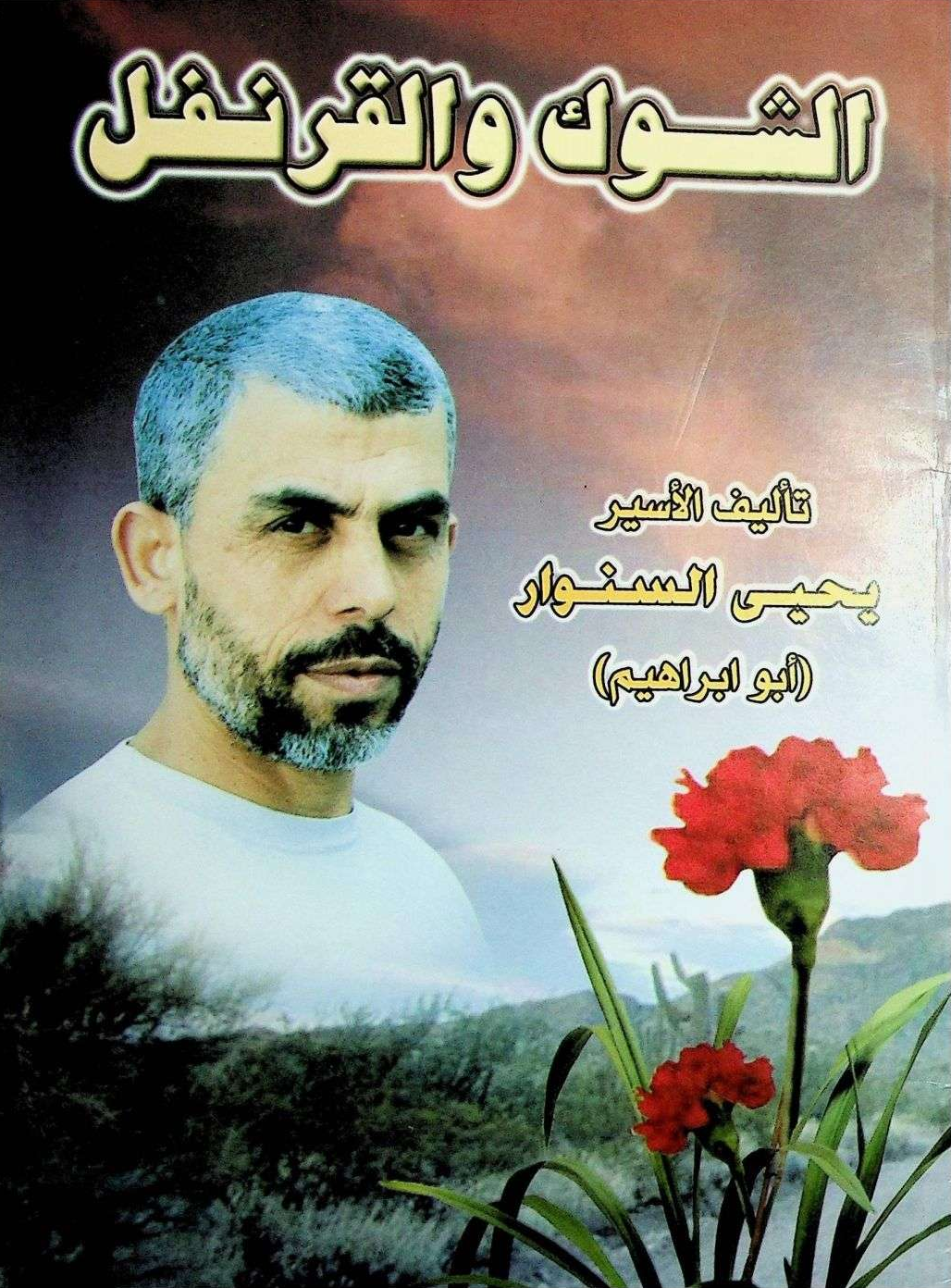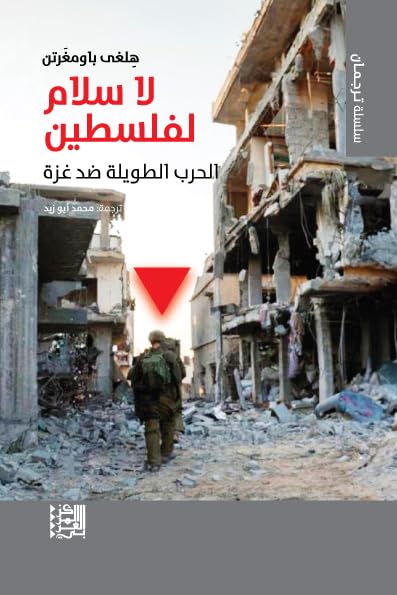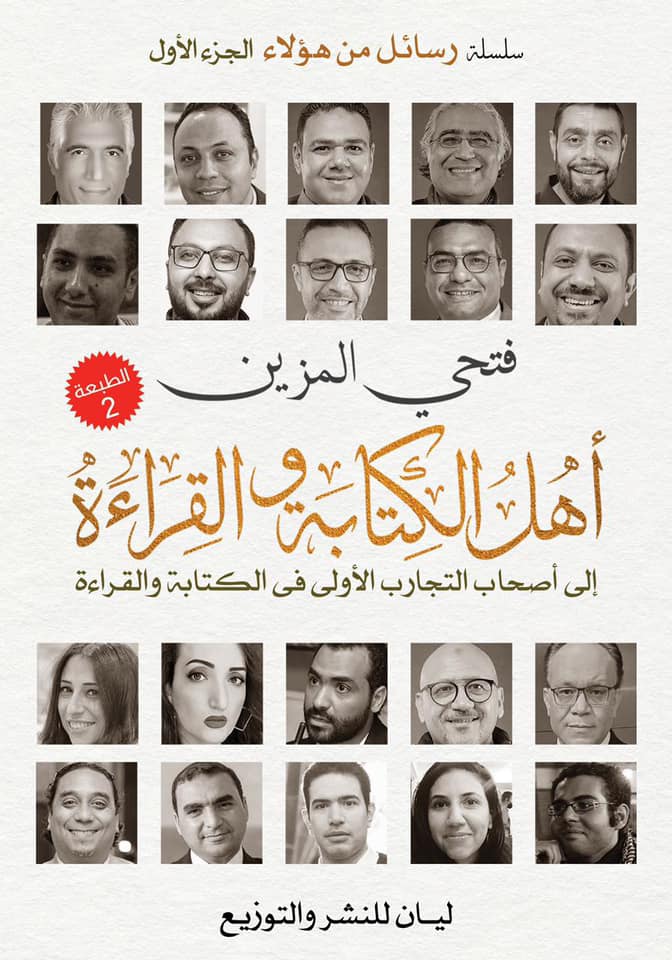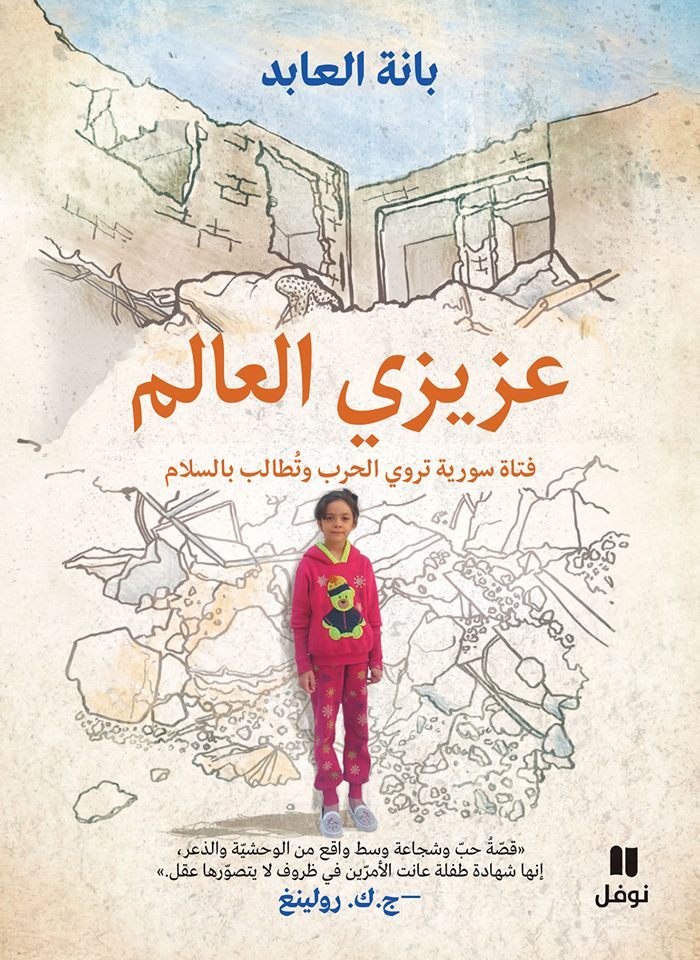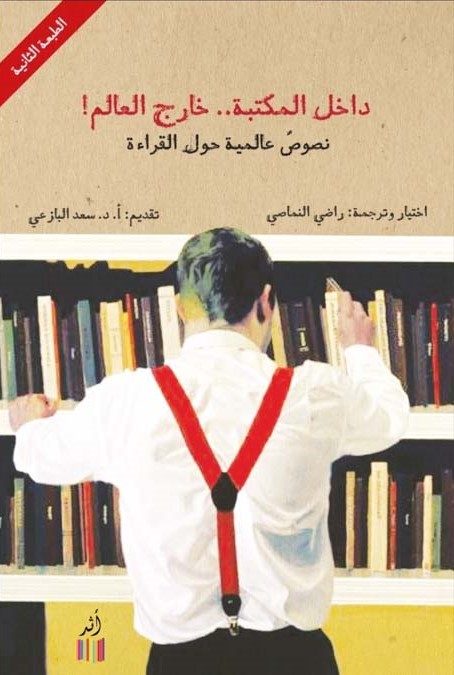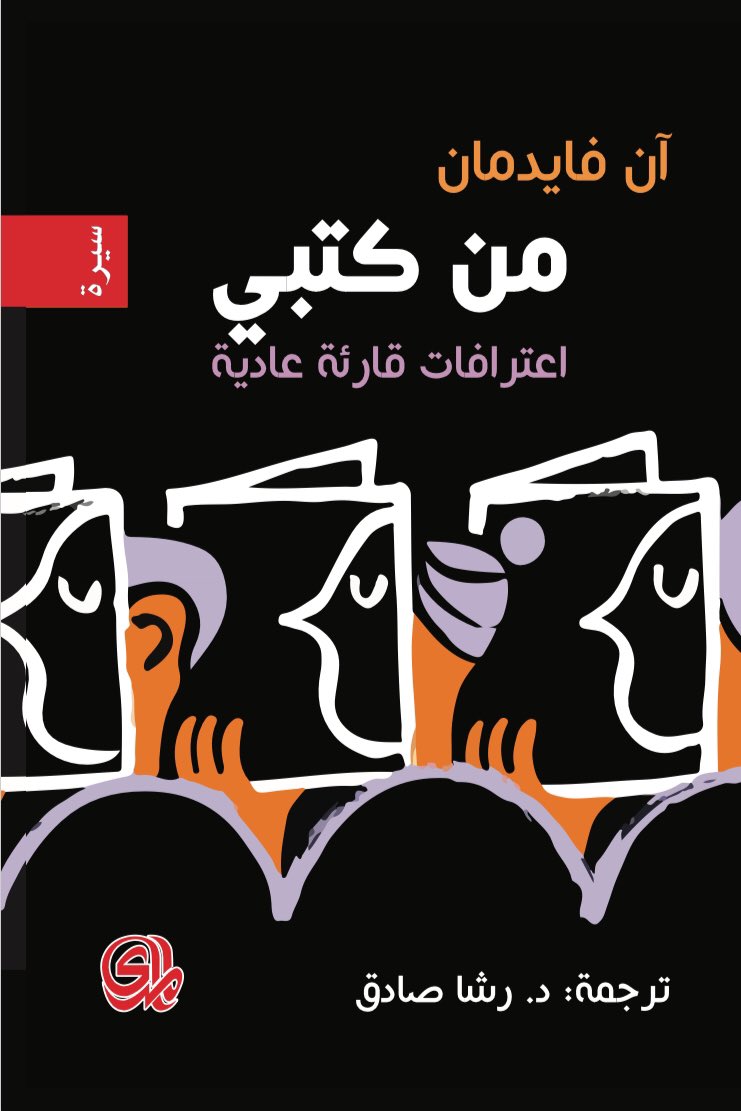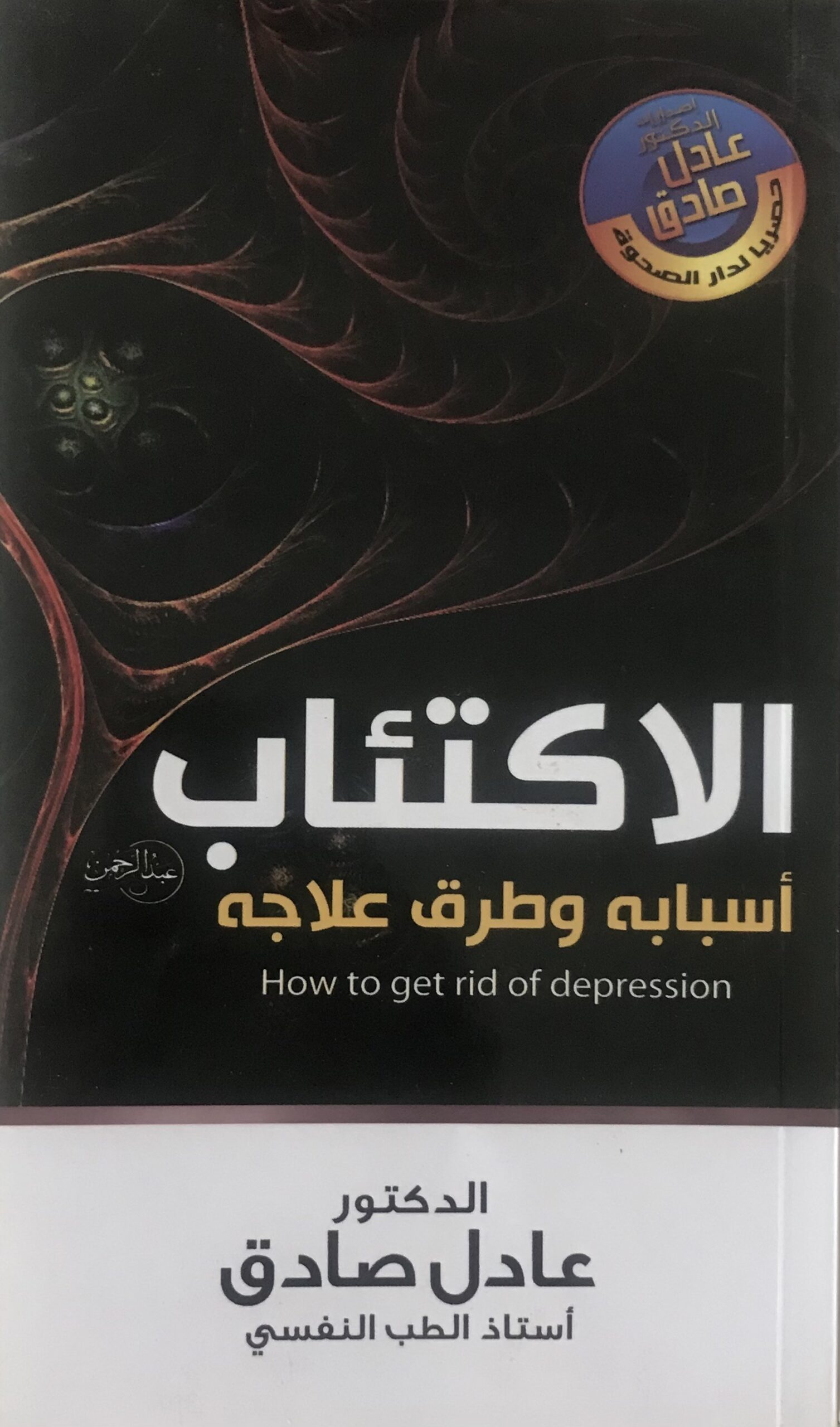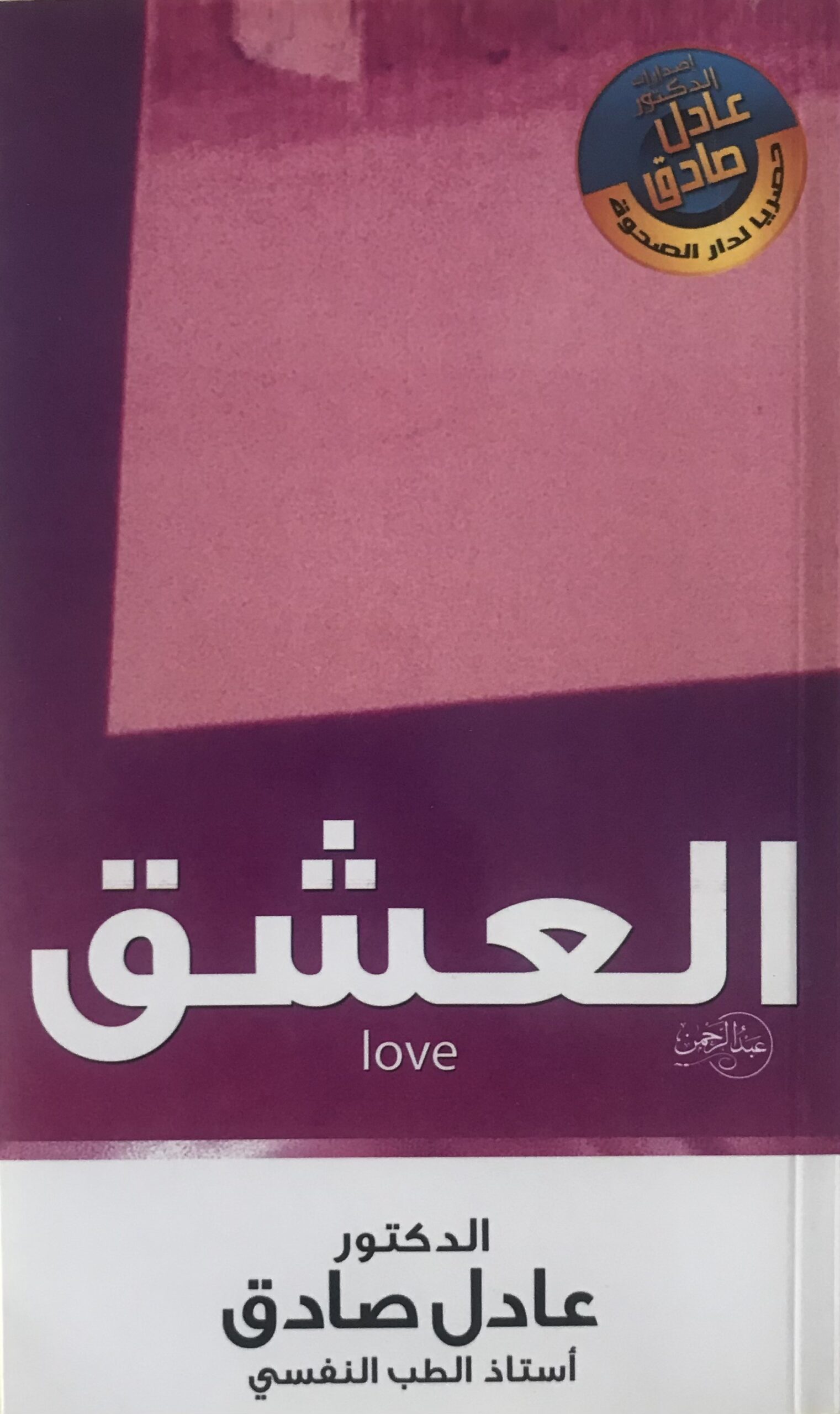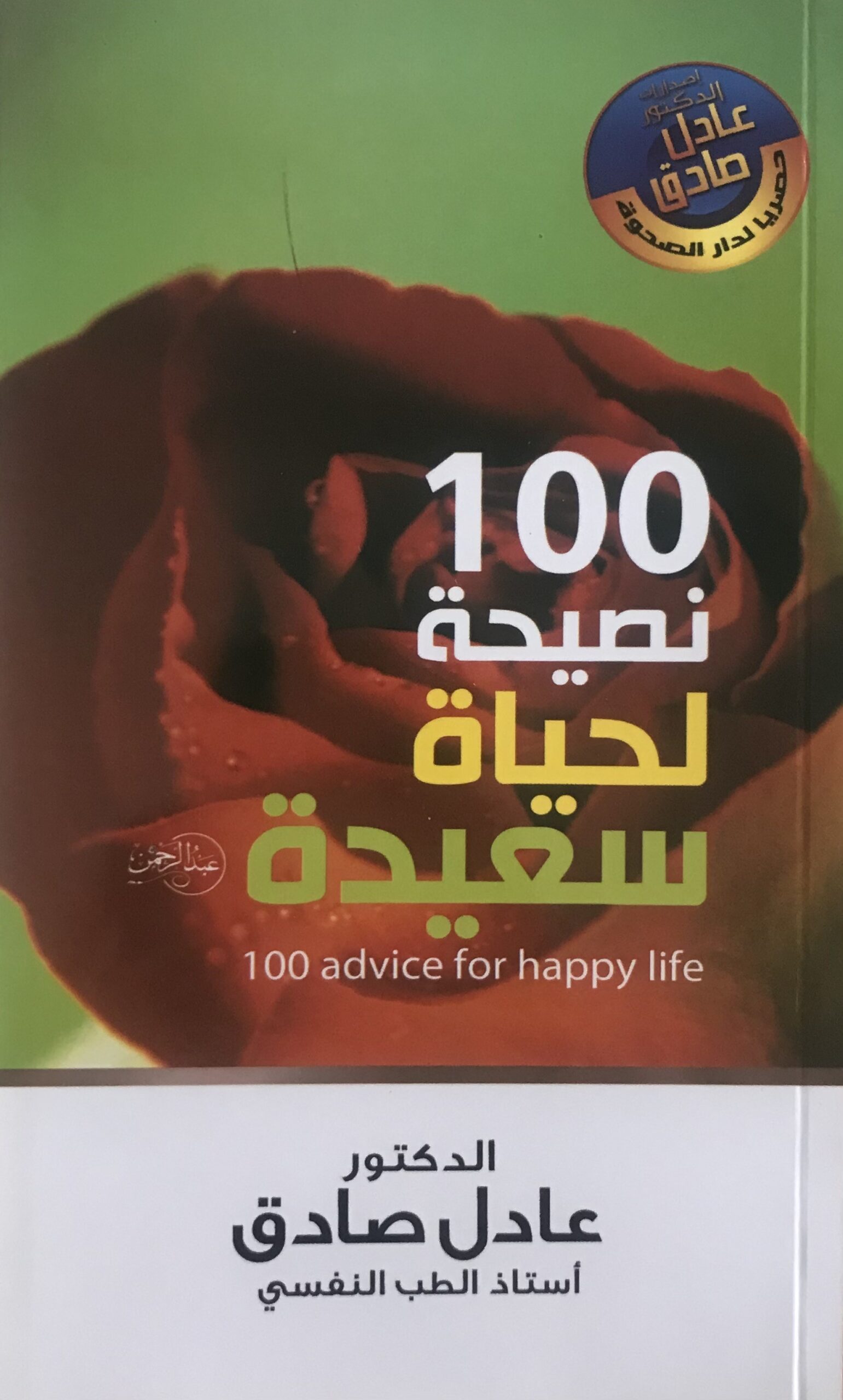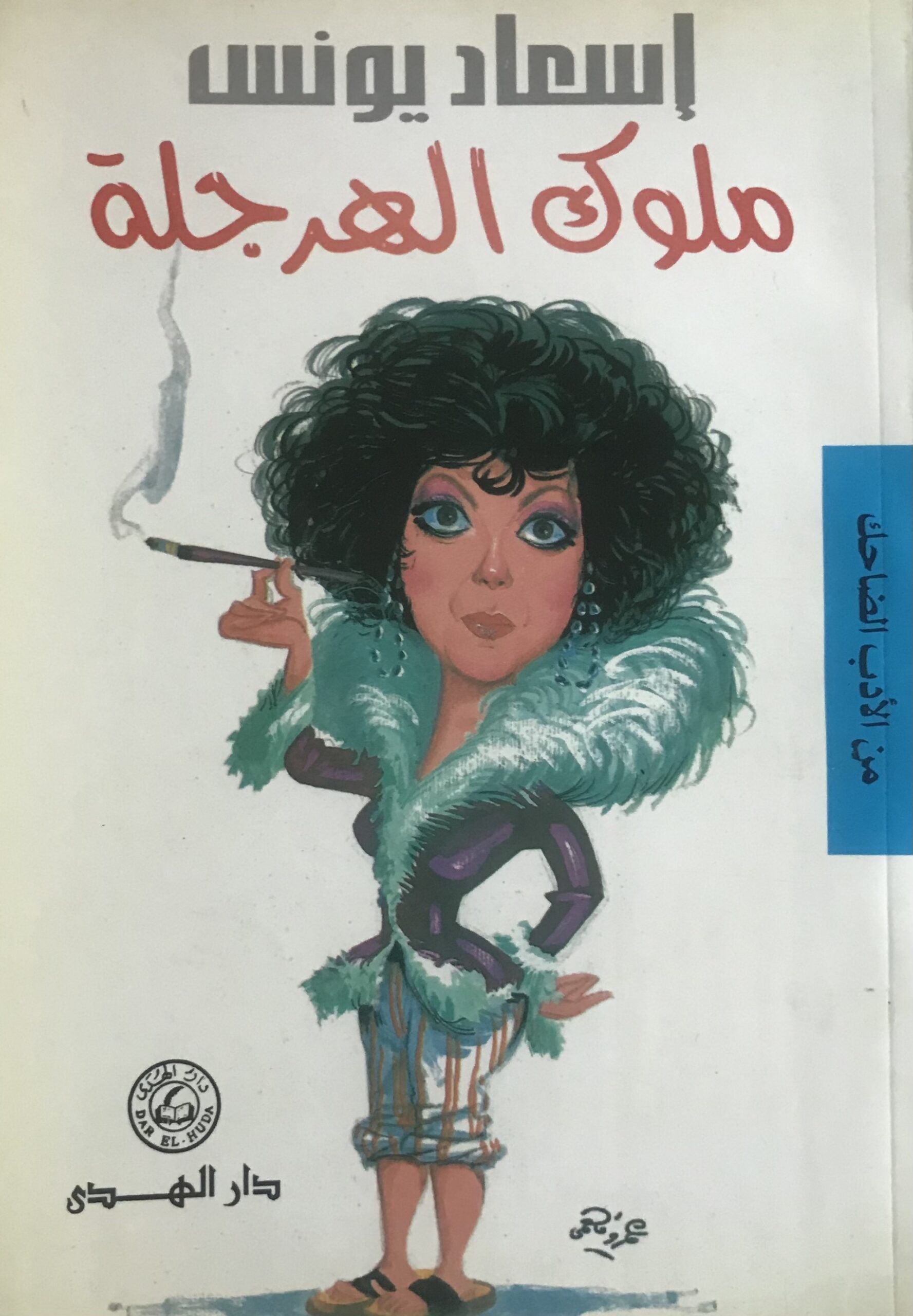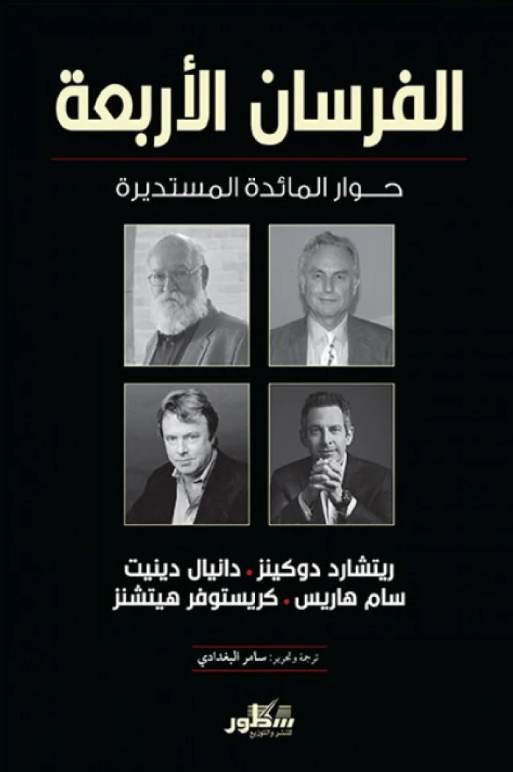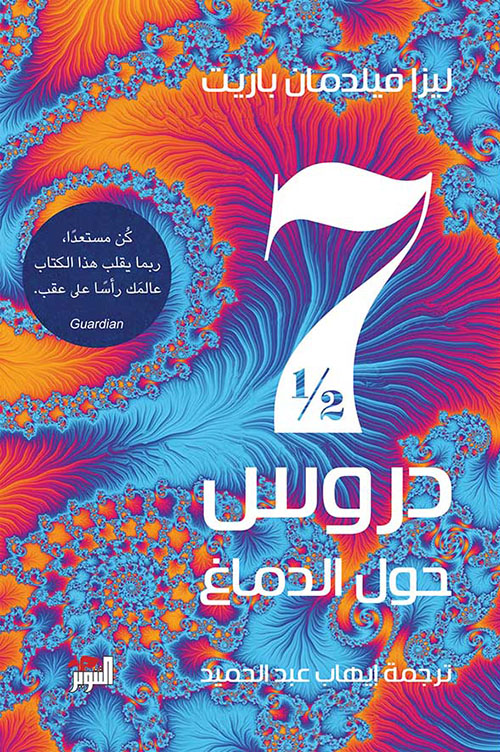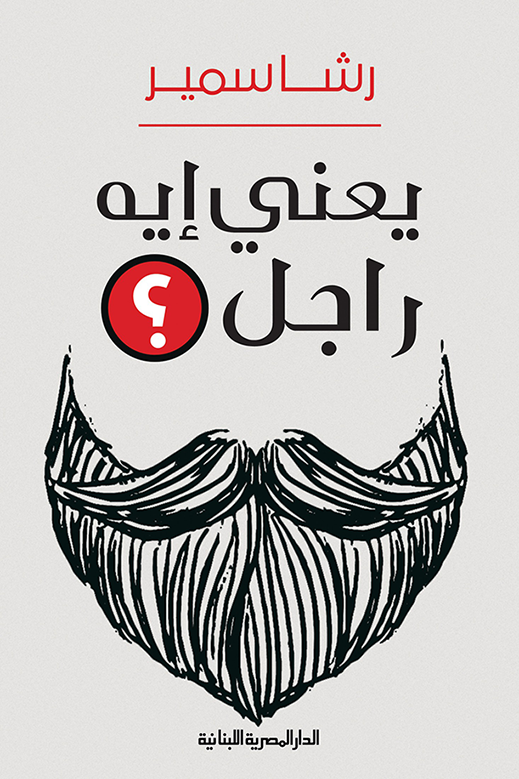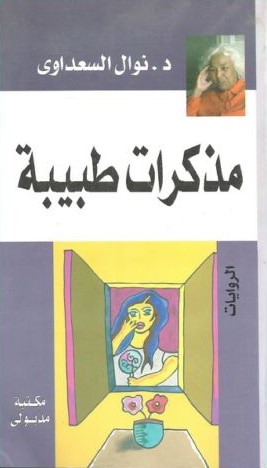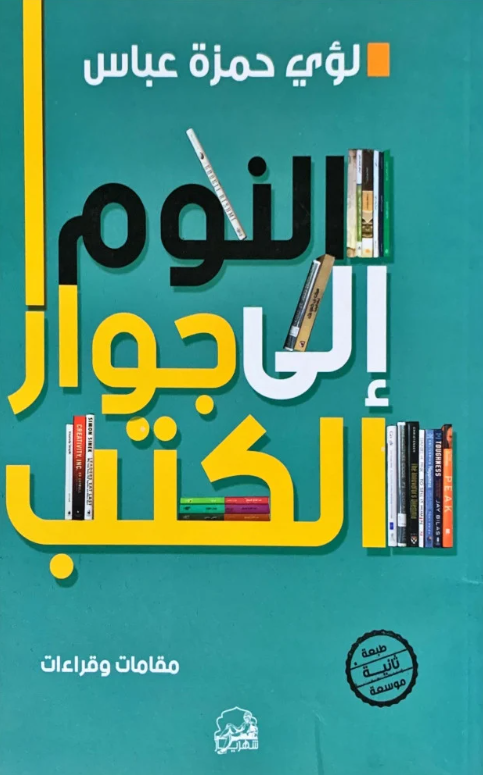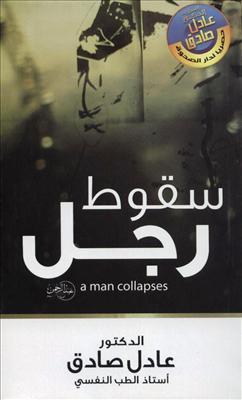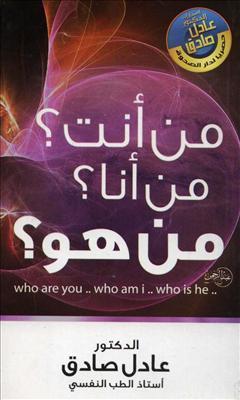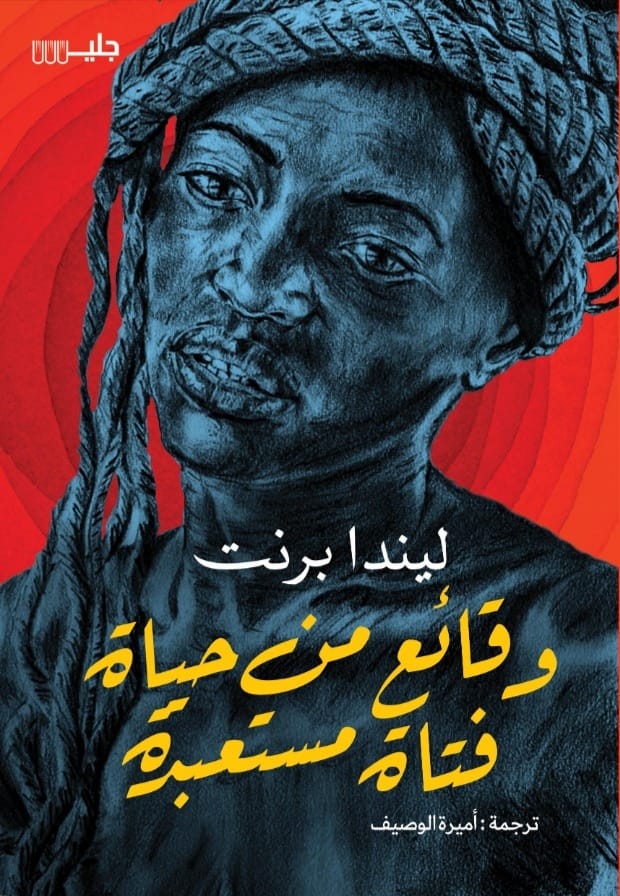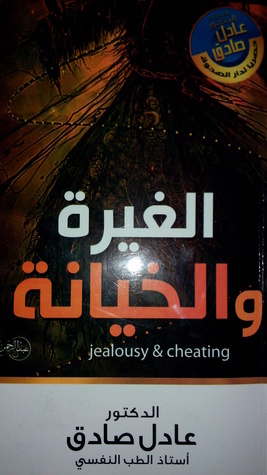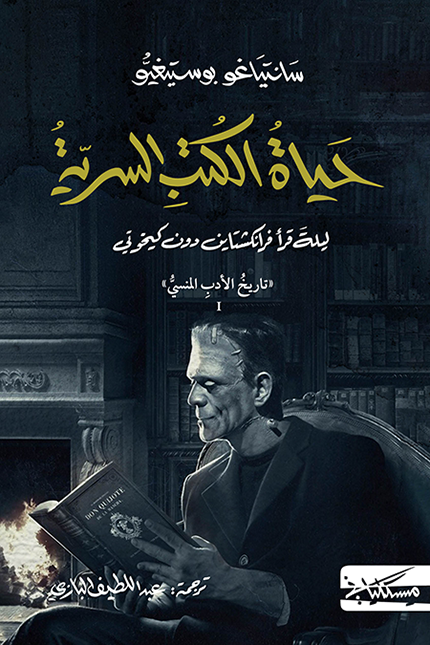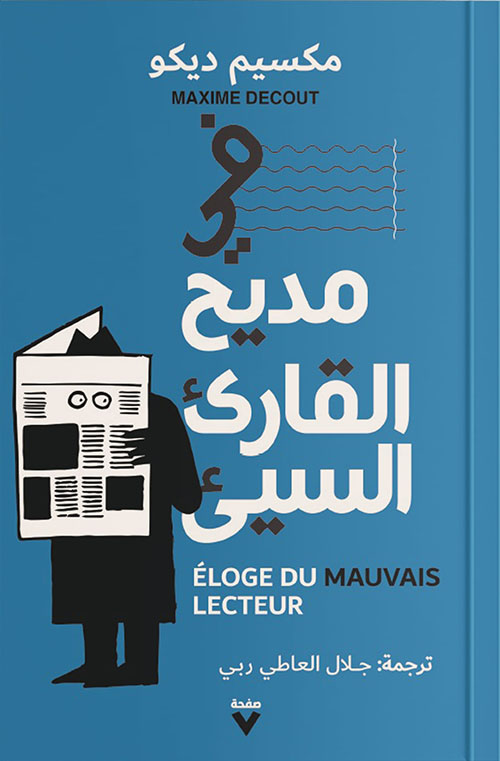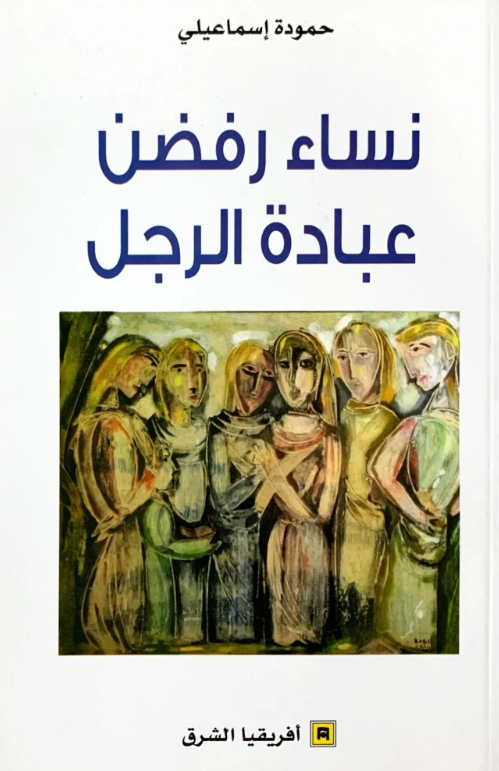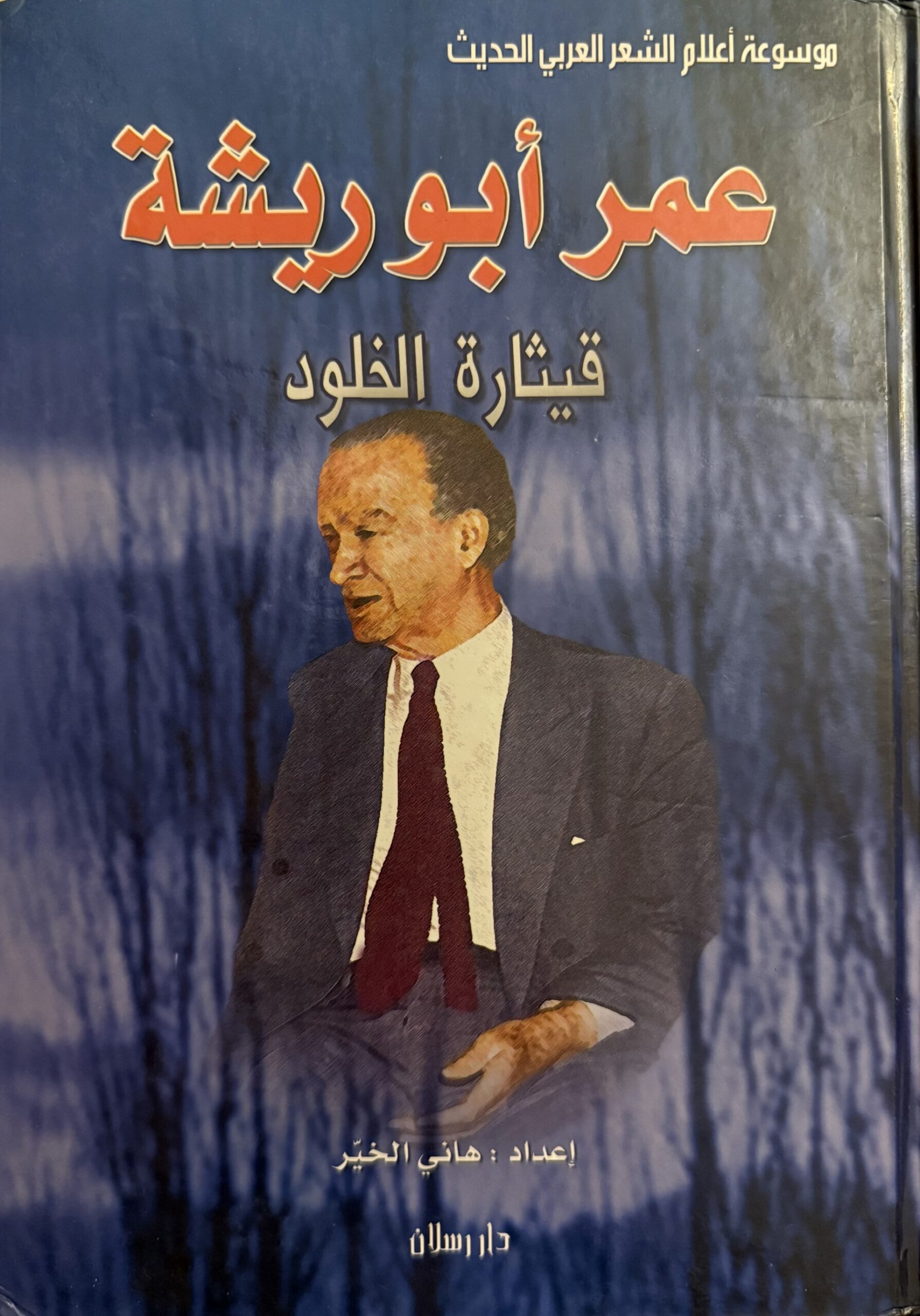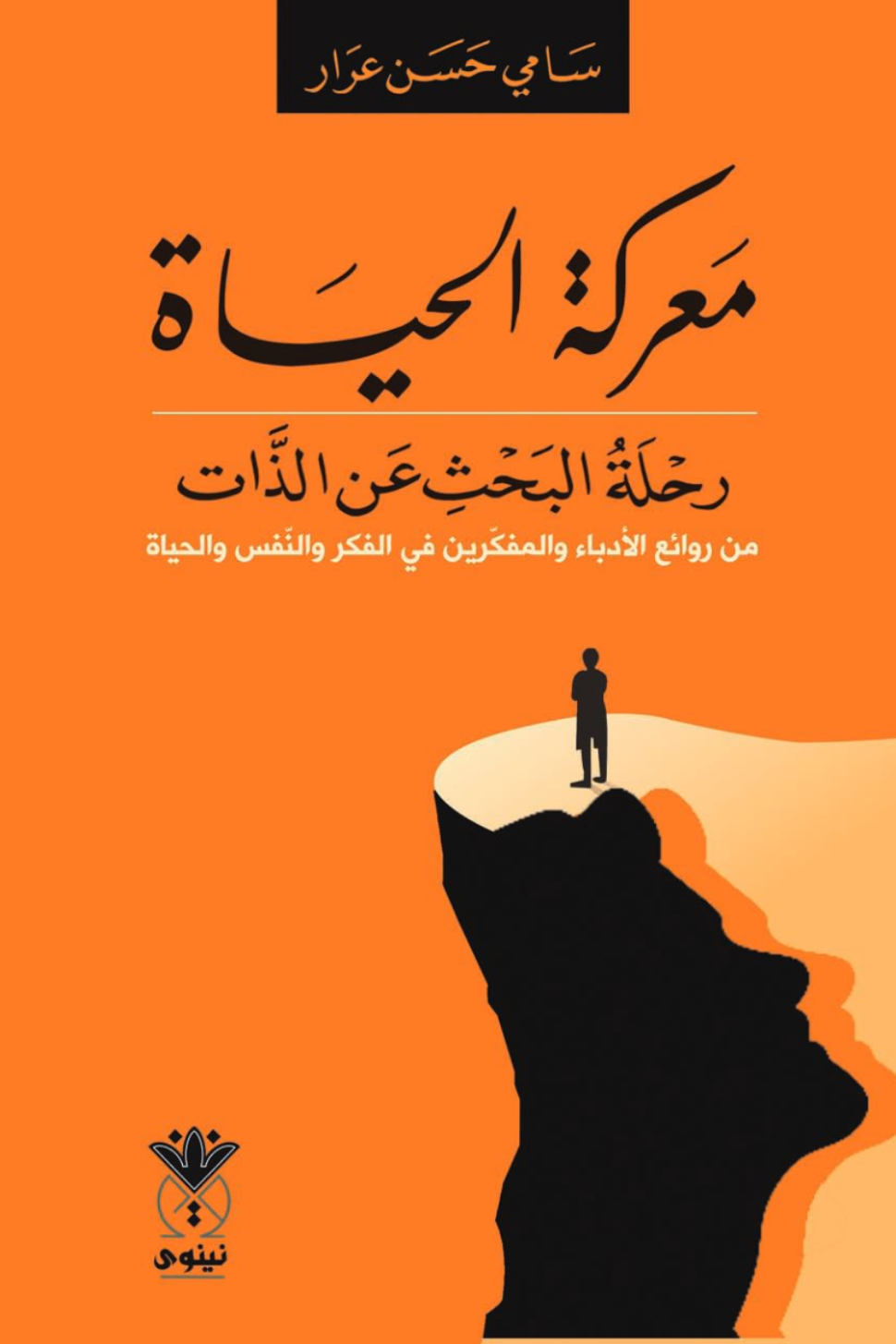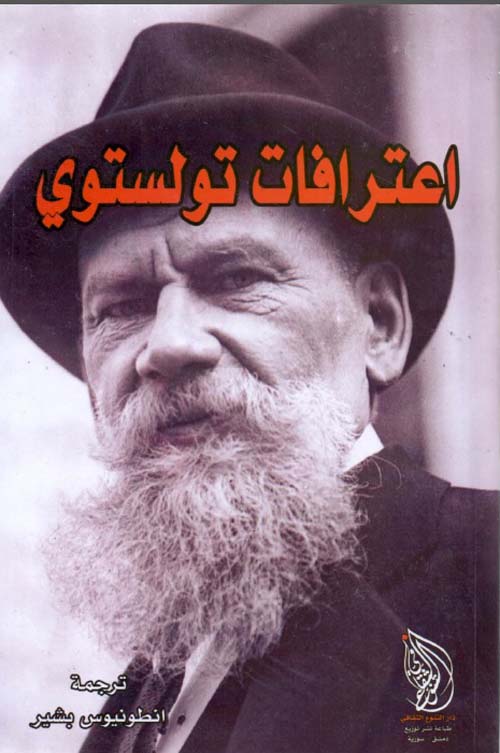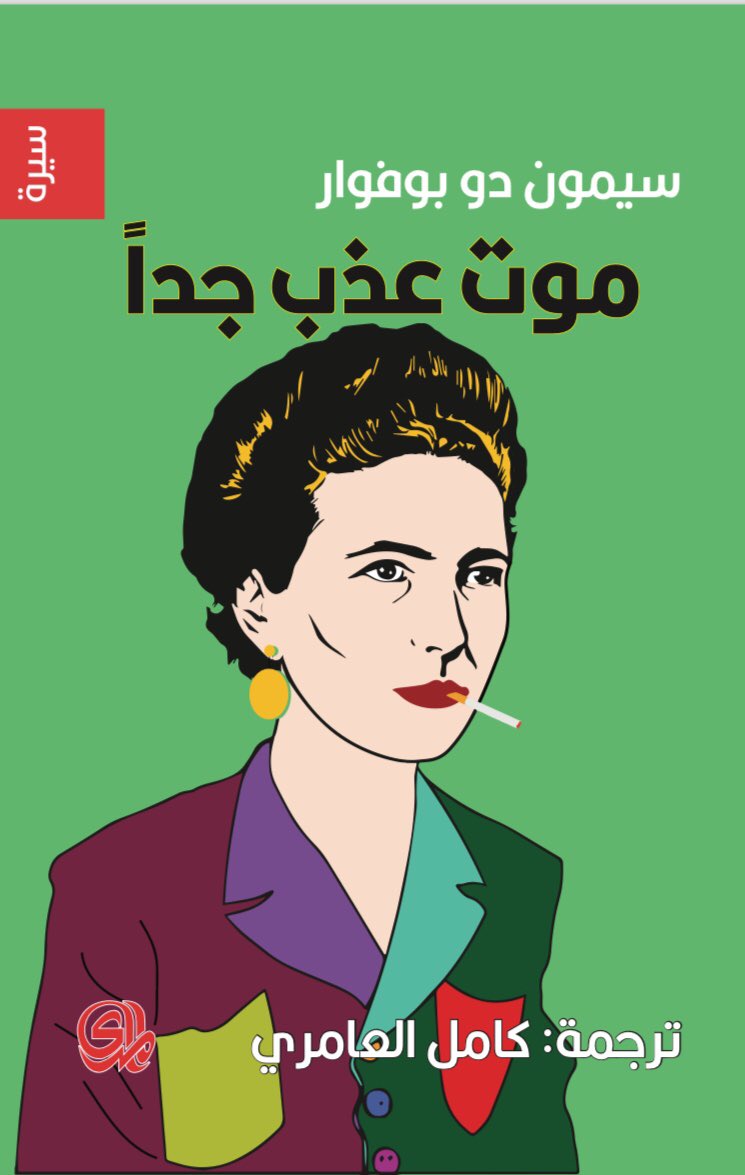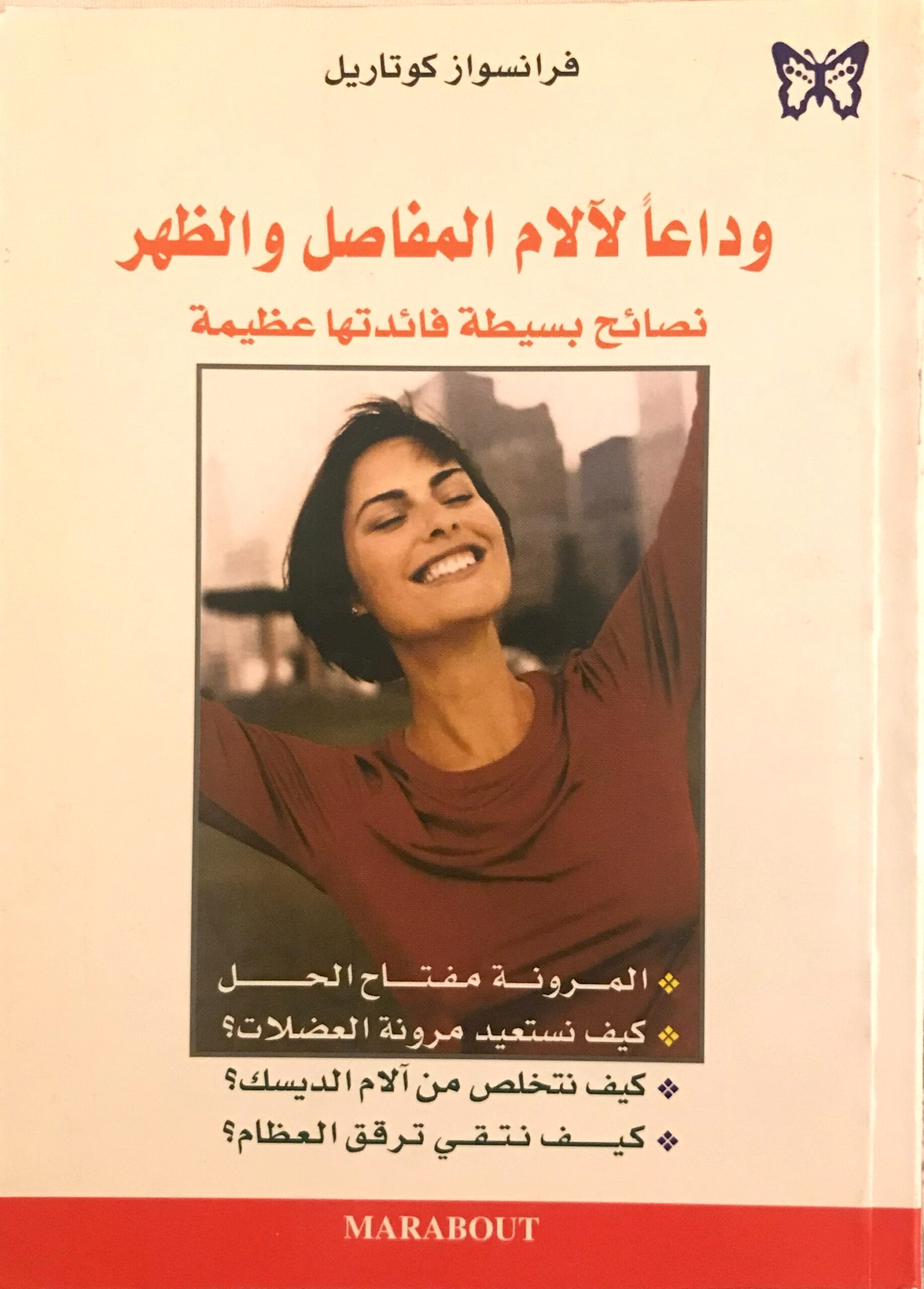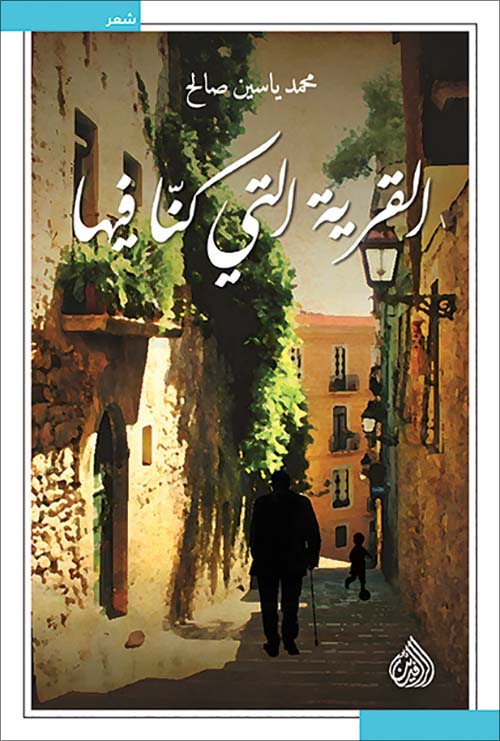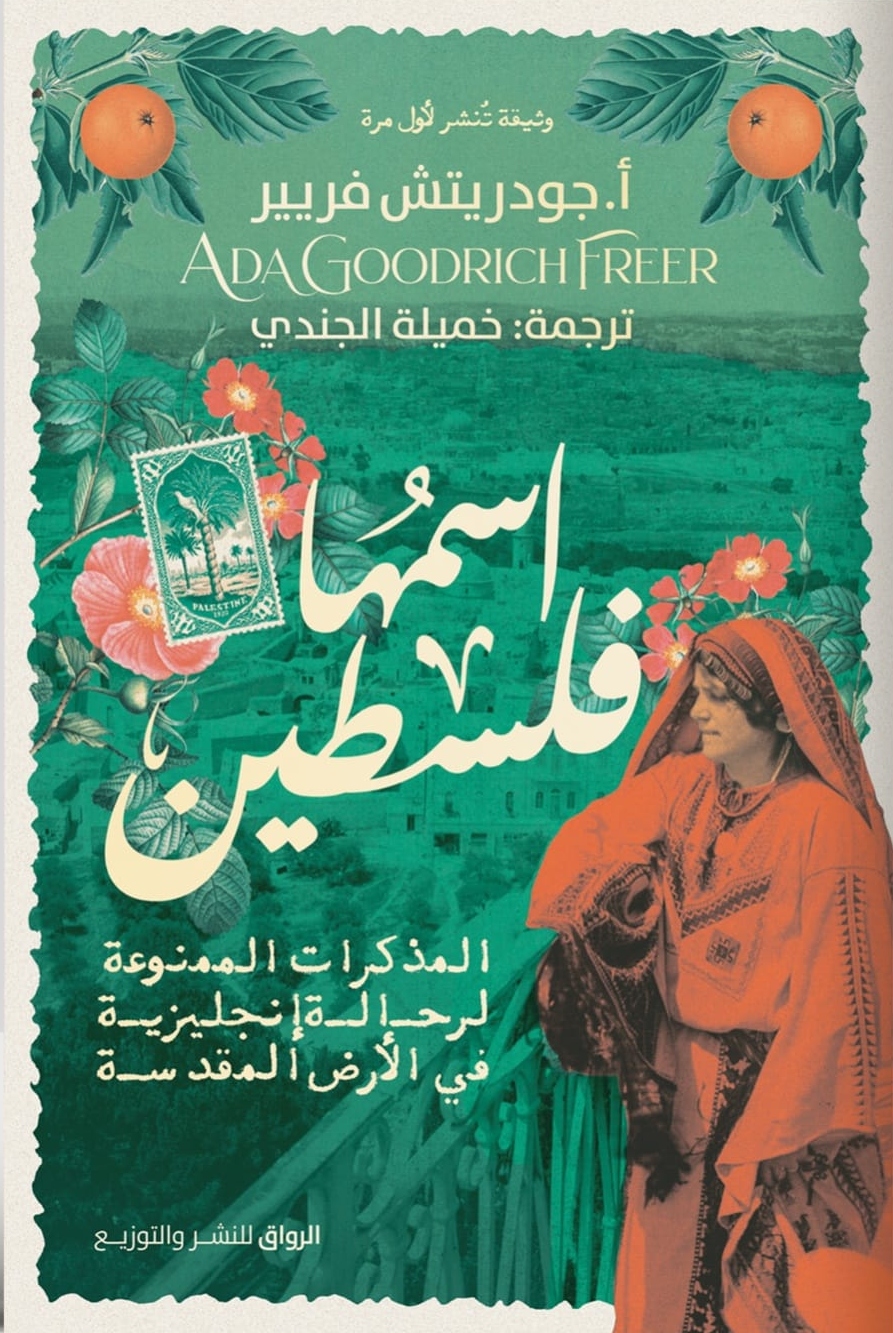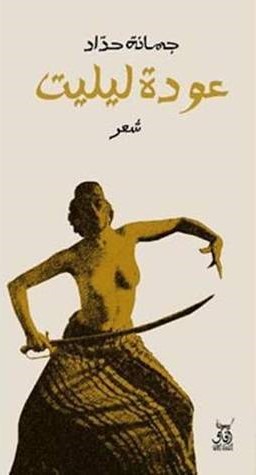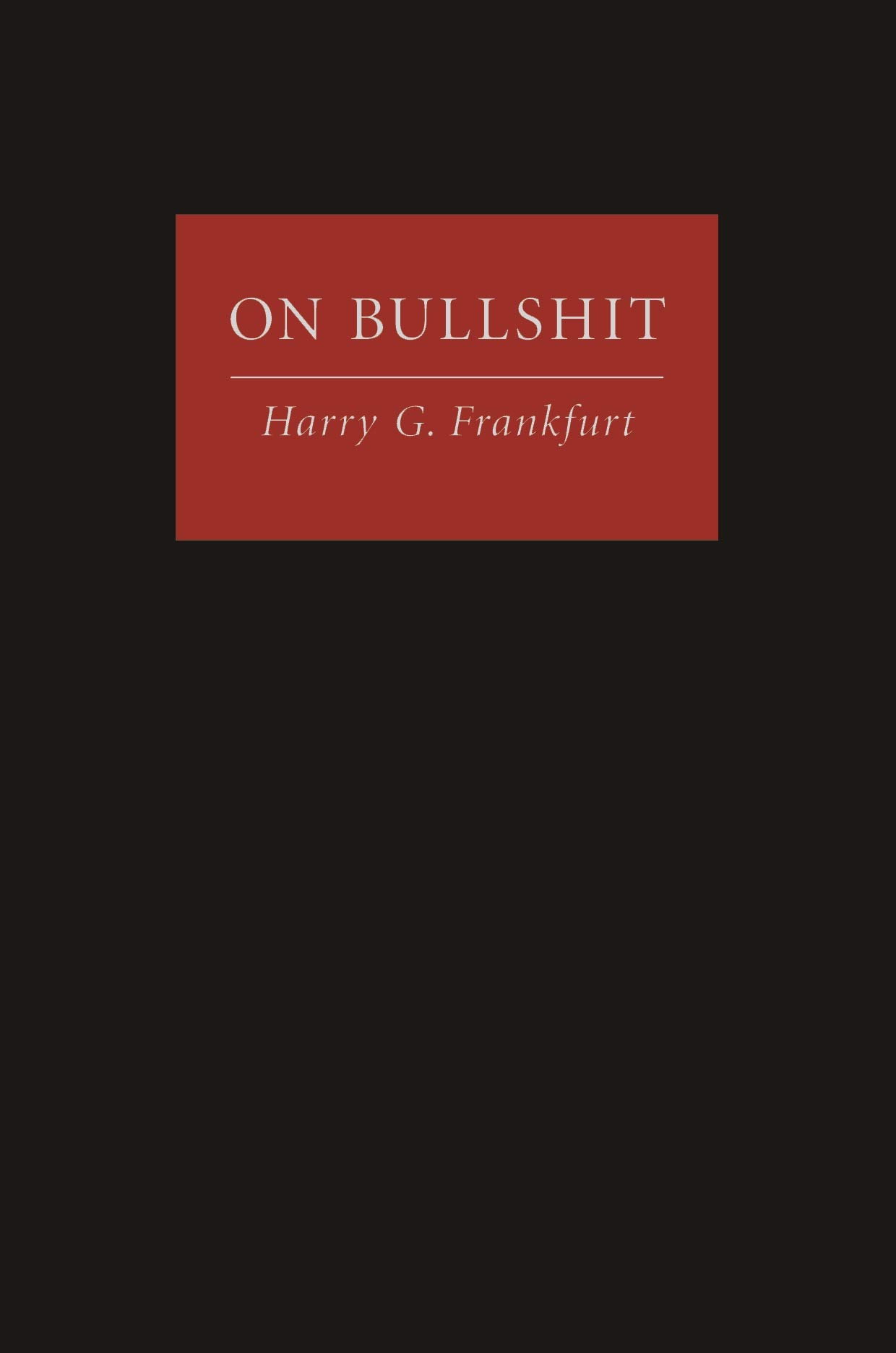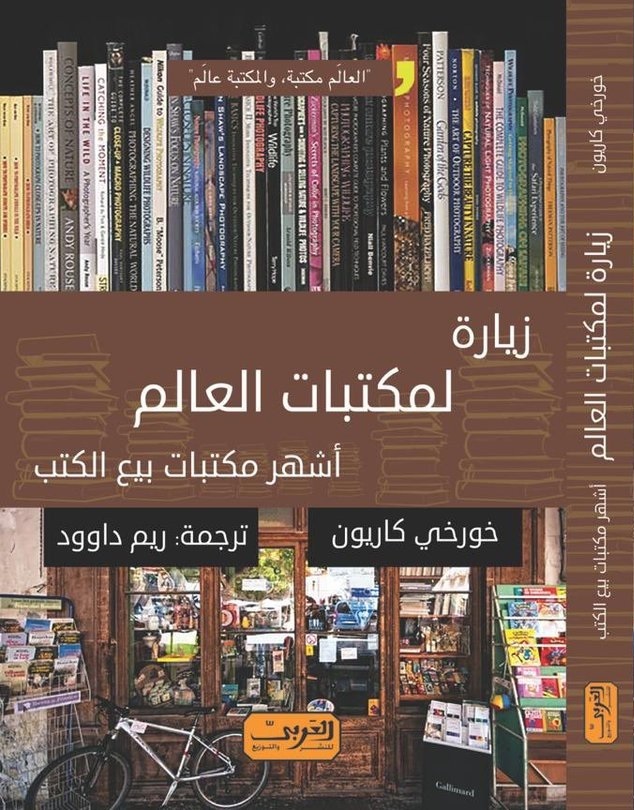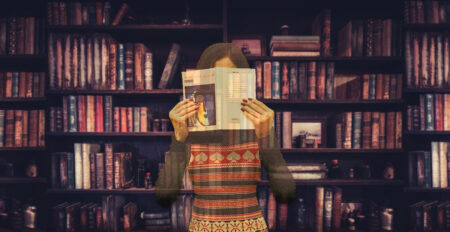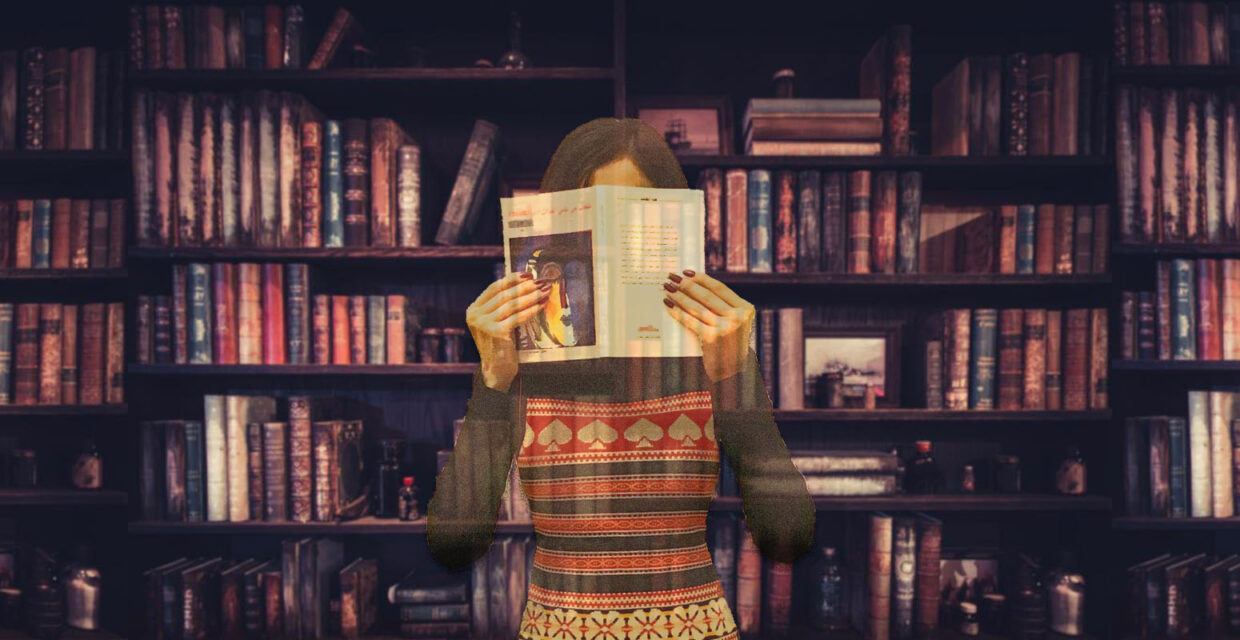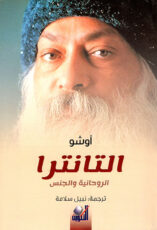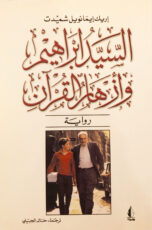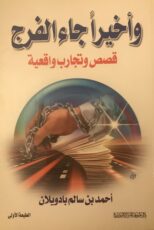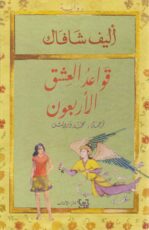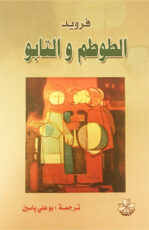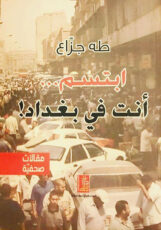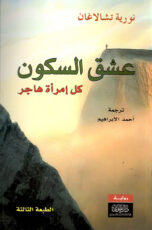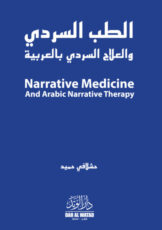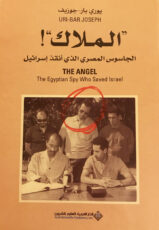| عدد |
اسم الكتاب |
المؤلف |
دار النشر |
التصنيف |
|
|
|
|
|
| 1 |
طرائف الخلفاء والملوك |
عبد. أ. علي مهنا |
دار الكتب العلمية – بيروت |
الأدب العربي |
| 2 |
طرائف الأصفهاني في كتاب الأغاني |
عبد. أ. علي مهنا |
دار الكتب العلمية – بيروت |
الأدب العربي |
| 3 |
المستطرف في كل فن مستظرف |
شهاب الدين الأبشيهي |
دار الكتب العلمية – بيروت |
الأدب العربي |
| 4 |
مختار الصحاح |
محمد عبدالقادر الرازي |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 5 |
طرائف عربية وطرائف غربية |
حنان ضاهر |
دار الحسام للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 6 |
خوارق مصرية حيرت العلماء |
ناصر فياض |
مكتبة مدبولي الصغير |
الأدب العربي |
| 7 |
كفر الهنادوة |
مصطفى حسين |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 8 |
افتح قلبك |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 9 |
أرجوك لا تفهمني |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 10 |
حصاد الصبر |
عبدالوهاب مطاوع |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 11 |
الشئ المكسور |
عبدالوهاب مطاوع |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 12 |
ساعات من العمر |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 13 |
الرسم فوق النجوم |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 14 |
ترانيم الحب والعذاب |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 15 |
حكايات شارعنا |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 16 |
وحدي مع الآخرين |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 17 |
أرجوك اعطني عمرك |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 18 |
أهلاً .. مع السلامة |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 19 |
قدمت أعذاري |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 20 |
صديقي ما أعظمك |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 21 |
صديقي لا تأكل نفسك |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 22 |
اندهش يا صديقي |
عبدالوهاب مطاوع |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 23 |
سلامتك من الآه |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 24 |
وقت للسعادة .. وقت للبكاء |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 25 |
من المفكرة الزرقاء |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 26 |
خاتم في إصبع القلب |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 27 |
عاشوا في خيالي |
عبدالوهاب مطاوع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 28 |
عالم الأسرار |
د. مصطفى محمود |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 29 |
أناشيد الأثم والبراءة |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 30 |
عصر القرود |
د. مصطفى محمود |
دار العودة – بيروت |
الأدب العربي |
| 31 |
يوميات نص الليل |
د. مصطفى محمود |
دار العودة – بيروت |
الأدب العربي |
| 32 |
الشيطان يسكن في بيتنا |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 33 |
عنبر7 |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 34 |
أكل عيش |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 35 |
الشيطان يحكم |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 36 |
نقطة الغليان |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 37 |
زيارة للجنة والنار |
د. مصطفى محمود |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 38 |
الذين ضحكوا حتى البكاء |
د. مصطفى محمود |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 39 |
الخروج من التابوت |
د. مصطفى محمود |
دار المعارف – القاهرة |
الأدب العربي |
| 40 |
حلم الحريم كلهم |
اسعاد يونس |
مكتبة مدبولي الصغير |
الأدب العربي |
| 41 |
كيمياء الفضيحة |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 42 |
الحب والفلوس والموت وأنا |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 43 |
هناك فرق |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 44 |
لحظات مسروقة |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 45 |
اتنين اتنين |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 46 |
عندي كلام |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 47 |
لعنة الفراعنة |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 48 |
كائنات فوق |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 49 |
أرواح وأشباح |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 50 |
لو جاء نوح |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 51 |
لعل الموت ينسانا |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 52 |
شباب شباب |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 53 |
هناك أمل |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 54 |
آه لو رأيت |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 55 |
حتى تعرف نفسك |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 56 |
نحن كذلك |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 57 |
أوراق على شجر |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 58 |
الحب الذي بيننا |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 59 |
دعوة للإبتسام |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 60 |
هموم هذا الزمان |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 61 |
وجع في قلب إسرائيل |
أنيس منصور |
الزهراء للإعلام العربي |
الأدب العربي |
| 62 |
الحائط والدموع |
أنيس منصور |
الزهراء للإعلام العربي |
الأدب العربي |
| 63 |
يا من كنت حبيبي |
أنيس منصور |
المكتب المصري الحديث |
الأدب العربي |
| 64 |
لعلك تضحك |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 65 |
السيدة الأولى |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 66 |
قل لي يا أستاذ |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 67 |
قالوا |
أنيس منصور |
المكتب المصري الحديث |
الأدب العربي |
| 68 |
من نفسي |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 69 |
ألوان من الحب |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 70 |
الذين هاجروا |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 71 |
مدرسة الحب |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 72 |
تعال نفكر معاً |
أنيس منصور |
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 73 |
جسمك لا يكذب |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 74 |
مذكرات شابة غاضبة |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 75 |
قلوب صغيرة |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 76 |
الخبز والقبلات |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 77 |
هي وغيرها |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 78 |
كرسي على الشمال |
أنيس منصور |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 79 |
القوى الخفية |
أنيس منصور |
المكتب المصري الحديث |
الأدب العربي |
| 80 |
هل لديك أقوال أخرى؟ |
علي سالم |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 81 |
وداعاً للطواجن |
محمود السعدني |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 82 |
مذكرات صائم |
أحمد بهجت |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 83 |
طرائف دبلوماسية |
السفير جمال بركات |
مركز الأهرام للترجمة والنشر |
الأدب العربي |
| 84 |
الفهامة |
أحمد رجب |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 85 |
الحب وسنينه |
أحمد رجب |
الوطن العربي للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 86 |
مذكرات نورا المذعورة |
اسعاد يونس |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 87 |
المتسولون |
اسعاد يونس |
دار الهدى للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 88 |
زوج مجرب |
محسن محمد |
دار الشروق للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 89 |
حكاوي البلاوي في الفن والصحافة |
حازم هاشم |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 90 |
الأشرار : لوحات ساخرة من مصر المعاصرة |
د. عمرو عبدالسميع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 91 |
النسوان : وثائق الحياة الاجتماعية في المحروسة |
د. عمرو عبدالسميع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 92 |
ملوك الهرجلة |
اسعاد يونس |
دار الهدى للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 93 |
هموم ضاحكة |
يوسف عوف |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 94 |
الضحك بسبب |
مختار السويفي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 95 |
نهارك سعيد |
أحمد رجب |
الوطن العربي للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 96 |
طرائف الأخطاء الصحفية والمطبعية |
منذر الأسعد |
مكتبة العبيكان |
الأدب العربي |
| 97 |
مسافر على الرصيف |
محمود السعدني |
مركز الأهرام للترجمة والنشر |
الأدب العربي |
| 98 |
الضحك بالراحة |
مختار السويفي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 99 |
صايع بالوراثة |
يوسف معاطي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 100 |
أيام الضحك والنكد |
علي سالم |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 101 |
فضائح السيسي بيه |
يوسف عوف |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 102 |
جريمة حب وحوادث أخرى |
محمود صلاح |
مكتبة مدبولي الصغير |
الأدب العربي |
| 103 |
حيجننوني |
يوسف عوف |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 104 |
الفن وأهله |
يوسف معاطي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 105 |
الهوامش لإبن قطامش |
ياسر قطامش |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 106 |
القلب في ورطة بين ليلى وبطة |
ياسر قطامش |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 107 |
عفاريت |
يوسف معاطي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 108 |
كلام فارغ |
أحمد رجب |
الوطن العربي للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 109 |
توتة توتة |
أحمد رجب |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 110 |
كلام يودي في داهية |
يوسف معاطي |
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 111 |
كذب المؤلفون ولو كتبوا |
يوسف معاطي |
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 112 |
عن العشاق سألوني |
يوسف معاطي |
دار المأمون للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 113 |
حكاية بنت روشة |
يوسف معاطي |
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 114 |
جواباتكوا |
يوسف معاطي |
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 115 |
عسل البنات |
يوسف معاطي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 116 |
التاريخ العريق للحمير |
مجيد طوبيا |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 117 |
اضحك مع الرياضيين |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 118 |
اضحك مع المساكين في خدمتك |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 119 |
اضحك معها ومعه |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 120 |
اضحك مع المرضى |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 121 |
اضحك مع أصحاب المهن |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 122 |
اضحك مع المحرومين : زفة العروس |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 123 |
اضحك مع الحموات في بيت الزوجية |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 124 |
شغل عقلك |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 125 |
ساعة لقلبك |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 126 |
طول عمرك |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 127 |
عريس خنفوس |
جوزف فاخوري |
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 128 |
مطرب الأخبار |
مصطفى حسين |
دار أخبار اليوم – مصر |
الأدب العربي |
| 129 |
نوادر الحمقى والمغفلين |
رحاب عكاوي |
دار الحرف العربي للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 130 |
هكذا يتحدث الكاريكاتير |
تاج |
دار آزال للطباعة والنشر والتوزيع – لبنان |
الأدب العربي |
| 131 |
المرأة وعشرة رجال |
طلعت همام |
مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشر |
الأدب العربي |
| 132 |
أقوال غير مأثورة |
محسن محمد |
مكتبة غريب |
الأدب العربي |
| 133 |
كليلة ودمنة |
عبدالله بن المقفع |
دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 134 |
كليلة ودمنة |
عبدالله بن المقفع |
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 135 |
أسطورة الأدب الرفيع |
د. علي الوردي |
دار كوفان للنشر – لندن |
الأدب العربي |
| 136 |
في رحاب اللغة العربية – مناهج وتطبيق |
د. عبدالرحمن عطبة |
دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 137 |
البخلاء |
الجاحظ |
دار صعب – بيروت |
الأدب العربي |
| 138 |
كلمات من طمي الفرات |
نخبة من الكتاب |
كتاب العربي |
الأدب العربي |
| 139 |
رسائل المناسبات |
سوفنيربوك هاوس |
سوفنيربوك هاوس – بيروت |
الأدب العربي |
| 140 |
متعة الحديث – تقريظ / أحمد القطان و عمرو خالد |
عبدالله الداوود |
مكتبة جرير |
الأدب العربي |
| 141 |
عاشقة الفجر : أدب الحب وحب الأدب |
خلود معطي |
مركز الراية للتنمية الفكرية |
الأدب العربي |
| 142 |
استراحة الأسبوع |
زهير قدورة |
استراحة الأسبوع |
الأدب العربي |
| 143 |
قاموس المترادفات والأضداد |
د. رضا عواضة |
رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 144 |
حديث الصباح |
أدهم شرقاوى |
دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |
الأدب العربي |
| 145 |
حديث المساء |
أدهم شرقاوى |
دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |
الأدب العربي |
| 146 |
الأدب الأندلسي |
د. سامي أبو زيد |
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة |
الأدب العربي |
| 147 |
ابتسم أنت في بغداد |
د. طه جزاع |
دار دجلة |
الأدب العربي |
| 148 |
دراسات في الأدب والنقد |
د. إبراهيم الشتوي |
المركز الثقافي العربي |
الأدب العربي |
| 149 |
طوق الحمامة : في الألفة والألاف |
ابن حزم الأندلسي |
دار صادر |
الأدب العربي |
| 150 |
البدائع والطرائف |
جبران خليل جبران |
دار العلم والمعرفة |
الأدب العربي |
| 151 |
الغزو الثقافي ومقالات أخرى |
د. غازي القصيبي |
المؤسسة العربية للدراسات والنشر |
الأدب العربي |
| 152 |
حديث العصافير: مقالات حبيسة الأدراج تنفست الصعداء |
أحمد البراك |
دار دريم بوك – الكويت |
الأدب العربي |
| 153 |
أوراق وأسمار |
باسل الزير |
مركز طروس للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 154 |
فقاقيع |
د. أحمد خالد توفيق |
دار كيان للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 155 |
زي ما بقولك كده – جزء 1 |
اسعاد يونس |
دار نهضة مصر للطبع والنشر |
الأدب العربي |
| 156 |
زي ما بقولك كده – جزء 2 |
اسعاد يونس |
دار نهضة مصر للطبع والنشر |
الأدب العربي |
| 157 |
لزوم ما لا يلزم – مجلد 1 |
أبو العلاء المعري |
دار النوادر |
الأدب العربي |
| 158 |
لزوم ما لا يلزم – مجلد 2 |
أبو العلاء المعري |
دار النوادر |
الأدب العربي |
| 159 |
النظرات – جزء1 |
مصطفى لطفي المنفلوطي |
دار الآفاق الجديدة |
الأدب العربي |
| 160 |
النظرات – جزء2 |
مصطفى لطفي المنفلوطي |
دار الآفاق الجديدة |
الأدب العربي |
| 161 |
النظرات – جزء3 |
مصطفى لطفي المنفلوطي |
دار الآفاق الجديدة |
الأدب العربي |
| 162 |
العبرات |
مصطفى لطفي المنفلوطي |
الابتكار للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 163 |
سأخون وطني: هذيان في الرعب والحرية |
محمد الماغوط |
دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 164 |
كابوس ليلة صيف |
د. طه جزاع |
دار الحكمة – لندن |
الأدب العربي |
| 165 |
رسالة التوابع والزوابع |
ابن شهيد الأندلسى |
دار صادر للطباعة والنشر – بيروت |
الأدب العربي |
| 166 |
من لغو الصيف |
طه حسين |
دار العلم للملايين |
الأدب العربي |
| 167 |
أن نلبس سروالاً قصيراً: نصوص ما فوق الركبة |
ابراهيم محمود |
دار سطور للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 168 |
العرب لا يحبون البصل: دراسة في متخيلات اللغة العربية |
ابراهيم محمود |
دار سطور للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 169 |
البقاء على قيد الكتابة |
عبدالعزيز محمد الخاطر |
المؤسسة العربية للدراسات والنشر |
الأدب العربي |
| 170 |
اهتزازات الروح: عشرة بحوث في أدب العرب وفكرهم |
أ. د. عيسى العاكوب |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 171 |
الأدب الصغير والأدب الكبير |
عبد الله بن المقفع |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 172 |
وحي القلم – الجزء الأول |
مصطفى صادق الرافعي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 173 |
وحي القلم – الجزء الثاني |
مصطفى صادق الرافعي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 174 |
وحي القلم – الجزء الثالث |
مصطفى صادق الرافعي |
الدار المصرية اللبنانية |
الأدب العربي |
| 175 |
اغتصاب كان وأخواتها |
محمد الماغوط |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 176 |
رسائل مي: صفحات وعبرات من أدب مي الخالد |
مي زيادة |
دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 177 |
لا نأسف علي الازعاج |
د. أحمد خيري العمري |
دار المعرفة للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 178 |
تدوين المجون في التراث العربي: عرض وكشف وتأويل |
د. عبدالله الرشيد |
دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 179 |
كتابات منسية |
مي زيادة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 180 |
المراحل |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 181 |
هوامش |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 182 |
في الغربال الجديد |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 183 |
الغربال |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 184 |
النور والديجور |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 185 |
زاد المعاد |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 186 |
كرم على درب |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 187 |
دروب |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 188 |
حوار بين رجلين |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 189 |
في مهب الريح |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 190 |
صوت العالم |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 191 |
ومضات |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 192 |
البيادر |
ميخائيل نعيمة |
نوفل / هاشيت أنطوان |
الأدب العربي |
| 193 |
الأعمال الكاملة – مجلد 1 |
مالك بن نبي |
دار الفكر للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 194 |
الأعمال الكاملة – مجلد 2 |
مالك بن نبي |
دار الفكر للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 195 |
الأعمال الكاملة – مجلد 3 |
مالك بن نبي |
دار الفكر للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 196 |
الأعمال الكاملة – مجلد 4 |
مالك بن نبي |
دار الفكر للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 197 |
الأعمال الكاملة – مجلد 5 |
مالك بن نبي |
دار الفكر للطباعة والنشر |
الأدب العربي |
| 198 |
برتقالة نيوتن في الإدارة |
إبراهيم السادة |
مطابع قطر الوطنية |
الأدب العربي |
| 199 |
مداد قلمي |
علي المحمود |
مطابع رينودا الحديثة |
الأدب العربي |
| 200 |
جنون آخر |
ممدوح عدوان |
دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 201 |
هكذا أفكر |
عارف حجاوي |
مدارات للأبحاث والنشر |
الأدب العربي |
| 202 |
هكذا أكتب |
عارف حجاوي |
مدارات للأبحاث والنشر |
الأدب العربي |
| 203 |
الاحلام المشرقية: بورخيس فى متاهات ألف ليلة وليلة |
عيسى مخلوف |
دار بتانة للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 204 |
بين الجزر والمد |
مي زيادة |
مركز إنسان للدراسات والاستشارات |
الأدب العربي |
| 205 |
وقائع عربية |
محمد المنسي قنديل |
دار الشروق للنشر |
الأدب العربي |
| 206 |
الرواية الفلسطينية: من سنة 1948 حتى الحاضر |
بشير أبو منة |
مؤسسة الدراسات الفلسطينية |
الأدب العربي |
| 207 |
اللغة العالية: العربية الصحيحة للمذيع والمراسل ولكل صحفي |
عارف حجاوي |
شبكة الجزيرة الإعلامية |
الأدب العربي |
| 208 |
الصحافة القطرية نحو الرقمية |
د. عبدالله العمادي |
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر |
الأدب العربي |
| 209 |
مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية في السيرة الذاتية |
ناهض زقوت |
وزارة الثقافة – فلسطين |
الأدب العربي |
| 210 |
الغريزة اللغوية |
ستيفن بنكر |
صفحة سبعة للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 211 |
الادب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال1948-1968 |
غسان كنفاني |
دار أسامة للنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 212 |
مغزى الناظر والسامع على تعلم العلم النافع |
ماء العينين الشنقيطي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 213 |
في الأدب الجاهلي |
طه حسين |
دار المعارف |
الأدب العربي |
| 214 |
العروض: العلم اللاعلم |
عارف حجاوي |
صفحات للدراسات والنشر |
الأدب العربي |
| 215 |
في الشعر الجاهلي |
طه حسين |
منشورات الجمل |
الأدب العربي |
| 216 |
وعلى سبيل الحياة |
أماني أحمد عثمان |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 217 |
العدوانية في النص الروائي العراقي |
آلاء السعدي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العربي |
| 218 |
اخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة |
محمد الضبع |
دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |
الأدب العالمي |
| 219 |
الفضول |
ألبرتو مانغويل |
دار الساقي – بيروت |
الأدب العالمي |
| 220 |
كتاب اللاطمأنينة |
فرناندو بيسوا |
المركز الثقافي العربي – المغرب |
الأدب العالمي |
| 221 |
الكتب مقابل السجائر |
جورج أورويل |
دار مدارك للنشر |
الأدب العالمي |
| 222 |
تجليات بورخيس |
حسونة المصباحي |
خطوط وظلال للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 223 |
حوارات حول الطغيان: ونصوص أخرى |
فرناندو بيسوا |
خطوط وظلال للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 224 |
رسالة إلى شاعر شاب |
فيرجينيا وولف |
خطوط وظلال للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 225 |
الحنين إلى الممكن |
أنطونيو تابوكي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 226 |
فضائح الترجمة |
لورانس فينتى |
المركز القومي للترجمة |
الأدب العالمي |
| 227 |
بورخس وأنا: حوارات وأسرار تنشر لأول مرة |
لوركا وآخرون |
دار سطور للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 228 |
حياة الكتب السرية: ليلة قرأ فرانكشتاين دون كيخوت |
سانتياغو بوسيغيو |
دار مسكيلياني للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 229 |
شخصيات حية من الأغاني |
محمد قنديل |
دار الكرمة |
الأدب العالمي |
| 230 |
ثنائيو اللغة |
فرانسوا جروجون |
هنداوي للطباعة والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 231 |
مع فرناندو بيسوا: قراءة نقدية في كتاب اللاطمأنينة |
كميل أبو حنيش |
دار طباق للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 232 |
مختارات من الأدب العبري المؤسس |
أنطوان شلحت |
الدار الأهلية للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 233 |
لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي |
إيتالو كالفينو |
دار المدى للنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 234 |
متعة الأدب |
بورخيس |
منشورات حياة |
الأدب العالمي |
| 235 |
رسائل إلى شاعرة |
غوستاف فلوبير |
دار الرافدين |
الأدب العالمي |
| 236 |
نظرات سايكولوجي في الحب |
ثيودور رايك |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 237 |
أشياء لن تسمع بها أبداً |
نعوم تشومسكي |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 238 |
أنشودة الحب |
جان جينيه |
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |
الأدب العالمي |
| 239 |
A Letter to a Young Poet |
Virginia Woolf |
Read & Co. Classics |
الأدب العالمي |